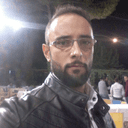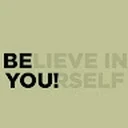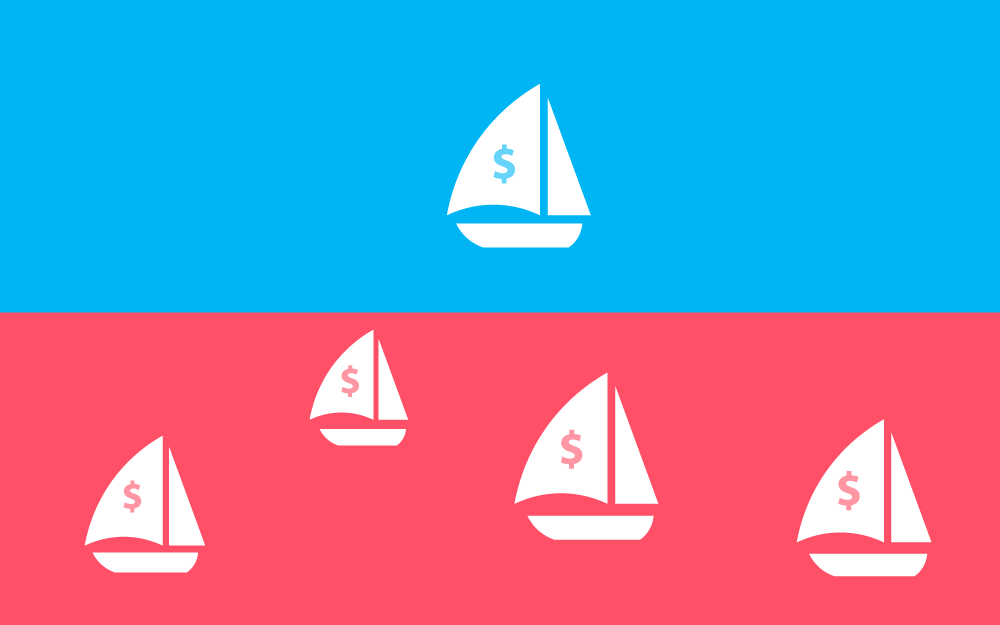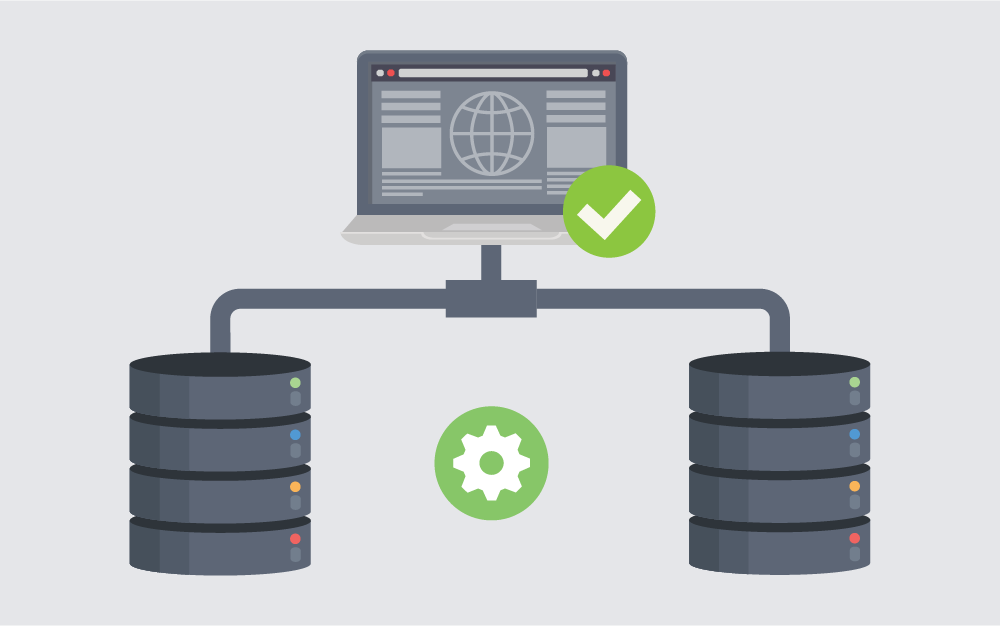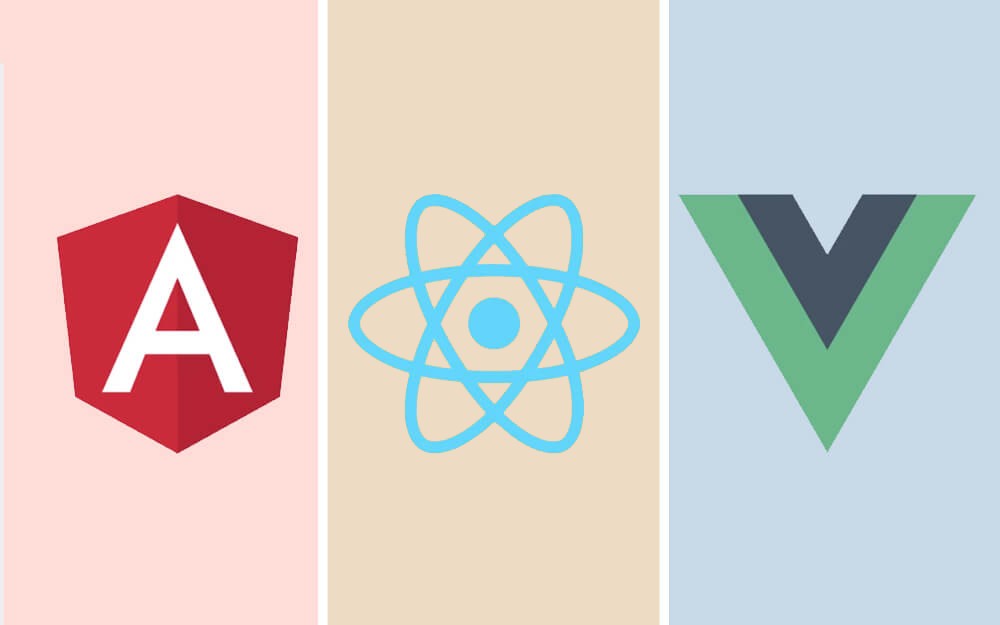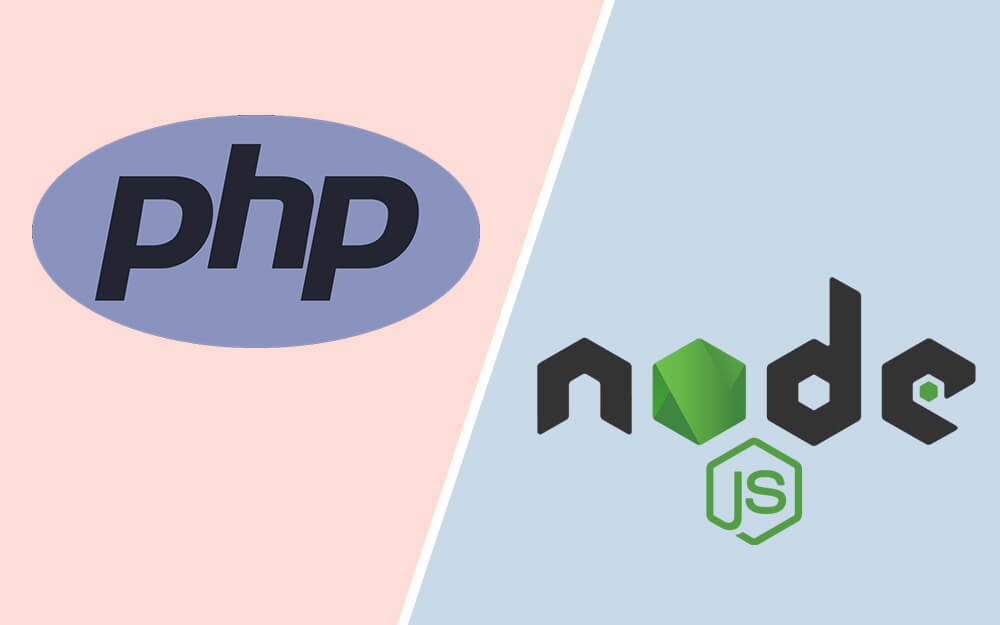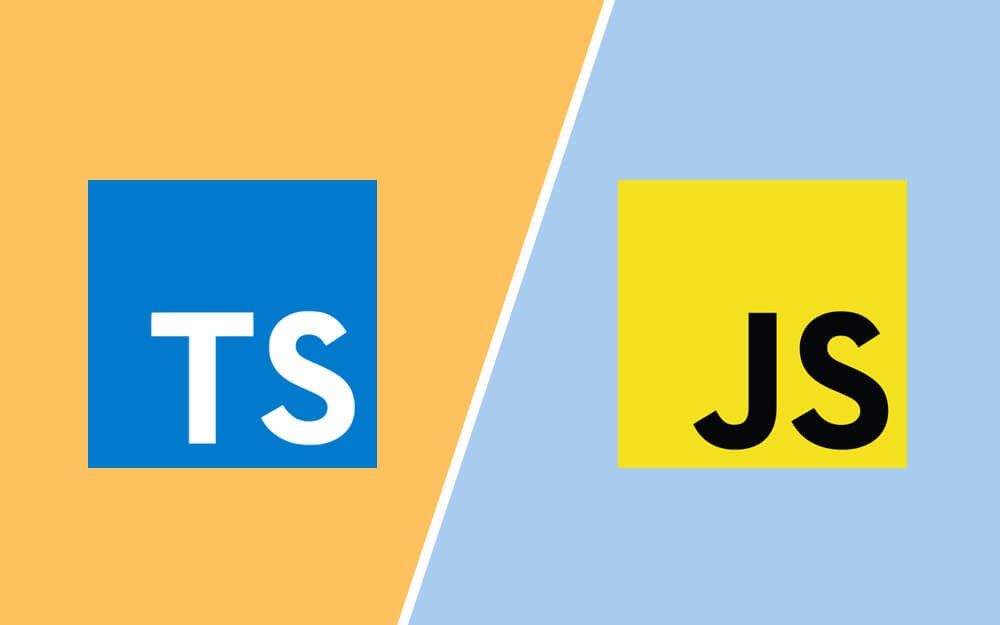-
المساهمات
64 -
تاريخ الانضمام
-
تاريخ آخر زيارة
المعلومات الشخصية
-
النبذة الشخصية
طالب ماجستير في تقينات الويب، مهتم في المواضيع التقنية والذكاء الصنعي والعلامات التجارية والاقتصاد عمومًا، أسعى لمشاركة أفكاري وتجاربي من خلال الكتابة وذلك للمساهمة في تطوير المحتوى العربي وتحسينه.
آخر الزوار
7473 زيارة للملف الشخصي
إنجازات Mohamed Lahlah

عضو نشيط (3/3)
47
السمعة بالموقع
-
حسام أحمد3 بدأ بمتابعة Mohamed Lahlah
-
Ali Ahmed39 بدأ بمتابعة Mohamed Lahlah
-
Majidj Saeed بدأ بمتابعة Mohamed Lahlah
-
تبنى مديرو الشركات والمستهلكون في السنوات الأخيرة وجهات نظر متباينة حول جودة المنتج، إذ تشير العديد من الدراسات الاستقصائية الحديثة إلى مدى اتساع فجوة إدراك الجودة بين عقل المستهلك والحقيقة. ومن أجل سدّ هذه الفجوة، لجأت العديد من الشركات إلى الأساليب الترويجية لتحسين صورتها أمام عملائها واستعراض قوة منتجاتها وجودتها. تتجلى هذه الجهود في اتجاهين؛ الاتجاه الأول: وهو التركيز الأكبر على جودة الإعلانات والمحتوى والكلمات والموضوعات المراد إيصالها للمستهلك، مثل الموثوقية والمتانة والاتقان. فعلى سبيل المثال، تعلن شركة فورد Ford لصناعة السيارات على أن "الجودة هي الميزة الوظيفة الأولى في سيارتها". الاتجاه الثاني: هو الانتقال إلى الضمان الحقيقي للجودة وبرامج خدمات ما بعد البيع. فمثلًا، تقدم كرايسلر Chrysler ضمانًا لمدة خمس سنوات أو 80467 كيلو متر (أي 50000 ميل)؛ في حين أن بعض الشركات الأخرى تقدم خدمات ما بعد البيع بطريقة أخرى، إذ تتعهد شركة Whirlpool Corporation مثلًا بأن الأجزاء لجميع الموديلات ستكون متاحةً لمدة 15 عامًا؛ أما شركة Hewlett-Packard المعروفة بالاختصار HP، فتمنح العملاء ضمان خدمة وقت التشغيل بنسبة 99٪ على أجهزة الحاسوب الخاصة بها. إن معرفتنا في كيفية تصور المستهلك للجودة، ستُفيدنا في الإدارة الفعالة للأفراد في الشركة، ومع ذلك، نادرًا ما نستطيع العثور على المقالات الأكاديمية الواضحة لتطبيق هذا الأمر. نسعى في هذا الطرح أن يدرك الجميع مدى أهمية الجودة المدركة ليس فقط الأكاديميون، وإنما المسوقون ومديرو العلامات التجارية، وكذا مديري التسويق ومديري الاتصالات التسويقية أيضًا، وذلك لكي يستكشفوا هذا المفهوم بعمق ويستثمر في تعزيز وتطوير جودة المنتج المتصورة في عقول العملاء. وعمومًا، عند تطوير منتجات أو خدمات ذات جودة عالية، غالبًا ما تفشل الشركات في مراعاة مجموعة من الأسئلة وهي: كيف يحدد العملاء الجودة؟ لماذا يطالبون فجأةً بجودة أعلى مما كانت عليه في الماضي؟ ما هي أهمية الجودة العالية في خدمة العملاء؟ كيف يمكن ضمانها بعد البيع؟ تبدو هذه الأسئلة للوهلة الأولى عادية، إلا أن الإجابات ليست سهلة، ولكن بمجرد إجابتنا عليها، سنستطيع بناء معلومات أساسية حول كيفية إنشاء برنامج جودة فعال يحركه العميل. ويجب ألا ننسَ أن العملاء هم بمثابة الحكم النهائي للجودة في السوق. ما هي الجودة المدركة Perceived Quality حاول العديد من الباحثين تحديد تعريف مفهوم الجودة المدركة. فمثلًا، يرى زيتامل بأن الجودة المدركة هي "حكم المستهلك على الامتياز العام للمنتج أو تفوقه"، كما يعتقد بأن من خصائص الجودة المدركة هي: تختلف الجودة المدركة عن الجودة الحقيقة. صفة عالية المستوى ومجردة أكثر من كونها إحدى ميزات منتج معين. تُعَد تقييمًا عامًا وتشبه الحالة الموقفية تجاه منتج ما. حكم يُتخذ عادةً على منتج ضمن مجموعة مستحضرة من المنتجات Evoked Set. أما أكار Aaker فيرى بأن تعريف الجودة المدركة هو "تصور العميل للجودة الشاملة أو تفوق المنتج أو الخدمة فيما يتعلق بالغرض المقصود منها بالمقارنة مع البدائل". وبالرغم من وجود الكثير من التعريفات من العديد من الباحثين، إلا أن كل تعريف له معنى مشترك؛ أي أن جودة المنتج المدركة هي تصور المستهلك للمكونات الإجمالية للمنتج، بمعنى الخصائص الملموسة وغير الملموسة. ويمكن أن تشمل أيضًا الأداء والميزات والموثوقية والتوافق والمتانة، وإمكانية تقديم خدمة ما بعد البيع، والجماليات وما إلى ذلك؛ كما يرى أكار بأن الجودة المدركة تختلف عن الجودة الفعلية Real Quality للمنتجات والخدمات. علاقة الجودة المدركة مع شكل المنتج يختلف تصور المستخدم لجودة المنتج وطريقة فحصه لها عن طريقة فحص الحكومات ومنظمات الجودة العالمية، مثل المنظمة الدولية للتقييس International Organization for Standardization، ويشار إليها بأيزو ISO، وذلك إشارةً إلى شهادات الجودة الخاصة بها، إذ تفحص هذه المنظمات الجودة من خلال فريق هندسي مختص، والذي يقيس معايير نجاح المنتج وفشله في الاختبارات المتنوعة، وفي تحقيق وظيفته الأساسية، وقيم التسامح مع النتائج الخاصة به، ودقة الأبعاد، وتحليل العيوب الهيكلية والعديد من الأمور الأخرى. أما المستهلك فله طريقة أخرى لفحص الجودة، فعندما يذهب إلى السوق لشراء منتج ما، فلن يجلب معه مسطرةً لمعرفة ما إذا كانت أبعاد المنتج صحيحة، كما تنص المواصفات الموجودة على غلاف المنتج أو في الدليل الإرشادي، ومن المحتمل ألّا يحكم بوعي على مكون معين أو تفاصيل المنتج الدقيقة، وسوف يحكم غريزيًا على الجودة الإجمالية للمنتج بناءً على نظرة سريعة على المنتج ربما لمدة 10 إلى 15 ثانية. وإذا كان المستهلك مهتمًا فعلًا بمعرفة المزيد عن المنتج، فعندها سيحاول التفاعل معه بقدر ما يسمح له مسؤول المتجر. بعد ذلك سينتقل لإلقاء نظرة على منتجات مماثلة للموازنة، وأخيرًا، سيقرر أي المنتجات سيشتري. في الحقيقة، يمكن أن يتأثر حكمهم دون وعي بسبب الاختلالات الصغيرة أو الخدوش والعيوب الأخرى الموجودة في المنتج أو الغلاف (العبوة)، مما يؤدي إلى تعميم هذا التصور على جميع المنتجات الأخرى للعلامة التجارية. ولتوضيح الفكرة أكثر، لنأخذ هذا المثال التالي: لدينا عبوتان مخصصتان لتعبئة المياه، لنلقِ عليهما نظرةً في الصورة التالية نلاحظ بأن المنتجين لهما نفس وظيفة تخزين المياه، وأنهما متشابهين في الحجم، ولكن كيف سيحكم العملاء على الجودة من خلال الشكل؟ إذا دققنا النظر في زجاجة المياه البيضاء، فسنُلاحظ وجود خط أسفل الزجاجة. ينتج هذا الخط عن طريقة الإنتاج التي تتبعها الشركة وغالبًا ما يمكن تفاديها، غير أن هذا الخط يمكن أن يُشعر المستهلك بأن الزجاجة تتكون من مكونين على عكس مظهر الزجاجة الأرجوانية التي توحي بأنها تتألف من مكون الواحد. في الواقع، إن هذا الخط يكسر الاستمرارية البصرية Visual Continuity للزجاجة وسيؤثر على جمالية الزجاجة وتصميمها، فبالرغم من إمكانية أن تكون وظيفتها -حفظ الماء- فعالة جدًا، إلا أن المستهلك يمكن أن يرى ذلك عيبًا فيها، ومن جانب آخر نلاحظ أن العبوة الأرجوانية لديها مظهر متسق وانسيابي. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ بأنه يمكن أن يكون ملمس الزجاجة البيضاء اللامعة أملس ومختلف عن الزجاجة الأرجوانية ذات الملمس الخشن، بالتالي يمكن أن يعطي ذلك شعورًا بالجودة، كما يمكن أن يمثل هذا السطح اللامع إشارةً للمتانة المنخفضة، وذلك لأن السطح اللامع يمكن خدشه بسهولة أكبر من السطح غير اللامع، كما أن الخدوش ستكون أكثر وضوحًا عليه. وبالتالي يمكن أن يهتم العملاء أيضًا بقدرة الزجاجة على إبقاء المياه باردة -أو ساخنة- لأطول فترة زمنية ممكنة؛ وفي هذه الحالة، سيكون الحفاظ على درجة حرارة المياه جانبًا من جوانب وظائف المنتج. وبالرغم من صعوبة تقدير ذلك بمجرد النظر إلى الزجاجة في المتجر، إلا أن تغيير لون العبوة الأرجواني إلى الأزرق الفاتح مع إضافة صور كرات ثلجية على العبوة يمكن أن يعزز من تصور العميل لجودة العبوة، ألا تتفق معي في ذلك؟ في الحقيقة تختلف طريقة ملاحظة الجودة بحسب المنتجات والمستهلكين والصناعة، ولكل حالة لها طريقة معينة في إظهار جودة منتجها وتميزها عن منافسيها، فطريقة تفاعل المستهلكين مع المنتج الصناعي تختلف عن طريقة المنتج العادي، ويجب أخذها في الحسبان عند تطوير أي نوع من المنتجات أو الخدمات. تختلف الطريقة التي تدمج بها كل شركة الجودة المدركة في منتجاتها، لكن الطريقة التي تؤثر بها على المستخدم النهائي متشابهة جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجودة المدركة لها تأثير كبير على تجربة المستخدم ويمكن أن يجعلها أكثر إمتاعًا إذا أُخذت بالحسبان مُبكرًا في مراحل تطوير المنتج. تؤثر الجودة المدركة كثيرًا على الطريقة التي يرى بها المستخدمون منتجًا معينًا وحتى علامة تجارية، مما يجعل منتجًا أو علامةً تجاريةً معينةً تبرز عن منافسيها. وتضيف الجودة المدركة الكثير من الفوائد للشركات والعلامات التجارية لنستعرض بعضًا من هذه الفوائد في الفقرة التالية. أهمية الجودة المدركة للمنتجات والخدمات هناك تعطش سائد لإظهار أن الاستثمار في قيمة العلامة التجارية Brand Equity سيؤتي ثماره، بالرغم من صعوبة ربط الأداء المالي بأي أصل غير ملموس (سواءً تعلق الأمر بالأشخاص أو التكنولوجيا أو قيمة العلامة التجارية)، إلا أن الشركات مع ذلك استثمرت في تعزيز قيمة العلامة التجارية وانتشرت هذا الأمر في العديد من الشركات الأخرى، مما استدعى انتباه الباحثين لهذا الأمر ليبدأوا بعد ذلك في دراسة جدوى استثمار الشركات في تعزيز قيمة العلامة التجارية. ومن بين الباحثين، كان هنالك الباحث ديفيد أكار David Aaker الذي اهتم بهيكلة طريقة الاستثمار في قيمة العلامة التجارية ونشر العديد من الأبحاث والكتب، ومن هذه الكتب، كتاب "بناء علامات تجارية قوية Building Strong Brands". شرح ديفيد في هذا الكتاب كيف يمكن للجودة المدركة أن تساعد في تعزيز ربحية الشركات والعلامات التجارية من استعراضه لثلاث دراسات جاء فيها: أظهرت الدراسة الأولى التي تستخدم قاعدة بيانات PIMS (البيانات السنوية التي تقيس أكثر من مئة متغير لأكثر من 3000 وحدة عمل) أن الجودة المدركة هي أهم مساهم في عائد الشركة على الاستثمار Return On Investment، ولها تأثير أكبر من الحصول على حصة سوقية أكبر، أو الاستثمار في البحث والتطوير، أو زيادة نفقات التسويق. بل يمكن أن تساهم الجودة المدركة في ربحية الشركة جزئيًا من خلال تحسين الأسعار وزيادة الحصة السوقية. كشفت دراسة أخرى مدتها خمس سنوات أجراها كلايس فورنيل وزملاؤه في المركز القومي لأبحاث الجودة بجامعة ميشيغان على 77 شركة في السويد، ووجدوا بأن الجودة المدركة كانت الدافع الرئيسي لرضا العملاء، والذي بدوره له تأثير كبير على زيادة العائد على الاستثمار. أظهرت الدراسة الثالثة والتي شملت 33 شركة مدرجة في البورصة على مدى أربع سنوات، أن الجودة المدركة كان لها تأثير على ربحية السهم والعائد على الاستثمار عليه. نظرت الدراسة في شركات مثل American Express و AT&T و Avon و Citicorp و Coke و Kodak و Ford و Goodyear و IBM و Kellogg’s و 23 شركة أخرى حققت لها العلامة التجارية للشركة قدرًا كبيرًا من المبيعات والأرباح. وعمومًا، يمكن تلخيص أهم فوائد الجودة المدركة على الشكل التالي: 1. زيادة هوامش الأرباح والمبيعات نظرًا لزيادة الجودة المدركة في أعين وعقول المستهلكين، فستكون أكبر ، وعندها يمكن رفع أسعار أرباح المنتجات بالمقارنة مع المنافسين بدون أن نرى أي تذمر من المستهلكين، في الحقيقة، يمكن أن يفسر المستهلكون بأن زيادة الأسعار لمصلحتهم في المستقبل من خلال إعادة استثمار الشركة في مراكز البحث والتطوير لصناعة منتجات جديدة تعزز من جودة حياة العملاء. 2. قوة العلامة التجارية والحصة السوقية قد تؤدي جودة المنتج المتصورة إلى قوة العلامة التجارية وحصة السوق المهيمنة لنتأمل الشكل التالي. نلاحظ من الشكل التالي بأن رواد الأعمال وأصحاب الشركات لديهم إحساس واضح باحتياجات ورغبة مجموعة محددة من العملاء، فهم ينتجون المنتجات ويقدمون الخدمات المرتبطة التي تلبي تلك الاحتياجات بطريقة جيدة للغاية، تضمن تدابير مراقبة الجودة الفعالة تلبيتهم للاحتياجات بطريقة صحيحة في المرة الأولى عند تقديم تلك المنتجات والخدمات، لذلك فهم يحققون جودةً عاليةً في المجالات التي تهم العميل مع هيكل تكلفة لا يزيد عن تلك الخاصة بالمنافسين الأقل جودة. بعد ذلك، يعلنون عن مزايا منتجاتهم الإضافية والمميزة. وعندها سيُدرك العميل الجودة والقيمة الاستثنائية التي تقدّمها الشركة لتستطيع الشركة في نهاية المطاف الحصول على علامة تجارية قوية وتليها حصة سوقية مهيمنة. 3. زيادة قيمة العلامة التجارية Brand Equity بما أن الجودة المدركة هي أحد الأبعاد الرئيسية لقيمة العلامة التجارية، فإن أي زيادة في الجودة المدركة تصحبها زيادة قيمة العلامة التجارية الأمر، الذي يساعد الشركة على زيادة كفاءة وفعالية برامج التسويق والولاء للعلامة التجارية، وتوسعات العلامة التجارية المستقبلية، والعديد من المزايا التنافسية الأخرى. علاوةً على ذلك، يمكن أن تكون جودة المنتج المدركة أساسًا لتوسع العلامة التجارية، فإذا كانت العلامة التجارية تحظى بتقدير جيد في سياق صناعة السيارات، فعندها سيكون أي توسع للعلامة التجارية مثل صناعة الشاحنات أو الدرجات الآلية، بمثابة تصور للعملاء عنه أنه ذو جودة عالية. بالتالي يمكن للإدراك العالي للجودة أن يوفر على العملاء ما يلي: تجنب صعوبة تفسير ومعالجة المعلومات. الثقة في قرار الشراء. الرضا عن عملية الشراء. 4. القيمة المدركة Perceived Value تعرّف القيمة المدركة بأنها التقييم العام للعميل لفائدة المنتج أو الخدمة، بناءً على التصورات المبنية لما استلمه وقدمته له الشركة من خلال المنتج أو الخدمة (على سبيل المثال، تكون القيمة المدركة لخدمة تنظيف البيوت هي النظافة التي يشعر بها العميل بعد مغادرة عمال الشركة). توفر القيمة المدركة تصورًا واضحًا للعلامة التجارية وللقيمة التي تقدمها، مما يجعل القيمة المدركة سببًا محوريًا للشراء، كما أن الجودة المدركة ستؤثر على العلامات التجارية التي تُضمن، وتستبعد من مجموعة الاعتبار Consideration Set، وهي مجموعة صغيرة من العلامات التجارية التي يوليها المستهلك اهتمامًا وثيقًا عند اتخاذه لقرار الشراء لحل مشكلة أو تلبية الحاجة التي يواجهها. 5. زيادة العائد على الاستثمار Returns on Investment بما أن الشركة سيكون لها حضورًا قويًا في السوق وفي أذهان العملاء، فعندها سيؤتي أي استثمار فيها ثماره؛ لأن نجاح الشركة أو العلامة التجارية في اقناع المستهلكين بالجودة الحقيقية للمنتج سيعزز من ربحيتها والعائد على الاستثمار Returns on Investment، حتى وإن استثمرت المال في أقسام البحث والتطوير، والتي تكون نتائجها على المدى البعيد نسبيًا. أبعاد جودة المنتج المدركة يختلف المستهلكون بحسب المنطقة الجغرافية والثقافات والأذواق. ومع هذا الاختلاف، تبرز أهمية الاهتمام بالجودة الخاصة بعقل كل مستهلك. ومن هذا المنطلق، ظهرت فكرة أبعاد الجودة التي يمكن أن يَعُدها المستهلك قيّمةً، ومن هذه الأبعاد نذكر الآتي: الأداء Performance: المستويات التي تعمل فيها خصائص المنتج الأساسية (مستوى منخفض ومتوسط ومرتفع ومرتفع جدًا). فبالنسبة للسيارات مثلًا، يمكن أن تشمل هذه سمات التسارع وناقل السرعة وسرعة الانطلاق؛ أما بالنسبة لجهاز التلفاز، فإنها ستشمل وضوح الصوت والصورة واللون والقدرة على استقبال المحطات البعيدة وهكذا. المميزات Features: عناصر المنتج الثانوية والتي تكمل الخصائص الأساسية. تشمل الأمثلة المشروبات المجانية على متن طائرة، وأجهزة التوليف الأوتوماتيكية على جهاز التلفاز القديمة. الاتساق مع مواصفات المنتج Conformance with Specifications: درجة مطابقة المنتج للمواصفات، ويكون خاليًا من العيوب، وهي نظرة تقليدية للجودة موجهة نحو التصنيع. الاعتمادية Reliability: وهو اتساق الأداء من كل عملية شراء إلى التي تليها، أي أنها الاستمرارية في جودة الأداء مع مرور الوقت. عادةً ما يولي المصنعون اليابانيون اهتمامًا كبيرًا لهذا البعد من الجودة المدركة، ويستخدمونه لاكتساب ميزة تنافسية في صناعات السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وأشباه الموصلات، وآلات النسخ. المتانة Durability: وهي العمر الاقتصادي المتوقع للمنتج، أي إلى متى سيستمر المنتج بالعمل بطريقة صحيحة؟ لطالما جعلت شركة فولفو لصناعة السيارات سيارتها متينةً، بحيث يعكف المستهلكون لشراء هذا النوع من المنتجات في أوقات الأزمات والكساد. قابلية الإصلاح Serviceability: سهولة إصلاح المنتج أو صيانته والسرعة والكفاءة في إصلاحه. بدأ عدد من الشركات في التأكيد على هذا البعد للجودة المدركة، إذ تتعهد شركة كاتربيلر Caterpillar مثلًا بأنها ستوفر قطع غيار في أي مكان في العالم في غضون ثمانية وأربعين ساعة، كما أن ضمانات مرسيدس لخدمات 24 ساعة في كاليفورنيا وأريزونا تظهر أنه حتى كبار المنتجين يعتقدون أن هذا النهج له قيمة. الملائمة واللمسات النهائية Fit and Finish: يشير إلى المظهر والشعور بالجودة، ويُعَدّ هذا البُعد مهمًا لأن العملاء يستطيعون الحكم عليه بسهولة من نظرتهم للمنتج، وعادةً ما يكون الافتراض هو أنه إذا لم تستطع الشركة إنتاج منتجات ملائمة وذات ذات مظهر جيد، فمن المحتمل ألا تحتوي المنتجات على سمات الجودة الأخرى، فبالنسبة لشركات السيارات مثلًا، يمكن أن ينعكس بُعد الملائمة واللمسات النهائية من خلال جودة طلاء السيارة وملاءمة الأبواب. من الأبعاد المختلفة للجودة المدركة، يمكن استنتاج أن جودة المنتج المدركة يمكن أن تختلف عن الجودة الفعلية للمنتجات (جودة التصنيع) كثيرًا؛ أي على الرغم من أن الجودة الفعلية للمنتجات جيدة، إلا أنه من الممكن أن يُنظر إلى المنتجات بطريقة سلبية. وبالتالي يجب الاهتمام بالبعد المناسب للجودة بحسب المستهلك والسوق والصناعة. المؤثرات على الجودة المدركة تتأثر الجودة المدركة بالعديد من الأمور يمكن تقسيم هذه المؤثرات إلى نوعين وهما: 1. الإشارات الداخلية Intrinsic Cues وهي الخصائص الفيزيائية للمنتج نفسه، بما في ذلك الحجم أو اللون أو النكهة أو المظهر أو الرائحة. يمكن للمستهلكين استخدام هذه الخصائص الفيزيائية للحكم على جودة المنتج. ولذلك تستثمر بعض الشركات بكثافة في تحسين الخصائص الداخلية لمنتجاتها. فعلى سبيل المثال، استأجر قسم كاديلاك التابع لشركة جنرال موتورز شركة تصميم السيارات الإيطالية Pininfarina من أجل تصميم سيارة Allante الجديدة لإضفاء مظهر أوروبي عليها. 2. الإشارات الخارجية Extrinsic Cues هي السمات التي لا تشكل جزءًا من المنتج المادي. مثل السعر، أو صورة العلامة التجارية، أو صورة الشركة المصنعة، أو صورة متجر البيع بالتجزئة، أو بلد المنشأ، أو قنوات التوزيع، أو صورة العلامة التجارية، أو الشهادات، أو الضمان، أو الإعلان، أو الحصة السوقية، أو اسم العلامة التجارية، أو اسم المتجر. تشير التجارب العملية إلى أن تصورات المستهلك لجودة المنتج تتشكل على أساس مجموعة من الإشارات الخارجية، وذلك لأنه لا يمكن للمستهلكين استخدام الخصائص المادية للحكم على جودة المنتج بسهولة في بعض الحالات، بالتالي يمكن عندها استخدام الإشارات الخارجية، ولذلك لا ينبغي لممارسي التسويق التغاضي عن هذه الإشارات. بناء تصورات واضحة عن جودة المنتجات عادةً ما يكون تحقيق تصورات الجودة أمرًا مستحيلًا ما لم يكن للمطالبة بالجودة مضمونًا. ويتطلب تحقيق الجودة العالية فهم ما تعنيه الجودة لشرائح العملاء، فضلًا عن ثقافة داعمة وعملية تحسين الجودة التي ستمكن المنظمة من تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. ومع ذلك، فإن إنشاء منتج أو خدمة جيدة هو انتصار جزئي فقط؛ إذ يجب إنشاء تصورات في أذهان العملاء أيضًا. ومن المشاكل التي تواجهها الشركات والعلامات التجارية عند السعي إلى بناء تصور عن الجودة، نجد الآتي: تأثر المستهلكين تأثرًا مفرطًا بالصورة السابقة للمنتجات ذات الجودة الرديئة، ولهذا السبب يمكن ألّا يصدقوا الادعاءات الجديدة، أو لا يكونون مستعدين لتخصيص الوقت للتحقق منها. وجدت كل من الشركات Suntory Old Whisky و Audi automobile و Schlitz بأن صنع منتجات ممتازة لم يكن كافيًا لمحو شكوك المستهلكين التي أثارتها جودة المنتجات السيئة سابقًا، وأحيانًا يكون من المستحيل إقناع المستهلكين. يمكن أن تحقق الشركة الجودة في بُعد لا يراه المستهلكون مهمًا. فمثلًا، عندما أراد مصرف سيتي بانك Citibank أحد أكبر المصارف في العالم زيادة كفاءة المكاتب الخلفية وتسريع العمليات في البنك أكثر من خلال أتمتة أنشطة المعالجة الخاصة بها، كان التأثير المتوقع على تقييمات العملاء مخيبًا للآمال، فقد اتضح أن العملاء إما لم يلاحظوا التغييرات، أو لم يدركوا أي فائدة منها؛ لذلك يجب التأكد من أن الاستثمارات في الجودة تحدث في المجالات التي سيكون لها صدى لدى العملاء. نادرًا ما يمتلك المستهلكون جميع المعلومات اللازمة لإصدار حكم منطقي وموضوعي على الجودة، حتى إذا كانت لديهم المعلومات، إذ يمكن أن يفتقروا إلى الوقت والحافز لمعالجتها. ونتيجةً لذلك، فإنهم يعتمدون على واحد أو اثنين من الإشارات التي يربطونها بالجودة؛ ويُعَدّ مفتاح التأثير على الجودة المدركة هو فهم وإدارة هذه الإشارات بطريقة صحيحة، ولذلك من المهم فهم الأشياء الصغيرة التي يستخدمها المستهلكون كأساس لإصدار حكم على الجودة. غالبًا ما يفتقر المستهلكون لمعرفة أفضل السبل للحكم على الجودة، ولذلك في بعض الأحيان إلى الإشارات الخاطئة، وفي هذه الحالة يجب أن تصحح الشركة طريقة الحكم على الشركة ومنتجاتها. من المهم أن يجعل جميع مديري التسويق جودة المنتج المتصورة تتطابق مع الجودة الفعلية. إذا كانوا متأكدين من أن منتجاتهم ذات جودة فعلية وحقيقة. ولتحقيق ذلك، يُنصح باتباع هذه الملاحظات التالية: توصيل فكرة الجودة بصورة مستمرة: يجب عليك توصيل المعلومات حول جودة المنتج لعملائك بصورة مستمرة باستخدام أدوات الاتصالات التسويقية المتكاملة، مثل: الإعلانات، والعلاقات العامة، وترويج المبيعات، والتسويق المباشر، والبيع الشخصي وما إلى ذلك. لا تبالغ في التحدث عن جودة منتجاتك: بالرغم من أن منتجاتك ذات جودة عالية، إلا أن كثرة التباهي بالجودة سيجعل العملاء يبالغون في توقعاتهم أيضًا ليشعروا بأن المنتجات لا يمكن أن ترضيهم كما توقعوا، وهذا سيخلق استياءً من العلامة التجارية. لن تؤدي التكتيكات الترويجية وحدها المهمة هنا، وذلك لأن العملاء يمكن أن ينظروا إليها على أنها حيل. الاعتناء بالصورة الكاملة للعلامة التجارية: يجب الانتباه إلى سياسة الأسعار وصورة المتجر والإعلان والضمانات التي تقدمها الشركة وصورة العلامة التجارية وما إلى ذلك، كما يمكن أن تؤثر هذه العوامل على جودة المنتج المدركة تأثيرًا مباشرًا. فمثلًا، يجب ألا تستخدم استراتيجية التسعير المنخفض، لأن ذلك سيُخفض من الجودة المدركة في أذهان المستهلكين نظرًا لاعتقاد معظمهم بأن المنتجات الرخيصة للغاية رديئة وسيئة. الجودة المدركة كمحرك استراتيجي الجودة المدركة هي متغير استراتيجي رئيسي للعديد من الشركات على مدار العقد الماضي. وهي جانب من جوانب إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management، وعادةً ما تكون الجودة المدركة هي الهدف النهائي لبرامج إدارة الجودة الشاملة. تصرح العديد من الشركات بأن الجودة هي إحدى قيمها الأساسية وتدرجها في بيان مهمتها. على سبيل المثال، أحد المبادئ التوجيهية التي وضعها رئيس شركة IBM لو جيرستنر Lou Gerstner هو "الالتزام الطاغي بالجودة". في الحقيقة، غالبًا ما تكون الجودة المدركة هي البعد الرئيسي لتحديد موقع العلامات التجارية في السوق وخصيصًا للعلامات التي تتوسع لمنتجات مختلفة، مثل توشيبا Toshiba، أو فورد Ford؛ والعلامات التجارية الأخرى التي تتنوع بين فئات المنتجات، مثل وايت ووتشرز Weight Watchers، وكرافت Kraft؛ والعلامات التجارية للمتاجر ،مثل سيفوي Safeway؛ ذلك لأن هذه العلامات التجارية الممتدة لفئات منتجات متعددة من غير المرجح أن تكون جميع منتجاتها مدفوعةً بالمزايا الوظيفية، ومن المرجح أن تلعب الجودة المدركة دورًا أكبر فيها. المحافظة على الجودة في عالم متغير الأذواق أذواق المستهلكين متغيرة بصورة كبيرة جدًا، إذ لا يكاد يظهر موضوع جديد في وسائل التواصل الاجتماعي إلا ويؤثر على طريقة حياة المستهلكين واختياراتهم، وبطبيعة الحال لا يقتصر الأمر على وسائل التواصل فحسب، وإنما تتأثر أذواق المستهلكين بالعديد من الأمور؛ لذا ففي طريقنا لبناء جودة عالية لمنتجاتنا وخدماتنا، لا بد أن نصطدم بسؤال مهم جدًا كيف يمكننا المحافظة على الجودة في هذا التغير المستمر لأذواق المستهلكين؟ للإجابة على هذا السؤال سنستعرض قصة حدثت في نهاية القرن الماضي. قرب نهاية العقد الماضي فشلت العديد من الشركات الأمريكية في ملاحظة التفاؤل الذي جاء بعد التشاؤم السائد في منتصف السبعينيات بسبب أزمة النفط التي عانت منها الدول الصناعية، فقد كانت هذه الأزمة تثير الكثير من السلبية وتُحجم المستهلكين عن الإفراط في الشراء بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. لقد أشارت العديد من استطلاعات الرأي التي أجريت خلال السبعينيات إلى طبيعة ومدى هذا التحول؛ فعلى سبيل المثال، أظهرت استطلاعات رأي أجرتها جالوب Gallup بأن 55% من المستجيبين للاستطلاع رأوا بأن "العام المقبل سيكون أسوأ من هذا العام"، وهذه النسبة مرتفعة جدًا؛ إذ كانت النسبة 21% في أوائل السبعينيات. وفي الواقع، كانت كل المقاييس تشير إلى أن الشعب الأمريكي متشائم بما يخبئه له المستقبل. في ظل هذه الأجواء، بدأت تظهر أنماط وأولويات جديدة في طريقة استهلاك الشعب للمنتجات، وذلك بسبب النقص الحاد في النفط، فقد عدّل الأمريكيون نمط حياتهم من خلال عمليات شراء أكثر مسؤوليةً وموضوعية مثل الشراء النزيه Integrity، والشراء الاستثماري Investment، والشراء على أساس دورة حياة المنتج Life-Cycle. الشراء النزيه هو عمليات الشراء التي تُجرى لأهميتها المدركة للمجتمع وليس للمصلحة الشخصية للمستهلك كما كان معتادًا آنذاك. على سبيل المثال، يكون شراء سيارة صغيرة موفرة للطاقة دليلًا على النزاهة الشخصية للمشتري وحرصه على المصلحة العامة؛ أما الشراء الاستثماري، فهو الشراء الموجّه نحو المنتجات طويلة الأمد، حتى لو أدى ذلك لدفع المزيد من الأموال، إذ ينصب التركيز هنا على قيم معينة، مثل المتانة والموثوقية والحرفية وطول العمر. ففي مجال صناعة الملابس مثلًا، بدأ المزيد من المصنّعين الأمريكيين في التأكيد على القيمة الاستثمارية للملابس وطول عمرها. من ناحية أخرى، الشراء على أساس دورة حياة المنتج هو الشراء الذي يركز على طول دورة حياة المنتج، فعلى سبيل المثال، يرى البعض مصباحًا كهربائيًا يستخدم ثلث كمية الكهرباء بالمقارنة مع المصباح التقليدي، ويدوم أربعة أضعاف عمر التقليدي وسعره 10 دولارات أمريكية سيكون صفقة أفضل من المصباح التقليدي الذي يبلغ سعره 1 دولار. أضاعت الشركات فرصة الاستفادة من هذا التحول الأساسي في مواقف المستهلكين عندما تجاهلوا رصد المعلومات، والاتجاهات الجديدة للمستهلكين، والاستجابة لها في الوقت المناسب، تعكس هذه التغييرات في سلوك الشراء النظرة المتشائمة للمستهلكين وتركيزهم المتزايد على الجودة بدلًا من الكمية مندفعين بجملة "إذا كنا سنشتري أقل، فليكن أفضل". وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ما يزال هذا النمط من الشراء في تصاعد، مع زيادة الاهتمام الزائد في البيئة واستخدام المواد المُعاد تدويرها والمواد التي تخفف من الانبعاثات الكربونية في المصانع. إن المستهلكين المهتمين بقضايا البيئة لديهم تعريفًا مختلفًا للجودة يجب أخذها بالحسبان إذا أرادت الشركات البقاء في السوق والمنافسة. الخاتمة تعرفنا في هذا المقال على ماهية الجودة المدركة، فبدأنا أولًا بالاطلاع على تعريفها وعلاقتها مع شكل المنتج، بعدها انتقلنا إلى معرفة أهميتها للعلامات التجارية والشركات، من خلال زيادة هوامش الأرباح والمبيعات وقوة العلامة التجارية وحصتها في السوق، بالإضافة إلى زيادة القيمة المدركة والعائد على الاستثمار ROI، كما استعرضنا أيضًا أبعاد الجودة المدركة المعروفة لتنويع مفهوم الجودة واختلافه بحسب المستهلكين، واطلعنا أيضًا على المؤثرات التي تضعف الجودة المدركة سواء المؤثرات الداخلية والخارجية، وعلى كيفية بناء تصورات واضحة في أذهان المستهلكين عن الجودة، كما فهمنا كيفية جعل الجودة المدركة كمحرك استراتيجي للعلامة التجارية، لنصل في الأخير لمعرفة كيفية المحافظة على الجودة في عالم متغير الأذواق. وختامًا يجب الاهتمام بالجوانب التسويقية لبرامج تحسين الجودة بنفس القدر من الاهتمام بالجودة، وذلك لأنه ما من جدوى لبناء جودة بدون أن يتعرف عليها أحد. نادرًا ما يمتلك المستهلكون جميع المعلومات اللازمة لإصدار حكم منطقي وموضوعي على الجودة - وحتى إن كانت لديهم المعلومات، فيمكن أن يفتقروا إلى الوقت والحافز لمعالجتها وتحليلها. ونتيجةً لذلك، فإنهم يعتمدون على واحد أو اثنين من الإشارات التي يربطونها بالجودة. مفتاح التأثير على الجودة المدركة هو فهم وإدارة هذه الإشارات بطريقة صحيحة. والتأثير عليها. وفي النهاية يجب أن تكون الجودة مدفوعةً بالعميل أولًا، وليست مدفوعةً بزيادة دمج بالتكنولوجيا، أو بزيادة الإنتاج، أو بالمنافسة. المصادر البحث Understanding of Perceived Product Quality : Reviews and Recommendations لصاحبه Somphol Vantamay. البحث Consumers’ Perceived Quality, Perceived Value and Perceived Risk Towards Purchase Decision on Automobile. مقال Perceived Quality—What it is and Why it is Important لصاحبه Monica Espinosa و Kaivon Assani. مقال Perceived Quality: Critical Asset For Brands - Branding Strategy Insider لصاحبه David Aaker. مقال 4 Psychology-Based Design Tips For Eye-Catching Packaging Design لصاحبته Katie Lundin. مقال Quality Is More Than Making a Good Product لصاحبيه Hirotaka Takeuchi و John Quelch. مقال Perceived Value لصاحبه Carol M. Kopp. اقرأ أيضًا جودة المنتج هي عامل التسويق الأول تبني المنتج: الطريق إلى إقبال العملاء على منتجك التحكم في الإنتاج والعمليات وتطويرهما
-
تعرفنا في المقال السابق على ماهية الوعي بالسعر وكيف تكون عملية التسعير واستراتيجيات التسعير المختلفة سنكمل في هذا المقال ما بدأنا به وسنتعلمُ كيف أن التغيير البسيط في السعر يمكن أن ينعكس سلبًا أو إيجابًا على إقبال المستهلكين على الشراء. غالبًا ما يعدل رواد الأعمال وأصحاب الشركات استراتيجيات التسعير بين الفينة والأخرى بحسب ما يجري في الأسواق، وبالرغم من أهمية تكلفة المنتجات المُباعة وأسعار المنافسين لكن لا ينبغي أن تكون أسعار المنافسين مركز استراتيجيًا للتسعير الخاص بالعلامة التجارية أو الشركة. لكن ماذا لو سعرت الشركة منتجاتها ثم أرادت لاحقًا تعديل استراتيجية السعر الخاصة بها هل سيتأثر الطلب على المنتج؟ لفهم ما سيحدث لا بدّ أن نستعرض مصطلح مهم في هذا السياق وهو المرونة السعرية للطلب Price Elasticity of Demand. المرونة السعرية للطلب Price Elasticity of Demand وهو مصطلح يستخدم لتحديد كيفية تأثير التغيّر في السعر على طلب المستهلكين للمنتج. إذا استمر المستهلكون في شراء منتج بالرغم من ارتفاع سعره (مثلما يحدث بأسعار السجائر والوقود)، عندها يعد هذا المنتج غير مرن أي الطلب عليه ثابت. بالمقابل عندما يتغير الإقبال على شراء منتج ما عند تقلبات الأسعار (مثل المنتجات الترفيهية والكمالية) عندها يكون المنتج مرن أي يكون الطلب عليه غير ثابت. يمكننا حساب مرونة الطلب السعرية باستخدام الصيغة التالية: على سبيل المثال: لنفترض أن سعر التفاح انخفض بنسبة 6٪ من 1.99 إلى 1.87 دولار أمريكي للكيلو الواحد، واستجابة لذلك زاد المتسوقون مشترياتهم من التفاح بنسبة 20٪ وبذلك تكون مرونة التفاح: 0.20 ÷ 0.06 = 3.33% نستنتج بأن الطلب على التفاح مرن للغاية. يساعد مفهوم المرونة السعرية على فهم ما إذا كان منتجك أو خدمتك حساسة لتقلبات الأسعار. من الناحية المثالية تريد الشركات بأن يكون منتجاتها غير مرنة لكي يظل الطلب مستقرًا إذا تقلبت الأسعار. من العوامل المؤثرة على مرونة الطلب السعرية نذكر: توفر المنتجات البديلة: يؤثر وجود منتجات بديلة على مرونة الطلب السعرية إذ تعد المنتجات مرنة كلما زاد توفر المنتجات البديلة لها. فإذا تواجد نوعين من القهوة في السوق وارتفع سعر واحدة منها فإن المستهلكين سيتوجهون لشراء النوع البديل وبالتالي يقل الطلب على النوع الأول. حاجة المستهلكين: إذا كان المنتج ضروري بالنسبة للمستهلكين فإنه سيكون غير مرن، مثل الماء أو البنزين الذي لن تتأثر كمية الطلب عليه مهما تغير سعره. ضغط الوقت: إذا كان سعر المنتج يتأثر مع مرور الوقت، فذلك يعني أنّها مرنة، مثل تأثر سعر المنتجات بمواسم معينة. كما أنّ توفر الوقت للمستهلكين يتيح لهم إيجاد منتجات بديلة وذلك يحدث في المنتجات غير الأساسية التي يمكن تأجيل شراؤها. التعلّق بالمنتجات: تسبب بعض المنتجات الإدمان من كثرة ما اعتاد الناس على تواجدها ولذلك تكون هذه المنتجات غير مرنة أي الطلب عليها ثابت، ومن الأمثلة عليها السجائر أو منتجات شركة آبل! تختلف أنواع مرونة الطلب السعرية بحسب المنتجات ومن هذه الأنواع نذكر: طلب غير مرن نهائيًا Perfectly Inelastic Demand: أي أنّ كمية الطلب على المنتجات لا تتغير أبدًا مهما تغير السعر، وذلك يعني بأنّ مرونة الطلب السعرية تساوي صفر. في الواقع لا يوجد منتج غير مرن نهائيًا، ولكن يمكن أن يكون عبوات المياه المعبأة المثال الأقرب لهذا النوع. يمثل هذا النوع على منحنى الطلب بخط طولي مستقيم. طلب غير مرن نسبيًا Relatively Inelastic Demand: أي أنّ كمية الطلب لا تتغير بنفس النسبة التي يتغير بها السعر، وتكون قيمة الطلب السعرية هنا أكبر من صفر وأقل من واحد. فعلى سبيل المثال، إذا زاد سعر المنتج بنسبة 10%، تنخفض كمية الطلب بنسبة 5% فقط، فذلك يعني أنّ الطلب على هذا المنتج غير مرن نسبيًا. يمثل هذا النوع بخط منحدر على محور الطلب. طلب مرن عند تغيير السعر Unit Elastic Demand: أي أنّ كمية الطلب تتغير بنفس النسبة التي يتغير بها السعر، وتكون قيمة مرونة الطلب السعرية مساوية للواحد. طلب مرن نسبيًا Relatively Elastic Demand: أي أنّ التغير في كمية الطلب يكون أكبر من التغير في السعر، وتكون قيمة مرونة الطلب السعرية أكبر من واحد. كما يمثل هذا النوع على منحنى الطلب بخط منحدر تدريجيًا لكن انحداره يكون أقل من انحدار الطلب غير المرن نسبيًا. طلب مرن دائمًا Perfectly Elastic Demand: أي أنّ تغير طفيف في السعر يؤدي إلى تغير كبير في كمية الطلب، وتكون قيمة مرونة الطلب السعرية هنا لا نهائية. يمثل هذا النوع على منحنى الطلب بخط عرضي مستقيم. عادة ما يتغير سعر المنتج أثناء تحركه خلال دورة حياة المنتج خصيصًا مع تغير الطلب على المنتج واختلاف الظروف التنافسية. غالبًا ما تحدد الإدارة سعرًا مرتفعًا في المرحلة التمهيدية، ويميل السعر المرتفع إلى جذب المنافسة. عادة ما تؤدي المنافسة إلى انخفاض الأسعار لأن المنافسين يخفضون الأسعار للحصول على حصة في السوق. عمومًا تنطوي كل إستراتيجية على مزايا وعيوب فالإستراتيجية التي تجذب بعض العملاء يمكن ألّا تجذب عملاء آخرين ولأن الشركة لا يمكن أن ترضي جميع العملاء، ينبغي عليها أن تحدد شريحة العملاء الأساسية والسعر المناسب لهم بناء على معلومات حقيقة من السوق وليس التوقعات من خلال تحليل احتياجات هذه الشريحة وسلوكيات الشراء الخاصة بها. إدراك المستهلك للسعر بحسب دراسة منشورة عام 2012 في جامعة تكساس جاء فيها أن هناك دليل على أن معرفة المستهلكين بالأسعار محدودة، أي أنه في بعض الأحيان يمكن ألّا يكون المستهلكين على دراية كاملة بالأسعار عند شراء المنتجات. كيف يتخذ المستهلكون قرار اختيار المنتجات أو العلامات التجارية؟ يرى الباحثون بأن أحد الاحتمالات هو أن المستهلكين يستخدمون توقعاتهم للأسعار. وهذا يثير مجموعة من الأسئلة المهمة في هذا الصدد وهي: متى نعُدّ الشراء من علامة تجارية معينة دالة على التفضيلات والأسعار المعلنة أم أنها دلالة تفضيلات وتوقع أسعار العلامة التجارية؟ هل يوجد للإعلانات والعروض التجارية دورًا في تبسيط اختيار العلامة التجارية للمستهلك؟ هل تؤدي العروض الترويجية إلى جعل المستهلكين يقصرون انتباههم على العلامات التجارية التي يُروج لها فقط؟ هل تؤثر العروض الترويجية على المستهلكين على دراية بالسعر أكثر من تأثيرها على المستهلكين غير المدركين للسعر؟ استخدم الباحثون بيانات استطلاعاتهم على منتجات الكاتشب وزبدة الفول السوداني للإجابة على الأسئلة السابقة. ووجدوا بأن ما بين 40٪ و 50٪ من المشتريات يجريها المستهلكون باستخدام توقعات الأسعار بدلًا من الأسعار المُعلنة. يُنظر إلى المستهلكين الذين يستخدمون توقعات الأسعار على أنهم "غير مدركين" للأسعار المعروضة. ووجدوا أيضًا بأن العروض الترويجية تجعل بعض المستهلكين يركزون حصريًا على العلامات التجارية التي يُروج لها، وهذا التأثير يكون أكبر على المستهلكين المدركين للسعر بالمقارنة مع المستهلكين غير المدركين للسعر. كما وجدوا تأثيرًا مهمًا على عقلانية توقع المستهلك للأسعار وخاصة العلامات التجارية التي رُوج لها. هذا البحث يضعنا أمام العديد من نقاط الاستفهام والأسئلة وللإجابة على هذه التساؤلات لا بدّ أن نعود بالزمن ونفهم الأمر من البداية من خلال الاطلاع على النظريات الأولية في كيفية إدراك المستهلك للسعر. إدراك السعر وفق النموذج التقليدي يواجه المستهلك عددًا لا يحصى من الخيارات لمعظم قرارات الشراء ولعبت المنافسة الشديدة دورًا كبيرًا في إرباك المستهلك عند اتخاذه للقرارات نظرًا لكثرة المعلومات وهذا يصعب من إمكانية صحة الافتراض الكلاسيكي للنظرية الاقتصادية بأن المستهلكين لديهم معلومات كاملة عن المنتجات والأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يفتقر المشترون إلى القدرة على معالجة جميع المعلومات والعروض المتاحة. في هذه البيئة السريعة والفوضوية يعتمد المستهلكون أثناء عملية التصنيف اعتمادا كبيرًا على المعلومات الدلالية Information Cues (وهي معلومات متنوعة متعلقة بالمنتج أو الخدمة أو سياق الشراء مثل، السعر والضمانات وأنماط تنفيذ الإعلانات) وذلك في سعي المستهلك لتسريع عمليات اتخاذ القرار وتقييم المنتجات والخدمات. لذلك يجب على المسوقين تحديد المعلومات الدلالية التي يستخدمها المستهلكون مما يمكنهم من فهم إدراك المستهلكين للمنتجات والخدمات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك يفهم المستهلكون السعر بناء على مفهوم التصنيف Classification فعندما يواجه المستهلكون سعرًا مختلفًا عن السعر الذي دفعوه سابقًا لنفس نوعية المنتج سيتوجب عليهم أن يقرروا فيما إذا كان الاختلاف بين السعر القديم والجديد يشكل فارقًا أم لا. فإن اعتقدوا أن الاختلاف لا يشكل فارقًا عندها سيصنفوا السعرين كسعرين متشابهين وبالتالي يتصرفون كما تصرفوا في الماضي، ويمكن أن يختاروا في هذه الحالة بناء على عوامل غير السعر. بالمقابل، إذا أدرك المستهلكون أن الاختلاف بين السعرين كبير فيمكن أن يصنفوا المنتجين على أنهما مختلفين وبالتالي يمكن أن يقوموا بالاختيار بناء على السعر. بناء على هذا النموذج التقليدي يتطلب السلوك العقلاني من المستهلك أن يكون قادرًا على: معرفة المعلومات الكاملة عن الأسعار. القدرة على معالجة المعلومات بطريقة صحيحة. عدم تأثر الأسعار في الرغبات النسبية أو الرضا. المعلومات الكاملة حول الأذواق والتفضيلات. يشير منتقدو النموذج الاقتصاد التقليدي بأن الفرضيات 1 و 2 و 4 غير عملية على أرض الواقع، ولذلك يرون بأن طريقة تقييم المستهلكين للجودة من خلال المزايا الخاصة بالمنتج مقابل التضحية المتمثلة بالسعر. وبالتالي فإن إدراك المستهلكين للقيمة يتأتى من خلال الموازنة العقلية بين الجودة أو المنافع Benefits التي يدركونها في المنتج مقابل التضحية Sacrifice التي يدركونها من خلال السعر الذي يدفعونه. نلاحظ من الشكل السابق السعر مع الجودة المدركة والتضحية المدركة في تكوين القيمة المدركة وتشكيل نية الشراء في نهاية المطاف يمكن أن يستخدم السعر كمؤشر على الجودة المدركة للمنتج وعلى التضحية المدركة عند الشراء وتنتج القيمة المدركة عن الموازنة بين الجودة المدركة والتضحية المدركة وتكون موجبة عندما يكون إدراك الجودة أعلى من إدراك التضحية. العلاقة بين السعر والجودة ضمن نماذج اقتصاديات السعر الكلاسيكية يفترض المرء أن العملاء لديهم معلومات كاملة ويمكنهم تقييم جودة المنتج بصورة مستقلة عن سعره، ولكن في الحقيقة أثبتت فرانزيسكا فولكنر Franziska Völckner في بحثها المنشور في مجلة اقتصاديات الأعمال Journal of Business Economics عام 2006 أن السعر يمكن أن يكون مؤشرًا للجودة وظهر هذا الأمر تجريبيًا في عدة أبحاث أخرى. كان السعر بمثابة مؤشر لجودة منتجات متنوعة مثل الأثاث والسجاد والشامبو ومعجون الأسنان والقهوة والمربيات والجيلي وأجهزة الراديو، ولوحظت آثار مماثلة في قطاع الخدمات (مثل المطاعم والفنادق). في بعض القطاعات أدت زيادة الأسعار زيادات في حجم مبيعات منتجات مثل بخاخات الأنف وجوارب النايلون والحبر والمنتجات الكهربائية. وفي بعض الأحيان كانت النتائج مثيرة حقًا للاهتمام ففي آلة الحلاقة الكهربائية الشخصية زاد حجم المبيعات بمقدار أربعة أضعاف بعد زيادة كبيرة في الأسعار جعلت الآلة أقرب إلى تكافؤ السعر مع المنتجات الرائدة في السوق مثل آلة الحلاقة براون. وبالرغم أنه لا تزال هنالك فجوة سعرية بين المنتج وآلة الحلاقة براون إلا أن الفرق البسيط كان حافزًا ولم يجعل المستهلكين يشكّون في جودة المنتج مثلما كان يحدث عندما كان الفرق السعري كبيرًا. لا يقتصر دور السعر كمحدد للجودة على المنتجات الاستهلاكية بل ينطبق الأمر أيضًا على المنتجات المتبادلة بين قطاعات الأعمال B2B. فمثلًا قدمت إحدى الشركة البرمجيات حزمة برامج سحابية للشركات بسعر منخفض للغاية يبلغ 19.90 دولارًا شهريًا، وكانت تُباع المنتجات المنافسة المماثلة في السوق بأكثر من 100 دولار شهريًا. أدرك الرئيس التنفيذي للشركة بعد عدة أشهر أن حماس شركته تجاه الأسعار كان مبالغًا فيه إذ تحوّل السعر المنخفض من ميزة تنافسية إلى عامل شك في جودة منتج الشركة وجعل الشركة تخسر ثقة العميل وأصبح السعر عائقًا أمام المبيعات نمو المبيعات. عملت الشركة لاحقًا على تتميز المنتج ورفع سعره إذ أضافت على منتجها ميزات جديدة ثم عرضت الحزمة الجديدة على الشركات مقابل رسوم شهرية مرتفعة وبالرغم من أن الحزمة لا تزال غير مكلفة على الشركة، لكنها الآن تتناسب بطريقة أفضل مع أسعار السوق. ساعد هذا التكيف الشركة على التخلص من الصورة السلبية التي عززها السعر المنخفض الأولي. ظهر ذلك أيضًا في المجال الطبي ففي إحدى التجارب وجد المرضى الذين خضعوا للاختبار عندما تناولوا صنفين من مسكن الآلام أحدهما مرتفع الثمن والآخر رخيص وعند سؤالهم عن الفعالية كان جوابهم بأن فعالية الدواء مرتفع الثمن أفضل بكثير. هذا النوع من التأثيرات الوهمية معروف في الطب باسم تأثير بلاسيبو Placebo Effect. يكون السعر مؤشرًا الجودة عندما لا يتمكن العملاء من تقييم جودة المنتج بشكل مناسب أو عندما يفتقر العملاء إلى الوقت أو القدرة أو عندما يكون التقييم الشامل مكلفًا للغاية. لذا فهم يبسطون عملية اتخاذ القرار ويستخدمون السعر كبديل للجودة. في الواقع، غالبًا لا يكون لدى العميل خيارًا سوى اتخاذ قرار الشراء على أساس معلومات غير كاملة أي يكون العميل غير واع بكافة خصائص المنتج وما تعنيه هذه الخصائص. يحاول العملاء تقليل مخاطرهم المتصورة والتنافر المعرفي الناتج عن طريق استخدام معايير أو مؤشرات أخرى لتقييم الجودة. توضح الصورة التالية النقاط التي يتأثر بها المستهلك. نلاحظ كيف تتأثر الجودة المدركة باسم الشركة وبلد المنشأ واسم المحل التجاري أو بائع التجزئة والسعر جميع هذه النقاط تؤثر إيجابيًا بالسعر إلا أن دولة المنشأ يمكن أن تؤثر بطريقة سلبية على اسم العلامة التجارية واسم المتجر وعلى السعر أيضًا لأنه إذا كان بلد الصين هو البلد المنشأ مثلًا، فسيتوقع المستهلك بأن السعر والجودة منخفضان والمحل التجاري يبيع البضاعة الرخيصة وينعكس الأمر في حال كان بلد المنشأ هو ألمانيا أو اليابان، بالإضافة إلى ذلك يؤثر السعر في التضحية المدركة والتي بدورها تؤثر هي والجودة المدركة على القيمة المدركة. بالإضافة إلى ذلك ومن منظور اقتصادي، يعد البحث عن معلومات الجودة الموضوعية الخاصة بمنتج ما ودراستها أمرًا مكلفًا إذ يكلف الباحث وقته الضائع في عملية البحث وفي قراءة تقارير الاختبار، وتجميع النتائج وفهمها، وبذلك تكون التكلفة الإجمالية لشراء منتج هو مجموع السعر الفعلي وتكاليف البحث تلك، وعندما يفترض العميل وجود علاقة إيجابية بين السعر والجودة يوفر بذلك تكاليف البحث، يمكن أن يكون شراء منتج أكثر تكلفة حلًا أرخص من إضاعة الوقت في حال كان المستهلك مديرًا أو ذا منصب رفيع. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من سهولة الوصول إلى المعلومات، يميل المستهلكون في بعض الأحيان إلى الاعتماد على مراجعات العملاء الفعليين والتي تؤثر تأثيرًا كبيرًا عليهم ويمكن أن تكون بمثابة بدائل جزئية أو كاملة لمؤشرات الجودة التقليدية مثل العلامة التجارية والسعر. يستخدم العملاء السعر كمؤشر جودة لعدة أسباب معقولة نذكر منها: العنصر الثقافي المنتشر من خلال الأمثال الشعبية مثل "الجودة لها ثمنها" أو "الغالي حقه فيه" أو "أعطِ الخباز خبزه حتى لو أكل نصه" تؤثر هذه الأمثال بطريقة غير مباشرة على وعي المستهلكين. اعتقاد الناس بأن السعر دومًا له علاقة وثيقة مع التكاليف وكلما زادت التكاليف للمواد الثمينة زاد السعر. الخبرة في مجال المنتج إما مفقودة أو مستحيلة الحصول عليها إما لأن المنتج جديد أو نادرًا ما يشتريه المستهلك. عند شراء المنتجات الجديدة المبتكرة. آخر عملية شراء أو استخدام للعميل كانت في الماضي البعيد. لا يشارك العملاء عادة تجاربهم مع بعضهم البعض حول هذا المنتج بعينه. وفي بعض الظروف يصبح السعر أكثر قوة كمؤشر للجودة خصيصًا في الحالات التالية: ضيق الوقت. زيادة تعقيد الشراء. انخفاض شفافية الأسعار. الثقة بمُقدم معلومات الأسعار. ويمكن أن تلعب أيضًا العوامل الشخصية الخاصة بالعميل دورًا في عدّ السعر مؤشرًا للجودة مثل: انخفاض ثقة العميل بنفسه. زيادة القوة الشرائية للعميل بالإضافة إلى كونه غير اقتصادي ومسرف. رغبة العميل في الشراء السريع والسهل. زيادة الرغبة في تجنب التنافر المعرفي. التلاعب على الجانب النفسي فهمنا حتى الآن أن للسعر خصائص إيجابية وسلبية في آنٍ واحد وتعرفنا على شخصية العميل الذي يمكن أن يربط السعر بالجودة ولكن ماذا عن العميل العقلاني المنطقي والحريص على أمواله، كيف سنُخفف من أثر السعر في قرار شرائه؟ كيف نجعله يتقبل السعر بطريقة سلسة؟ في الحقيقة ظهرت عدة حيل للتلاعب على المستهلك من أجل تخفيف أثر صرف المال ومن بين هذه الحيل ظاهرة الأسعار النفسية Psychological Price Phenomena ومن أشهر الأمثلة على ذلك الأسعار الفردية أو الكسرية Odd Prices. الأسعار الكسرية Odd Prices تشير إلى الأسعار الكسرية Odd Prices إلى الأسعار المنتهية بأرقام عشرية غير صحيحة مثل 9.99، وتنتشر طريقة التسعير هذه في متاجر البيع بالتجزئة في قارة أوروبا وأمريكا، ومن الأسباب التي تشجع على التسعير بأرقام تنتهي بالرقم 9 أن هذه الأسعار تشير إلى سعر أقل أو إلى حسم على مستوى السعر مما يحفز الطلب. من التفسيرات العلمية لتبرير الفرق في كيفية إدراك الأسعار المنتهية بأرقام عشرية مثل 9.99 هو أن الأشخاص يميلون للتقليل من الجهد الذهني ويميلون إلى معالجة الأرقام من اليسار إلى اليمين وبالتالي فإن الرقم الأهم سيكون هو 9 ويهمل الجزء الثاني والذي يعطي شعورًا بأن السعر هو 9 فقط وبالمثل قد تقرأ سريعًا سعر 49.99 فتتذكر منه 40 وهو الرقم الأهم ويمكن حتى أن تتذكر سعر المنتج بحدود الأربعين إن سئلت عنه لاحقًا. موازنة الأسعار والسعر المرجعي يشير أثر المسافة Distance Effect إلى أن الزمن اللازم للمقارنة بين رقمين يتناسب عكسًا مع المسافة الرقمية بينهما إذ يستغرق القرار بأن الرقم 8 أكبر من 6 زمنًا أطول من الزمن الذي يتخذه القرار بأن الرقم 8 أكبر من الرقم 2 هذا يدل على أن المسافة بين الأرقام لا توازن كأرقام وإنما ككميات. ينظر عادة إلى الأرقام 2 و 3 و 4 إلى أنها أرقام صغيرة بينما ينظر إلى 6 و 7 و 8 إلى أنها أرقام كبيرة أي أن الرقم 5 يفصل بين الأرقام الكبيرة والأرقام الصغيرة وعندما يوازن المستهلك الأسعار يرمز عقله أولًا وبصورة آنية ومن ثم تصنف الأسعار صغيرة أو كبيرة. أما السعر المرجعي Reference Price فهو السعر الذي يستخدمه المستهلك كمعيار للموازنة عند تقييم سعر المنتج. ويمكن أن يكون السعر المرجعي داخليًا أي مخزن في الذاكرة أو خارجيًا مشاهدًا في البيئة المحيطة مثل الأسعار التي تظهر في الإعلانات أو الكتالوجات أو دليل الأسعار أو أسعار المنتجات الأخرى الواضحة ضمن السوبر ماركت. الأسعار المخزنة داخليًا هي الأسعار المخزنة في الذاكرة من التجارب السابقة أو من المعرفة بقطاع العمل أو المكونات الأساسية للمنتج أو المعلومات المخزنة من تجارب الآخرين. يستخدم مدراء الشركات عادة الأسعار المرجعية للتأثير في المستهلكين. فيمكن أن يلجأ بعض البائعين إلى وضع منتج ما ضمن مجموعة من المنتجات ذات الأسعار المرتفعة لتوليد انطباع بأن المنتج ينتمي إلى هذه الطبقة من المنتجات ولكن سعره أقل أو عليه خصم معين. في حال اكتشاف المستهلك بأن الأسعار التي يشاهدها في المتجر أقل من الأسعار المرجعية يندفع عندها إلى المنتج ويحاول أن يقرر فيما إذا كان الأمر فيه خدعة مثل أن يكون هناك مشكلة معينة في المنتج أو المنتج مقلد …إلخ، أو أن التخفيض حقيقي وذلك لأن الأسعار المنخفضة يمكن أن تشعر المستهلك بأن هنالك خلل في المنتج. العلاقة بين السعر والفخامة ظهر مفهوم أثر السعر على الفخامة Prestige Effect of price منذ أكثر من 120 عامًا وتحديدًا في كتابات Thosrtein Veblen في عام 1899 وظهر ما يدعى بأثر التكبر Snob effect أو أثر فبلين في سلعة فبلين Veblen Effect. عند حدوث هذا الأثر يتزايد الطلب على المنتج حتى مع ارتفاع السعر لأن المستهلكين يريدون استخدام المنتج لبناء أو تعزيز مكانتهم الاجتماعية بالمقارنة مع بقية الناس. فمثلًا ارتفعت أسعار منتجات العلامة التجارية البلجيكية ديلفو Delvaux المتخصصة في صنع الحقائب اليدوية بصورة كبيرة بالموازنة مع بقية المنافسين وكانت تهدف إلى إعادة تموضع العلامة التجارية لتصبح للفئة الراقية سرعان ما ازدادت مبيعات العلامة التجارية من منتجاتها وأصبحت تنافس أسعار حقائب لوي فيتون Louis Vuitton، بالمقابل نجد بأن بعض العلامات التجارية بالغت في رفع أسعارها مثل مالبري Mulberry وبرادا Prada لدرجة تجاوزت فيها حدود السعر المقبول لدى المستهلك ونتيجة لذلك بدأت مبيعاتها بالانخفاض. تبنت بعض العلامات التجارية النُدرة والحصرية لتدل على التميز والتفرد والفخامة لتبرير أسعارها المرتفعة تركز هذه الشركات على مفهوم الفخامة في رسائلها التسويقية وخصيصًا ضمن أسواق الساعات والمجوهرات والعطور وغيرها، وعادة ما يكون المستهلكون الباحثون عن التميز والتفرد مستعدين لدفع سعر أعلى لاعتقادهم بأن القليل من الأشخاص يمكنهم الحصول على هذا المنتج. ولكن ماذا عن المنتجات الفائضة لدى هذه الشركات الفاخرة؟ في الحقيقة تعتمد الشركات الفاخرة على إتلاف منتجاتها في حال لم تستطع بيعها ضمن فترة زمنية محدد وهذا ما فعلته العلامة التجارية البريطانية بربري Burberry المتخصصة في الأزياء والمنتجات الفاخرة، إذ عمدت الشركة في عام 2018 على إتلاف منتجات غير مباعة من الملابس الفاخرة والإكسسوارات والعطور بقيمة 28.6 مليون استرليني، للحفاظ على علامتها التجارية، وليبلغ إجمالي ما أتلفته ودمرته بربري على مدار خمس سنوات (من 2013 وحتى 2018) أكثر من 90 مليون جنيه استرليني. تسعى هذه الشركات للتوسع لإرضاء المستثمرين ومع هذا التوسع يزداد الإنتاج والمنتجات المعروضة ولذلك يضطروا إلى إتلاف هذه البضاعة في حركة منها لمنع بيع منتجاتها بثمن بخس مما يؤثر على سمعة الشركة لاحقًا. الخاتمة استكملنا في هذا المقال رحلتنا في تعلم أهمية الوعي بالسعر واستعرضنا فكرة مرونة الطلب السعرية وكيف تؤثر على تغير طلب على المنتج في الأسواق وانتقلنا بعدها لفهم كيفية إدراك المستهلك للسعر فبدأنا بطريقة إدراك السعر بحسب النموذج التقليدي وتعرفنا على العلاقة بين السعر والجودة وكيف يستخدم المدراء والمسوقون حيل نفسية للتلاعب على المستهلكين والتخفيف من وقع ارتفاع السعر سواء من خلال الأسعار الفردية أو الكسرية كما اطلعنا أيضًا على الطريقة التي يوازن بها المستخدمون الأسعار وأهمية السعر المرجعي وقد ختمنا بعدها بالتعرف على العلاقة بين السعر والفخامة وختامًا إن الوعي بالسعر جزء من الوعي بالعلامة التجارية يضيف قيمة كبيرة إذا أُحسن استخدامه ويسبب خسائر فادحة للشركات التي تسيء استخدامه لذلك إن السعي للمعرفة والاطلاع على هذه الأمور هي السلاح الوحيد لتجنب هذه الخسائر. المصادر البحث Direct evidence of ending-digit drop-off in price information processing. البحث The Widespread Use of Odd Pricing in the Retail Sector. مقال The Ultimate Guide to Pricing Strategies لصاحبته Allie Decker. مقال 10 Timeless Pricing Strategies to Increase Sales لصاحبه Gregory Ciotti. البحث Left-digit price effects on smoking cessation motivation. البحث Price Endings, Left‐Digit Effects, and Choice. اقرأ أيضًا المفاهيم الأساسية للوعي بالسعر Price Awareness السعر هو ما تدفعه، والقيمة هي ما تحصل عليه أهداف تسعير المنتج واستراتيجياته المختلفة
-
بعد أن تعرفنا في مقال مدخل إلى الوعي بالعلامة التجارية على ماهية الوعي بالعلامة التجارية وعلى الوعي بالإعلام سنتعرف في هذا المقال على تأثير الوعي بالسعر ودوره في بناء الوعي بالعلامة التجارية. إن معرفتنا لكيفية فهم المستهلكين للإعلان والسعر وطريقة معالجتها في عملية تقييم المنتجات واختيارها سيسهل علينا بناء استراتيجية تسعيرية مناسبة ليرتبط السعر بقيمة وفوائد المنتج وليشكلوا بعد ذلك الوعي بالعلامة التجارية. يعد التسعير أحد المكونات الرئيسية لخطة العمل Business Plan؛ أي أنه نشاط استراتيجي يؤثر على كيفية رؤية المستهلكين لمنتجك ومكانتك في السوق وتمييز منتجك عن منتجات منافسيك، ومع ذلك يجب أن يتماشى السعر الذي تحدده مع استراتيجيات التسويق الأخرى وسمات المنتج. سواء كنت بصدد تطوير خطة تسويق رسمية أم لا، فإن إجراء بعض الأبحاث اللازمة لخطة التسويق قبل تحديد استراتيجيات التسعير أمر بالغ الأهمية. ستساعد المعرفة المكتسبة من البحث ومعرفة شخصية العميل Persona في تحديد الأسعار المناسبة لمنتجاتك أو خدماتك. ما هو الوعي بالسعر Price Awareness استحوذ مفهوم الوعي بالسعر Price Awareness على اهتمام الباحثين خلال العقود القليلة الماضية وحاول كل واحد منهم صياغة تعريف شامل له فبعضهم عرفه على أنه "قدرة المشترين على إبقاء الأسعار في الذهن"، والبعض الآخر عرفه بأنه "درجة معرفة المشترين بأسعار المنتجات والخدمات البديلة التي يرغبون في شرائها" والعديد من التعاريف الأخرى التي تدور في نفس المعنى. تتألف تركيبة الوعي بالسعر غالبًا من خلال قدرة المستهلكين على: معرفة سعر المنتج الذي اشتراه مؤخرًا. تصنيف منتجات عديدة اعتمادًا على أسعارها. تمييز سعر منتج معين. ويختلف المستهلكين أيضًا في طريقة معرفتهم بالسعر وينقسمون إلى ثلاثة أقسام وهي: يعرفون السعر معرفة دقيقة. يعرفون مجال السعر وليس لديهم اطلاع كامل الأرقام الدقيقة. لا يعرفون السعر الدقيق ولا مجال السعري. يؤثر السعر على مبيعات العلامة التجارية كما يعدّ من أهم عناصر المزيج التسويقي الأربعة (وهي المنتج والسعر والتوزيع والترويج وسبق أن تحدثنا في مقال مفصل عن تأثير عناصر المزيج التسويقي على سلوك المستهلك ننصحك بالاطلاع عليه)، كما تؤثر الاستراتيجية التسعيرية على مدى نجاح الشركة وقدرتها على تحديد ذلك بدقة ضمن خطتها، إذ يهتم المدير بخصائص المنتج لينتقل بعدها ليضع سعرًا لهذا المنتج، ومن ثم يقرر كيف سيُوزعه ويوصلهُ للزبائن، ومن ثم اختيار الطريقة المثلى لترويجه، وبما أن إدارة الشركة تسعى وراء العائد دائمًا، فإن من الواضح أن السياسات المتعلقة بالسعر تعدّ مهمة جدًا باعتبار أن أرباح المنتجات هي العنصر الوحيد الذي يولد العوائد أما باقي العناصر فينتج عنها تكاليف. عملية التسعير تنطوي عملية التسعير على الكثير من النشاطات وكل نشاط يتأثر بالآخر وتتناغم هذه النشاطات لتشكل لدينا سمفونية سيسمعها العميل ليقرر بعدها هل يشتري المنتج أم لا، ولنفهم كيف يؤثر السعر في ذهن المستهلك سنستعرض جميع المراحل الأساسية التي تمر بها عملية التسعير وانعكاسها على المستهلك. في البداية تمر أي شركة أو علامة تجارية بالخطوات التالية قبل تسعير منتجاتها: تحديد الأهداف المالية والتسويقية والإستراتيجية العامة للشركة. تحديد أهداف المنتج أو العلامة التجارية. مرونة أسعار المستهلك ونقاط السعر. الموارد المتاحة للشركة. ولكي نستطيع تحديد الأهداف السابقة سنحتاج للإجابة على بعض الأسئلة التي ستُساهم في تكوين صورة عامة عن وضع الشركة الحالي ومن أبرز الأسئلة نذكر: ما مزيج المنتجات أو الخدمات التي تقدمها شركتك؟ ما هو السوق أو الأسواق المستهدفة؟ هل تخطط لتوزيع منتجك بالجملة أم التجزئة؟ ما هي دورة حياة منتجاتك أو خدماتك؟ ما هو الطلب المتوقع على المنتج؟ هل يمكن أن تملي كيانات أخرى (مثل الحكومات أو لجان مكافحة الاحتكار) على الشركة نطاق سعري معين؟ يحدد مزيج المنتجات المتوفرة لدى الشركة استراتيجيات التسعير فإما سيَحدُ من تنوع التسعير أو يوسعها لأن المنتجات الكثيرة توسع من تنوع الأسعار والعروض وفي حال المنتجات قليلة ستكون الخيارات محدودة، بالإضافة إلى ذلك يساعدك معرفة التركيبة السكانية للسوق الذي تستهدفه في تحديد استراتيجيات التسعير المناسبة. فمثلًا هل العملاء المستهدفين مهتمون بالقيمة المضافة الخارجية (مثل التوصيل المجاني)؟ أو الجودة العالية (مثل جودة المواد الخام للمنتج)؟ أو أنهم مهتمون بانخفاض التكلفة فقط؟ بالإضافة إلى ذلك تؤثر طريقتك في توزيع المنتج على أهداف التسعير فمثلًا يمنحك التسويق بالتجزئة تحكمًا أكبر بالمقارنة مع التسويق بالجملة في كيفية تجميع المنتجات وعرضها وتسعيرها، ويمكن أن تؤثر دورة حياة منتجك على اختيارك لأهداف واستراتيجيات محددة. فمثلًا في المنتجات التي تكون دورة حياتها التقديرية قصيرة، سيكون من الضروري بيع كميات أكبر من المنتج أو تحقيق هوامش ربح أكبر من المنتجات التي تكون دورة الحياة فيها أطول. تمنحك دورات الحياة الأطول مزيدًا من الوقت لتحقيق هدف المبيعات الخاص بك. عندما يُتوقع أن يكون الطلب على منتج مرتفعًا، يكون لديك المزيد من المرونة في اختيار استراتيجيات التسعير لأن العملاء من غير المرجح أن يهتموا بالسعر والتعبئة لأنهم يريدون حقًا منتجك. كما يجب الانتباه إلى أن بعض المنتجات مثل الحليب لديها لوائح تفرضها الحكومة تُحدد فيها السعر الواجب بيعها للمستهلك ولمكافحة عمليات الاحتكار أيضًا لذلك يجب على المسؤول عن التسعير أن يتابع اللوائح التي تصدرها الدولة لتجنب الوقوع في مشاكل. الفرق بين السعر والتكلفة والقيمة تعد عملية التسعير من أكبر مسببات الصداع لدى مدراء الشركات لما لها من أهمية كبرى في وجود الشركة في السوق وهي من القرارات الاستراتيجية وتتسم بدرجة عالية من التعقيد والتداخل بسبب المتغيرات الكثيرة التي تتضمنها، وانعكاسها على مجمل أنشطة الشركة التي تقودها إلى تحقيق الأرباح وبالتالي الاستمرار والنمو، وأي قرار خاطئ في عملية التسعير سيؤثر ليس فقط على المبيعات وإنما على وجود الشركة وسمعتها في السوق كما أن استراتيجية التسويق ستتأثر تأثرًا كبيرًا باستراتيجية التسعير. ولكي نضمن اتخاذنا الخطوات الصحيحة يجب أن نتوسع في فهم كل مصطلح نستخدمه في هذه العملية. في الحقيقة غالبًا ما تتداخل مفاهيم السعر والقيمة والتكلفة لنستعرض معًا الفروقات بين هذه المصطلحات حتى نوضح أهمية كل منها. السعر Price السعر هو المبلغ الذي يتقاضاه البائع من المشتري مقابل أي منتج أو خدمة والتي تشمل التكلفة Cost وهامش الأرباح Profit Margin. يعتمد سعر المنتج أو الخدمة على كمية العرض والطلب. تحاول هذه القوتان المتعارضتان تحقيق التوازن دائمًا كي تتوافق كمية المنتجات أو الخدمات المقدمة مع طلب السوق. وتتغير الأسعار مع تغير ظروف السوق. يذكر أنه في بعض الأحيان تستخدم كلمات بديلة للتعبير عن السعر مثل: الرسوم: مثل رسوم الجامعات أو مراكز التدريب. الاقساط: مثل أقساط السيارة. الإيجار: مثل استئجار البيوت أو الآلات. الأجرة: مثل وسائل النقل. التكلفة Cost يمكن تعريف التكلفة على أنها المبلغ الإجمالي الذي ينفق على المنتجات مثل الأرض والعمالة ورأس المال والآلات والمواد والضرائب وكل الأمور التي تدخل في سلسلة إنتاج منتج معين أو توفير الخدمات ما. أي ببساطة هو أي شيء يضيف كُلفة على المنتج أو الخدمة التي تصنعها الشركة. من الضروري عند تحديد السعر حساب جميع التكاليف بدقة كبيرة لأنها ستؤثر على ربحية الشركة إلى حد كبير. تقسم التكاليف عادة إلى قسمين وهما: التكلفة الثابتة: هي التكاليف التي تظل كما هي بغض النظر عن عدد الوحدات المنتجة، مثل الإيجار، والتأمين الصحي، واستضافة المواقع وما إلى ذلك …إلخ. التكلفة المتغيرة: يسمى نوع التكاليف، الذي يختلف مع عدد الوحدات المنتجة، بالتكلفة المتغيرة، مثل المواد الخام والعمالة وتكلفة الشحن وما إلى ذلك. القيمة Value يمكن وصف القيمة بأنها الفائدة التي يجنيها العميل من المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة. بعبارة أخرى هي الفوائد أو المميزات التي يدركها العميل من المنتج أو الخدمة. يمكن أن تكون المميزات عبارة عن الخصائص المادية أو الوظيفية أو موثوقية المنتج أو سهولة الاستخدام أو المظهر أو دعم العملاء أو جميع ما سبق. تتميز القيمة ببعض الخصائص نذكر منها: لا تقاس بطبيعتها: وذلك لأن قيمة المنتج تختلف باختلاف الأشخاص، فمثلًا بالنسبة للشخص الذي يعاني من مشكلة في النظر فإن النظارات لا تقدر بثمن ولكن إذا كان نظر الشخص سليم، فإن النظارات لا قيمة لها في حياته لذلك تعتمد القيمة على حاجة للفرد وفائدة المنتج له. اختلاف القيمة من وقت لآخر: فمثلًا قيمة الكتاب للطالب قبل الامتحانات أكبر بكثير من قيمته بعد الامتحان. اختلاف القيمة بحسب نسبة العرض والطلب في السوق: فمثلًا لنفترض أن هناك محلًا للبيع في منطقة مكتظة جدًا في السوق بالتأكيد سيكون لديه المئات من المشترين وهذا هو ارتفاع الطلب بسبب الموقع المناسب، وفي حال كانت المحال المجاورة مختلفة عن نشاط المحل سيكون عندها العرض منتجات هذا المحل أقل، وبالتالي ستكون القيمة عالية لهذا المحل ويمكن أن يستغل صاحب المحل ذلك ويرفع من أسعاره. اختلاف القيمة من مكان لآخر: فمثلًا قيمة الملابس الصوفية ستكون أعلى في المناطق الباردة بالمقارنة مع المناطق الصحراوية. أهداف التسعير تُحدد أهداف التسعير أثناء وضع الأهداف التجارية والمالية للعلامة التجارية. يمكن لعناصر خطة عملك أن توجه اختياراتك لهدف التسعير وطريقة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المستقبلية. فإذا كان أحد أهداف عملك العامة هو أن تصبح رائدًا في السوق من خلال الحصة السوقية لمنتجك، يمكن أن يكون تعظيم هامش الربح هو هدف التسعير الأنسب لشركتك خصيصًا إذا كانت خطة عملك تتطلب نموًا في الإنتاج في المستقبل القريب لأنك ستحتاج إلى تمويل للمرافق والعمالة. وعمومًا يمكن تصنيف أهداف التسعير إلى ثلاث أهداف وهي: التسعير الموجهة للربحية Profit-Oriented Pricing. التسعير الموجه للمبيعات Sales-Oriented Pricing. أهداف التسعير وفق المنافسين Competitor-Oriented Pricing. التسعير الموجهة للربحية Profit-Oriented Pricing وهي الأهداف التي تركز على الأرباح كمحور مركزي للقرارات، وتتنوع أهداف التسعير الموجه للربحية وكل هدف له سياسة تسويقية وتنفيذية مختلفة كما هو الحال في معظم الأهداف التسويقية تحتاج أهداف التسعير إلى أن طريقة لقياسها للتحقق بشكل دقيق، وبناء على نتائج القياس توازن الأهداف مع النتائج التي استطاعت الشركة تحقيقها ومدى التقدم الحاصل في بلوغ الهدف.ولكن حتى نستطيع زيادة الأرباح أو تعظيمها يجب أن نفهم العميل والمنتج فهمًا عميقًا وفي طريقنا لتحقيق ذلك يجب أن نجيب على بعض الأسئلة المهمة التالية: ما أبرز الجوانب التي نريد معرفتها عن العملاء الذين نستهدفهم (الدراسة أو العمر أو عدد أفراد الأسرة …إلخ)؟ ما هي أبرز المشاكل التي يواجهونها والمتعلقة بالمنتج أو الخدمة التي نقدمها؟ ما هي الحلول المقترحة لهم؟ ما معايير العملاء الذين يشترون المنتجات أو الخدمات الحالية؟ هل العميل يقدر فعلًا قيمة المميزات الموجودة في المنتج؟ ما مدى رضاهم عن الجودة؟ هل العملاء حساسون للسعر؟ وما مدى حساسيتهم؟ بعد أن فهمنا العميل والمنتج يجب أن نحدد وجهتنا الدقيقة في الربحية، ومن أبرز تطبيقات التسعير الموجهة للربحية نذكر: تعظيم الأرباح Profit Maximization. الأرباح المرضية Satisfactory Profits. العائد على الاستثمار Return On Investment. 1. تعظيم الأرباح Profit Maximization يهدف التسعير في هذه الحالة إلى تحديد أسعار تؤدي إلى رفع الإيرادات الكلية للشركة بأكبر قدر ممكن بالمقارنة مع التكاليف الإجمالية كما أن رفع الأسعار يجب أن يكون منطقي وغير مبالغ به، ولا يجب على الشركة رفع الأسعار إذا كانت الشركة في مركز احتكاري في حال كونها الوحيدة في السوق لأن ذلك سيعطي انطباعًا سيئَا لها، بالإضافة إلى ذلك يجب ألا تتجاوز الأسعار القيمة المدركة للمنتج Product Perceived Value وتلعب قدرة المشتري الشرائية والبيئة الاقتصادية للدولة دورًا مهمًا في تحديد السعر الأعظمي. في بعض الأحيان عندما يعتمد المدراء على تعظيم الأرباح للمنتجات يحاولون زيادة القيمة المضافة للمنتج من خلال التوصيل المجاني أو الخدمات المرفقة المجانية كما يحاولون أيضًا تقليل التكاليف من خلال زيادة كفاءة للموظفين وأتمتة بعض العمليات أو شراء المواد الأولية بكميات كبيرة …إلخ. وبعض التجار وأصحاب الأموال يتوجهون إلى القطاعات ذات الربحية العالية مثل قطاع المكياج وأدوات العناية الشخصية للنساء أو المجالات الكيميائية الطبية التي تُعطى بدون وصفة طبيب لأن أرباحها عالية جدًا إذ يمكن أن تصل الربحية في هذه المجالات إلى 90% أو أكثر في بعض الأحيان؛ في الحقيقة هذا ما يجعل هذه المجالات شديدة التنافسية! تسيئ بعض الشركات فهم فكرة تعظيم الأرباح فتراها تركز بصورة كبيرة على تخفيض التكاليف كثيرًا بطريقة غير مدروسة سواء من خلال تسريح الموظفين أو الأقسام ذات الرواتب العالية أو تخفيض الميزانيات الخاصة بتطوير المنتجات ومن أشهر الأخطاء التي تقع بها الشركات هي تخفيض ميزانية الإعلانات فبالرغم من أن تخفيض الميزانية الإعلانية سيؤدي إلى زيادة الأرباح ولكن هذه الأرباح ستكون على المدى القصير، كما أن هذه الطريقة ستؤدي إلى انخفاض الوصول إلى العملاء الجدد وبالتالي انخفاض معدل تحويل العملاء الجدد إلى مشترين وبالتالي انخفاض أرباح الشركة على المدى الطويل؛ لذلك تعمل الشركات دومًا على إيجاد المعادلة المناسبة بين طموح الشركات لإبقاء تكاليف التشغيل منخفضة مع الحفاظ على تعظيم ربحية الشركة. 2. الأرباح المرضية Satisfactory Profits تهدف الشركة في هذه الحالة إلى تحديد مستوى أرباح مقبول ومنطقي للشركة أي أن الشركات تسعى لتحقيق مستوى ربح يتوافق مع مستوى المخاطر التي تواجه الشركة. يمكن أن تصل الأرباح المرضية في بعض الصناعات أو الأسواق شديدة المخاطر إلى 35% وهو رقم أكبر بكثير من مستوى الأرباح الشائع 10-20%. أو أن الشركة تسعى لتحقيق نسبة الربح المشابهة للمنافسين ريثما تعزز من قوة فريقها وإمكانياتها في المستقبل لكي تستطيع عندها زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها. في الحقيقة إن الشركات الذكية حريصة جدًا على ضمان استدامتها على المدى الطويل ولذلك فإنها تسعى لوضع أسعار منطقية وتحقيق أرباح معقولة بالإضافة إلى ذلك الأرباح المرضية للمنتجات تشجع الموزعين والموردين للاستفادة من هذا المنتج. تعتمد شركة آبل Apple على التسعير المرضي في بعض منتجاتها، فبحسب إحصائية صادرة عن موقع Statista جاء فيها أن هامش الربح في أجهزة ماك Mac بلغ 25٪ فقط، وهذا أمر مفاجئ بالموازنة مع جودة المنتج ومكانته في السوق. يتكهن بعض الباحثين بأن شركة آبل تسعى إلى تعظيم الأرباح من خلال الوظائف الإضافية التي يمكن أن يشتريها العملاء مثل اشتراكات آبل ميوزك Apple Music وخدمة التخزين السحابي وهذه الخدمات الإضافية لها هامش ربح أعلى بكثير وهو 59٪. في الحقيقة لا نعلم بنية شركة آبل في هذا التعسير سواء أكان ذلك حقًا من أجل كسب أرباح مرضية في أجهزة الماك وجعلها متاحة لجميع طبقات المجتمع أم أنها طريقة ذكية منها للالتفاف والدوران وتشجيع المستهلكين للدخول إلى النظام البيئي Ecosystem لشركة آبل! في الحقيقة يمكن أن تكون استراتيجية الأسعار المرضية مفيدة في الشركات التي تقع في البلدان ذات المعايير الثقافية القوية والتي تشجع على الإنصاف والإيثار والود والكرم والعطف مع الآخرين. 3. العائد على الاستثمار Return on Investment يعد هدف العائد على الاستثمار (ويشار إليه اختصارا ROI) من أكثر أهداف الربحية شيوعًا. إذ يقيس العائد على الاستثمار إلى نسبة الأرباح مقابل الاستثمار (كنسبة مئوية). فمثلًا إذا كان رأس المال 100 مليون دولار أمريكي وتسعى الشركة لتحقيق عائد 15% على الاستثمار فهذا سيتطلب أن تكون الأرباح 15 مليون دولار أمريكي وكلّما ارتفع العائد على الاستثمار كان وضع الشركة أفضل. تسعى الشركة في هذا التوجه إلى تحقيق الربحية التي تراها مناسبة من خلال العائد على الاستثمار بغض النظر عن أسعار المنافسين وبقية التفاصيل الأخرى. عمومًا يمكن الاعتماد على أهداف التسعير الموجهة للربحية عندما نواجه الحالات التالية: تمتلك الشركة منتجات منخفضة التكلفة من خلال استطاعتها تحقيق ميزة تنافسية على مستوى التكاليف (مثلما يحدث عند استيراد كميات كبيرة من مواد أولية من الصين). عندما تقود الشركة أسعار السوق في هذه الحالة ستكون أسعار الشركات المنافسة ملاحقة لأسعار الشركة القائدة ويمكن ألا يتأثر المستهلك برفع السعر. يكون هناك عائد مهم مطلوب لدى إطلاق المنتجات الجديدة. سهولة نسخ المنتج من قبل المنافسين وبالتالي سيكون الوقت قصيرًا لنشر المنتج وفي حال رؤية المستهلكين لأسعار المنافسين قريبة لسعر المنتج الأول في السوق عندها سيشترون المنتج الأول لأقدميته. التسعير الموجه للمبيعات Sales-Oriented Pricing ترتكز أهداف التسعير الموجهة للمبيعات إلى زيادة الحصة السوقية أو تعظيم المبيعات. ولتحديد التوجه الأنسب يجب في البداية تقدير المبيعات الحالية للشركة سواء نقدًا أو بعدد المنتجات المباعة، ومن المهم تحديد طريقة تقييم الحصة السوقية لأن النتائج ستكون مختلفة بحسب طريقة التقييم لنفترض مثلًا وجود أربع شركات تتنافس في سوق بحجم مبيعات كلي 2000 منتج وبعائدات كلية على مستوى الصناعة 4000 دولار أمريكي كما هو مبين في الجدول التالي: فوفقًا لعدد الوحدات المباعة تتمتع الشركة A بأكبر حصة سوقية وهي 50% ولكنها لا تمتلك سوى 25% كحصة سوقية من الإيرادات بالمقابل تستحوذ الشركة D على 15% فقط من عدد المنتجات المباعة في السوق ولكنها تمتلك أعلى حصة من إيرادات السوق 30%. نلاحظ من المثال السابق بأنه ليس من الضروري بيع كميات كبيرة للحصول على عائد مجزي على الاستثمار لذلك لا يمكننا الجزم دائمًا بأن الحصة السوقية الأعلى تعني الأرباح الأكثر لأن الكثير من الشركات التي تتصارع في الأسواق شديدة التنافسية يمكن أن تخسر المال عندما تحاول السيطرة على أكبر حصة سوقية. فمثلًا، حولت شركة بروكتر وغامبل Procter & Gamble من تركيزها على زيادة الحصة السوقية للشركة إلى زيادة العائد على الاستثمار وذلك عندما أدركت بأن الأرباح لا تتولد تلقائيًا عند زيادة الحصة السوقية. عمومًا تتجه الشركات في هذه الاستراتيجية التسعيرية إلى تحقيق أحد الهدفين التاليين: الحصة السوقية Market Share. تعظيم المبيعات Sales Maximization. 1. الحصة السوقية Market Share يراقب المستثمرون والمحللون تاريخ الشركات التي يريدون أن يستثمروا بها ويركزون على حالات زيادة أو نقصان الحصة السوقية بعناية لأنه يمكن أن يشير إلى ضعف القدرة التنافسية النسبية لمنتجات الشركة أو خدماتها أو فريق عملها. مع نمو السوق الإجمالي لمنتج أو خدمة، فإن الشركة التي تحافظ على حصتها في السوق تزداد إيراداتها بنفس معدل نمو السوق. تلجأ بعض الشركات إلى اعتماد الابتكار لزيادة حصتها في السوق. لأنه عادة عندما تقدم إحدى الشركات تقنية جديدة لم يقدمها منافسيها بعد، فإن المستهلكين الراغبين في امتلاك هذه التكنولوجيا سيشترون من تلك الشركة حتى ولو لم يسبق لهم التعامل معها من قبل ويمكن جدًا أن يصبح العديد من هؤلاء المستهلكين عملاء مخلصين. بالإضافة إلى ذلك تحمي الشركات حصتها الحالية في السوق من خلال إدارة العلاقات مع العملاء Customer Relationship Management ومنع العملاء الحاليين من القفز إلى سفينة إحدى المنافسين عندما يطرحوا عرضًا جديدًا. ويمكن استخدام نفس الأسلوب -الاهتمام الكبير بالعملاء- للحصول على عملاء الشركات المنافسة ففي نهاية المطاف سيتحدثُ العملاء الراضين عن تجربتهم الإيجابية لأصدقائهم وأقاربهم الذين سيُصبحون فيما بعد عملاء جدد أيضًا. من الجدير بالذكر أن الحصول على حصة في السوق من خلال التسويق الشفهي يزيد من إيرادات الشركة دون الزيادات المصاحبة في نفقات التسويق وهذا أمر يحبذه أصحاب العلامات التجارية ويسعون إلى تحقيقه. 2. تعظيم المبيعات Sales Maximization تسعى بعض الشركات نحو تعظيم مبيعاتها بدلًا من السعي للحصول على حصة سوقية معينة. تميل الشركات التي تسعى إلى تعظيم مبيعاتها إلى عدم التركيز على الأرباح أو المنافسة أو البيئة التسويقية طالما أن المبيعات في تزايد مستمر، فإذا كانت الشركة تعاني من مشكلات في التمويل أو كانت تواجه مستقبلًا يكتنفه الغموض فإنها تحاول توليد أكبر قدر من السيولة على المدى القريب من خلال زيادة المبيعات. ويتوجب على الإدارة عندها تبني منهجية تساعد على موازنة العلاقة بين السعر والكمية Price-quantity Relationship التي تولد أكبر سيولة من الإيرادات. يمكن اللجوء إلى تعظيم المبيعات عندما يوجد في المخزون منتجات زائدة أو منتجات يمكن أن تكسد وتحتاج لعناية مُكلفة (مثل تبريد) لذلك لا نستغرب مشاهدة تخفيضات تتراوح بين 50% وحتى 70% بالمئة على بعض المنتجات المتعلقة بالمناسبات (مثل الشجر أو الزينة) بعد انتهاء مواسمها. وعمومًا يجب ألا نعتمد على هدف تعظيم المبيعات كهدف بعيد المدى لأن تعظيم المبيعات يمكن أن يُخفض أو يلغي الربحية. عمومًا يمكننا الاعتماد على أهداف التسعير الموجهة للمبيعات عندما نواجه الحالات التالية: السوق حساس للتغيرات الصغيرة على مستوى السعر. تكاليف الإنتاج منخفضة. يمكننا التوقع أو التنبؤ بانخفاض التكاليف بنسبة محددة عند زيادة الإنتاج. احتمالية كبيرة لدخول منتجات بديلة إلى السوق. عند الدخول إلى سوق جديد نامٍ. وجود فروقات بسيطة في القيمة المدركة للمنتجات المطروحة في الأسواق. الرغبة في زيادة التنافسية وتقليص فرص دخول المنافسين إلى السوق. أهداف التسعير وفق المنافسين Competitor-Oriented Pricing تعد استراتيجيات التسعير وفق المنافسين من أبرز الاستراتيجيات المنتشرة بين الشركات الناشئة، وفي هذه الطريقة تُحدد أسعار منتجاتك أو خدماتك بناءً على الأسعار التي يحددها أقرب منافسيك. تُطبق هذه الاستراتيجية عندما يكون المنتج متجانسًا مع بقية المنتجات والسوق شديد التنافسية. يُعرف التسعير التنافسي أيضًا باسم التسعير الموجه نحو السوق لأن الشركات تنظر في أسعار السوق بدلًا من تحليل التكاليف الخاصة بها. ومن أجل الوصول إلى فهم عميق لكيفية تسعير المنافسين يجب الإجابة على هذه الأسئلة في البداية: ما هي الشركات المنافسة؟ وكم عددها؟ وما حجم حصتها من السوق؟ ما هي مناطق انتشار الشركات المنافسة؟ وما المنتجات التي يبيعونها؟ كيف يحققون مكانة متميزة وأفضلية لأنفسهم؟ ما هي السلبيات والإيجابيات الخاصة بمنتجاتهم المطروحة وعروضهم المقدمة؟ ما نوع استراتيجية التسعير التي يتبعونها؟ وكم مرة يغيرون أسعارهم في السنة؟ ما حجم نفقات المنافسين؟ وهل يستطيعون تحقيق الأرباح؟ وما هي نسبة أرباحهم؟ ما المواد التسويقية التي يستخدمونها؟ وكيف كان أداؤهم فيها؟ ما العروض التي لا يقدمونها ونستطيع تقديمها؟ كم عمر المنافسين في السوق؟ وما هو معدل نموهم؟ وللتعرف أكثر على كيفية إيجاد المنافسين والتعرف على ميزاتهم وأسعارهم، ننصحك بمتابعة جزئية البحث والتخطيط من مسار أساسيات إدارة تطوير المنتجات لدورة إدارة تطوير المنتجات المقدمة من أكاديمية حسوب. تتجه الشركات في هذه الاستراتيجية التسعيرية إلى تحقيق أحد الهدفين التاليين وهما: الاستراتيجية التوافقية Adjustment Strategy. الإستراتيجية المتخصصة Niche Strategy. 1. الاستراتيجية التوافقية Adjustment Strategy تعتمد الشركات في بعض الحالات على وضع أهدافها السعرية بما يتوافق مع أسعار المنافسين بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار السوق وعدم نيتها الخوض في الحروب السعرية أو سباق السقوط إلى الهاوية. عادة ما يكون سعر المعياري هو السعر الذي يحدده زعيم السوق. تسمى هذه الاستراتيجية بالتسعير وفقًا للوضع الراهن Status Quo Pricing وعوضًا عن المنافسة بالسعر تتنافس الشركات على العناصر الأخرى من المزيج التسويقي مثل التوزيع أو الترويج والتسويق أو تطوير المنتجات أو التوصيل المجاني …إلخ. تبنت الشركات هذه الإستراتيجية في العديد من الأسواق، بما في ذلك السفر الجوي والمنتجات البترولية والاتصالات. المتطلبات الأساسية لاستراتيجية التعديل هي هياكل تكلفة متشابهة بين قائد السوق والشركات المنافسة. تفترض الإستراتيجية أيضًا أن سياسات التسعير لزعيم السوق لا تهدف إلى إضعاف أتباع السعر، وبالرغم من ذلك تعد سياسة التسعير التوافقي سلبية وغير أمثلية لأنها تتجاهل القيمة المدركة من قبل المستهلكين لمنتجات وخدمات الشركة والشركات المنافسة. كما تتجاهل أيضًا كمية العرض والطلب في السوق. 2. الاستراتيجية المتخصصة Niche Strategy تُحدد الاستراتيجية المتخصصة السعر من خلال التمايز عن أسعار المنافسين. أي يحدد السعر برقم لم يستخدمه أحد في السوق. يمكن لمركز السعر هذا أن يقع ضمن نطاق غير مغطى بين الأسعار الأخرى مثل أن يقع عند الطرف العلوي أو السفلي من النطاق السعري السائد. في الحقيقة كلما زاد تجزئة السوق من ناحية القوة الشرائية للمستهلك وتفضيلاته الشخصية زادت إمكانية وضع سعر مناسب وتحقيق المعادلة الرابحة. تتجه الشركات في هذه الاستراتيجية إلى طريقتين وهما: التسعير المرتفع عن المنافسين: ترفع الشركات وفقًا لهذه السياسة أسعار منتجها لتكون الأعلى بين أسعار المنافسين، ويمكن أن يكون ذلك فعالًا في المرحلة الأولى من دورة حياة المنتج؛ ويمكن أن يعطي السعر انطباعًا أوليًا بارتفاع جودة المنتج وبأنه أفضل من منتجات بقية المنافسين؛ لذلك فهو يستحق التميز وتعزز الشركة هذه الفكرة من خلال التغليف المميز والأنيق وتصميم المتجر الراقي والحملات التسويقية المميزة. التسعير المنخفض عن المنافسين: ويسمى أيضًا بالتسعير العدائي Aggressive Pricing أو التسعير الجائر تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد الأسعار منخفضة لمحاولة طرد المنافسين وخلق أجواء احتكارية على بيع منتج محدد، ويستفيد المستهلكون من انخفاض الأسعار على المدى القصير، لكنهم يعانون إذا نجح المخطط في القضاء على المنافسة، لأن ذلك سيؤدي ذلك إلى تراجع الاختيار واحتمالية ارتفاع الأسعار بسبب الاستغلال. بالرغم من أن هذه السياسة لا تتطلب الكثير من التخطيط إلا أنها مخاطرة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل كارثية. ينتهك التسعير الجائر قوانين مكافحة الاحتكار، لأنه يجعل الأسواق أكثر عرضة للاحتكار. ومع ذلك من الصعب مقاضاة مزاعم هذه الممارسة لأن المدعى عليهم يجادلون بأن خفض الأسعار جزء من المنافسة العادية، وليس محاولة متعمدة لتقويض السوق. علاوة على ذلك، لا ينجح التسعير الجائر في تحقيق هدفه دائمًا بسبب الصعوبات في استرداد الإيرادات المفقودة والقضاء على المنافسين بنجاح. هناك بعض التطبيقات الخطرة في ممارسة التسعير العدائي منها عملية الإغراق Dumping، وهي عندما يحاول أحد المفترسين غزو سوق أجنبية جديدة عن طريق بيع البضائع هناك على الأقل مؤقتًا مقابل أقل مما يفرضونه في الأسواق المحلية. يكمن التحدي لا سيما في الأسواق العالمية المتزايدة، في منع شراء البضائع "المغرقة" في الخارج وإعادة بيعها في السوق المحلية المربحة. حاول تحالف من الشركات الألمانية في أوائل القرن العشرين إغراق سوق الولايات المتحدة بمادة البروم Bromine والذي هو عنصر أساسي في العديد من الأدوية كما أنه عنصر حيوي في التصوير الفوتوغرافي. حاول الألمان بيع البروم في الولايات المتحدة بأقل من تكلفة التصنيع، إلا أن إحدى الشركات الأمريكية التي تدعى Dow Chemical كانت أذكى من ذلك واستجابت بذكاء على هذا الأمر من خلال شراء البروم في الولايات المتحدة وإعادة بيعه في أوروبا، مما سمح لها بتقوية قاعدة عملائها الأوروبيين على حساب تحالف الشركات الألمانية. لحسن الحظ بالنسبة للمستهلكين فإن المنافسة بتخفيض السعر يفيدهم ويزيد من قوتهم الشرائية، بينما تكون هذه المنهجية صعبة التطبيق على الشركات وخصيصًا إذا كانت لفترات طويلة، فعلى سبيل المثال، إذا أرادت محطة وقود خفض الأسعار لفترة كافية لطرد جميع المنافسين في منطقة يكثر بها محطات الوقود لن تستطيع تحقيق أية أرباح لأن الأرباح على أٍسعار الوقود منخفضة بطبيعتها وبالتالي لن تكون المهمة سهلة. تعمد بعض الشركات إلى اعتماد التسعير الجائر عند الحالات التالية: عندما يكون المنتج في مراحل مبكرة من دورة حياته. في حال كانت الأسواق بحالة نمو مستمر. عند وجود فرص لبناء أو الحصول على حصة سوقية كبيرة. ولكن هل هذه كل الخيارات لدينا في التسعير؟ في عام 2005 نشر الباحثان دبليو شان كي وزميلته البروفسورة رينيه موبورن كتابًا جاء كخلاصة لأبحاثهم؛ إذ عكفوا على إجراء دراسة لـ 150 خطوة استراتيجية للشركات ضمن 30 صناعة تجارية مختلفة بعض الخطوات امتدت على مدى 100 عام، وتوصلوا إلى فكرة مفادها بأن الخيار الأفضل للشركات الجديدة التي تريد الدخول في السوق هو أن تولد طلبًا في مساحة سوق جديدة بدلًا من التنافس على نفس مساحة السوق الحالية. صاغ الباحثان هذه الفكرة ونشروها في كتابهم المميز "استراتيجية المحيط الأزرق". استراتيجية المحيط الأزرق Blue Ocean Strategy يرى هذان الباحثان بأن أسوأ خيار يمكن أن يتخذه مدير الشركة هي أن تتنافس مع الشركات الأخرى على السعر وإنما جعل الفكرة الأساسية للتنافسية مبنية على الإبداع والابتكار وإنشاء مساحة سوق غير متنازع عليها والاستيلاء عليها، مما يجعل المنافسة غير موجودة أساسًا. ولكن يعد إنشاء محيط أزرق أمرًا صعبًا ويتطلب عمومًا من الشركة الابتكار لدرجة التمايز وليس التميز فقط، بطريقة تخلق طلبًا غير موجود سابقًا أو غير محقق، ويتضمن الابتكار السعي وراء تحسين جودة التصنيع أو التصميم لفتح أسواق جديدة وغير تنافسية، والنتيجة هي تطوير سوق خالٍ من المنافسة ويسمح بنمو واسع النطاق. في المحيطات الزرقاء لا يوجد تعريف محدد للسوق ولا يوجد هيكل للصناعة ولا منافسين أقوياء ويمكن إعادة بناء كل هذه المفاهيم من خلال قيادة السوق، ولكي نستطيع إنشاء محيط أزرق جديد لا بد من الإجابة على بعض الأسئلة التالية: لماذا يختارنا عملاؤنا حاليًا ويبقون معنا؟ ماذا يفعل منافسونا؟ هل يختار عملاؤنا المثاليون منتجًا مختلفًا؟ أين المحيطات الحمراء؟ ما المميزات والفوائد التي نتنافس فيها وجهًا لوجه مع منافسينا؟ ما هو محيطنا الأزرق؟ ما الذي نقدمه لعملائنا ولا يستطيع أي شخص آخر تقديمه؟ تسعى الكثير من الشركات إلى بناء محيطات زرقاء لمنتحاتها ومن أبرز فوائد بناء المحيطات الزرقاء نذكر: إنشاء سوق بلا منازع: الهدف الأول لاستراتيجية المحيط الأزرق هو النظر إلى ما وراء الحدود التقليدية للأسواق الحالية لإنشاء سوق بلا منافسين. جعل عملية الموازنة غير منطقية: من خلال التمايز الكبير عن المنافسين تعكس هذه الاستراتيجية لجعل الموازنة مع منتجات المنافسين غير منطقية، وبذلك تكون الفرصة لإنشاء قواعد اللعبة واحترافها. إنشاء طلب جديد والتقاطه: لا تتعلق فقط بخلق طلب جديد وإنما بتلبية هذا الطلب في السوق يجب أن يكون للشركة استراتيجية توزيع قوية للسيطرة على هذا السوق الجديد. وبخلاف ذلك فإن الخطر لا يزال قائمًا. كسر مقايضة التكلفة والقيمة: المفهوم المركزي لاستراتيجية المحيط الأزرق هو كسر مقايضة التكلفة والقيمة. وبالتالي، لا يمكنك فقط تقديم المزيد من القيمة مقابل نفس سعر المنافسين. وإنما بناء استراتيجية خاصة لا تفرض عليك شروط محددة للمنافسة. تعزيز أهمية القيمة الأعلى التي تقدمها الشركة بتكلفة أقل: يدرك لاعبو المحيط الأزرق إمكانية كسر مقايضة التكلفة والقيمة. إنهم بحاجة إلى جعل هذا المبدأ ميزة مضمنة في المنظمة ككل مثل التركيز على الخصوصية أو الأمان والحماية ومحاولة إقناع جميع المستهلكين بأهمية هذه المبادئ ووضع السعر المناسب لهذه التركيبة الموجودة في المنتج. الخاتمة تعرفنا في هذا المقال على ماهية الوعي بالسعر واستعرضنا عملية التسعير والفروقات بين السعر والتكلفة والقيمة وفصلنا في فهم استراتيجيات التسعير وتطبيقاتها المتنوعة لنختتم المقال باستعراض استراتيجية المحيط الأزرق والتي جعلتنا نعيد التفكير في كيفية التميز في الأسواق المزدحمة ولكن كيف يدرك المستهلكين السعر؟ وهل يمكن أن يرتبط السعر المرتفع بالجودة العالية؟ أو يعزز القيمة المدركة للمنتج؟ هذا ما سنتعرف عليه في الجزء الثاني من هذا المقال. المصادر كتاب Price Management_ Strategy, Analysis, Decision, Implementation للكاتبان Hermann Simon و Martin Fassnacht الطبعة الأولى. كتاب Pricing Strategy: Setting Price Levels, Managing Price Discounts and Establishing Price Structures للكاتب Tim Smith الطبعة الأولى. مقال Market Share لصاحبه Adam Hayes. مقال The Blue Ocean Strategy Summary (With 4 Examples) لصاحبته Amanda Atrash. مقال Blue Ocean Strategy versus competitive-based strategy لصاحبه Ioan Carpus. اقرأ أيضًا السعر هو ما تدفعه، والقيمة هي ما تحصل عليه أهداف تسعير المنتج واستراتيجياته المختلفة مدخل إلى الوعي بالعلامة التجارية مفهوم الوعي بالإعلان Advertising Awareness
-
هل تساءلت يومًا لماذا تتبادر بعض العلامات التجارية إلى الذهن عند التفكير في كلمات أو أماكن أو أشخاص أو أوقات معينة؟ يبدو هذا الأمر طبيعيًا، أليس كذلك؟ ولكن في الحقيقة أمضت العلامات التجارية والشركات أعوامًا مديدة وأنفقت أموالًا عديدة في تأسيس هذه الارتباطات الذهنية من خلال تفاعل هذه العلامات التجارية مع المستهلكين في لحظاتهم اليومية والأوقات المهمة في حياتهم مع هذه العلامات التجارية. في الواقع لم يكن الاهتمام بالعلامة التجارية في القرن الماضي مثل ما نراه اليوم، إذ كان ينظر للتسويق بحد ذاته على أنه هدرٌ للأموال وينظر للبيع على أنه الأداة الأقوى لنمو الشركة وجلب الأرباح ولكن مع اهتمام الباحثين بدراسة العلامات التجارية وكيفية بنائها تطورت رؤيتنا للعلامة التجارية ومكوناتها على مر السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا وأصبح من المعروف على نطاق واسع بأن العلامة التجارية واحدة من أهم أصول الشركة، مما يجعل الإدارة الفعالة للعلامة التجارية عاملًا رئيسيًا في نجاح الشركة، وكل خطوة تؤدي إلى تطوير وتعزيز قوة العلامة التجارية على المدى الطويل يجب تطبيقها لأنها ستُعزز من وجود الشركة وتحافظُ على مركزها التنافسي في السوق، سواء السوق المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي. سنكمل في هذا المقال ما بدأنا به في التعرف على مكونات العلامة التجارية وسنطلّع على صورة العلامة التجارية والارتباطات الذهنية للعلامة التجارية. صورة العلامة التجارية Brand Image صورة العلامة التجارية هي وجهة النظر الحالية للعملاء حول العلامة التجارية. يمكن تعريفها على أنها "مجموعة فريدة من الارتباطات في أذهان العملاء المستهدفين". أي إنها مجموعة من المعتقدات المتعلقة بعلامة تجارية معينة، كما أنها الطريقة التي يُنظر للعلامة التجارية معينة في السوق، وغالبًا ما تمثل صورة العلامة التجارية قيمة عاطفية وليست مجرد صورة ذهنية. الفكرة الكامنة وراء صورة العلامة التجارية هي أن المستهلك لا يشتري المنتج أو الخدمة فحسب، بل يشتري أيضًا الصورة المرتبطة بها؛ لذلك يجب أن تكون صور العلامة التجارية إيجابية وفريدة ومميزة. يمكن تعزيز صور العلامة التجارية باستخدام اتصالات العلامات التجارية مثل الإعلان والتعبئة والتغليف والتسويق الشفهي والأدوات الترويجية الأخرى وما إلى ذلك، كما يجب أن تسليط الضوء على رؤية ومهمة الشركة أو العلامة التجارية. الارتباطات الذهنية بالعلامة التجارية Brand Association في الحقيقة تتألف صورة العلامة التجارية في جوهرها من الارتباطات الذهنية الخاصة بالعلامة التجارية لأنه عندما يرى المستهلك صورة أو فيديو عن العلامة التجارية فإنه يبني ارتباطات مختلفة مع العلامة التجارية، وبناءً على هذه الارتباطات فإنه يشكل صورة العلامة التجارية. ويمكننا تعريف الارتباطات الذهنية بالعلامة التجارية Brand Association بأنها أي شيء مرتبط في الذاكرة بالعلامة التجارية في الحقيقة لا يمكننا استنتاج القوة الحقيقة لهذه المكونات الخاصة بالعلامة التجارية من خلال التعريف فقط، ولفهم الأمر بطريقة صحيحة لا بد الغوص عميقًا في النظريات المختلفة لمعرفة درجة ارتباط كل عنصر من عناصر العلامة التجارية في أذهان المستهلكين. علم النفس وراء الارتباطات الذهنية بالعلامات التجارية لا بدّ لنا في التعمق في علم النفس Psychology لمعرفة كيف تبنى الارتباطات الذهنية بالعلامات التجارية. في الحقيقة إن معظم النظريات الحديثة بنيت على نظرية هببيان Hebbian Theory، التي طورها الأب الروحي لعلم النفس العصبي Neuropsychology دونالد هب Donald Hebb، والتي نُشرت عام 1949. يحاول هب في نظريته شرح كيفية يحدث التعلم داخل الدماغ. يستعرض هب في جزء من نظريته كيفية تطور المسارات العصبية بناءً على الخبرات وأنه عندما تُنشأ اتصالات معينة بصورة متكررة، فإنها تصبح أسرع وأقوى من مثيلاتها. كما افترض هب أنه من المرجح أن تسبب فكرة ما في استدعاء فكرة أخرى إذا استدعيت في نفس الوقت في مناسبات متعددة في الماضي. غيرت نظرية هب طريقة رؤيتنا للدماغ وكيفية التعلم الخاصة به ومع صعود الحواسيب والأنظمة البرمجية توالت الأبحاث والاهتمامات في نقل طريقة هيكلة المعرفة في الدماغ إلى الحاسوب ومن بين الباحثين الذين عكفوا على نقل ذلك الباحث جون آر أندرسون John R. Anderson والذي نشر في عام 1983 كتابه في مجال "هيكلية المعرفة The Architecture of Cognition"، والتي ناقش فيه لأول مرة مفهوم "الارتباطات الذهنية Mental Associations" اعتمد جون في بحثه على مفهوم البنية المعرفية Cognitive Architecture أو هيكلية المعرفة وهي نظرية حول الهياكل الموجودة داخل العقل البشري وكيف تعمل معًا لإدارة السلوك الذكي في أي بيئة معقدة. الهدف من هذه النظرية هو استخدام البحث في علم النفس المعرفي لإنشاء نموذج حاسوبي كامل للإدراك البشري. حاول جون بناء نموذج شامل ومعقد لعمل الذاكرة تحت مسمى نموذج شبكة الارتباطية الذهنية Associative Network Model والتي هي مجموعة من العقد المعرفية المخزنة في الذاكرة طويلة الأجل والمرتبطة بمفاهيم معينة. في الحقيقة كان هذا البحث الذي طرحه جون بوابة الباحثين للدخول إلى مفاهيم عميقة حول الارتباطات الذهنية وكيفية تشكيلها في الدماغ. كعادتهم علماء التسويق والباحثين فما إن يروا أي طريقة جديدة لاختراق دماغ المستهلك إلا واشبعوها بحثًا لمعرفة كيفية التأثير على المستهلك المسكين. ومن بين هؤلاء الباحثين كان هنالك باحثان شديدا الاهتمام في هذا الأمر وهما كيفن لين كيلير Kevin Lane Keller وديفيد آكر David A. Aaker، وسرعان ما استطاعوا تحديد مفهوم "الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية Brand Associations"، فعرفها كيفن بالتعريف التالي: أما ديفيد فرأى بأن الارتباطات الذهنية هي: هنالك الكثير من التعاريف التي تحاول لم شمل هذا المفهوم المتوسع باستمرار، وعمومًا يمكن للارتباطات الذهنية أن تعكس مجموعة من الأفكار والمشاعر والإدراكات والصور والتجارب والمعتقدات والاتجاهات نحو العلامة التجارية، كما تتأثر عملية بناء الارتباطات الذهنية بالتجارب الاستهلاكية للفرد بالدرجة الأولى، إذ إن تكرار التجارب الإستهلاكية على نحو مستمر يساهم في تقوية الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية. إن هذه الطروحات العلمية المتتالية لم تغير طريقة تفكيرنا حول كيفية عمل الدماغ فحسب وإنما غيرت تفكيرنا حول كيفية بناء العادات واكتسابها وأهمية التكرار، وبالتأكيد غيرت أيضًا مفهوم مدراء العلامات التجارية حول أهمية الاستثمار في بناء الارتباطات الذهنية والدخول إلى عقول العملاء من خلال بناء ارتباطات تتعلق بالجودة أو الأناقة أو التميز أو الفخامة …إلخ، لتتشكل من هذه الارتباطات في نهاية المطاف إلى صورة للعلامة التجارية. نظرة معمقة على الارتباطات الذهنية يختلط في بعض الأحيان على البعض بين مصطلحي الارتباطات الذهنية وصورة العلامة التجارية ويعتقدون بأن لهما نفس المعنى في الحقيقة أنهما مفهومان مكملان لبعضهما بعضًا والتمايز الرئيسي في أن الارتباط الذهني هو الدرجة التعرف على المنتج في إطار صنف المنتجات التي ينتمي لها، بينما تتضمن صورة العلامة التجارية إدراكات العلامة التجارية بصورة عامة، بعبارة أخرى أن الارتباطات الذهنية هي مجموعة من النقاط التي تشكل صورة العلامة التجارية. لنستكشف معًا ما يمكن أن تشير إليه الارتباطات الذهنية بالضبط. يحاول الباحث كيفن لين كيلر Kevin Lane Keller في بحثه بعنوان "قياس قيمة العلامة التجارية Measuring Brand Equity" المنشور عام 2017 أن يحلل عناصر العلامة التجارية ويقدر أهمية كل مكون لتحديد طريقة منهجية لقياس قيمة العلامة التجارية، ولكن ما يهمنا في هذه الدراسة هي رؤيته لصورة العلامة التجارية والارتباطات الذهنية الخاصة بها وكيف يمكن فهم صورة العلامة التجارية في أعين العملاء. في الحقيقة يرى كيفين بأن الصورة الذهنية تتألف من: أنواع الارتباطات الذهنية، وتتألف من: الارتباطات الذهنية بخصائص المنتج، وهي بدورها تتألف من: الارتباطات الوظيفية الارتباطات غير الوظيفية الارتباطات الذهنية بالموقف تجاه المنتج الارتباطات الذهنية بفوائد المنتج، وتتألف من: الفوائد الوظيفية الفوائد التجريبية الفوائد الرمزية تفضيل الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية قوة الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية تميّز الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية سنشرح كل واحدة منها بالتفصيل لنشكل صورة واضحة عن كيفية أخذ المستهلك صورة عن العلامة التجارية. 1. أنواع الارتباطات الذهنية تتعدد أنواع الارتباطات الذهنية وكل نوع يتميز بطريقة اتصال معينة مع المستهلك وأسلوب محدد لتوصيل رسائل العلامة التجارية وسنتعرف عليها بالتفصيل. 1.1. الارتباطات الذهنية بخصائص المنتج تعرف بأنها المكونات الأساسية التي تمكن المنتج أو الخدمة من تنفيذ الوظيفة التي يبحث عنها المستهلكون وبالتالي فهي ترتبط بالتركيبة الفيزيائية أو المادية للمنتج ومتطلبات الخدمة، وتختلف هذه الخصائص باختلاف صنف المنتج أو الخدمة وهي تعبر عن خصائص أو مزايا أو سمات المنتج التي يمكن التعرف عليها من تقييم المستهلك للمنتجات. فمثلًا لنفترض بأن لدينا شركة تصنع شاشات ذكية فمن البديهي بالنسبة لهذه الشركة بأن تكون ميزتي الجودة وحجم الشاشة من أهم المميزات الفارقة لدى المستهلكين، ولكن هل هاتين الميزتين هما الوحيدتين اللتان يجب الاهتمام بهما؟ في الحقيقة تطوّر الشركات العديد من الميزات والخصائص وتتجمع تحت مسمى "الفضاء متعدد الأبعاد The Multiattribute Space، فعندما نأخذ مثال الشركة التي تبيع الشاشات ونفترض بأن لدينا خاصيتين فقط عندها يمكننا وضع هذه الخصائص في فضاء ثنائي البعد Two Dimensional Attributes، تتمثل في بعدي حجم الشاشة وجودة الصورة، ووفقًا لهذا الفضاء يوجد نوعين من خصائص المنتج تتمثل في كل من الخصائص الأفقية والخصائص العمودية، إذ تمثل الخصائص العمودية الخصائص التي يتفق عليها أغلب المستهلكين بشأن مزايا وعيوب المنتج. أما الخصائص الأفقية فهي التي لا يتفق عليها المستهلكين وتختلف باختلاف المستهلكين، فعلى سبيل المثال فإن الأداء والجودة هما خاصيتين عموديتين للشاشة لأن معظم المستهلكين يؤمنون بضرورة ارتفاع جودة هاتين الخاصيتين، بينما يختلف المستهلكون في تقييم خاصية التصميم والألوان الطلاء ولذلك يمكننا اعتبارهما خاصيتين أفقيتين. أ. الارتباطات الوظيفية: إن أفضل استراتيجية لبناء مكانة للعلامة التجارية هي ربط شيء ما ذهنيًا بإحدى خصائص أو سمات المنتج لأن تطوير مثل هذه الارتباطات له فعالية كبيرة نظرًا لإمكانية ترجمة هذه الارتباطات الذهنية لأسباب لشراء أو حتى لعدم الشراء في بعض الأحيان، على سبيل المثال أصبحت العلامة التجارية كرست Crest رائدة في مجال معاجين الأسنان من خلال ارتباطها ارتباطًا قويًا بقدرتها على محاربة التسوس، بينما نجد شركة سنسوداين تربط علامتها بالحفاظ على اللثة. في الحقيقة تعتمد كل علامة تجارية على ربط نفسها بخاصية مختلفة عن العلامات التجارية الأخرى، فمثلًا ترتبط العلامة التجارية فولفو Volvo نفسها في أذهان المستهلكين بالمتانة بينما بي إم دبليو BMW بالأداء ونظام التعليق، أما جاكور Jaguar فربطت علامتها بالأداء والتصميم الأنيق والراقي، ويمكن للعلامات التجارية ربط نفسها بأكثر من ميزة ولكن يجب الانتباه لأنه يجب أن تكون الميزات متناسقة فيما بينها. ب. الارتباطات غير الوظيفية: من ناحية أخرى، هنالك خصائص غير مرتبطة بالمنتج وهي الجوانب الخارجية للمنتج أو الخدمة ويمكن اعتبارها ارتباطات ثانوية لأنها لا ترتبط مباشرة بوظائف المنتجات الرئيسية في ذهن المستهلك ومن الأمثلة عليها ارتباطات السعر أو بلد المنشأ أو قنوات التوزيع أو نوعية المشاهير أو الأحداث التجارية. 1.2. الارتباطات الذهنية بفوائد المنتج تمثل منافع العلامة التجارية القيمة الشخصية والمعاني التي يربطها المستهلك بالعلامة التجارية، وتكمن وراء هذه المنافع مجموعة من المعتقدات الوظيفيّة والعاطفية والرمزية ومن المهم فهم الاختلافات بين هذه المنافع لمعرفة كيفية تحسينها وزيادة تأثيرها في أذهان المستهلكين ولذلك سنشرح كل منفعة على حدة. أ. المنفعة الوظيفية: هي المنفعة المدركة والمكتسبة نتيجة قدرة المنتج على أداء أهداف وظيفية، أو نفعية أو مادية، فالمنافع الوظيفية تمثل إشباع الحاجات الجوهرية من خلال خصائص المنتج أو الخدمة وتلبي هذه المنافع عمومًا الحاجات الأساسية مثل الحاجات الفيزيولوجية. هناك مثلًا بعض المنافع الوظيفية المرتبطة ذهنيًا لدى المستهلكين بعلامات تجارية معينة مثل مشروب كوكاكولا بمنح الشعور بالانتعاش، ولكن ما يعاب على هذه المنافع الوظيفية أنها سهلة التقليد من طرف المنافسين الأمر الذي يجعل العلامة التجارية غير متميزة في أذهان مستهلكيها مما يفقدها خاصية التفرد عكس المنافع غير الوظيفية التي تساهم في خلق علامات تجارية قوية، وذلك بسبب صعوبة تقليدها من قبل المنافسين وكذلك بسبب تفاعل المستهلك بصورة أكبر مع الجوانب غير الملموسة بالموازنة مع الجوانب الملموسة للمنتج، لأنه في الحقيقة يرتبط المستهلك مع المنتج من خلال عقله بينما مع العلامة التجارية بواسطة قلبه الذي ينبع منه الولاء للعلامة التجارية والذي هو حلم كل علامة تجارية، ولذلك تستطيع العلامة التجارية أن تكسب ولاء المستهلك من خلال منحهم قيمًا أو صورًا ذهنية لا تُنسى. ب. المنفعة العاطفية: هي المنفعة الناتجة عن قدرة المنتج على إثارة المشاعر وهي كل ما يتعلق بعواطف وأحاسيس المستهلكين حيث أن العلامة التجارية التي تجعل المستهلك يشعر بمشاعر إيجابية نحوها هي العلامة التي منحته قيمة عاطفية جراء شراءها أو استخدامها، ومن أمثلة ذلك الشعور بالإثارة داخل سيارة بي أم دبليو BMW. ج. المنفعة الرمزية: يقف وراء إبراز الهوية الشخصية للفرد مجموعة من الأهداف، والقيم والمعتقدات التي تكون شعور متماسك بالذات عبر مجموعة من الأدوار الاجتماعية مثل العمل، والمنزل والأحداث الاجتماعية، ويسعى كل فرد منا إلى إنشاء هوية خاصة به بالاعتماد على خياراته الشرائية وتجاربه الاستهلاكية لذلك يستخدم العديد من المستهلكين العلامات التجارية للتعبير عن هويتهم في الحياة الاجتماعية وعن نموهم في الحياة والعمل، ولذلك يمكن أن يفضل المستهلكون تفرد العلامة التجارية بسبب ارتباطها بمفهوم الفخامة إذا ترقوا مثلًا في السلم الوظيفي في عملهم، في الحقيقة يمكن أن يكون السبب الرئيسي لشراء ساعة رولكس ROLEX ليس لمنع التأخر عن المواعيد أو الحفاظ على الوقت، وإنما لإظهار المشتري للناس بأنه يستطيع شراء مثل هكذا ساعة! عادة ما تتوافق المنافع الرمزية مع الخصائص غير المرتبطة بالمنتج، وتتصل بالحاجات الأساسية للقبول الاجتماعي كما تعزز هذه الفوائد المكانة الإجتماعية للمستهلك وهذا بسبب إرتباط هذه المنافع بالصورة الذاتية. تدعم أدبيات التسويق فكرة تقديم العلامات التجارية لمنافع رمزية في شكل قيم ثقافية واجتماعية، باعتبار أن هذه الأخيرة تخلق جماعات اجتماعية مرجعية والتي تقدم للعلامة التجارية مصدرًا مهما لارتباطات المستخدم ذهنيًا بالعلامة التجارية، لأن التفاعلات الاجتماعية بين المستهلكين والتفاعل بينهم وبين العلامة التجارية يساهم في تطوير الولاء وتكوين مجتمعات حول تلك العلامات التجارية وفق علاقات اجتماعية منظمة بين معجبيها أو مستخدميها. في هذا الإطار يعد معنى مجتمع العلامة التجارية جانبًا مهمًا من القيمة الاجتماعية للعلامة التجارية، لأن العلاقة بين الارتباط بالعلامة التجارية والارتباط بالمجتمع يرتكز على العلامة التجارية في حد ذاتها، كما أن الأفراد ينجذبون إلى المجتمع الذي ينتمون إليه، ويمكن أن تتطور العلاقة العاطفية لهؤلاء الأفراد مع العلامة التجارية إذا ما كانوا يشعرون بأنهم جزء من ذلك المجتمع، وإذا كانت مبادئ وقيم وعادات المجتمع تتعلق ببعض العلامات التجارية لتصبح مهمة بالنسبة إليهم كونها رمزًا من رموز التفاعل الاجتماعي بينهم، وتسمى المنتجات التي تنمي انتماء الفرد لمجتمع معين بالمنتجات ذات العلامة التجارية المجتمعية Community Branded Products. هرم المنافع للعلامة التجارية: في سياق متصل مع منافع العلامة التجارية لا بد من ذكر هرم منافع العلامة التجارية وطرق بنائها والذي يركز على كيفية انتقال العلامة التجارية عبر الوقت من إرتباطها ذهنيًا بخصائص المنتج التي من الممكن تقليدها بسهولة من قبل المنافسين إلى المنافع العاطفية ومن ثم إلى المنافع الرمزية التي من الصعب تقليدها، ومن العلامات التجارية التي تتربع على قمة هرم المنافع، ويتطلب منح المستهلك منافع عاطفية ورمزية جهدًا أكبر من الشركات المنافسة لأنه من الصعب تقليد هذه المنافع. يمكن تلخيص هذا الهرم في الشكل التالي: الصورة مقتبسة من بحث بعنوان Implementing your BAM2 strategy: 11 steps to making your brand a more valuable business asset في الحقيقة هذا الأمر يقودنا إلى الانتباه عند بناء العلامة التجارية الجديدة، وكما هو متعارف هناك نموذجين لتطوير العلامة التجارية وهما: الانطلاق من المنتج إلى العلامة التجارية. الانطلاق من الفكرة إلى العلامة التجارية ومن ثم المنتجات. إذ يؤكد النموذج الأول الأول على تطور العلامة التجارية بتطور المنتج وذلك بتركيز الاتصال التسويقي (الإعلان) على المنافع الوظيفية للمنتج، ثم التحرك نحو المنافع العاطفية والتي هي عبارة عن قيم معنوية أو قيم غير ملموسة وغير ذلك من القيم والوظائف التي تخص المنتج والتي عادة ما تكون غير ملموسة لتطوير (سمات Features أو خصائص Attributes) المنتجات الأكثر ملموسية، يتعلق النموذج الأول بالعلامات التي تنطلق كمنتج وتتطور بتطور مكوناته وسماته وخصائصه، ومن ثم تعتمد الشركة على خلق شخصية للعلامة التجارية، ووضع تشكيلة من المنتجات مع رسالة وقيم للعلامة التجارية، وبذلك يصبح للمنتج قيم إضافية غير ملموسة في نظر المستهلكين وهي قيم العلامة التجارية. أما النموذج الثاني فيبدأ بالعلامات التجارية التي تنطلق من كونها مفهوم أو فكرة خاصة بالنسبة للمنتجات التي تعبر عن الشخصية أو العلامات التي خلقت من فهم عميق للجانب النفسي من خلال آرائهم التي تميل إلى تقديم منافع عاطفية، ومع مرور الوقت تطور هذه العلامات سماتها ومنافعها الوظيفية وذلك بتوفير قيم ومنتجات إضافية ملموسة للمستهلكين مثل العلامة التجارية بالوما بيكاسو Paloma Picasso وهاري بوتر Harry Poter وديزني Disney والعديد من العلامات التجارية الأخرى. إن عملية اختيار أسماء العلامات التجارية دقيق جدًا إذ لا ينبغي أن يكون اسم العلامة التجارية وصفًا للمنتج لأن الاسم الوصفي يصبح بعيد الصلة بنشاط العلامة التجارية في حال أرادت التوسع لمنتجات جديدة، لذلك يجب أن توحي الأسماء بأشياء غير ملموسة فمثلًا العلامة التجارية أمازون Amazon توحي بالقوة والغزارة كخصائص نهر الامازون، لكن هذا لا يعني ألّا تهتم إدارة العلامة التجارية بالأصول المادية بل يجب أن ترتكز العلامة التجارية على كلا الجانبين، فنجد أنه حتى بالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة التي تشترى لغرض إشباع منفعة رمزية يجب عليها أن تمنح لمشتريها شعور بأنهم اشتروا منتجًا جيدًا حتى يكون للعلاوة السعرية تبرير منطقي. 1.3. الارتباطات الذهنية بالموقف تجاه المنتج يعد الموقف تجاه العلامة التجارية بمثابة حالة ذهنية للعميل تسمح له بتصفية منتج أو خدمة من خلال جميع الخيارات المتاحة له. يحمل الموقف عنصران رئيسيان وهما: قوة الشعور الإيجابي أو السلبي لدى العميل بناءً على تجربته. نسبة ثقة المنتج في الشعور الإيجابي أو السلبي. يمكن أن يؤدي إنشاء موقف إيجابي للعلامة التجارية في السوق إلى تحقيق فوائد قصيرة وطويلة الأجل للعلامة التجارية. لتحقيق موقف إيجابي للعلامة التجارية، يجب على الشركة تحديد توقعات العملاء التي لم تلبيها الشركات المنافسة في السوق المستهدفة وطرق تلبية هذه الاحتياجات. هناك العديد من الجوانب التي يجب على العلامة التجارية مراعاتها عند إنشاء موقف إيجابي للعلامة التجارية لمنتجاتها. يوضح هذا مدى تفضيل العميل للعلامة التجارية على العلامات التجارية المنافسة الأخرى في الصناعة. يمكن أن يؤدي هذا الإعجاب أو عدم الإعجاب بالعميل إلى إدراكهم للعلامة التجارية، وكذلك استخدام العلامة التجارية كعادة. يعد مفهوم موقف العلامة التجارية مهمًا لكل من الشركات والمستهلكين، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تتوافق قيم المستهلكين الشخصية مع قضايا مجتمعية للعلامة التجارية مثل تعهد العلامة التجارية واربي باركر Warby Parker بالتبرع بزوج من النظارات للأطفال والمحتاجين مقابل كل زوج يشتريه العملاء هذه الأمور تعزز من موقف المستهلك تجاه العلامة التجارية. 2. تفضيل الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية تختلف الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية باختلاف درجة تقييم المستهلك لها، وكلما كانت الارتباطات الذهنية إيجابية بنى المستهلك توجهًا إيجابيًا نحو العلامة التجارية، وإذا كانت الخاصية غير رئيسية في المنتج فغالبًا لن يهتم المستهلكين بها وبجودتها، وبالتالي من الصعب بناء ارتباط إيجابي لخاصية غير مهمة ويعود السبب في ذلك بأن المستهلك لا يستطيع تقييم جميع الارتباطات الذهنية الموجودة في ذاكرته عند شرائه لمنتج ما من العلامة التجارية، فمثلًا يكون غلاف المنتج غير مهم بالموازنة مع المتانة وقوة المنتج. يجب على مدراء المنتجات والعلامات التجارية الاهتمام أولًا ببناء ارتباطات بالخواص الأساسية للمنتج والانتقال لبقية الخواص، ومن الجدير بالذكر أيضًا بأنه يمكن أن يكون تفضيل الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية وضعي أو ضمن إطار معين ويختلف وفقًا لأهداف المستهلك من الشراء، فيمكن تفضيل ارتباط ذهني ما في وضعية معينة ولا يمكن تفضيله في وضعية أخرى فمثلًا سيُفضل المستهلك سرعة تقديم الخدمة أو المنتج في حال كان على سفر أو طبيعة حياة المستهلك مزدحمة. 3. قوة الارتباطات الذهنية بالعلامة التجارية يمكن تمييز أو وصف الارتباطات الذهنية انطلاقًا من قوة علاقتها بعقدة العلامة التجارية، إذ تعتمد قوة الارتباطات الذهنية على مدى عمق المعلومة في ذهن المستهلك وكيفية الحفاظ عليها كجزء من صورة العلامة التجارية، لأن الارتباط إذا كان قويًا سيحسن من كمية المعلومات المحفوظة في الذاكرة وكلما زادت الارتباطات التي تذكر المستهلكين بهذه العلامة التجارية إزداد تمسكه في هذه العلامة التجارية. في الحقيقة يؤكد علم النفس المعرفي Cognitive Psychology على ثبات الذاكرة في حال تكرار التعرض المستمر للمُحفر الذي يذكر المستخدم بالعلامة التجارية وهذا ما تسعى إليه الشركات من خلال إعلاناتها الطرقية والتلفزيونية والتي يصعب قياس نتائجها ومدى نجاحها. 4. تفرد الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية يشير هذا البعد إلى إمكانية وجود ارتباط ذهني لعلامة تجارية ما غير مشترك مع العلامات التجارية المنافسة، للمستهلك فجوهر تموضع العلامة التجارية Brand Positioning هو امتلاكها لميزة تنافسية حصرية ومتفردة مما يعطي سببًا أو دافعًا لشرائها. أما في حال تشارك مجموعة ارتباطات ذهنية بين عدة علامات تجارية فذلك يضعها في خانة المنافسة المحتدمة مما يجعل المستهلك يأخذ هذه العلامات التجارية بعين الاعتبار كبدائل معتبرة عند اتخاذه لقرار الشراء لذلك يجب على العلامات التجارية أن تنشئ لنفسها ارتباطات ذهنية تميزها عن منافسيها. في الحقيقة هذا الأمر معروف في الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية Brand Management Strategy إذ لا يمكن لأي شركة أن تكون ناجحة وخصيصًا إذا كانت شركة ناشئة عندما تكون عروضها تشبه عروض منافسيها، وإنما يجب أن يكون كل عرض عرضًا مقنعًا ومميزًا للقيمة المتصورة في ذهن السوق المستهدف. الركيزة الأساسية لاستراتيجية دخول أي سوق جديد هو التجزئة Segmentation والاستهداف Targeting والتموضع Positioning. في البداية تكتشف الشركة احتياجات مجموعات مختلفة من المستهلكين في السوق، ثم تختار الأهداف التي يمكنها تحقيقها بطريقة تنافسية ثم تضع عروضها لتظهر بطريقة تنافسية في السوق المستهدف لتعكس الصورة المميزة للشركة أو العلامة التجارية. وتتموضع الشركة في هذه المكانة في السوق وتستمر في تطوير العروض التنافسية الخاصة بها لكي يستمر نجاحها ولتحقق في نهاية المطاف ميزة تنافسية مستدامة Sustained Competitive Advantage. أشكال الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية أشار ديفيد أكر إلى أن معظم إرتكاز تطوير استراتيجيات المتعلقة بالعلامة التجارية على ارتباطات نقاط الاختلاف، وذلك من أجل إعطاء المستهلك سببًا جيدًا لتفضيل علاماتهم التجارية. في الوقت نفسه تلعب نقاط التعادل دورا مهمًا في عملية المنافسة لكل الشركات في السوق. ارتباطات نقاط الاختلاف Points of Difference: ويشار إليها اختصارا POD وهي مجموعة من الخصائص والمنافع المتعلقة بالعلامة التجارية والمرتبطة بشكل قوي في ذهن المستهلك، إذ يقييم المستهلك العلامة بشكل إيجابي ويعتقد أنه لن يجد هذه الخصائص والمنافع نفسها في العلامات التجارية المنافسة. ارتباطات نقاط التعادل Point of Parity: ويشار إليها اختصارا POP مجموعة من الارتباطات التي ليس من الضرورة أن تكون نادرة أو مميزة، أي قد تكون هذه الارتباطات مشتركة مع العلامات التجارية الأخرى، وهذا النوع من الارتباطات له شكلان: نقاط تعادل الصنف Category POPs: وهي مجموعة الارتباطات التي يرى المستهلك وجودها ضروريًا ضمن صنف المنتج. نقاط التعادل التنافسية Competitive POPs: :وهي مجموعة الارتباطات التي تقوم بإلغاء ارتباطات نقاط الاختلاف للمنافسين. أهمية بناء صورة العلامة التجارية توفر صورة العلامة التجارية والارتباطات الذهنية عنصرًا مؤثرًا على قرارات الشراء، وتعد الارتباطات الذهنية جزءًا أساسيًا من بناء هوية العلامة التجارية. كما يمكن للارتباطات الذهنية أن تغير تجربة الاستخدام المنتج أو الخدمة، كما أنها تساعد في معالجة المعلومات واسترجاعها بطريقة معينة. فمثلًا، إذ يمكن لمنتجين متطابقين أن يُحدثا تأثيرًا مختلفًا في الاستخدام فقط بسبب اختلاف ارتباطات الذهنية. كما تساعد الارتباطات الذهنية على زيادة الألفة بالعلامة التجارية مما يؤدي إلى زيادة احتمالية استدعاء العملاء للعلامة التجارية من خلال العروض والصفقات الفريدة التي تقدمها العلامة التجارية، كما أنه يساعد الشركات القائمة على إطلاق منتجات جديدة تحت نفس الاسم التجاري، وبالإضافة إلى ذلك يخلق ارتباط العلامة التجارية صورة إيجابية للعلامة التجارية والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة وبالطبع يمكن أن تؤدي السمعة الإيجابية إلى المزيد من المبيعات. يساعد الارتباط الإبداعي والإيجابي للعلامة التجارية المستهلكين على تصور شعار أو علامة تجارية معينة مع التفرقة عن منافسيها والتمايز عنهم مما يساعد في تطوير ولاء للعلامة التجارية. وتساعد الشركات ذات الارتباط الإيجابي للعلامة التجارية في طمأنة العملاء بجودة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة وهذا يساهم أيضًا في زيادة المبيعات. شركات احترفت بناء ارتباطات الذهنية قوية استطاعت العديد من العلامات التجارية الرائدة في العالم أن تظل رائدة في ربط علاماتها التجارية مع القيم التي تريد إيصالها؛ لذلك يجب على العلامات التجارية التي تكافح لتصبح الأولى في أسواقها أن تبني ارتباطات ذهنية إيجابية وتحافظ عليها. ومن بعض الأمثلة لشركات استطاعت تحقيق ذلك باحترافية نذكر ما يلي. الارتباطات الذهنية لشركة كوكاكولا Coca-Cola حقوق الصورة لموقع: www.papirfly.com سواء كنت تمضي عطلتك الصيفية أو في الحفلات العامة والأماكن المزدحمة مثل المطاعم والمولات ستجد برادات وعبوات كوكاكولا الزجاجية المميزة، وذلك لأن شركة كوكاكولا Coca-Cola اعتمدت على ربط علامتها التجارية بالفرح والسعادة واللحظات الجميلة ومن خلال وضع زجاجاتها في الأماكن الترفيهية فهي تعمق هذا الارتباط وتقوّيه لكي تبدو كما لو أنها تشاركك السعادة في كل أوقات حياتك. من خلال ترسيخ نفسها في هذه التجارب الإيجابية للغاية، ستجعل العلامة التجارية المستهلكين يصلون إلى منتجاتها في الأوقات الجيدة والسيئة لإعادة إحياء الذكريات الجميلة. الارتباطات الذهنية لشركة آبل Apple حقوق الصورة لموقع: www.papirfly.com لم تكسب شركة آبل Apple عملاء فحسب، بل حصلت على مهووسين بها، ويمكن لقائل أن يقول بأن منتجاتهم ثورية ومتطورة عن السوق ولكن مهلًا ألا تتفق معي في أن الشركة تضخمَ من ذلك في بعض الأحيان؟ مع ذلك فهي في الغالب تنجح في ذلك من خلال احترافها لبعض التفاصيل مثل: بناء تصميم أنيق لمنتجاتها والاعتناء الكبير بالتعبئة والتغليف لتقديمها للمستهلك لتبدو اختراع متطور. تجهيز أحداث خاصة لإطلاق منتجاتها ودراسة كافة جوانب الحدث من سواء من خلال كيفية عرض المنتجات وطريقة الحديث عنها والصور المستخدمة وكل شيء حرفيًا مدروس ليعطي شعورًا بأن ما تشاهده هو منتج ثوري سيغير من قواعد اللعبة. ربط العلامة التجارية بالمبتكرين والذين أنتجوا أعمال كبيرة ومميزة فمثلًا لاحظ سلسلة ما وراء الماك Behind The Mac نجد بأنهم جاؤوا بالأشخاص الذين غيّروا صناعتهم من خلال أجهزة آبل في رسالة بأن طريق النجاح يبدأ باقتناء أجهزة آبل. إذا أردنا عرض كافة الأمور التي أقدمت عليها الشركة لتعزيز مكانتها كصاحبة منتجات ثورية سنحتاج إلى كتب وليس مقالات والأمثلة السابقة ليست سوى بعضًا من الطرق العديدة التي تواصل بها آبل في بناء علامة تجارية أسطورية على قدم المساواة مع الطبيعة التكنولوجية المستمرة في التطور. الارتباطات الذهنية لشركة ستاربكس Starbucks حقوق الصورة لموقع: www.papirfly.com عندما تفكر في ستاربكس هل تفكر في المجموعة الواسعة من أنواع القهوة المتوفرة لديها والحورية المميزة على شعارها، أم أن الشيء الذي يخطر ببالك هو كتابة أسماء العملاء على الأكواب. في حين أن هذا هذه الحركة لا تبدو وكأنها صفقة مميزة إلا أنها كافية لتشجيع الناس على مشاركة فنجان القهوة الخاص بهم على منصاتهم الاجتماعية. في الحقيقة هذه اللمسة الصغيرة لمشاركة العملاء سرعان ما جعلت من ستاربكس علامة تجارية مؤثرة وبارزة على منصات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وما تزال الشركة تحافظ على التواصل مع الملايين العملاء في جميع أنحاء العالم بهذه الطريقة. الارتباطات الذهنية لشركة ماكدونالدز McDonald's كانت تجربة ماكدونالدز معقدة قليلًا إذ أحاط بالعلامة التجارية نظرة السلبية بسبب وجباتها التي تسبب السمنة، كان لا بد لهم من إعادة التفكير في الاستراتيجية التسويقية وتغييرها بما يتناسب مع تغير اهتمامات المستهلكين فعكفت الإدارة على تغيير ما يلي: تجديد قوائم الطعام لتضمين خيارات صحية، مع تضمين المعلومات الغذائية للوجبات فيها. تغيير ألوان علامتهم التجارية بشكل جذري إلى اللون الأخضر وقدموا عبوات قابلة لإعادة التدوير لإظهار رسالة قوية بأن علامتهم صديقة للبيئة. أعادوا استخدام زيوت الطهي الخاصة بهم لتزويد الشاحنات التي تعمل على الديزل الحيوي بالوقود. أصلحوا التصميم وحسنوا الديكورات الداخلية لتشجيع المزيد من الناس على تناول الطعام في المطعم بدلًا من الالتزام بالوجبات السريعة كثيرة السعرات الحرارية. ساعد هذا الإصلاح الشامل في تغيير الارتباطات السلبية التي تحدث مع مطاعم الوجبات السريعة، وساعدت في إعادة وضع ماكدونالدز كمطعم عصري صديق للعائلة مع قيم نبيلة وذات مسؤولية تجاه البيئة. الارتباطات الذهنية لشركة نايك Nike حقوق الصورة لموقع: www.papirfly.com لطالما ارتبطت شركة نايك أو نايكي Nike بأفضل الرياضيين أداءً والأكثر شهرة في العالم. يتمتع الرياضيين الذين تختارهم شركة نايك ليكونوا سفراء للعلامة التجارية بسمات شخصية متشابهة مع طريقة تسويق نايك لنفسها مثل التنافسية والعمل الجماعي وتحسين الذات والطموح والتفاني والاندفاع الذي لا يمكن إيقافه ليكون الأفضل. في الحقيقة من كثرة ارتباط شركة نايك بالألبسة والأحذية الرياضية الخاصة بكرة السلة أصبح من الصعب وخصيصًا في الولايات المتحدة الأمريكية التفكير في شراء المنتجات الخاصة بكرة السلة بدون أن يخطر للمشتري أحذية شركة نايك أو بقية منتجاتها، ومن المثير للاهتمام البحث الذي أجرته شركة نيلسون بزميتريك Nielsen BuzzMetrics بالاعتماد على التعليقات عبر الإنترنت لمعرفة خريطة الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية نايك Nike وكان هدفها اكتشاف الأنماط في آراء المستهلكين حول علامات تجارية معينة وكانت النتيجة في الشكل التالي حقوق الصورة لموقع www.nytimes.com طريقة بناء صورة قوية للعلامة التجارية بغض النظر عن حجم أو عمر الشركة، من الضروري أن يربط المستهلكون علامتك التجارية بمنظور إيجابي، ويعد إنشاء ارتباط إيجابي للعلامة التجارية عملية مستمرة مع نمو الشركة وتطورها، وفيما يلي بعض الطرق لبناء ارتباط إيجابي بالعلامة التجارية. بناء إستراتيجية متماسكة للعلامة التجارية وجود استراتيجية ثابتة للعلامة التجارية أمر ضروري لتخطيط لما سيكون الارتباط الإيجابي للعلامة التجارية. ولبناء الاستراتيجية يجب إنشاء هوية قوية للعلامة التجارية من خلال استعراض مهمة ورسالة علامتك التجارية وقيمها وشخصيتها وصوتها ومكانتها الفريدة. تحكي هوية العلامة التجارية قصة عن علامتك التجارية من خلال شعارك وألوان علامتك التجارية (ننصح بقراءة مقال العلامة التجارية وأهميتها في قرار الشراء - الفرق بين العلامة التجارية والمنتج). بالإضافة إلى ذلك تساعد رسائل علامتك التجارية على إيصال فوائد علامتك التجارية والقيم التي تقدمها وتوضح ما يميزك عن منافسيك. تحتاج علامتك التجارية أيضًا إلى نبرة معينة للتواصل يمكنك تطويرها من خلال التواصل مع جمهورك والانطباع الذي تتركه مع المستهلكين (مثل نبرة الاهتمام والتعاطف) مما يساعد ربط المشاعر التي يشعر بها جمهورك بشركتك أو علامتك التجارية. تحليل مصطلحات البحث عندما يبحث الأشخاص عن شيء ما على محرك البحث غوغل Google، سيحاولون غالبًا استخدام مجموعة من المصطلحات أو العبارات. يمكن العثور على هذه المعلومات من خلال الشركات المختصة وغالبًا ما تكون هذه النوعية من الخدمات مدفوعة. عند حصولك على هذه المعلومات ستُحلل هذه البيانات لاكتشاف الروابط الذهنية التي يقيمها الأشخاص بناءً على الموضوعات التي يبحثون عنها وربطها بالمنتجات أو خدماتك أو الحلول التي تقدمها، بالإضافة إلى الكشف عما إذا كان وضع علامتك التجارية يتوافق مع ما يبحث عنه الأشخاص حقًا، يمكن لتحليل بيانات البحث للمستهلكين إبراز الفرص لبناء ارتباطات جديدة بناءً على البيانات ومدى دقتها وموثوقيتها. لا يقتصر الأمر على بيانات البحث إذ يوجد أيضًا الكثير من أدوات الاستماع على وسائل التواصل الاجتماعي يمكنك الاستثمار بها وتجربتها بالتزامن مع المعلومات المتاحة لك من خلال بيانات البحث لتجمع بذلك صورة أوضح لما يبحث الناس عنه وذلك في الوقت الفعلي. من خلال فحصك الدائم لنبض وسائل التواصل الاجتماعي يمكنك الإحساس بدقات قلوب الناس نحو ما يجذبهم وما يربطون علامتك التجارية به والموضوعات الساخنة التي يمكنك الاستفادة منها للمحتوى القادم أو المنتجات القادمة. بناء خرائط ذهنية للارتباطات المحتملة ستساعدك خريطة ارتباط العلامة التجارية في تحليل الارتباطات الإيجابية والسلبية التي يمتلكها المستهلكون حاليًا بعلامتك التجارية. سيُظهر لك المكان الذي تتميز فيه عن منافسيك وما الذي يجعل عملائك يختارون منتجاتك أو خدماتك. يمكنك استخدام هذه المعلومات للتركيز على المجالات التي يمكنك فيها غرس معنى جديد وتوليد المشاركة وإنشاء الاتصالات فريدة بين علامتك التجارية والمستهلكين. ستُغذي المناطق التي تختار إنشاؤها بعد ذلك كيفية تشكيل استراتيجية التسويق الخاصة بك في المستقبل، وكيفية توزيع المحتوى الخاص بما يضمن تعزيز هذه الارتباطات الذهنية. تعزيز تفاعلات العملاء تلعب كيفية تفاعلك مع عملائك عبر الإنترنت أو شخصيًا دورًا كبيرًا في الارتباط الإيجابي للعلامة التجارية. فكر جيدًا في التفاعل الذي يحصل عليه المستهلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وموقع الويب الخاص بك، بالإضافة إلى الاجتماعات الشخصية وأثناء المحادثات الهاتفية مع المستهلكين، كما تساهم الطريقة التي يستجيب بها فريقك للعملاء الغاضبين والمقالات الهجومية في تحديد منظور المستهلكين للعلامة التجارية. تؤثر الطريقة التي تغذي بها مجتمعك على نظرة المستهلكين لشركتك لذلك من المهم أن يكون لديك خدمة عملاء وأدوات إدارة علاقات ممتازة للحفاظ على صورة إيجابية لعلامتك التجارية. بناء الشراكات الاستراتيجية من المهم بناء علاقات استراتيجية مع العلامات التجارية والمؤثرين الآخرين للمساعدة في الحفاظ على صورة إيجابية لعلامتك التجارية. ضع في اعتبارك أن تكون انتقائيًا مع من يتعاون معك لأن هذا الشخص سيُمثل علامتك التجارية ويصبح الشخصية التي يربطها المستهلكون بشركتك (مثل مايكل جوردان وارتباطه بمنتجات نايك). من المفيد الشراكة مع المشاهير أو الشخصيات العامة أو المنظمات الأخرى التي لها اهتمامات مماثلة. يتوقع المستهلكون في هذا العصر الرقمي بأن تكون العلامات التجارية أكثر صخبًا وأكثر تفاعلًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك من المهم أن يكون لديك صلات مع المؤثرين الإيجابيين، وإذا فعل المؤثرون شيئًا غير مقبول اجتماعيًا أو يتعارض مع مبادئ العلامة التجارية، فمن المهم أيضًا إزالتهم من الحملات المستقبلية وتوضيح ذلك للمستهلكين. عندما تحاول الحفاظ على ارتباط إيجابي للعلامة التجارية فكن حذرًا عند الشراكة مع منظمات أو مؤثرين آخرين. تجنب السلبيات قبل حدوثها يفضل أن يتجنب مدير العلامة التجارية الأمور الحساسة والتي يمكن أن تسبب في بناء ارتباطات سلبية بالعلامة التجارية وفي بعض الأحيان تكون النية حسنة مع ذلك ينتج عن بعض الأمور ارتباطات سلبية ولذلك يفضل دومًا إلى بعض النقاط التي ستساعد على تجنب ذلك: تجنب التناقضات في حال كانت المنتجات عالية الجودة يجب أن تكون خدمة العملاء ممتازة أيضًا بل يجب أن يرى المستهلك الجودة في جميع تفاصيل المنتج أو الخدمة أو أي أصول للعلامة التجارية، إن الحفاظ على الاتساق هو أمر حيوي وحساس للبقاء على رأس توقعات العملاء والوصول إلى مستوى الخدمة التي يتوقعونها. عندما تكون هنالك فوارق بين ما يراه المستهلك من جودة وحرص في فريق خدمة المبيعات ومن إهمال وتسيب في فريق الدعم الفني ومعالجة المنتجات المرتجعة سيشكل هذا الأمر مشكلة وسيعتقدُ المستهلك أنك بعته المنتج ولم تساعده في حل مشكلته التي يواجهها، يجب ألا ننسَ بأن المشاعر السلبية لها تأثير كبير على المستهلكين ويفضل دائمًا تجنبها عوضًا عن معالجتها. لا تتعارض مع قيم علامتك التجارية الخاصة في حال كانت العلامة التجارية ملتزمة في أنها لا تستخدم مواد اللحوم في منتجاتها فيجب أن تحافظ على ذلك حتى وإن صعد نجم أحد أنواع اللحوم وازدادت شعبيته يجب ألا تضيفه إلى قائمة الطعام الخاصة بمطعمك. في الحقيقة تلجأ معظم العلامات التجارية في بعض الأحيان إلى بناء علامة تجارية فرعية للتوجهات والصيحات الجديدة بدلًا من مخاطرة تضمينها في العلامة التجارية الأصلية. التفاعل مع الأحداث بما يتناسب مع قيم العلامة التجارية من المهم أن تتفاعل العلامات التجارية مع ما يحدث في العالم هذا أمر لا مفر منه في وقتنا الحالي ولكن هل جميع المواضيع الشائعة يجب التفاعل معها؟ بالتأكيد لا، يجب أن تبقى العلامة التجارة في منأى عن المُجريات الروتينية اليومية والتحفظ عن المشاركة في المواضيع البعيدة عن مجال العلامة التجارية وبالتأكيد لا بأس في لعبة شد الحبل مع المنافسين وهذا النشاط متوقع ويجذب التفاعل لكلا الطرفين. الخطط الاحتياطية مفيدة دوما من المهم أن تكون استباقيًا وأن تستعد للمواقف التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صورة علامتك التجارية وهويتها. فعلى سبيل المثال يمكن أن يساعدك وضع خطة احتياطية لإدارة الأزمات في الحفاظ على صورة إيجابية للعلامة التجارية مثل الخُطط التي تضعها شركات تصنيع السيارات في حال حصول عطب ما في السيارات الجديدة التي باعتها واضطروا بعد ذلك إلى سحب هذه السيارات من السوق في هذه الحالة يمكن للخطة الاحتياطية إنقاذ الشركة من مشاكل كبيرة في حال استطاعت السيطرة على غضب المستهلكين والرد عليهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. تفيد الخطة الطارئة في تحجيم المشكلات وتتيح إمكانية معالجتها وحلها بسرعة وإصلاح العلاقات مع المستهلكين وشركاء الأعمال. الخاتمة تعرفنا في هذا على صورة العلامة التجارية وعلاقتها مع الارتباطات الذهنية كما تعمقنا في فهم هذه الارتباطات من خلال الاطلاع على علم النفس وراء هذه الارتباطات الذهنية بالعلامات التجارية واطلعنا على مكونات الارتباطات الذهنية وأشكالها وأهميتها ثم استعرضنا بعدها مجموعة من الشركات التي احترفت بناء ارتباطات ذهنية قوية وختمنا المقال في التعرف على طريقة بناء صورة قوية للعلامة التجارية. وختامًا إن بناء روابط إيجابية تصل إلى قلوب وعقول جمهورك هي عملية مستمرة، وهي واحدة من أقوى تقنيات التسويق فمن خلال فهم قوي لما يربطه المستهلكون بالفعل بعلامتك التجارية والتركيز الواضح على المكان الذي تحتاج إلى التميّز فيه عن منافسيك، يمكنك الاستفادة من الطبيعة البشرية والتأثير على السلوك وبناء هوية العلامة التجارية التي تظل في المقدمة لسنوات طويلة، ولا تنسَ أن الحفاظ على الاتصال بين علامتك التجارية والمستهلكين يعتمد على المحتوى المتسق والمستمر. المصادر كتاب Strategic Brand Management Building, Measuring, and Managing Brand Equity لصاحبه Kevin Lane Keller الطبعة التاسعة. كتاب The New Strategic Brand Management لصاحبه JEAN-NOËL KAPFERER الطبعة الرابعة. البحث The Concept of Brand Equity - A Comparative Approach لصاحبه Ovidiu Ioan Moisescu. البحث Development of a brand image scale and the impact of lovemarks on brand equity لصاحبته Eunjoo Cho. البحث A New Typology of Brand Image لصاحبه Michael Korchia. مقال Brand Association - Definition, Importance, Types, & Examples لصاحبه Sakshi Darpan. مقال What Is Brand Association? (With Strategies and Examples) لمحرري الموقع. مقال Brand association: How to establish your brand in the minds of consumers لمحرري الموقع. مقال Brand Attitude and Its Importance to the Purchase Intention of Customers لمحرري الموقع. اقرأ أيضًا أساسيات ترسيخ العلامة التجارية للمصممين المبتدئين أساسيات ابتكار العلامة التجارية دليل المصمم لإنشاء قصة العلامة التجارية مدخل إلى الوعي بالعلامة التجارية
-
من منا لا يحب ذلك الشعور الغامض الدافئ الذي ينتابك عندما ترى شيئًا يذكرك بالماضي؟ ربما كان هذا الشيء المميز منتجًا أو لحظة تعتز بها وتعيد إليك أوقاتًا كنت بها أكثر سعادة وبساطة من الآن. في عالم يتطور بسرعة فائقة فإن الانغماس في الحنين إلى الماضي يشبه التفاف نفسك في بطانية مريحة وتذكر أيام الماضي، ورائحة طبخ والدتك، أو رؤية ألعابك القديمة أيام طفولتك، هناك العديد من المناسبات والمدخلات الحسية والمواقف الاجتماعية القادرة على إشعال شوق الحنين للماضي عندما كانت الأمور أبسط والحياة أسهل والعلاقات أقوى. لاحظنا على مدار السنوات السابقة جليًا ظهور نمط جديد من التسويق وهو التسويق بالحنين إلى الماضي، لذا سنستعرض في هذا المقال ماهيّة التسويق بالحنين إلى الماضي وأهميته ومدى قوته بالتأثير على المستهلكين وعلاقته بعلم النفس كما سنتعرف أيضًا على بعض الشركات التي استخدمت هذا النمط من التسويق لجذب الجمهور ولفت الأنظار كما سنقدم بعض النصائح لاستثمارها في هكذا نوع من الحملات الإعلانية أو المنتجات على حد سواء. ما هو التسويق بالحنين إلى الماضي؟ إن التسويق بالحنين إلى الماضي أو التسويق بالنوستالجيا Nostalgia Marketing هو استراتيجية الاستفادة من المفاهيم الإيجابية والمألوفة من العقود السابقة لبناء الثقة للأفكار الجديدة وتنشيط الحملات الحديثة. بمعنى آخر، إنه طريقة لربط شركتك بشيء يحبه العملاء بالفعل ولديهم ذكريات جميلة معه. يمكن النظر لفكرة التسويق بالنوستالجيا على أنها طريقة لمواءمة الحملات الإعلانية مع الأشياء التي تثير ردود فعل عاطفية من الماضي، فمعظمنا يعلم مدى قوة التسويق العاطفي وقدرته على إقناع العملاء باتخاذ فعل الشراء. نبني جميعنا ذكريات جميلة عن أيام شبابنا مع تقدمنا في العمر، من الطعام الذي تناولناه والألعاب التي لعبناها، وحتى الموسيقى التي استمعنا إليها، إذ تجارب الماضي هي التي تساعد في الحقيقة في تكوين شخصياتنا وهوياتنا في الوقت الحاضر. عندما نرى هذه الذكريات من ماضينا لا نفكر فقط اللحظات السعيدة فقط بل غالبًا ما نشاركها مع من حولنا من أصدقائنا أو عائلتنا بحسب الذكرى. هذه الذكريات تجعلنا نفكر بأيام لم تكن لدينا أية أحزان أو مشاكل لأي شيء - باستثناء وجبة غداء كنا ننتظرها بفارغ الصبر عند عودتنا من المدرسة، إذ هذا الشعور يجعلنا نسافر عبر الزمن إلى وقت آخر وحقبة مريحة من حياتنا. ولكن قبل أن نبدأ الشرح، يمكن أن يخطر على بالنا سؤال مهم وهو هل التسويق بالحنين إلى الماضي يناسب العلامات التجارية القديمة فقط؟ ليس بالضرورة إذ يمكنك استثمار بعض الأحداث العامة القديمة مثل لحظة الصعود إلى القمر أو ظهور أول جوال أو أي حدث مهم بحسب الصناعة، فالمهم أن تعرف الشركة كيف تستطيع محاكاة الحقبة أو اللحظة المنشودة من الماضي، وتستطيع أي شركة البحث عن الأفكار والمفاهيم المتعلقة بمنتجاتها واهتمامات جمهورها وإجراء تحليل عميق للأحداث، وعندها ستتمكن من إيجاد ما يناسب العلامة التجارية وتصميم إستراتيجية تسويقية بناء عليها تبعث على الحنين إلى الماضي. أهمية الحنين للماضي من منظور علم النفس إذا كنت مسوقًا أو مهتمًا في التسويق فغالبًا أنك تحاول معرفة ما يثير اهتمام المستهلك، وما الذي يحفزه على شراء المنتجات، لتحاول بعد ذلك إطلاق شرارة بدء عملية الشراء لشراء المنتج الذي تسوق له. في الحقيقة إن هذا النوع من الأسئلة هو من سيُميز المسوقين الموهوبين حقًا عن باقي المسوقين العاديين لأن الفهم الدقيق لأجوبة الأسئلة السابقة ومعرفة كيفية أخذ المستهلك لقرارات الشراء أو تنفيذ أي إجراء مثل الاشتراك في النشرة الإخبارية أو حضور حدث معين سيُساعد في بناء إعلان أو صفحات هبوط ناجحة. إذًا، نحن بحاجة للبحث عن إجابات للاسئلة التي تبدأ بكلمة "لماذا"، مثل لماذا نشعر بالدفء عندما نرى شيئًا من الماضي؟ أو لماذا نشعر بهذه الطريقة؟ ولماذا هو مهم للتسويق؟ في هذا السياق لا يمكننا العثور على إجابات دقيقة دون التطرق إلى علم النفس. محفزات الحنين وعلم النفس أشارت دراسة باسم Nostalgia marketing and (re-)enchantment نشرت عام 2019 في المجلة الدولية للأبحاث في التسويق على أن أنشطة التسويق باستخدام الحنين إلى الماضي تهتم معظمها بخلق السحر؛ أي تحويل الشيء العادي إلى شيء ساحر، ولخلق هذا السحر تسعى الشركات والعلامات التجارية إلى تسويق الأشياء المتعلقة بتاريخ الناس. ويمكن أن نتذكر الحنين إلى الماضي عندما تُثار حواسنا، فيمكن أن تثار حواسنا من خلال الرائحة مثل العطر الذي يذكرك بمنزل جدتك أو طعم الطبق الذي يعيدك إلى طفولتك أو من خلال النظر مثل مشاهدة فيلم كرتون قديم اعتدت مشاهدته مع إخوتك، وعمومًا أقوى محفزين هما الشم والسمع. ووجد الباحثون أنه مهما خطر ببالك أفكارًا عن الحنين للماضي فحتمًا ستكون ضمن هذه الخيارات الثلاثة أو مزيجًا منها: أشياء ومنتجات ملموسة (مثل الراديو أو الأقراص المرنة …إلخ.). لحظات لا يمكنك إعادتها من جديد. أشخاص رحلوا (مشهورون وعلماء ..,إلخ.). في الحقيقة هذا الأمر منطقي لأن الحنين هو كل شيء عن الحواس، وتحديدًا هو التصورات الحسية التي تثير المشاعر الإيجابية. في نفس الدراسة السابقة أبلغ معظم الناس الذين شملهم الاستطلاع عن شعورهم بالحنين إلى الماضي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وما يقرب من نصفهم يمرون به ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع. غالبًا ما تتأثر هذه النوبات المبلغ عنها بالأحداث السلبية ومشاعر الوحدة، لكن الناس يقولون إن "الحنين إلى الماضي" يميزه الباحثون عن الذكريات يساعدهم على الشعور بالتحسن، ويجعلهم يشعرون بالتفاؤل. كما حاول الباحثون تحليل كيفية بناء سحر الحنين إلى الماضي بناءً على طرائق مختلفة من الحنين اختاروها من الأدبيات الاجتماعية التي شرحت أنواع الحنين إلى الماضي (مثل الحنين المتردد، والحنين التدريجي، والحنين المرح ..إلخ) ووجدوا بأنه لاستحضار الشعور بالسحر هنالك ثلاث طرق وهي: إعادة إنشاء مثيل: إرجاع رمزي إلى الماضي. إعادة تمثيل للماضي: إعلام انعكاسي للحاضر بعلامات تجارية وممارسات قديمة. إعادة التخصيص: أي إعادة تفسير للماضي بطريقة الحاضر. من خلال هذه الطرق المختلفة يمكن للمسوقين استغلال الحنين للماضي لخلق السحر، فإننا نلاحظ آثارًا مهمة للدراسة النظرية وإدارة العلامات التجارية ذات السمات السابقة فيما يتعلق باستراتيجية التسويق والاستهداف وتحديد المواقع وتصميم تجربة العلامة التجارية والاتصالات التسويقية. يذكر أن هناك نوع آخر من الحنين إلى الماضي تستثمره بعض العلامات التجارية وهو الحنين التاريخي للماضي وهو الحنين إلى أحداث أو أوقات لم يكن الشخص فيها مولودًا بعد. ولكن بطريقة ما لا تزال هذه الأحداث أو الفترات الزمنية تجذب بعض الناس مثل المغناطيس. وغالبية الأشخاص الذين يتأثرون بهذا النوع من الحنين يكون لديهم ارتباط عاطفي أو اشتياق لأوقات في التاريخ تسبق ولادته. وظائف الحنين من وجهة نظر علم النفس يحدث الحنين إلى الماضي عندما تعالج اللوزة الدماغية أو اللوزة العصبية مدخلات معينة، واللوزة الدماغية هي جزء من الجهاز الحوفي ويتكون من حوالي 13 نواة و تنقسم هذه النوى إلى مجمعات أصغر، وترتبط بعض الأقسام مع القشرة المخية والمهاد وكذلك منطقة الحصين Hippocampus ويرتبط هذا الجزء بالعديد من الوظائف والاستجابات الجسمانية، والإثارة والخوف، وردود الأفعال العاطفية، والإفرازات الهرمونية، والذاكرة والمعلومات الحسية، فضلًا عن أن اللوزة تتلقى معلومات حسية من المهاد و من القشرة الدماغية. ثبت أن المحفزات مثل اللمس، والشم، والصوت، وحالة الطقس، والموسيقى تولد ذكريات عقلية شديدة، ثم يربط الدماغ هذه المحفزات بأحداث معينة أو بأشخاص من الماضي، مثل مكان العطلة المفضل لعائلتك أو صديق طفولتك المفضل، وعند مصادفتنا لإحدى هذه الذكريات تنطلق الشرارة ونسترجع الذكريات الجميلة أو شعور الحنين إلى الماضي مع بعضهما بعضًا. يخدم الحنين وظيفة إنسانية مهمة تتجاوز مجرد "الشعور بالسعادة". إنه يخلق صلاحية وجودية لحياة المرء، ويشجع النمو البدني والعقلي ويعزز الحالة المزاجية والوعي الذاتي. كما تساعد على توحيد إحساسنا بذواتنا وهويتنا؛ لأننا مع مرور الوقت نتغير باستمرار بطرق لا تصدق. نحن لسنا نفس الأشخاص عندما كنا في الثالثة من العمر. فمثلًا، يساعد الحنين تذكرنا لماضي حياتنا ويوحدنا مع تلك الذات الأصيلة ويذكرنا بما كنا عليه ومن ثم موازنة ذلك بما نشعر به اليوم، ويمنحنا ذلك إحساسًا عميقًا بما نريد أن نكون على الطريق الصحيح في المستقبل. الحنين إلى الماضي عاطفة اجتماعية الطريقة الأخرى التي يخدم بها الحنين وظيفة نفسية أساسية هي أنها عاطفة اجتماعية للغاية، فإنها تربطنا بأشخاص آخرين. فمنذ الصغر ترتبط حياتنا مع عائلتنا وإخواننا وأصدقائنا. وبينما نكبر في هذه الحياة تتسع دائرة معارفنا لتشمل نطاقًا أوسع من الأشخاص الذين نتفاعل معهم ومع هذا التفاعل نشكل ذكريات جميلة ولذلك تساعد ظاهرة الحنين إلى الماضي على الترابط الاجتماعي فهي عاطفة اجتماعية مفيدة للصحة. والطريقة الأخرى التي تجعلها عاطفة اجتماعة موحدة هي أنها تساعدنا على توحيد ما نشعر به أو نختبره كنزاعات داخلية. إنها تؤجج الصراع الداخلي فينا لأنها عاطفة حلوة ومرّة بنفس الوقت. فهي حلوة لأنها تذكرنا بأفضل أوقات حياتنا، ومرّة لأنها تشعرنا بأنه لا يمكننا أبدًا استراجاع تلك اللحظات الجميلة، أي أنها ستبقى ذكريات تدغدغ ذاكرتنا إلى الأبد. يساعد الحنين على تهدئة صراع الشوق المرير لما لا يمكن أن يكون مرة أخرى مع حلاوة تجربته والقدرة على إعادة النظر فيه وإعادة إحيائه مرة أخرى. الأمر الآخر عندما يشعر العملاء بالحنين إلى الماضي، فإنهم يميلون بطريقة طبيعية لمشاركة أفكارهم ومشاعرهم. مثلًا عندما تتذوق طعمًا يشابه طعمًا تذوقته في شبابك أو طفولتك فغالبًا لا ترغب فقط في الاستمتاع بهذه التجربة لوحدك فحسب وإنما تريد مشاركتها مع من تعرفهم ليُشاركونك نفس الذكريات. في الحقيقة هذا يجعل الحملات الإعلانية المعتمدة على الحنين إلى الماضي قابلة للمشاركة بطبيعتها. يساعدنا الحنين على زيادة إنفاق المستهلكين تشير دراسة باسم Nostalgia Weakens the Desire for Money صادرة عن جامعة إكسفورد عام 2014 إلى أن الحنين إلى الماضي يلهم المستهلكين لإنفاق أموالهم لأن تنمية ذكريات الماضي والعصور الغابرة تعزز الشعور بـ "الترابط الاجتماعي"، إذ يُنظر إلى القيم المجتمعية القديمة والعلاقات مع الآخرين على أنها أكثر أهمية من المال. في مثل هذه الأجواء تقل قيمة المال بنظر المستهلكين ويبدو أن مثل هذا المزاج يقلل من مقاومة الإنفاق. يقول الباحثون: "تصبح قدرة المستهلكين على تحديد الأولويات والتحكم في أموالهم أقل إلحاحًا بعبارة أخرى يمكن أن يكون شخص ما أكثر ميلًا لشراء شيء ما عندما يشعر بالحنين إلى الماضي". حتى عندما يكون الحنين إلى الماضي مزاجًا كئيبًا إلى حد ما، مثل استحضار ذكريات طفولة ضائعة أو وفاة شخص ما، تنخفض الرغبة في الاحتفاظ بالمال كما قال الباحثون في تلك الدراسة. اختبرت هذه النظرية من خلال إجراء سلسلة من تجارب المستهلكين، وقياس ردود الفعل على أنواع مختلفة من الإعلانات، والاستعداد للتبرع للأعمال الخيرية والاستعداد لتحمل الضغوط للحصول على مكافآت مالية. يقول الباحثون في الدراسة السابقة إن الأمر المشترك في مشاعر الحنين إلى الماضي هو أنها تضعف مشاعر الحرص على المال الأمر الذي يسهل عملية بيع المنتجات للأشخاص الذين يهدأون في هذا المزاج السيئ عندما يعدهم المنتج باسترجاع المشاعر والأيام القديمة. لهذه الأسباب نمت حملات التسويق بالحنين إلى الماضي بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة، إذ بدأت العلامات التجارية في اكتشاف قيمة التواصل مع عملائها على مستوى عاطفي أكثر تعمقًا. ولكن هنالك بعض المخاطرة مثل أي حملة إعلانية لذلك يجب التفكير جيدًا في الأمر لأنك إذا تسرعت في توظيف الحنين إلى الماضي دون تفكير وتخطيط، فيمكن أن تدمر سمعتك بدلًا من تحسينها. الحنين يجعل الناس يشعرون بالرضا وجد بحث بعنوان What Is Nostalgia Good For? Quite a Bit, Research Shows منشور في جامعة ساوثهامبتون أن الحنين إلى الماضي يمكن أن يكون مفيدًا للإنسان. ووفقًا للباحثين، يمكن أن يؤدي الحنين إلى "مواجهة الشعور بالوحدة والملل والقلق" بالإضافة إلى استحضار المشاعر الإيجابية، كما أنه يجعل الناس أكثر تسامحًا وكرمًا مع الغرباء، وكشفت دراسات أخرى أن الحنين إلى الماضي ساعد الناس على التعامل مع اللحظات العصيبة وتحولات الحياة. في الواقع، يمكن للحنين إلى الماضي أن يجعل الناس يشعرون بالدفء الروحي في يوم بارد. يساعد الحنين إلى الماضي المسوقين لأن له تأثير عاطفي قوي للغاية على عملائهم. تحدثنا سابقًا عن مدى فعالية التسويق العاطفي؛ (ننصحك بقراءة المقال لفهم أعمق للموضوع) من المرجح أن يستجيب العميل بطريقة إيجابية أكثر لإعلانك إذا أثار نوعًا من الاستجابة العاطفية. نصائح لإنشاء استراتيجية التسويق الخاصة بك بالحنين إلى الماضي في سوق شديد التنافسية مثل أسواق اليوم، أصبح لزامًا على الشركات والعلامات التجارية طرق كل أساليب التسويق، ولما كان التسويق بالنوستالجيا أحد الأساليب القوية والمؤثرة على العواطف فهي استثمار مناسب لوضعها في الإعلانات. يمكن لأي شركة ربط هدف علامتها التجارية بالأفكار القديمة لإثارة مشاعر الأمان والراحة والمشاركة في جمهورها. بالرغم من أن هذا التكتيك كان موجودًا منذ عدة سنوات إلا أنه شهد انتعاشًا قويًا بصورة خاصة مؤخرًا، إذ يبحث جيل الألفية باستمرار عن ملاذ آمن من ضغوط وتشويش العصر الرقمي. في حين أن العديد من الأمثلة المميزة هي من علامات تجارية كبيرة، فإن هذا لا يعني أن شركة صغيرة لا يمكنها أن تنشئ حملتها التسويقية الفريدة من نوعها للحنين إلى الماضي، وعمومًا عند التخطيط لحملة إعلانية من هذا النوع ضع هذه النصائح في الاعتبار. 1. ركز على هدف محدد بغض النظر عن الموضوع أو الدافع، يجب أن يكون لاستراتيجية التسويق الجيدة دائمًا هدف واضح ومحدد. إذا رغبت في استخدام الأفكار القديمة بطريقة فعالة في حملتك فأنت بحاجة إلى أن تسأل نفسك: "كيف يمكنك جعل الحنين إلى الماضي يعمل بصورة جيدة مع حملتك الحالية، وما الميزات التي ستحتاج إلى التفكير فيها لضمان جذب انتباه جمهورك؟" وفي هذا السياق من بعض الأساليب المشهورة في تضمين الحنين إلى الماضي في الإعلان: إحياء منتج أو خدمة أوقفتها الشركة في الماضي. الاحتفال بالذكرى السنوية للشركة أو علامة فارقة. إعطاء علامتك التجارية صورة جديدة لإعادة نفسك إلى قلوب جمهورك (مثل تحديث العلامة التجارية أو إعادة العلامة التجارية). تسليط الضوء على تغيير في الشركة، مثل التعاون مع شريك جديد، أو التركيز على أهداف العلامة التجارية المختلفة، أو قرار تغيير الاسم أو الشعار. تأكد من وجود سبب قوي وراء حملتك قبل أن تبدأ في استكشاف الفرص التسويقية لها. 2. ضع في اعتبارك جمهورك وشخصيتك مفتاح أي حملة تسويقية هو فهم احتياجات وتفضيلات جمهورك. قبل أن تتمكن من الانخراط في استراتيجية تسويقية قوية للحنين إلى الماضي تأكد من أنك ترسم الصور والأفكار من الحقبة الزمنية المناسبة لكي تكسب رضا الجيل الذي تستهدفه. فكر في الفئة العمرية لجمهورك المستهدف، وتأكد من أنك تبحث في تفضيلاتهم بالتفصيل عند وضع خطتك التسويقية. وتأكد من أن أي تكتيكات تختارها تنسجم تمامًا مع شخصية العلامة التجارية الحالية ونبرة صوت علامتك التجارية (تحدثنا في مقال منفصل عن مكونات العلامة التجارية يمكنك الاطلاع على المقال لمزيد من التفاصيل). لا يعني التكيف مع أفكار التسويق القديم بالضرورة التخلي عن الشخصية التي أنشأتها لشركتك. كلما كنت أكثر اتساقًا زادت فرص نجاحك في إقناع عملائك بربط علامتك التجارية بذكرياتهم المفضلة. جهز أبحاث دقيقة لشريحة العملاء المستهدفين، واعمل على شخصية المشتري لتحديد عمر جمهورك المستهدف واكتشف الأشياء التي تهمهم، فمثلًا إذا كنت تستهدف المستهلكين من جيل الألفية، فيمكنك أن تستمد الإلهام من التسعينيات أو من أوائل القرن الحادي والعشرين. أو إذا كان جمهورك من الجيل العاشر أو الجيل إكس Gen X، فيمكنك التفكير في سبعينيات القرن الماضي. المهم أن تبحث في المكان المناسب والزمن المناسب. 3. ادمج أفكار الحنين إلى الماضي بوسائل التواصل الاجتماعي إذا كان الحنين هو الطُعم لحملتك التسويقية، فإن وسائل التواصل الاجتماعي هي قصبة الصيد. إنها طريقة مثالية لبدء تعريف جمهورك بأحدث إستراتيجيتك، لأن الحنين إلى الماضي هو تجربة عاطفية بطبيعتها. هذه هي فرصتك للتواصل مع جمهورك من خلال المشاعر المرتبطة بأعمق ذكرياتهم وأعزها. من خلال نقل التجربة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فإنك تزيد من تأثير حملتك على الفور، عن طريق بدء المحادثات بشكل طبيعي حول تلك الذكريات. لا يريد الناس الاستمتاع فقط بذكريات صورة أو صوت حنين إلى الماضي، بل يريدون أن يكونوا قادرين على ربط أصدقائهم وأفراد عائلاتهم بالتجربة ويقولون "مرحبًا، أتذكرون هذا؟" كما يمكن أخذ المحتوى الحديث وتحويله إلى قديم ودمج الحنين إلى الماضي، وهذا شيء يمكن لأي منظمة تنفيذه دون بذل جهود كبيرة. ليس عليك أن تكون علامة تجارية عمرها 100 عام لتجد طريقة ذكية لاستخدام الذكريات. ولكن مع ذلك ستُواجه صعوبة في تحديد ما تريد عرضه بالضبط. إليك أحد الأمثلة لتوجيهك في الاتجاه الصحيح. أجرى متجر التجزئة البريطاني Holiday Hypermarket مسابقة اجتماعية للاحتفال بعيد الأب لتشجيع الأشخاص على إرسال صور لآبائهم في العطلة عبر انستغرام وتويتر. بينما كانت الجائزة صغيرة (حقيبة هدايا)، كانت حملة وسائل التواصل الاجتماعي ناجحة بطريقة لا تصدق. هذا مثال رائع على كيفية الحفاظ على صدقك وإشراك معجبيك في حملتك، فيحب الناس مشاركة الذكريات مع الآخرين وكانت طريقة المتجر ذكية كفاية لإثارة ذلك. 4. الاستفادة من سجل العلامة التجارية (إذا كان بإمكانك) إذا كانت شركتك موجودة بالفعل منذ بعض الوقت، فإن الطريقة الرائعة لزيادة تأثير استراتيجية التسويق بالحنين إلى الماضي هي الاستفادة من تاريخ العلامة التجارية القوي. فمثلًا يعد الفيديو الترويجي لمنصة البلايستيشن من شركة سوني في عام 2013 مثلًا رائعًا لطريقة استثمارًا الشركة بتاريخ العلامة التجارية واحتفل الفيديو باللاعبين من جميع أنحاء الجيل واعتمد على دمج العلامة التجارية بين الحنين إلى الماضي ووضع العلامة التجارية الحالية في الحاضر. يمكن للعلامة التجارية بناء استراتيجيات الحنين إلى الماضي من خلال تذكير عملائها بالتجارب الجيدة التي مروا بها معهم في المناسبات السابقة. فمثلًا اعتمدت شركة Sony على تذكير جمهورها بالذكريات الجيدة التي جمعوها معًا في الماضي وتقنعهم بأنه يمكن صنع المزيد من الذكريات الرائعة في المستقبل إذا اشتروا فقط أحدث وحدة تحكم PlayStation من منتجها. ذكّر المستهلك بتاريخك الثري، وأظهر مدى جدارتك بالثقة وأظهر قيمك الأساسية. ستحتاج للبحث في أرشيف علامتك التجارية وتحديد الصور ومقاطع الفيديو والحقائق حول شركتك، والتي تريد عرضها على عملائك. ابحث عن شيء ملهم في تاريخ شركتك. كل علامة تجارية لديها قصة لترويها. ربما بدأت علامتك التجارية في مرآب لتصليح السيارات. أو يمكنك إعادة منتج قديم وتجديده مرة أخرى. ضع في اعتبارك تضمين قصة علامتك التجارية في استراتيجية التسويق بالحنين إلى الماضي. من بين أهم الرسائل التي يمكنك إيصالها هي كيف وقفت علامتك التجارية بجانب عملائك عبر عقود أو حتى قرون. إن أحسنت صياغة الحملة فستكون بمثابة "ذهب تسويقي" لعلامتك التجارية. 5. انتبه جيدًا للتفاصيل عند محاولة محاكاة حقبة زمنية معينة من الأهمية بمكان الحصول على التفاصيل المتعلقة بالموسيقى والألوان والخطوط والصور بطريقة صحيحة. فمثلًا إذا أردت صنع مقطع فيديو يسافر بالمستهلك بالزمن إلى حقبة زمنية يحبها يجب عليك الاعتناء بكل جوانب الفيديو يجب أن يشعر المستهلك بأن اللقطة مأخوذة فعلًا من الحقبة الزمنية المقصودة هذا يشمل لباس الممثلين وقصات شعرهم وطريقة تنظيم بيوتهم وانتبه جيدًا أنه كلما كانت اللقطة في مكان كبير وكثير المعالم زادت المسؤوليات الواجب الانتباه لها. من الجيد عمومًا الجمع بين المفاهيم القديمة والأفكار الجديدة لجعل التجربة أكثر جاذبية وإثارة لعملائك. تذكر أن المصداقية والأصالة هي مفتاح استراتيجية التسويق الخاصة بالحنين إلى الماضي. تتطلب الحملات الإعلانية الناجحة سواء باستثمار أفكار الحنين إلى الماضي أو بدونها العمل على أدق التفاصيل والمفتاح هو معرفة كيفية تحديد أهم اللحظات في الجدول الزمني لعميلك واستخدام تلك الذكريات لتعزيز هوية شركتك. يعمل التسويق بالحنين إلى الماضي بشكل أفضل عندما تفهم الشركات جمهورها وتراقب نبض الثقافة الحالية وتستمع إلى أكثر ما يتوق إليه الناس. كلما شعر المستهلك بارتياح عند تجربته مع العلامة التجارية الجديدة أو القديمة، زاد انفتاحه على رسائل تلك العلامة. شركات استخدمت التسويق بالحنين إلى الماضي المتابع المدقق للأسواق سيجد بأن إعادة نشر المنتجات القديمة بالطرق الحديثة يؤتي ثماره إذا قدم بطريقة ممتازة. هل تذكر لعبة بوكيمون هل لاحظت كيف أنها استغلت الواقع المعزز لإعادة إحياء لعبة قديمة جدًا لعبة البوكيمون وعمومًا هذه نظرة سريعة على قصتها. صدرت لعبة بوكيمون الأصلية في عام 1996 وكانت تلعب على جهاز Game Boy المحمول ذو الشاشة الصغيرة بسمك خمسة سنتيمترات مربعة وكانت تعرض بالألوان الأبيض والأسود. لاقت اللعبة نجاحًا آنذاك لأنه صدر معها مسلسل كرتوني مرتبط بشخصيات اللعبة ويحكي القصة الكاملة لهذه البوكيمونات. من ذلك الحين حاولت العديد من الشركات بناء ألعاب واستنساخ هذه اللعبة وتطويرها إلى أن جاءت شركة نيانتيك Niantic المتخصصة في ألعاب الواقع المعزز وطورت أفضل لعبة بوكيمون وهي بوكيمون غو Pokémon Go والجدير بالذكر أن الشركة مقرها في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية وتأسست في الأصل كشركة داخلية ناشئة داخل شركة ألفابت (غوغل سابقًا). أطلقت الشركة اللعبة في يوليو 2016 وسرعان ما أصبحت من الألعاب الناجحة بل أصبحت ظاهرة ثقافية عالمية. ففي صيف عام 2016، بدا الأمر كما لو أنه لا مفر من لعبة بوكيمون غو. حطمت عائدات اللعبة في الشهر الأول من صدورها أرقامًا قياسية، إذ بلغت 207 مليون دولار. بالرغم من أن النسخة اليابانية لم تصدر إلا بعد أسبوعين من الإصدار العام. لكنها أيضًا ما لبثت إلى أن تصدرت هي الأخرى الألعاب الأكثر تنزيلًا في اليابان، ووصلت اللعبة أيضًا إلى المرتبة الأولى بين التطبيقات الأكثر بحثًا على آبل ستور. تستخدم اللعبة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ويمكن للمستخدمين التقاط البوكيمونات وتدريبهم، ثم القتال ضد المستخدمين الآخرين، ومحاكاة طريقة اللعب في سلسلة ألعاب الفيديو. السؤال المهم الذي يتبادر إلى الذهن عند الاطلاع على كل هذه المعلومات: ما الذي يجعل هذه اللعبة جذّابة إلى هذا الحد؟ في الحقيقة إن الأمر يعود لعدة عوامل أولها بأن الشركة اعتمدت على ربطها بذاكرة الشباب لا سيّما جيل التسعينيات هذا الجيل أحب اللعبة جدًا آنذاك ومازالوا يحنّون إليها، (أي أنها اعتمدت على الحنين إلى الماضي) ولطالما أحبها كل من عايشها، كما أن الشركة جعلت طريقة عمل اللعبة بالاعتماد على الواقع المعزز الأمر الذي جعلها تتميز ولا تشبه أي لعبة أخرى، وإجبارها المستخدمين على الخروج إلى الشوارع والطبيعة ودفعهم إلى الحركة، بالإضافة إلى ذلك إجبار المستخدمين على التفاعل بين الناس، وتمكينهم من توسيع دائرة معارفهم الاجتماعية إلى جانب التسلية والهروب من الضغط اليومي لبعض الوقت. إلا أن رئيس شركة إنترأكت ومحلل الألعاب هيراباياشي هيساكازو يعتقد بأنه من الأفضل ألا نقيم اللعبة على أنها مجرد لعبة تعتمد على خدمة تحديد الموقع والواقع المعزز وإنما كنقطة انطلاق لاتجاه أكثر حداثة من ألعاب الهواتف الذكية ذات الواقع المعزز باستخدام البيانات الوصفية المعتمدة على خدمة تحديد الموقع. هذا بالضبط ما جعلها تحطم الأرقام القياسية. تباطأ نمو عدد اللاعبين بالرغم من إضافة الشركة المطورة نيانتيك ميزات جديدة كانت مطلوبة بشدة إلى اللعبة. إلا أنها مع ذلك لم تعود إلى القوة التي انطلقت بها، وهذا التحدي الصعب يواجه كل المنتجات التي تعتمد على الحنين إلى الماضي لأنها ستواجه فورة في الاستخدام ومن ثم هبوط حاد بسبب عدم تجديد اللعبة أو طرحها لتحديات ومغامرات جديدة. تجاوزت إيرادات الشركة المليار دولار في عام 2020 لأول مرة. يذكر أن ألعاب الواقع الافتراضي تذهب إلى ما هو أبعد من التجربة البصرية ثلاثية الأبعاد المتاحة للاعبين. يخبرنا علم النفس المعرفي أننا نرى بواسطة أدمغتنا وليس عيوننا لأن وظيفة العيون تنحصر اكتشاف الضوء وتحويله إلى إشارات لترسل بدورها إلى الدماغ للتعرف عليها. أي أن الصور الرقمية المنقولة عبر الواقع الافتراضي يمكن أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من العالم الحقيقي ويصعب تمييزه بالعين المجردة، وهذا بالضبط ما يبرر خوف الناس من العالم الافتراضي ميتا المقدم من شركة ميتا (فيسبوك سابقًا). الفكرة أنه عندما يصعب على العقل التفريق بين الحقيقة والواقع يصبح تأثير الحنين إلى الماضي أكبر بكثير على المستهلكين غير المطلعين على هذه الأمور وبالتالي سيكونون هدفًا سهلًا للمعلنين، بعبارة أخرى التطبيقات للتسويق بالحنين إلى الماضي من خلال الواقع الافتراضي سيكون تأثيره أشد وطأة من الطرق الحالية. الخاتمة تعرفنا في هذا المقال على ماهيّة التسويق بالحنين إلى الماضي وفهمنا ارتباطه مع علم النفس واطلعنا على أهم النصائح التي يجب علينا اتباعها عند إطلاقنا لحملة تعتمد على فكرة الحنين إلى الماضي، وأخيرًا إن الحنين إلى الماضي مهم للغاية إنه يجعلنا ننظر للوراء إلى المحطات التي تخطيناها في حياتنا، ويعيدنا لأوقات لم يكن لدينا أدنى فكرة عما يخبئه لنا المستقبل، ويظهر لنا ما كنا عليه ومن نحن اليوم. تعمل الحملات التسويقية للحنين إلى الماضي لأن صداها يتردد مع الذكريات الإيجابية من الماضي. وتسمح للعملاء باستعادة لحظاتهم الأكثر جمالًا متجاهلين الضغوط والمسؤوليات والفوضى التي تصيبنا في الوقت الحاضر، ولذلك إذا كنت صاحب شركة أو علامة تجارية يجب ألا تهمل هذه الحملات الإعلانية، وجعل العميل يسافر عبر الزمن ويكتشف الذكريات التي يحبها. المصادر Nostalgia Marketing and How Brands Recreate a Time From the Past لكتابه Chidinma Nnamani. Nostalgia Marketing: What Is It and Why Is It Hot? لكاتبته Angie Tran. Passion For The Past: Nostalgia Marketing And The Retro Revolution لمحرري الموقع. What Is Nostalgia Good For? Quite a Bit, Research Shows لكاتبه John Tierney. Pokémon Go Revenue and Usage Statistics (2021) لكاتبه Mansoor Iqbal. اقرأ أيضًا التسويق والمزيج التسويقي لتوضيح رؤيتك ومهمتك وأهدافك أنواع التسويق الأساسية فهم السوق والتعامل معه مكونات التسويق الاستراتيجية
-
تطور مفهوم الإعلانات في السنوات الأخيرة الماضية بسرعة كبيرة وأصبح أكثر تعقيدًا وزادت فيه التفاصيل وكثرت المنصات الإعلانية وتباينت طرق التعامل معها لدرجة يصعب تخيلها ومع هذا التطور يحاول مدراء التسويق إنشاء حملات إعلانية فعالة وإدارة ميزانيات التسويق واتخاذ القرارات بطريقة مدروسة ومثالية لتقوية علاماتهم التجارية وزيادة قدرتها على التنافسية في السوق. يأخذ الإعلان التجاري دورًا أساسيًا ومحوريًا في التسويق فهو أكثر ما يشغل بال مدراء التسويق لأن الإعلان المناسب سيُساعد في جذب العملاء وبناء الوعي كما سيُعزز الإعلان الارتباطات الذهنية بالعلامة التجارية وسيزيد من الجودة المدركة في عقول المستهلكين ومن ثم سيتعززُ الولاء للعلامة التجارية وبالتأكيد كل هذه الأمور ستزيد من حصة العلامة التجارية في السوق، ولكن الإعلان ليس بهذه البساطة إذ أصبحت حروب العلامات التجارية في عصرنا الحالي شرسة جدًا ولا تنتهِ، وعادة ما تتبنى الشركات استراتيجيات إعلانية مختلفة في الأسواق شديدة التنافسية، مثل الإعلانات الهجومية أو الدفاعية أو العامة أو جميعها معًا، ومن أبرز التحديات الّتي يواجهونها هي القدرة على تحليل السوق والمستهلكين لمعرفة التغييرات المطلوبة في استراتيجيات التسويق لتتناسب مع الأجيال الجديدة وتغييرات السوق ودخول المنافسين ولا يوجد في الصدد سوى قاعدة وحيدة وراسخة وهي بأن الإستراتيجية الثابتة في الإعلان ستؤدي إلى خسائر فادحة. سنستكمل في هذا المقال حديثنا عن الوعي بالعلامة التجارية الذي بدأناه في المقال السابق مدخل إلى الوعي بالعلامة التجارية وسنستعرضُ تأثير الوعي بالإعلان Advertising Awareness في زيادة الوعي بالعلامة التجارية. مفهوم الوعي بالإعلان Advertising Awareness الوعي الإعلاني Advertising Awareness هو استراتيجية تسويقية مصممة بطريقة تعزز وعي المستهلكين بما تقدمه الشركة على المدى القصير (المنتجات والخدمات) وعلى المدى الطويل (رسالة الشركة والقيمة الّتي تقدمها). يمكن تخصيص الوعي الإعلاني وفقًا لأهداف وغايات الشركة في الصورة الّتي تسعى الشركة إلى تشكيلها في أذهان المستهلكين، ولا يهدف نشر الوعي الإعلاني إلى تحقيق الربح على المدى القصير، وإنما زيادة التعرف على العلامة التجارية ومنتجاتها وثقافتها. بعبارة أخرى هو مقدار الاهتمام الّذي تحصل عليه العلامة التجارية من خلال إعلاناتها. يرتبط الوعي الإعلاني بالعديد من المفاهيم ويتأثر بالكثير من المتغيرات ولذلك سنُبسط الأمور في البداية وسنتعرفُ على مفهوم الإعلان ونشرّحه تحت المجهر لنستكشف التفاصيل الدقيقة الّتي تجعل الإعلان مؤثرًا في عقول المستهلكين وفي أي مرحلة يتكون الوعي بالإعلان. مفهوم الإعلان يعد الإعلان Advertising نشاطًا قديمًا وتاريخًا ويُعتقدُ بأنه نشأ عندما استطاع الإنسان إنتاج مواد فائضة عن حاجته ولا سبيل لبيع هذا الفائض إلا من خلال زيادة الإنتشار لتصريف هذه المنتجات ومع سرعة تطور الآلات والتقنيات وتغير حياة الإنسان عبر الزمن انتقل مفهوم الإعلان وتغير تغيرًا جذريًا ومع مجيئ الثورة الصناعية الأولى وظهور نظام المصنع الميكانيكي بدلًا من التصنيع اليدوي، إذ أصبح فائض الإنتاج أكثر من أي وقت مضى وأصبحت الآلات تعمل بلا كلل أو ملل وعلى مدار الساعة لزيادة الإنتاج، وترافق ذلك مع زيادة مستوى الدخل للفرد والتسهيلات الحكومية وبناء الدول لمنظومات الشحن البحري وربط الدول بالسكك الحديدية وتحسين سلاسل التوريد. أدت جميع العوامل السابقة إلى فائض غير مسبوق في كمية المنتجات الأمر الّذي جعل من الإعلان ضرورة حتمية للشركات لبيع هذه المنتجات في المقام الأول. تنوعت رؤية الباحثين لمفهوم الإعلان فمنهم من رأى بأن الإعلان "وسيلة تمكننا من الوصول إلى عدد كبير من المشترين المتباعدين جغرافيًا بتكلفة جيدة"، ومنهم من رأى بأنه "مجموعة من الوسائل المسخرة بهدف التعريف بمؤسسة صناعية أو تجارية بغية بيع منتج ما"، وغيرها من التعاريف ويمكن تلخيص جميع تعاريف الإعلان على الشكل التالي: "هو مجموعة وسائل موجهة لإعلام الجمهور بمنتج وإقناعه بشرائه أو الإقبال عليه أو على خدمة معينة، وهو يقوم أساسًا على الإقناع (أي مخاطبة العقل) وإثارة الرغبة (أي مخاطبة الغرائز)". بالرغم من اختلاف التعاريف إلا أنه يمكننا تلخيص أهم خصائص الإعلان وهي: يعتمد الإعلان على وسائل اتصال مختلفة. إمكانية الوصول الكبير للجمهور. اتصال غير شخصي بين البائع والمشتري. وسيلة تسويق غير مجانية ومكلفة في بعض الأحيان. أهمية أكبر في حالة المنتجات الاستهلاكية بالموازنة مع المنتجات الصناعية. لا يقتصر الإعلان على عرض وترويج المنتجات فقط وإنما يشتمل أيضًا على ترويج الأفكار والخدمات والأشخاص والشركات. تتعد رسائل الإعلان فهي لا تهدف دومًا لزيادة المبيعات وإنما تكون في بعض الأحيان لزيادة الوعي أو توضيح مشكلة. معظم الإعلانات تعتمد على الإبداع بالدرجة الأولى. أنواع الإعلان تتعدد أنواع الإعلانات وقد صنف الباحثون في هذا المجال الإعلانات بطرق مختلفة فبعضهم صنفه بحسب النطاق الجغرافي مثل الإعلان المحلي أو الإقليمي أو العالمي ومنهم من صنفه بحسب الجمهور المستهدف ولكن من أكثر الطرق العامة والشائعة في التصنيف هي الّتي صنفت الإعلان لثلاثة أنواع وهي: إعلانات هجومية Offensive Advertising: وهي إعلانات تهاجم نقاط ضعف العلامات التجارية المنافسة مع إبراز تميزها وتوضيح نقاط قوتها. بعض الشركات لا تذكر منافسين محددين وإنما يشيرون إلى المنافسين بطريقة ملتوية وغير مباشرة. إعلانات دفاعية Defensive Advertising: وهي الإعلانات الّتي تحاول الدفاع على العلامة التجارية والمحافظة على حصتها في السوق وإبقاء عملائها موالين لها، وغالبًا ما تلجأ الشركات الرائدة في السوق لهكذا أنواع من الإعلانات لتحجيم حصة الشركات الناشئة أو لتخفيف الضرر والتأثير السلبي المحتمل الناتج عن إعلانات المنافسين. إعلانات عامة Generic Advertising: وهو إعلانات المصممة للترويج لمنتجات أو عادات صحية عامة بدلًا من علامة تجارية معينة. تنتج هكذا نوع من الإعلانات الحكومات أو الشركات المسيطرة على السوق، فمثلًا نرى هذه الإعلانات الحملات الإعلانية لشرب الحليب الطازج وتشجيع تنظيف وغسل الأسنان قبل النوم، ويحاول هذا الإعلان بناء وعي عام للمستهلك وإعلامه بالمشكلة وتنشئ الشركات إعلانات لحل المشكلة المطروحة. بالرغم من شمولية الأنواع السابقة إلا أننا مع تطور التقنيات وطرق الإعلان بالإضافة إلى التطورات السريعة في عالم التسويق والإعلان انقرضت الأنواع السابقة وظهرت أنواعًا جديدة من الإعلانات وصنفت هذه الإعلانات بحسب الهدف الدقيق منها فمثلًا يمكن أن يكون الإعلان إخباريًا أو إقناعيًا مثلًا، فيجب على الشركة تحليل السوق الحالية من أجل اختيار الإعلان المناسب، ومن أبرز هذه الأنواع من الإعلانات نذكر: الإعلان الإخباري Informative Advertising. الإعلان الإقناعي Persuasive Advertising. الإعلان التذكيري Reminder Advertising. الإعلان التعزيزي Reinforcement Advertising. الإعلان الموازن Comparative Advertising. 1. الإعلان الإخباري Informative Advertising تعتمد الإعلانات الإخبارية على المعلومات الدقيقة والواضحة لجذب العملاء المحتملين، ويهدف الإعلان بصورة رئيسية إلى بيع المزيد من المنتجات أو الخدمات من خلال شرح وتوضيح فوائد المنتج. يشرح الإعلان الإخباري بوضوح كيفية استخدام المنتج ويحدد صفاته أو فوائده أو جاذبيته، وفي بعض الأحيان تستخدم الكيانات العامة أو الحكومية أو المنظمات غير الربحية الإعلانات الإخبارية لمشاركة الرسائل الهادفة، فمثلًا تعتمد حملات مكافحة التدخين المختلفة اعتمادًا كبيرًا على المعلومات المباشرة حول مخاطر التدخين، وإعلانات عدم الإسراف في استخدام المياه أو الطاقة الكهربائية، ويستخدم الإعلان الإخباري عمومًا للهدفين التاليين: الإعلان عن منتجات جديدة أو تحديثات على المنتجات الحالية. موازنة المنتجات. يمكن استخدام الإعلانات الإخبارية عند طرح علامة تجارية جديدة أو منتجًا جديدًا، ويوضح الإعلان الصفات المميزة للمنتج مثل ماهيّة المشكلة الّتي يحلها أو الرغبة الّتي يلبيها للمستهلك، وبعض الشركات تعتمد على هذه الإعلانات لإظهار كيفية تميّز منتجها في السوق، ويجلب هكذا إعلان المستهلكين المهتمين بفئة المنتج، كما يعد الإعلان الإخباري نموذجيًا لمشاركة التحسينات الّتي تجريها العلامات التجارية للمنتجات أو الترقيات لبرامج الولاء أو الإصدارات الجديدة المُخطط لطرحها في الأسواق وغيرها من الأخبار الجديدة لدى الشركة، توضح هذه الإعلانات ضرورة ترقية البرنامج أو الخدمة الّتي يستخدمها جمهور العلامة التجارية الحالية للحصول على المميزات الجديدة، وغالبًا ما تستخدم شركات التجميل والمستحضرات الطبية هذا النوع من الإعلانات. 2. الإعلان الإقناعي Persuasive Advertising يحاول الإعلان الإقناعي خلق استجابة عاطفية إيجابية لدى العملاء المحتملين من خلال النصوص والصور المقنعة، ويعمل الإعلان على جذب الدوافع وتحفيز الاندفاعات العاطفية الفطرية لدى المستهلكين، ويرى الكثير من المسوقين بأن هذه الطريقة فعالة ومؤكدة لتشجيع الاهتمام بالمنتجات والخدمات الجديدة أكثر من مجرد تقديم المعلومات والحجج المنطقية، وفي حال نجاح الإعلان سيزداد انفتاح المستهلكين على المنتج ورغبتهم في تجربته أو حتى البحث عنه في محرك البحث، ومن أبرز النصائح لتصميم إعلان مقنع ويغير من توجه المستهلكين: استخدم العواطف. التعاون مع المشهورين. أما استخدام العواطف، فيجب أن تفكر في الطرق الّتي يمكن لإعلاناتك أن تخلق مشاعر إيجابية لدى العملاء المحتملين، مثل جعل الناس يبتسمون أو يضحكون. استفد من رغباتهم الفطرية في الاتصال مع مجتمعهم والسيطرة على طريقة سير حياتهم الشخصية ومساعدتهم في تحقيق النجاح. في الحقيقة ليس من الضروري التخلي تمامًا عن المنطق عند إنشاء إعلانات مقنعة؛ إلا أن تركيزنا يجب أن يركز على خلق رد فعل عاطفي إيجابي للإعلان وزرع بذور الرغبة في المنتج أو الخدمة، ويُعد الإعلان المدغدغ للعاطفة من أكثر الإعلانات إقناعًا وسهولة في توصيل الفكرة كما أنه يخلق شعورًا إيجابيًا بمنتجك. بالإضافة إلى ذلك يجب الحرص على جعل الإعلان بسيط وأن يكون نص الإعلان قصيرًا ولطيفًا ودقيقًا، وغالبًا ما يُستخدم هذا النوع من الإعلانات للمنتجات البسيطة والتي لا تحتوي على تفاصيل معقدة. وأما التعاون مع المشهورين، فيمكن الاستفادة من الأشخاص المشهورين والمحبوبين عن طريق ظهورهم في الإعلان والترويج لعلامتك التجارية هذا الأمر سيزيد من مصداقية الإعلان وسيُحفز مشاعر المحبة الموجودة لهذا الشخص المؤثر ويربطها مع المنتج، ويجب أن يوضح الإعلان القيمة الّتي يضيفها المنتج إلى المؤثر لكي تتوضح الصورة للمستهلك ولا يكون الإعلان مجرد تلميع للمنتج فقط. 3. الإعلان التذكيري Reminder Advertising يهدف الإعلان التذكيري إلى الحفاظ على الوعي بالعلامة التجارية وتشجيع العملاء الحاليين على إجراء عمليات شراء متكررة، وتستفيد الشركات من العملاء المحتملين المطلعين على العلامة التجارية وهناك العديد من أشكال إعلانات التذكير مثل النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني والإعلانات المصورة وحملات الوسائط الاجتماعية. تستخدم الشركات في بعض الأحيان الإعلانات الطرقية للحفاظ على الشعار وهوية العلامة التجارية في أذهان العملاء مثل شركات المشروبات الغازية مثل وكاكولا وبيبسي، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة الّتي يستخدمها المسوقون للإعلانات التذكيرية نذكر منها: التذكير بعربات التسوق المتروكة والرسائل الإخبارية. حملات إعادة الاستهداف. ففي النقطة الأولى، التذكير بعربات التسوق المتروكة والرسائل الإخبارية، يترك العملاء في كثير من الأحيان عربة التسوق الافتراضية الخاصة بهم دون إتمام عملية الشراء وعندما نرسل إليهم تذكير بالمتابعة فهذا سيعزز من فرصة إكمال الشراء كما تعتمد بعض الشركات على إضافة كوبونات مخصصة لتحفيزهم وحثهم على اغتنام الفرصة، بالإضافة إلى ذلك نرى في بعض الأحيان رسائل تذكيرية لإعلام المستهلكين بجديد المنتجات المضافة أو المنتجات الأكثر مبيعًا لهذا الأسبوع …إلخ، كما يمكن إرسال بعض العروض والخصومات الخاصة بمشتركي النشرة الإخبارية أو عروضات تصفيات المنتجات الصيفية أو الشتوية. وفي النقطة الثانية، حملات إعادة الاستهداف، يستهدف هذا النوع من الإعلانات تذكير العملاء المحتملين بناءً على سجل التصفح الخاص بهم حتى وإن تصفح العميل المتجر فقط ولم يشتري العميل المنتجات ولم يضيفها إلى عربة التسوق فإن تصفحه إليها سيؤدي إلى حفظ النشاط في ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمتصفح الّذي يستخدمه والتي تعتمد عليها الشبكات الإعلانية مثل غوغل وفيسبوك لتظهر له إعلانات المنتجات الّتي تصفحها في المتجر عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن أكثر الشركات الّتي تستخدم هذا النوع من الإعلانات هي شركات الوساطة العقارية والتقسيط نظرًا لأن قرار شراء المنزل يحتاج للكثير من التخطيط والبحث وتشجع هذه الإعلانات على اتخاذ المستخدمين الخطوة الأولى للشراء وهي تسجيل معلومات الشخصية للتواصل ومن ثم يتدخل مندوب المبيعات لإكمال مهمة الإعلان وإقناعهم بالشراء. 4. الإعلان التعزيزي Reinforcement Advertising يهدف هذا الإعلان إلى إقناع المشترين الحاليين أن اختيارهم صحيح وصائب من خلال عرض أفضل الطرق لاستخدام المنتج والحفاظ عليه، ويستخدم هذا الإعلان بكثيرة في قطاع السيارات، إذ تُظهر المستهلكين على أنهم راضون عن مميزات سياراتهم ويستمتعون بها. 5. الإعلان الموازن Comparative Advertising يوازن هذا الإعلان بين المنتج الّذي تقدمه الشركة ومنتجات الشركات المنافسة في السوق ويهدف الإعلان لتوضيح تفوق منتج الشركة على المنتجات المنافسة، ويمكن أن تكون الموازنة بين التكلفة أو الجودة أو التصميم أو سهولة الاستخدام …إلخ، وهذا النوع من الإعلان شائعة بين شركات صناعة السيارات والهواتف والحواسيب المحمولة وسلاسل الوجبات السريعة، وهنالك العديد من المزايا للإعلان الموازن نذكر منها: إنشاء تمايز للعلامة التجارية والتأثير في قرار الشراء. بناء الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز ولاء العملاء. أما النقطة الأولى، فإذا كانت الشركة تعمل في سوق شديد التنافسية ومشبع بالمنتجات فيمكن أن تساعد هكذا حملات إعلانية في جعل منتجات الشركة بارزة في عقول المستهلكين لأنه في كثير من الأحيان لا يدرك المستهلكون خيارات الشراء المتاحة لهم وهنا يأتي دور الإعلان الموازن، ويمكن أن تستفيد الشركات الّتي أجرت أبحاثًا تسويقية دقيقة من نشر تعليقات المستهلكين الّتي تركز على مميزات منتجها مقابل منتج منافس. وأما بخصوص النقطة الثانية، فتساعد الحملة الإعلانية الموازنة في خلق وعي بالعلامة التجارية من خلال تسليط الضوء على الميزات المتفوقة لمنتجك خاصةً إذا كان المنتج المنافس لديه حصة أكبر في السوق، بالإضافة إلى ذلك يمكن للإعلان الموازن التأكيد على صحة قرارات الشراء للعملاء الحاليين مما يساعد على بناء قاعدة عملاء مخلصين. تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكننا استخدام الإعلانات الموازنة دائمًا ففي بعض الأحيان سيؤثر تأثيرًا سلبيًا على العلامة التجارية مثل استخدام شركة كبيرة إعلانًا تنافسيًا للاستخفاف بشركة صغيرة ذات حصة سوقية أقل من حصتها في السوق، فإنها تخاطر بالظهور وكأنها متسلطة، بالإضافة إلى ذلك يتطلب استخدام الإعلان الموازن معرفة شاملة بقوانين الإعلان المحلية فمثلًا في الولايات المتحدة الأمريكية تحدد لجنة التجارة الفيدرالية أنواع الإعلانات الموازنة الّتي يُسمح للشركة باستخدامها، ولا يجوز للشركة تقديم ادعاءات كاذبة بشأن العلامات التجارية المنافسة، وعمومًا لكل دولة قواعدها الخاصة فيما يتعلق بالإعلان الموازن ويجب على مدير التسويق دراسة هذه القوانين لكي لا يعرض الشركة للمساءلة القانونية لاحقًا. نماذج تأثير الإعلان منذ بداية الإعلانات كان هنالك مجموعة من الأسئلة الّتي شغلت وما زالت تشغل المسوقين والمعلنين، ومن هذه الأسئلة نذكر: ما آلية عمل الإعلان؟ كيف يستجيب المستهلكين للإعلان؟ ما هي الصياغة الأفضل للإعلان؟ هل يوجد تسلسل معين يجب الاعتماد عليه في عرض أفكار الإعلان؟ في أي مرحلة من الإعلان تكون الرسالة المراد إيصالها أقوى؟ كيفية تأثير الإعلان على مستقبل الرسالة الإعلانية؟ حاول العديد من الباحثين الإجابة على هذه الأسئلة والعديد من الأسئلة الأخرى وصاغوا الإجابات على شكل نظريات أسموها نماذج تأثير الإعلان، وسنستعرض أبرز خمسة نماذج لتأثير الإعلان لنرى في أي مرحلة تكون الاستجابة العقلية والعاطفية والسلوكية للمستهلك. جميع هذه النماذج خطية وتفترض بأن المستهلكين يتحركون ضمن سلسلة من الخطوات (المعرفية والعاطفية والسلوكية) عندما يتخذون قرارات الشراء، وهذه النماذج هي: نموذج AIDA. نموذج التسلسل الهرمي للتأثيرات Hierarchy of Effects. نموذج تبني الابتكار Innovation Adoption. نموذج معالجة المعلومات Information Processing. النموذج التشغيلي Operational. 1. نموذج AIDA يشير اسم النموذج إلى المراحل التي يمر بها المستهلك والتي هي (Attention->Interest->Desire->Action)، ويعد من النماذج القديمة والتاريخية لكيفية استجابة المستهلكين للإعلان يتألف هذا النموذج من أربعة مراحل أساسية وهي: الانتباه Attention: وتدعى أيضًا مرحلة الوعي Awareness، وهي المرحلة الّتي يجب على الإعلان جذب انتباه المستهلك ليصبح على دراية بالمنتج أو العلامة التجارية، وهذه المرحلة من أصعب المراحل لأن المستهلكين الحاليين يصعب جذب انتباههم وتركيزهم لمنتج ما وخصيصًا في ظل تأثير الشبكات الإجتماعية على تركيز المستهلكين، ولذلك تحتاج هذه المرحلة الكثير من التخطيط والاختبار على فئات مستهدفة صغيرة قبل نشر الإعلان النهائي لتجنب الخسارات المحتملة. الاهتمام Interest: بعد نجاح مرحلة جذب الانتباه تأتي مرحلة اهتمام المستهلك بمعرفة المزيد عن المنتج أو الخدمة أو العلامة التجارية وهي فرصة لشرح فوائد المنتج ومميزاته واختلافه عن المنتجات الأخرى في السوق، ومدى أهمية المنتج لحياة المستهلكين المستهدفين، ولذلك فإن إعطاء المعلومات المناسبة بطريقة سهلة وسهلة سيعزز من الجودة المدركة لدى المستهلكين. الرغبة Desire: بعد إثارة اهتمام المستهلك تجاه المنتج سيُرغب في امتلاك المنتج ومهمتنا في هذه المرحلة هي تحريك الرغبة تنميتها ونقل المستهلك إلى قرار الشراء أو أي فعل نريده. الإجراء Action: بعد إثارة رغبة المستهلك في امتلاك المنتج يأتي دور إشباع هذه الرغبة من خلال عرض طريقة الشراء ليبدأ بخطوات الشراء الفعلية والتي يجب أن تكون سهلة ومتنوعة. لمزيد من المعلومات حول هذا النموذج ننصحك بالاطلاع على مقال كيف تستخدم كتابة الإعلانات لزيادة مبيعاتك؟. 2. نموذج التسلسل الهرمي للتأثيرات صمم هذا النموذج روبرت جي لافيدج Robert J Lavidge وجاري أشتاينر Gary A Steiner وذلك في عام 1961، ويحاول هذا النموذج -والنماذج الحديثة عمومًا- التعمق أكثر في كيفية تأثّر المستهلكين بالإعلان ويتألف هذا النموذج من 6 مراحل وهي على الشكل التالي: الوعي Awareness: وهي المرحلة الأولية الّتي يدرك فيها العميل وجود المنتج أو العلامة التجارية سواء كان من خلال الإعلانات أو أي طريقة أخرى. المعرفة Knowledge: يبدأ العميل في هذه المرحلة بجمع المعلومات المطلوبة عن المنتج، ويحاول ببطء فهم الفوائد المرتبطة به من خلال البحث أو سؤال مندوبي المبيعات أو من خلال الأشخاص الذين استخدموا المنتج بالفعل. يمكن للمستهلكين التبديل بسهولة إلى علامة تجارية منافسة عندما لا يتمكنون من جمع المعلومات المطلوبة، ولذلك تقع على عاتق المعلن مسؤولية التأكد من توفر معلومات المنتج بسهولة. الإعجاب Liking: يطور العميل في هذه المرحلة إعجابه بالمنتج وتتمثل مسؤولية المعلن في إبراز مميزات المنتج لزيادة الترويج للعلامة التجارية أو المنتج. التفضيل Preference: تتكون في هذه المرحلة الصورة الذهنية للمنتج في عقل العميل ويعرف مميزات المنتج ويجب على المعلنين تعزيز الجوانب الإيجابية لعلامتهم التجارية لضمان إكمال المستهلك عملية الشراء. الاقتناع Conviction: يكون العميل في هذه المرحلة مقتنعًا بالمنتج واتخذ قراره بشراءه وتتمثل مسؤولية المعلن هنا في تسريع هذا التوجه من خلال استخدام تأثير FOMO وهو تأثير الخوف من ضياع الفرصة سواء عن طريق تحفيز العملاء على استغلال الخصومات الحصرية أو قبل نفاذ الكمية …إلخ، ولمزيد من المعلومات عن تأثير FOMO ننصحك بالاطلاع على المقال المفصل كيف تستخدم الخوف من الفوات FOMO لزيادة المبيعات؟). الشراء Purchase: وهي المرحلة الّتي يشتري المستهلك المنتج وبالطبع يجب تسهيل عملية الشراء وتنويع طرق الدفع. 3. نموذج تبني الابتكار طور هذا النموذج روجرز Rogers في عام 1995، وفي هذا النموذج يبحر العميل خلال خمس مراحل للوصول إلى الفعل المنشود سواء من خلال الشراء أو التسجيل النشرة البريدية، وهذه المراحل هي: الوعي Awareness: يصبح المستهلك على دراية بعلامة تجارية أو منتج في الغالب من خلال الإعلانات. الاهتمام Interest: يهتم العميل في هذه المرحلة بالمنتج أو العلامة التجارية ويبدأ بجمع المعلومات واكتساب المزيد من المعرفة. التقييم Evaluation: يكمل المستهلكين في هذه المرحلة الاطلاع على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمنتج، ويقيّمون البدائل ويحاولون اكتساب فهم أعمق للمنتج الّذي أثار اهتمامهم. التجربة Trial: يجرب العملاء المنتج قبل اتخاذ القرار النهائي لشراء المنتج. التبني Adoption: يقبل في هذه المرحلة العملاء المنتج ويتخذون قرارًا بشراءه. 4. نموذج معالجة المعلومات نموذج معالجة المعلومات هو هيكل يستخدمه علماء النفس المعرفي لتحديد العمليات العقلية. يربط هذا النموذج عملية التفكير البشري بوظائف الحاسوب ويعامل العقل البشري مثل الحاسوب، أي أنه يأخذ المعلومات وينظمها ويخزنها ليستعيدها لاحقًا. وبحسب النموذج يمتلك الانسان جهاز إدخال معلومات (مثل العين والأذن والحواس) ووحدة معالجة (وهي العقل) ووحدة تخزين (وهي الذاكرة) وجهاز إخراج وهي تصرفات الإنسان وقراراته، أي أن الحاسوب له إطار عمل مشابه لعقل الإنسان، ويتكون نموذج معالجة المعلومات من 6 مراحل وهي: العرض Presentation: يدرك المستهلك في هذه المرحلة احتياجاته ويبحث عن منتج يشبع احتياجاته. الانتباه Attention: ينتبه العملاء المحتملين للمنتج أو العلامة التجارية. الاستيعاب Comprehension: يوازن المستهلك خياراته ويقيّم المنتجات المختلفة من العلامات التجارية الموجودة في السوق للتأكد من المنتج المطلوب يلبي بالفعل متطلباته. الاعتماد Yielding: هذه مرحلة يكتشف فيها العميل ما يريده بالضبط والعلامة التجارية المناسبة ومنتجها الّذي يلبي احتياجاته. الاحتفاظ Retention: يحتفظ المستهلك في هذه المرحلة بالمميزات والسمات الرئيسية للمنتج والفوائد وجميع الجوانب الإيجابية للمنتجات الّتي يسعى لشرائها. سلوك Behavior: يتخذ المستهلك في هذه المرحلة قرار الشراء لمنتج معين ويقدم على سلوك الشراء. 5. النموذج التشغيلي يعد النموذج التشغيلي الأعم والأشمل وهو إطار عمل استراتيجي يتألف من ثلاثة أنشطة وهي: التفكير غير التقييمي Non-Evaluative Thinking: وهي المرحلة الّتي يتعرض المستهلكون للمنتجات والعلامات التجارية المختلفة الّتي يرونها، وهذه المرحلة يبنى فيها الوعي في المستهلكين المحتملين. التفكير التقييمي Evaluative Thinking: وهي المرحلة الّتي يقيّم فيها العملاء المحتملون المنتجات المختلفة ويدرسوا الخيارات المتاحة لاختيار منتج من بين البدائل المختلفة. الإجراء Action: يتخذ المستهلك في هذه المرحلة قرار الشراء النهائي ويشتري المنتج. نلاحظ أن بالرغم من اختلاف النموذج الإعلاني فإنه يوجد ثلاث مراحل أساسية لابدّ منها وهي يمكننا أن نستنتج أنه بغض النظر عن النوع أو الشخصية أو وصف النماذج، فإن المرحلة الأولى من جميع النماذج المذكورة أعلاه هي مرحلة الإدراك، يليها الفهم. ولا يمكن تعزيز الرسالة ما لم يتم إنشاء الوعي وتطوير الفهم. الفرق بين تكرار الإعلان ومعدل الوصول يحصل في عالم التسويق والإعلان جدل كبير بين أولوية الوصول لشريحة جمهور كبيرة وتكرار الإعلان لشريحة جمهور محددة، وللوهلة الأولى يعتقد البعض بأن رؤية المزيد من الأشخاص للإعلان سيؤدي لإقبال المزيد من الأشخاص لشراء المنتج أو الخدمة ولكن في الحقيقة إن الأمر أعقد من ذلك. في البداية لنتعرف على مفهوم التكرار الفعال Effective Frequency ومفهوم مدى الوصول Reach: فالأول هو عدد المرات الّتي يجب أن يتعرض فيها الشخص لرسالة إعلانية لتحقيق اتصال فعال سواء من خلال الشراء أو أي فعل آخر، وقبل أن يمل المستخدم ويعتقد بأن الإعلان مجرد هدر للوقت، والثاني هو إجمالي عدد الأشخاص الذين عُرض إعلان معيّن لهم بدون تكرار الإعلان لنفس الشخص، ويساعدك هذا المقياس في معرفة عدد المرات الّتي عُرض فيها الإعلان للمستهلكين عبر مختلف الأجهزة والشبكات الاجتماعية. فمثلًا نجد من خلال إعلانات غوغل أنه لديها مقاييس مدى الوصول الفريد على الشكل التالي: عدد المستخدمين الذين شاهدوا الإعلان. متوسط عدد مرات الظهور لكل مستخدم. متوسط عدد مرات الظهور لكل مستخدم خلال فترة 7 أيام. متوسط عدد مرات الظهور لكل مستخدم خلال فترة 30 يومًا. يرى بعض المعلنين بأن الاستهداف الواسع للجمهور يؤدي لاستهداف أشخاص عشوائيين لن يشتروا المنتجات أو يقوموا بالفعل المنشود، والبعض الآخر من الباحثين يجد بأن التكرار مفيد في الرسائل الإعلانية فمثلًا يرى الباحث توماس سميث في كتابه "الإعلانات الناجحة Successful Advertising" بأن لكل تكرار من الإعلانات رد فعل مختلف للمستهلك وهذه الردود تكون على الشكل التالي: التعرض الأولى: لا يرون الإعلان. التعرض الثاني: لم ينتبهوا له. التعرض الثالث: يدركون بأنه موجود. التعرض الرابع: لديهم إحساس عابر بأنهم شاهدوا الإعلان من قبل. التعرض الخامس: قرأوا الإعلان بالفعل. التعرض السادس: يتجاهلون الإعلان تمامًا. التعرض السابع: ينزعجون منه قليلًا. التعرض الثامن: يقولون في أنفسهم "ها هو هذا الإعلان المحير مرة أخرى". التعرض التاسع: يتساءلون عما إذا كانوا يفوتون شيئًا ما. التعرض العاشر: يسألون أصدقاءهم أو جيرانهم إن جربوا ما جاء في الإعلان. التعرض الحادي عشر: يتساءلون كيف تدفع الشركة مقابل كل هذه الإعلانات. التعرض الثاني عشر: يبدأون في التفكير بأنه لا بدّ أن يكون المنتج جيدًا. التعرض الثالث عشر: يبدأون بالشعور بأن المنتج ذو قيمة. التعرض الرابع عشر: يُساورهم شعور بأنهم يريدون منتجًا كهذا منذ فترة طويلة. التعرض الخامس عشر: بدأوا يتوقون لشراء المنتج بالرغم من أنهم لا يستطيعون شرائه. التعرض السادس عشر: يقبلون بحقيقة أنهم سيشترونُ المنتج في وقت ما في المستقبل. التعرض السابع عشر: يلتزمون بشراء المنتج. التعرض الثامن عشر: يلومون فقرهم لأنهم لا يستطيعون شراء هذا المنتج الرائع. التعرض التاسع عشر: يجهزوا أموالهم بعناية شديدة. التعرض العشرين: في هذه المرة يشترون ما يعرضه الإعلان. صاغ السيد سميث هذه الرؤية الذكية في عام 1885 أي منذ 137 عام (من تاريخ كتابة المقال)، ومع أن مجال الإعلان آنذاك كانت في مهده، ولكن سميث كانت رؤيته صائبة بعض جزئيًا وسرعان ما اكتشف المسوقون بأن ما قاله سميث "المزيد من التكرار = المزيد من الفعالية" هو قانون صحيح وبدأوا في تطبيقه. ومع تطور علوم التسويق ودراسة سلوك المستهلك وجد الباحثون بأنه يجب الحد من كمية التعرض المستهلك للإعلان لكي لا يصاب المستهلك بعمى الإعلانات Banner Blindness والذي يؤدي على عدم انتباه المستهلك للإعلان المعروض وكأنه لم يره تمامًا، وكان الحل الأمثل لهذه المشكلة هي إيجاد حد أعظمي لتكرار الإعلان لتعظيم النتائج وتجنب المشاكل المترتبة عليها، وبدأت تظهر نظريات مختلفة مثل قاعدة الرقم 7 ونظرية الكاتب هربرت إي كروغمان Herbert E. Krugman والذي وجد بأن التعرض ثلاث مرات للإعلان كافٍ جدًا؛ فمن خلال عمله في شركة جنرال إلكتريك تبنت الشركة نظريته واستخدمتها على نطاق واسع في ساحة الإعلانات ونظريته تتكون من ثلاث نقاط وهي على الشكل التالي: التعرض الأول للإعلان: سيكون ردة فعل المستهلك "ما هذا الشيء؟" وهي استجابة طبيعية لأي شيء جديد بغض النظر عن مدى اهتمام المستهلك أم لا. التعرض الثاني: يستجيب المستهلك للإعلان في هذه المرحلة ويستعرض رسالة المنتج أو العلامة التجارية. التعرض الثالث: يتخذ المستهلك في هذه المرحلة قرار الشراء أو الامتناع. يرى هربرت بأن التعرضات الرئيسية هي الأولى والثانية والثالثة ولا يوجد شيء مثل التعرض الرابع نفسيًا أو الخامس أو السادس …إلخ لأن هذه التكرارات ماهي إلى إعادة لتأثير التعرض الثالث، هذه الأفكار جعلت المعلنين يعيدون التفكير في قراراتهم وكيفية الإنفاق على المنصات الإعلانية واستهداف الجمهور. كما لجأ المعلنون لتجزئة الجمهور إلى أجزاء منفصلة لأن هذا سيُساعد على تحليل البيانات ورؤية التأثير الأكبر ومحاولة تكراره على بقية الجمهور، كما تتيح التجزئة إمكانية تخصيص الرسائل الإعلانية لكل شريحة، الأمر الّذي يجعل الحملة الإعلانية تحقق نجاحًا أكبر، وعمومًا يكون الحكم النهائي في التكرار والوصول هو الاختبار والتحسين. مقومات الإعلان الناجح الأمر المهم الّذي لا بدّ لنا من الحديث عنه في سياق الحديث عن الإعلانات هو موضوع طرحه الأب الروحي للتسويق فيليب كوتلر Philip Kotler والذي رأى بأن عند إنشاء أي إعلان يجب الأخذ بعين الاعتبار للقرارات الخمسة التالية: المهمة Mission: تعدُ الخطوة الأولى وتحدد في هذه الخطوة هدف الإعلان، هل الهدف التزود بالمعرفة أي إعلان إخباري أو إقناعي؟ أو أنه يركز على تفاصيل دقيقة مثل بناء أو تعزيز الوعي Awareness؟ أو الاهتمام Interest أو الرغبة Desire؟ الرسالة Message: يجب على المعلن أن يقدم عرضا واضحًا لرسالة العلامة التجارية أو القيمة الّتي يقدمها المنتج، ويعد الإعلان هدرًا إذا لم تجد الشركة أي شيء يميزها عن المنافسين، أو كانت طريقة عرض الرسالة خطأ. وسائل الإعلام Media: يجب أن نحدد الوسائل الّتي نريد إيصال الرسالة من خلالها سواء كانت تقليدية مثل الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والإعلانات الطرقية والبريد المباشر أو الهاتف، أو وسائل حديثة مثل المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومنصات بث الفيديو وغيرها من الطرق الحديثة للإعلان. المال Money: يجب على الشركة اتخاذ دراسة الميزانية المناسبة بحسب وسيلة الإعلان الّتي تريدها، إذ يؤثر السوق المستهدف ونسبة التكرار ووقت عرض الإعلان ونوعية المستهلكين المستهدفين والموقع الجغرافي وغيرها من العوامل المهمة في تحديد الميزانية. القياس Measurement: يجب وضع مقاييس لكيفية تأثير الإعلان سواء كان على الوعي بالعلامة التجارية أو زيادة نسبة المبيعات أو زيادة عدد مرات البحث عن المنتج أو العلامة التجارية وغيرها وتتناسب مقاييس الإعلان بحسب الهدف الرئيسي منه فإذا كان الهدف زيادة المبيعات فالمقياس الأساسي هو زيادة المبيعات والمقاييس المتعلقة به. الخاتمة تعرفنا في هذا المقال ماهية الوعي بالإعلان وبدأنا بفهم الإعلان وتعرفنا على أنواعه فاستعرضنا الإعلان الإخباري والإقناعي والتذكيري والتعزيزي والموازِن وتعرفنا بعدها على نماذج تأثير الإعلان ابتداءً بنموذج AIDA ونموذج التسلسل الهرمي للتأثيرات ونموذج تبني الابتكار ونموذج معالجة المعلومات والنموذج التشغيلي ومن ثم انتقلنا لتوضيح العلاقة بين تكرار الإعلان ومعدل الوصول ولنختتم المقال بمعرفة قرارات الإعلان الناجح بحسب فيليب كوتلر. وختامًا يعد الوعي بالإعلان من أساسيات التسويق الحديث وتختلف الإعلانات باختلاف طبيعة المنافسة، ويلجأ كبار المعلنين عادة إلى الإعلانات الدفاعية للحفاظ على أرباحهم وحصتهم السوقية، ولضمان عدم تحول عملائهم إلى المنتجات أو الخدمات المنافسة، فإذا قدم المنافسون المنتجات بسعر أقل، فستركز الإعلانات الدفاعية على طريقة تسعير خدمات الشركة لتوضيح التباين للعملاء الحساسين للسعر، لذا قبل اختيار الإعلان المنشود يجب دراسة المنافسين واكتشاف نقاط قوتهم وتحديد العملاء المتأثرين بهم، ومن ثم الاستجابة للمنافسين بالطريقة المناسبة. في الحقيقة لا يوجد خطوات ثابتة لإنشاء إعلان يبني الوعي في عقول المستهلكين لأن الأمر يعتمد بصورة أساسية على السوق والمنافسين والمستهلكين والشركة وميزانيتها. سنكمل في المقال القادم مشوارنا وسنستعرضُ تأثير الوعي بالسعر على الوعي بالعلامة التجارية. المصادر مقال Defensive Marketing: How a Strong Incumbent Can Protect Its Position لصاحبه John H. Roberts. مقال Defensive Marketing: How to Protect Your Brand and Market Position مقال Informative Advertising: 4 Ways to Use Informative Advertising مقال Persuasive Advertising: 7 Persuasive Techniques in Advertising مقال Reminder Advertising: 5 Types of Reminder Advertising مقال Comparative Advertising: What Is Comparative Advertising? مقال Say It Again: Messages Are More Effective When Repeated كتاب "الإعلانات الناجحة Successful Advertising" لصاحبه توماس سميث الطبعة السابعة. اقرأ أيضًا مدخل إلى الوعي بالعلامة التجارية الوعي في العالم الرقمي العلامة التجارية وأهميتها في قرار الشراء - مكونات العلامة التجارية استراتيجية الترويج والتأثير الهائل للاعلانات
-
منذ بداية ظهور الشبكة العنكبوتية تغيرت حياتنا تغيرًا جذريًا سواء كنا مستهلكين أو مُنتجين اضطررنا لنقل جزء من حياتنا أو أعمالنا إلى هذه الشبكة وسرعان ما أصبحت الشبكة جزءًا رئيسيًا من حياتنا اليومية ومن أنشطتنا التجارية أيضًا، اقتصر الأمر في البداية على الحواسيب ولم تحدث القفزة الكبيرة التي عززت اندماج الإنترنت في عصرنا الحالي إلا عندما تطورت صناعة أجهزة الهواتف المحمولة وانتشرت بأيدي جميع المستهلكين فمنذ أن أعلن ستيف جوبز عن تحفته في عام 2007 وهو جهاز الآيفون ثم انتقلت صناعة الهواتف المحمولة من مجرد جهاز مخصص للاتصالات والتواصل إلى حاسوب شخصي مصغّر قادر على أداء العديد من المهام والوظائف ولكن الأهم من ذلك عرض الإعلانات! عندما أثبت ستيف جوبز بأنه يمكننا تطوير جهاز حاسوب بحجم كف اليد لم تتغير صناعة الأجهزة الذكية فحسب بل نشأ سوق جديد وهو سوق الأجهزة القابلة للارتداء ليظهر لدينا العديد من الأجهزة الذكية مثل النظارات والساعات والألبسة وأجهزة مراقبة الصحة والكثير من الأجهزة الأخرى كما تطورت الأجهزة الموجودة في الأسواق مثل الشاشات الذكية وأدوات المنزل الذكي. احتوت جميع الأجهزة الذكية على نظام تشغيل يخزن البيانات ويعالجها ويتتبع بيانات المستخدمين ويعرض بعضها إعلانات تناسب اهتماماتهم. ومع وجود هذا الكم الكبير من الأجهزة الذكية والمواقع والشبكات الاجتماعية أدى ذلك إلى توليد بيانات كبيرة جدًا لأنه في الحقيقة كل حركة حرفيًا يمكن أن تُسجل وتحفظ في قاعدة البيانات فمثلًا سواء كنت جالسًا أما تلفازك الذكي وتقلب القنوات أو ذاهبًا للركض وبيدك ساعة ذكية تراقب حركتك أو حتى عالقًا في سيارتك في وسط زحمة المرور خانقة ومشغلًا ميزة التتبع الجغرافي GPS، فإنك في كل نشاط تقريبًا تولّد بيانات يمكن استثمارها والاستفادة منها. هذه الوفرة من البيانات غيرت طبيعة المنافسة لطالما استفاد عمالقة التكنولوجيا من تأثير الشبكة فمثلًا كلما زاد عدد مستخدمي شبكة فيسبوك، زادت جاذبية الاشتراك بهذه شبكة. الأمر الذي يساعد على جمع المزيد من البيانات، وبالتالي سيكون لدى الشركة مجال أكبر لتحسين منتجاتها، والذي بدورها تجذب المزيد من المستخدمين وتضاف المزيد من البيانات وهكذا دواليك. على سبيل المثال، تجمع شركة تسلا البيانات من سياراتها الذاتية مثل معلومات حول السرعة وسجل الشحن والصيانة ومعلومات متنوعة عن أداء النظام الكهربائي للسيارة والكثير من المعلومات الأخرى الدقيقة بالإضافة إلى جمع البيانات الخاصة بنظام القيادة الآلي ولكن مشاركة هذه البيانات اختياري وليس اجباري كما صرحت الشركة، ومن خلال هذه البيانات استطاعت الشركة تطوير ميزات تنافسية مثل تحسين نظام القيادة الذاتية وإمكانية توفير أكثر من 30% من كلفة التأمين على السيارة (في حال مشاركة معلومات القيادة) وفهم أفضل لأنماط القيادة التي يتبعها المستهلكين لذلك من السهل فهم كيف استطاعت شركة تسلا أن تصل بقيمتها السوقية إلى نصف قيمة شركة جنرال موتورز وذلك في عام 2013 بالرغم من أن تسلا لم تبع سوى 25 ألف سيارة خلال 10 سنوات بالمقابل باعت شركة جنرال موتورز 450 مليون سيارة على مدى 105 سنة من تاريخ الشركة، بالطبع لا يعود الأمر كله للبيانات ولكن لعبت البيانات جزءًا كبيرًا في تقييم الشركة وهذا يدل على قوة البيانات الضخمة وكيف يمكن أن تساعد الشركات على رفع قيمتها وحفر خنادق حولها لتجنب وصول الشركات المنافسة إليها وإلى عملائها. ولكن أين تتجمع كل هذه البيانات؟ وهل تخزن جميعها وتستثمر؟ في الحقيقة تعد عملية تجميع البيانات وتنقيتها وفرزها واستخلاص المناسب منها من أصعب العمليات يمكنك تخيل الأمر على أن البيانات هي نفايات وموجودة في مكب نفايات عملاق، كيف يمكننا الاستفادة منها؟ في البداية نحتاج إلى تصميم مكب النفايات ليناسب النفايات الموجودة فيه وهذه هي عملية تصميم قواعد البيانات وبعد أن وضعنا النفايات في المكب سنحتاج إلى آلات لفرز هذه النفايات؟ وهنا يأتي دور عمليات تنقية البيانات وتنقيحها وحذف المكرر منها …إلخ، كلما اعتنينا بطريقة تصميم قواعد البيانات وطرق تنظيفها استفدنا أكثر من هذه البيانات وبالتأكيد كلما حسنا من أي خطوة في هذه السلسة مثل طريقة جمع البيانات من الأساس سهلت الخطوات التي تليها. سنستعرض في هذا المقال أهمية البيانات في عصرنا الحالي كمجال دراسي واستثمار لأصحاب الشركات على المدى الطويل وسنتعرف على خطوات تصميم قاعدة بيانات وما هي الوظائف المرتبطة بقواعد البيانات؛ وسنتبع التدرج الآتي في عرض عناصره: البيانات كمحرك رئيسي للتطوير ما هو تصميم قواعد البيانات؟ التخصصات المرتبطة بقواعد البيانات من أين أبدأ بتعلم تصميم قواعد البيانات؟ التخصص في قطاعات البيانات التوظيف وفرص العمل في تخصصات البيانات اقتصاد البيانات Data Economy البيانات كمحرك رئيسي للتطوير كلما زادت كمية البيانات التي تجمعها الشركات عن مستخدميها زادت قوة هذه الشركات وتحسنت طريقة فهمها لهم لأنه في الواقع أظهرت لنا البيانات السلوك الحقيقي للمستهلكين مثلًا في مجال التجارة الإلكترونية وبأن قرارات الشراء الخاصة بهم يمكن جدًا ألا تكون ناجمة عن تخطيط ودراسة وإنما تأثيرات خارجية لا علاقة لها بالمنتج أو الجودة أو السعر بطريقة مباشرة (لمزيد من المعلومات حول القرارات اللاعقلانية للمستهلكين ننصح بقراءة مقال مدخل إلى سلوك المستهلك). لا يتوقف الأمر عند ذلك فحسب بل إن خوارزميات الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence وتعلم الآلة Machine Learning تستخلص وتحلل وتستنج معلومات أكبر من حجم البيانات أحيانًا، ويمكن أن تتنبأ الخوارزميات بالوقت الذي يكون فيه العميل جاهزًا للشراء، أو عندما يحتاج محرك السيارة الذكية إلى الصيانة أو عندما يكون الشخص معرضًا لخطر الإصابة بمرض ما عندما تشير ساعته الذكية إلى اضطراب في دقات القلب، ولكن لنعود قليلًا للوراء لنرى الصورة الكبيرة للأمر ونفهم كيف حدث ذلك، وهنا لا بدّ لنا من طرح بعض الأسئلة: كيف صُممت قواعد البيانات لتتحمل هذه الكميات الكبيرة من البيانات؟ ما هي الطرق المستخدمة في التصميم؟ هل تصميم قاعدة بيانات لشركة سيارات مثلًا يختلف عن تصميم قاعدة بيانات لمحل تجاري؟ هل يجب تعهيد عملية تصميم قواعد البيانات للمختصين؟ ما هي الاستثمارات المرتبطة بقاعدة البيانات؟ كيف تؤثر قواعد البيانات بقرارات الشركات؟ من هم الموظفون الذين يمكن أن نوظفهم لتحقيق أكبر استثمار لقواعد البيانات الخاصة بنا؟ هل ستحقق قواعد البيانات العائد على الاستثمار الذي وضعناه بها؟ شكلت هذه الأسئلة وغيرها عقبة في وجه الشركات الناشئة ووضعتها في موقف صعب لأن تصميم قاعدة بيانات تعمّر في هذا الزمن المتسارع يتطلب جهدًا كبيرًا ودراسة مفصلة ولكن لحسن الحظ أن الدليل بين أيدينا ويمكن تطبيقه. هيا بنا لنتعرف على خطوات تصميم وبناء قاعدة بيانات بالتفصيل. ما هو تصميم قواعد البيانات؟ في أي نظام تراه أعيننا (سواء موقع أو متجر إلكتروني أو أي نظام إلكتروني) يوجد مرحلة أولية تشترك بها جميع الأنظمة وهي تصميم قواعد البيانات في هذه المرحلة نخطط لما ستكون عليه الجداول والأعمدة التي تحتويها وأنواع البيانات فيها والعلاقات بين الجداول والقيود المحددة لها وهكذا، ولذلك تحتل مرحلة تصميم قاعدة بيانات أهمية كبيرة في أي نظام ولا بدّ من إجراء تصميم متين ومناسب لكي نستطيع تطويره في المستقبل. تعد قواعد البيانات Database جزءًا من منظومة معلوماتية أكبر تدعى نظام المعلومات Information System والتي هي مجموعة متكاملة من المكونات لجمع البيانات وتخزينها ومعالجتها ولتوفير المعلومات والمعرفة والمنتجات الرقمية. تعتمد الشركات على أنظمة المعلومات لتنفيذ عملياتها وإدارتها، والتفاعل مع عملائها ومورديها، والمنافسة في الأسواق، وتتكون أنظمة المعلومات من الأجهزة والبرمجيات والبيانات والأشخاص والعمليات. تتكامل أنظمة المعلومات مع قواعد البيانات لتشكل لدينا نظامًا معلوماتيًا متكامل الوظائف، تتشابه دورة حياة تطوير الأنظمة Systems Development Life Cycle (ويشار إليه اختصارًا SDLC) مع دورة تطوير قواعد البيانات Database Life Cycle (ويشار إليها اختصارا DBLC)، وهي عملية مستمرة لإنشاء وتصميم قواعد البيانات ونمذجتها وتحسينها وتطويرها وصيانتها. في الحقيقة هنالك العديد من الأطر المقترحة لدورة تطوير قواعد البيانات لن نناقش الفروقات بينها وإنما سنشرحُ أعم إطار مقترح والذي تكون خطواته على الشكل التالي: تحليل متطلبات البيانات Data Requirements Analysis تصميم قاعدة البيانات Database Design 3.نمذجة قاعدة بيانات Database Modeling تنفيذ قاعدة البيانات Database Implementation اختبار قاعدة البيانات Database Testing التشغيل وإدارة قاعدة البيانات Database Operation صيانة قاعدة البيانات Database Maintenance 1. تحليل متطلبات البيانات Data Requirements Analysis تبدأ عملية تطوير قاعدة البيانات بتحليل عام لوظائف النظام الذي ستُبنى من أجله ومستخدمي هذا النظام، وطبيعة البيانات المطلوب تخزينها ومعالجتها، والتقارير المطلوب تسليمها في النظام أو المستندات الرسمية بين الأقسام الموجودة؛ لذلك من الضروري جمع الحقائق من خلال المقابلات والاستبيانات والملاحظات وفحص الوثائق المختلفة المعتمدة في الشركة أو أي نظام نحن بصدد تصميم قواعد بيانات له مثل النماذج والتقارير والمستندات الأخرى ذات الصلة، ويمكننا عندها تكوين نظرة أولية لما ستكون عليه قاعدة البيانات بصورة عامة. يجب تحديد الأهداف أو المشاكل التي نتوقع من النظام أو قاعدة البيانات حلها، ومن المرجح أن ينتج عن كل مشكلة قائمة مرتبطة بها من المشاكل. تتمثل مهمة المصمم في التأكد من أن أهداف نظام وقاعدة البيانات الخاصة به تتوافق مع تلك التي يتصورها صاحب الشركة والمستخدم (المستخدمون) النهائي، بالإضافة إلى ذلك يجب على المصمم الإجابة على الأسئلة التالية: هل سيشمل تصميم قاعدة البيانات الشركة بأكملها أو قسمًا واحدًا فقط؟ هل سيخدم النظام وظيفة واحدة لكل قسم أم كل الوظائف؟ هل ستتوسع قاعدة البيانات (أو النظام) ليضيف كل أقسام الشركة؟ هل سيتفاعل النظام مع أنظمة أخرى حالية أو مستقبلية في الشركة؟ هل سيشارك النظام البيانات مع أنظمة أو مستخدمين آخرين؟ ما هو المدة الزمنية المقدرة للتسليم؟ ما هي الميزانية المتاحة؟ تساعد الإجابة على هذه الأسئلة في معرفة النطاق والحدود الخاصة بالمشروع إذ يحدد نطاق النظام مدى حجم التصميم المطلوب لكي يعرف المصمم حجم البيانات التقديري. تساعد معرفة النطاق في تحديد هياكل البيانات المطلوبة ونوع الكيانات وعددها والحجم المادي لقاعدة البيانات وما إلى ذلك. يخضع النظام المقترح أيضًا لحدود تُعرف بالحدود الخارجية للنظام، مثل الوقت المتاح للتصميم والميزانية المتاحة. تؤثر النقاط السابقة في كيفية تصميم النظام وقاعدة البيانات المطلوبة وتتمثل مهمة المصمم في تحديد الخيارات الأفضل للنظام ضمن هذه القيود. 2. تصميم قاعدة البيانات Database Design هنالك عدة طرق لتصميم قواعد البيانات كل طريقة لها محاسنها ومساوئها يجب على المحلل النظام ومسؤول قواعد البيانات التحدث والعمل مع المستخدمين لتحديد ما هو مهم للمستخدمين ونتيجة لذلك تحديد البيانات التي يجب تخزينها في قاعدة البيانات. ما يفعله المحلل عادة هو إنشاء بعض النماذج الأولية من التقارير والواجهات الخاصة بالمستخدمين والنماذج لمساعدة المستخدمين على تصور الشكل الذي سيبدو عليه النظام وكيف سيعمل النظام، ومن أبرز طرق تصميم قواعد البيانات نذكر: تصميم قواعد البيانات من الأعلى إلى الأسفل Top-down Design تصميم قواعد البيانات من الأسفل إلى الأعلى Bottom-up design تصميم قواعد البيانات من أعلى إلى أسفل Top-down Design ويسمى أيضًا بنموذج التصميم التنازلي وتبدأ هذه الطريقة في التصميم من الأعم إلى الأخص. أي تبدأ بفكرة عامة عما هو مطلوب للنظام ثم تسأل المستخدمين النهائيين عن البيانات التي يحتاجون إلى تخزينها. سيعمل المحلل بعد ذلك مع المستخدمين لتحديد البيانات التي يجب الاحتفاظ بها في قاعدة البيانات، ويتطلب استخدام هذا الأسلوب أن يكون لدى المحلل فهمًا مفصلًا للنظام؛ لأنه في بعض الحالات يمكن أن يؤدي التصميم من أعلى إلى أسفل إلى نتائج غير مرضية لأن المحلل والمستخدمين النهائيين يمكن أن يفوتوا معلومات مهمةً وضرورية للنظام. تصميم قواعد البيانات من الأسفل إلى الأعلى Bottom-up Design ويسمى أيضًا بنموذج التصميم التصاعدي ويبدأ هذا النهج بالتفاصيل الدقيقة والمحددة للمشروع ويحاول أن يعمم الفكرة. يفحص محلل النظام في البداية جميع واجهات المستخدمين المطلوبة تنفيذها في النظام، بالإضافة إلى التقارير والمعلومات المطلوب عرضها وتخزينها ومعالجتها. سيعمل المحلل بطريقة عكسية من خلال التركيز على التفاصيل الدقيقة والانتقال تباعًا للتفاصيل الأكبر منها. لفهم الاختلافات بين هذين الأسلوبين لنأخذ بعض الأمثلة عنهما. فمثلًا في أنظمة التحليل الإحصائي يعكف المحللين على أخذ عينة بيانات صغيرة من المجتمع ومن ثم تعميم الفكرة على إجمالي عدد السكان المتبقي. كما يستخدم الأطباء أيضًا النهج التصاعدي إذ يفحصون أعراضًا معينة للمرض ثم يحددون المرض العام الذي تسببه هذه الأعراض، وبالمقابل من الأمثلة التي تتطلب نهجًا تنازليًا هي مهام إدارة المشاريع والمهام الهندسية عمومًا إذ يجب في البداية تحديد المتطلبات العامة قبل فهم التفاصيل الدقيقة فيجب على الشركات الهندسية المصنعة للسيارات اتباع نهج التنازلي لتحقيق المواصفات المطلوبة للسيارة. فمثلًا إذا كان المطلوب أن تبلغ تكلفة السيارة أقل من 17000 دولار أمريكي، وأن تقطع 29 ميلًا للغالون الواحد من البنزين، وتتسع لسبعة أشخاص، فهذه المتطلبات العامة يجب الاعتماد عليها أولًا لتلبية التصميم المتوافق معها والانتقال إلى التفاصيل الدقيقة لتصميم السيارة. يُنظر عادة للنهجان على أنهما متكاملان إذ كلاهما يوصف التفاعلات التي تحدث في النظام ولكن واحدة ستكون من المنظور الأعلى والأخرى من الأسفل وللمزيد من المعلومات حول كيفية تصميم قواعد البيانات ننصح بقراءة مقال أمثلة عملية عن كيفية تصميم قواعد البيانات. 3. نمذجة قاعدة بيانات Database Modeling هي عملية إنشاء نموذج بيانات للبيانات المراد تخزينها في قاعدة بيانات وتعد النماذج تمثيلًا مبسطًا لكائنات البيانات، والارتباطات والقواعد المختلفة الموجودة بينها، تعد نماذج البيانات تمثيلًا بسيطًا لوصف تراكيب البيانات المعقدة في الحياة العملية على شكل رسومات وأشكال دون التركيز على الجانب التقني وهي وسيلة لتوضيح الأفكار بين المصمم والمبرمج والمدير وجميع أعضاء الفريق. تساعد نماذج البيانات في تحديد الجداول العلائقية والمفاتيح الأولية والخارجية المطلوبة، كما توفر صورة واضحة للبيانات الأساسية ويمكن لمطوري قواعد البيانات استخدامها لإنشاء قاعدة بيانات فعلية، بالإضافة إلى ذلك تفيد نمذجة البيانات في تحديد البيانات المفقودة والمكررة مما يساعدنا على تقليل عمليات توحيد البيانات Normalization، ويساعد أيضًا على تطوير قاعدة البيانات وصيانتها وإصلاحها وسد الثغرات الموجودة فيها؛ لذلك يعد العمل على النماذج استثمارًا طويل الأمد بالنسبة للجهد والمال، ومن أشهر النماذج المستخدمة في تصميم قواعد البيانات والأنظمة نذكر: لغة النمذجة الموحدة Unified Modeling Language نموذج الكيان والعلاقة Entity-relationship Model لغة النمذجة الموحدة Unified Modeling Language ويشار لها اختصارًا UML، وهي لغة نمذجة رسومية تقدم صيغة لوصف العناصر الرئيسية للنظم البرمجية. تستخدم هذه اللغة لعمل رسوم تخطيطية لوصف برامج الحاسوب والأنظمة عمومًا وذلك من خلال توصيف العناصر المكونة لها أو خط سير العمليات الذي ينفذه البرنامج. تساعد هذه اللغة على إنشاء النماذج وتصميم نموذج متكامل لأي مشروع برمجي. يوجد نوعان رئيسيان من مخططات UML وهما: المخططات الهيكلية Structural Diagrams، والذي يحتوي بدوره على المخططات التالية: مخطط الأصناف Class Diagram. مخطط الحزمة Package Diagram. مخطط الكائنات Object Diagram. مخطط المكونات Component Diagram. مخطط الهيكل المركب Composite Structure Diagram. مخطط النشر Deployment Diagram. المخططات السلوكية Behavioral Diagrams، والذي يحتوي بدوره على المخططات التالية: مخطط النشاط Activity Diagram. مخطط التسلسل Sequence Diagram. مخطط حالات الاستخدام Use Case Diagram. مخطط الحالة State Diagram. مخطط الاتصال Communication Diagram. المخطط التفاعلي العام Interaction Overview Diagram. المخطط الزمني Timing Diagram. تهدف هذه المخططات المتنوعة على تمثيل أنواع عديدة من السيناريوهات والأنظمة وطرق التفاعل بين الكائنات. يمكن أن تكون بعض المخططات أقرب لمنهجية معينة من المخططات الأخرى مثل مخطط الكائنات أقرب للبرمجة كائنية التوجه إلا أنه عمومًا تهدف لغة النمذجة الموحدة إلى توصيف النظام بدون التطرق إلى طريقة تنفيذ البرمجيات. في المثال السابق لدينا نظام صراف آلي يحتوي على 7 أصناف Classes وهي: البنك Bank الزبون Customer جهاز الصراف الآلي ATM الحساب المجرد Account حساب التوفير (الإدخار) Saving Account حساب جاري Current Account إجراءات الصراف الآلي ATM Transactions نلاحظ أن هنالك علاقات تربط بين جميع الأصناف لكل تحدد كل علاقة طريقة تفاعل الأصناف مع بعضها بعضًا ويشير كل رمز إلى مصطلح أو مفهوم في البرمجة كائنية التوجه مما يساعد المطور على فهم النظام وتحويله إلى شيفرة برمجية مناسبة، وللمزيد من المعلومات عن هذا المخطط والرموز الموجودة به ننصحك بقراءة مقال مخططات الفئات (Class Diagram) في لغة النمذجة الموحدة UML. نموذج الكيان والعلاقة Entity-relationship Model وهو نموذج مجرد لوصف الأشياء المترابطة في مجال معين من المعرفة. يكثر استخدام هذا النموذج عند تمثيل قواعد البيانات وفي هندسة البرمجيات عند تمثيل متطلبات النظام الأولي، بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا النموذج على تفاصيل أقرب للمفاهيم المعلوماتية بالموازنة مع لغة التوصيف الموحدة، وعمومًا يتألف النموذج الكيان والعلاقة من المفاهيم الرئيسية التالية: الكيان Entity: وهي الجدول -أو الجداول- التي نحتاجها في قاعدة البيانات الخاصة بنا ويمكن أن تشير إلى جدول الطلاب، أو الدورات التعليمية، أو الكتب، أو الموظفين. السمات Attributes: وهي الحقائق أو الأوصاف الخاصة بالكيانات، وغالبًا ما تكون أسماء وتصبح أعمدة في الجدول. فمثلًا بالنسبة لكيان الطلاب يمكن أن تكون السمات هي الاسم الأول والاسم الأخير والبريد الإلكتروني والعنوان وأرقام الهواتف …إلخ. 3.العلاقات Relationship: وهي الارتباطات بين الكيانات وتوصف الأفعال العلاقات بين الكيانات. وهنالك خمسة أنواع من العلاقات وهي: علاقة واحد إلى واحد One to one Relationship أو 1:1 علاقة واحد إلى متعدد One to many Relationship أو 1:M علاقة متعدد إلى متعدد Many to many Relationship أو M:M علاقة أحادية Unary Relationship علاقة ثلاثية n-ary عند نمذجة نظام من خلال نموذج الكيان والعلاقة يكون لدينا ثلاثة مستويات من التجريد وهي: نموذج البيانات المفاهيمي Conceptual Data Model. نموذج البيانات المنطقي Logical Data Model. نموذج البيانات المادي Physical Data Model. في البداية يعمل المحللون والمصممون على بناء نموذج مفاهيمي للبيانات لقاعدة البيانات المطلوبة ومن ثم يحولون النموذج المفاهيمي إلى منطقي ومن ثم إلى مادي وسنستعرض الفروقات بين هذه النماذج لفهم المراحل النمذجة التي تمر بها قاعدة البيانات، وللاسزادة والاطلاع على نموذج الكيان والعلاقة ننصحك بالاطلاع على مقال نموذج الكيان والعلاقة ER لتمثيل البيانات وتخزينها في قاعدة البيانات الذي يتناول بالتفصيل ويوضح كيفية بناءه. سنشرح سريعًا النماذج الثلاثة الخاصة بنموذج الكيان والعلاقة. 1. نموذج البيانات المفاهيمي Conceptual Data Model تبدأ عملية النمذجة من خلال بناء نموذج بيانات مفاهيمي بعرض منظم لمفاهيم قواعد البيانات وعلاقاتها، ويهدف هذا النموذج إلى إنشاء الكيانات وخصائصها وعلاقاتها بصورة عامة لذلك لا نجد في هذا المستوى من النمذجة أي تفاصيل متاحة حول بنية قاعدة البيانات الفعلية. عادة ما يبني هذا النموذج أصحاب الشركات التجارية، ومن خصائص نموذج البيانات المفاهيمي نذكر: يشرح معلومات أساسية ورؤية عامة لقاعدة البيانات أو المشروع. صُمم هذا النوع للأشخاص غير التقنيين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات. طوّر هذا النموذج بطريقة مستقلة عن مواصفات الدقيقة لقاعدة البيانات. لن يشرح هذا النموذج أبدًا التفاصيل التقنية الدقيقة مثل سعة تخزين البيانات أو نوعية قواعد البيانات أو لغات البرمجة أو أنظمة إدارة قواعد البيانات Database Management Systems، وينصبُ تركيزه على تمثيل البيانات كما يراها المستخدم في العالم الحقيقي بدون الدخول للتفاصيل الدقيقة، ويمكن تنفيذها النموذج لاحقًا على أي نظام وقاعدة بيانات نريدها، ويكون النموذج الناتج مشابه للشكل التالي: 2. نموذج البيانات المنطقي Logical Data Model يستخدم نموذج البيانات المنطقية لتحديد هيكل عناصر البيانات وتعيين العلاقات فيما بينها، ويضيف نموذج البيانات المنطقي مزيدًا من المعلومات إلى عناصر نموذج البيانات المفاهيمية. يوفر هذا النموذج الأساس الأولي لتشكيل قاعدة البيانات للنموذج المادي. ومع ذلك، تظل بنية النمذجة عامة نسبيًا، ولن يتحدد في هذا المستوى من النمذجة المفاتيح الأساسية أو الثانوية بين الجداول، ومن خصائص نموذج البيانات المنطقية نذكر: يصف احتياجات البيانات لمشروع واحد ولكن يمكن أن يتكامل مع نماذج البيانات المنطقية الأخرى بناءً على نطاق المشروع. يصمم هذا النموذج ويطور بطريقة مستقلة عن نظام إدارة قواعد البيانات DBMS. يحتوي التصميم على سمات الكينونات الموجودة كأسماء بدون ذكر السعة أو النوع. تطبق عمليات التوحيد على النموذج لضبط عمليات تكرار البيانات. يحرص هذا النموذج على تجنب تكرار البيانات من خلال إجراء عملية التوحيد للوصول إلى النموذج الثالث 3NF على الأقل مع العلم أنه يوجد خمسة مراحل لعملية التوحيد، ويكون النموذج الناتج مشابه للشكل التالي: 3. نموذج البيانات المادي Physical Data Model نبني في هذه المرحلة الشكل النهائي للنموذج المقترح ويتطلب تصميم قاعدة البيانات المادية معرفة جميع التفاصيل الدقيقة ابتداءً من نظام إدارة قواعد البيانات DBMS وطريقة تنظيم السجلات وتنظيم الملفات واستخدام الفهارس …إلخ، يهدف هذا النموذج لتوفير تصميم قاعدة بيانات فعلي الذي يضمن أداءً مناسبًا، ومن خصائص نموذج البيانات المادية نذكر: يصف نموذج البيانات المادية الحاجة إلى البيانات لمشروع أو تطبيق واحد بالرغم من أنه يتكامل مع نماذج البيانات المادية الأخرى بناءً على نطاق المشروع. يحتوي نموذج البيانات على العلاقات بين الكيانات والتي ستصبح جداول. طوّر هذا النموذج لنسخة محددة من نظام إدارة قواعد البيانات أو طبقًا لتكنولوجيا محددة ما في المشروع. يجب أن تحتوي الأعمدة على أنواع بيانات دقيقة والقيم الافتراضية لبعض البيانات بحسب المطلوب. يحدد هذا النموذج المفاتيح الأساسية والثانوية والخارجية، والفهارس وملفات تعريف الوصول والتراخيص وما إلى ذلك. الهدف الرئيسي لتصميم نموذج المادي هو التأكد من أن كائنات البيانات التي يقدمها المصمم يمكن تمثيلها بدقة في نظام قاعدة البيانات المطلوب. ولمزيد من المعلومات حول طريقة نمذجة البيانات ننصح بقراءة مقال نمذجة البيانات وأنواعها في عملية تصميم قواعد البيانات. 4. تنفيذ قاعدة البيانات Database Implementation بعد اعتمادنا على التصميم المادي النهائي لقاعدة البيانات وتوضيح جميع أنواع البيانات المطلوبة في هذه المرحلة ننتقل إلى الخطوة التالية وهي تثبيت أنظمة إدارة قواعد البيانات المطلوبة على الخوادم ، وإنشاء قاعدة البيانات ونقل البيانات إليها، ويمكن أن تكون البيانات الأولية إما بيانات جديدة أو بيانات مستوردة من قاعدة بيانات قديمة، وعمومًا تتضمن هذه المرحلة النشاطات التالية: تثبيت نظام إدارة قواعد البيانات DBMS: مثل نظام MySQL أو MongoDB (تحدثنا في مقال مفصل عن الفرق بين MySQL و MongoDB ننصح بالاطلاع عليه) يمكن تثبيت النظام على خادم محلي أو استخدام خدمة قاعدة بيانات سحابية مثل Microsoft Azure SQL Database Service أو Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) أو Google Cloud SQL، يتيح هذا الجيل الجديد من الخدمات السحابية إنشاء قواعد بيانات يمكن إدارتها واختبارها وترقيتها بسهولة حسب الحاجة. ضبط الإعدادات: ضبط متغيرات الإعداد وفقًا للأجهزة والبرامج وظروف الاستخدام. إنشاء قاعدة البيانات والجداول: يمكن إنشاء قاعدة بيانات باستخدام لغة قاعدة البيانات القياسية، مثل لغة الاستعلام المهيكلة SQL الموجودة في نظام إدارة قواعد البيانات MySQL. بالإضافة إلى ذلك قدمت العديد من أنظمة إدارة قواعد البيانات DBMS ميزة الرسم التخطيطي لإنشاء قاعدة البيانات دون الحاجة إلى كتابة تعليمات يدوية، مثل أنظمة Microsoft SQL Server و Microsoft Access و Oracle وغيرها. أو يمكن استخدام حلول خارجية مثل الأداة Erwin وهي (Entity Relationship for Windows) و Embarcadero ER/Studio و SQL Power Architect وغيرها. تحميل البيانات إلى قاعدة البيانات الجديدة: يمكن أن نحتاج في بعض الأحيان إلى ترحيل البيانات أو نقلها من قواعد البيانات القديمة إلى الجديدة، وتتطلب هذه الخطوة دراسة وتخطيط دقيقين لتجنب خسارة البيانات. عندما تكون جميع البيانات من نفس النوعية مثل قاعدة البيانات العلائقية فيمكن أن تكون عملية نقل البيانات سريعة وفي حال كانت الأنواع مختلفة عندها سنحتاج إلى عملية تحويل البيانات قبل إدخالها إلى قاعدة البيانات الجديدة. تطبيق السياسات الأمنية على قاعدة البيانات: تجهيز وإعداد المستخدمين لبدء العمل وشرح المفاهيم الأمنية والخطوات اللازمة لتطبيقها (مثل الحرص على تسجيل الخروج من نظام قاعدة البيانات عند الانتهاء من العمل) بالإضافة إلى منح المستخدمين المختلفين الذين حددتهم حق الوصول المناسبة بناء على متطلباتهم. تنفيذ نظام النسخ الاحتياطي: يفضل أن يكون النسخة الاحتياطية في مخدم آخر وتجنب وضعها على نفس المخدم لأنه في حال حدوث إختراق فعندها سنخسر جميع البيانات. تهيئ هذه المرحلة قاعدة البيانات لعملية الاختبار النهائي قبل النشر. 5. اختبار قاعدة البيانات Database Testing اختبار قاعدة البيانات هو نوع من اختبار البرامج الذي يتحقق من المخطط والجداول والقوادح Triggers وسلامة البيانات واتساقها وجميع الأمور المتعلقة بها علمًا بأن القوادح هي إجراءات تُنفَّذ في الخلفية آليًا بعد كل عملية إضافة أو تعديل أو حذف على جدول ما، ويمكن أن يتضمن الاختبار إنشاء استعلامات معقدة لقياس كيفية استجابة قاعدة البيانات وقدرتها على معالجة الاستعلامات والتحقق من صحة استجابتها. يعد اختبار قاعدة البيانات مهمًا لأنه يضمن صحة قيم البيانات والمعلومات المخزنة فيها، ويساعد على تجنب فقدان البيانات وعدم الوصول غير المصرح به إلى المعلومات. يجب أن يكون لدى المختبرين معرفة جيدة بلغة الاستعلام SQL، ويمكن أن تتضمن أنشطة الاختبار ما يلي: اختبار صحة مخطط قاعدة البيانات. صحة تخزين البيانات في جداول قاعدة البيانات. أنواع الأعمدة وسعتها. المفاتيح الأساسية والثانوية والفهارس. صحة طريقة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقوادح. التحقق من تكرار البيانات. كما يمكن إجراء اختبار الحمل Load Testing واختبار الإجهاد Stress Testing واختبار الأمان Security Testing واختبار سهولة الاستخدام Usability Testing واختبار التوافق Compatibility Testing وما إلى ذلك، إذ يساعد اختباري الحمل والإجهاد (يُعرف اختبار إجهاد البيانات أيضًا باسم اختبار التعذيب Torturous Testing أو اختبار التعب Fatigue Testing) على معرفة أداء قاعدة البيانات فمثلًا عندما يكون هنالك ضغطًا كبيرًا على قاعدة البيانات عندها يجب أن تتحمل قاعدة البيانات الكثير من الطلبات ويحب علينا أن نعرف فيما إذا كان هنالك نقطة ما ستنهار قاعدة البيانات عندها، إذ يساعد تحديد نقطة انهيار نظام قاعدة البيانات على معرفة محدودية النظام وإمكانياته وبالتالي جدولة التحديث اللازم له في المستقبل. كما يجب تكثيف الجهود لتجنب الإفراط في استخدام الموارد الموجودة في قاعدة البيانات. 6. التشغيل وإدارة قاعدة البيانات Database Operation تحدث مرحلة التشغيل عند اكتمال الاختبار والاستعداد النهائي لنشر قاعدة البيانات للاستخدام اليومي. يبدأ مستخدمو النظام في تشغيل النظام وتحميل البيانات وقراءة التقارير وما إلى ذلك، ومن الطبيعي جدًا أن تظهر المشاكل في هذه المرحلة، إذ يحتاج المسؤولون في هذه المرحلة إلى الإسراع في صيانة قاعدة البيانات، يذكر أن هناك العديد من الاستراتيجيات لنشر قاعدة البيانات وغالبًا ما يستخدم نهج النشر المحدود والذي يخفض عدد المستخدمين نسبيًا ولتكون عملية إصلاح الأخطاء سهلة نسبيًا، وبالرغم من كثرة عمليات الاختبار إلى أن المستخدمين غالبًا ما يجدون أخطاء لا تخطر على البال أثناء التطوير كما أن بعض الشركات أيضًا تنشر تطبيقًا تجريبيًا لكي يتجهز المستخدم لمواجهة الأخطاء بدون التأثير على علاقته بالعلامة التجارية هذا الأمر يساعد على حفاظ الشركة على سمعتها ومكانتها في الأسواق، وفي حال استقرار النظام وقاعدة البيانات ينشر التطبيق إلى بقية المستخدمين. ويمكن أن تتضمن هذه المرحلة ما يلي: مراقبة عملية تطبيق السياسات الأمنية على قاعدة البيانات والاطلاع على فهم الموظفين لحجم الخطورة الخاصة بالبيانات. مراقبة تنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي والتحقق من صحة عملية النسخ الاحتياطي دوريًا. إحصائيات الوصول إلى قاعدة البيانات لتحسين الكفاءة وسهولة استخدام عمليات تدقيق النظام ومراقبة أداء النظام. تلخيص استخدام النظام الشهري أو ربع السنوي أو السنوي لأغراض إعداد الفواتير الداخلية أو الميزانية. في حال ظهور خطأ ما في قاعدة البيانات ننتقل عندها إلى عملية الصيانة. 7. صيانة قاعدة البيانات Database Maintenance تعد صيانة قاعدة البيانات جزءًا أساسيًا من عمليات تطوير قاعدة البيانات ولها أثر كبير على ديمومة النظام ككل لأن الصيانة الأولية لقاعدة البيانات تقينا من شر إعادة بناء القاعدة من جديد، تتضمن أنشطة الصيانة العديد من المهام المتنوعة، بالإضافة إلى ذلك عند تشغيل قاعدة البيانات وبدء الاعتماد عليها يراقب المسؤول عنها الأداء والسرعة والمشاكل التي يمكن أن تظهر في البداية لمعرفة فيما إذا حققت المعايير المطلوبة الجودة والسلامة. يجري مسؤولو قاعدة البيانات عمليات صيانة روتينية وتتضمن بعض أنشطة الصيانة الدورية المطلوبة ما يلي: الصيانة الوقائية (مثل عمليات النسخ الاحتياطي وتغيير كلمات المرور دوريًا). الصيانة التصحيحية (مثل تصحيح الأخطاء المكتشفة عند التشغيل وصيانة أنواع البيانات والفهارس). الصيانة التكيفية (مثل العمل على تحسين الأداء وإضافة الكيانات والسمات وما إلى ذلك). تخصيص أذونات الوصول وصيانتها للمستخدمين الجدد والقدامى (مثل إضافة صلاحيات مخصصة ودقيقة للمستخدمين وإزالة الصلاحيات العامة). عمليات تدقيق أمنية دورية بناءً على الإحصائيات التي ينشئها النظام. يمكن تكون هناك حاجة إلى تعديلات أخرى لقواعد البيانات مع تغير احتياجات الشركة والمستخدمين، وبالتالي ستستمر دورة الحياة بالمراقبة وإعادة التصميم والتحسين. والآن يمكن أن إلى هنا نكون فهمنا بالفعل معظم أساسيات تطوير وتصميم قواعد البيانات التي سنحتاج إليها، ولكن ماذا عن أسواق العمل وما الذي يمكن أن يضيفه طلاب التخصصات المرتبطة بقواعد البيانات إلى الشركات القديمة أو الناشئة؟ في الحقيقة هنالك الكثير من التخصصات المرتبطة بقواعد البيانات وكل تخصص يضيف قيمة مختلفة إلى الشركة، وعندما يدرس الطلاب عادة تخصص علوم الحاسوب أو التخصصات التقنية في الجامعة عمومًا لا يتخصص الطالب في مجال معين وإنما تكون التخصصات اختيارية سواء مع أو بعد دراسة علوم الحاسوب، يختار الطالب تخصصًا واحدًا أو اثنين على الأكثر، ثم يدرسونه دراسة معمقة، لذلك سننتقل تاليًا إلى شرح التخصصات المرتبطة بقواعد البيانات التي يمكن لمهندس الحاسوب أو دارس تخصص علم الحاسوب أو أي مجال قريب إليها أن يعمل ويتخصص فيها. كما ستوضح الفقرات التالية أهمية هذه التخصصات لأصحاب شركات المستقبل. التخصصات المرتبطة بقواعد البيانات لا تكاد توجد شركة في وقتنا الحالي إلا ولديها موظف على الأقل من التخصصات المرتبطة بقواعد البيانات ولا نقصد بذلك الشركات التقنية فقط وإنما جميع الشركات التجارية وهذه فرصة للطلاب لكي يتعلموا الوظائف المتاحة لهم من خلال تأسيس أنفسهم بها لإكمال دراستهم لهذه المجالات سواء كان مع دراستهم الجامعية أو حتى بعد التخرج. يتزايد اهتمام أصحاب الشركات بتوظيف الأشخاص الذين يساعدون الشركة في بناء وتصميم قاعدة بيانات قوية لأنهم يرون تزايد أهمية تقنيات الذكاء الصنعي وتعلم الآلة في تطوير الشركات وهذه التقنيات تعتمد بالدرجة الأولى على قواعد البيانات وطريقة جمع بيانات العملاء والمستخدمين. تتنوع تخصصات قواعد البيانات ابتدءًا من مدير قواعد البيانات مرورًا بمحلل أمن المعلومات وانتهاء بمهندس البيانات الضخمة وكل تخصص من هذه التخصصات لديه واجباته ومهامه المتنوعة يمكن أن يتخصص الدراس لتصميم قواعد البيانات في إحدى هذه التخصصات ويعمل بها بعد التخرج، ومن أهم تخصصات قواعد البيانات الوظيفية نذكر: مدير قواعد البيانات Database Administrator مُنمذج البيانات Data Modeler مطورو ومهندسو البرمجيات Software Developer and Engineer محلل أمن المعلومات Information Security Analyst محلل البيانات Data Analyst عالم البيانات Data Scientist مهندس البيانات الضخمة Big Data Engineer 1. مدير قواعد البيانات Database Administrator يركز مدير قواعد البيانات على إدارة وصيانة كل قواعد بيانات الخاصة بالشركة. يحتاج المرشحون لدور إدارة قاعدة البيانات إلى أسس تقنية قوية لفهم بنية وتكوين قاعدة البيانات وطريقة صيانتها، ويبحث غالبية أصحاب العمل عن أفراد لديهم معرفة وخبرة في لغات وتطبيقات قواعد البيانات العلائقية الرئيسية مثل Microsoft SQL Server وأوراكل Oracle و IBM DB2، ومن المهام مسؤول قاعدة البيانات نذكر: إدارة ومراقبة وصيانة قواعد بيانات الشركة. إجراء التغييرات والتحديثات والتعديلات المطلوبة للبيانات ولهيكل قاعدة البيانات أيضًا. ضمان أمان قاعدة البيانات وتكاملها واستقرارها وتوفرها عند الطلب. الحفاظ على البنية التحتية للنسخ الاحتياطي والاستعادة لقاعدة البيانات. يتشابه عمل مدير قواعد البيانات مع مطور قواعد البيانات Database Developer وغالبًا ما يؤدي المهمتين شخص واحد وتكون مهام مطور قواعد البيانات على الشكل التالي: تصميم قواعد بيانات مستقرة وموثوقة وفعالة. تحسين وصيانة الأنظمة القديمة. تعديل قواعد البيانات حسب الطلبات وإجراء الاختبارات. حل مشكلات استخدام قاعدة البيانات والأعطال. الاتصال بالمطورين لتحسين التطبيقات وإنشاء أفضل الممارسات. جمع متطلبات المستخدم وتحديد الميزات الجديدة. تطوير كتيبات فنية وتدريبية. توفير دعم إدارة البيانات للمستخدمين. التأكد من أن جميع برامج قواعد البيانات تلبي متطلبات الشركة والأداء. البحث واقتراح منتجات وخدمات وبروتوكولات قواعد البيانات الجديدة. تتشابه وظيفة مديرو قواعد البيانات مع مطوروها إلا أن المدير يشرف عادةً على قواعد البيانات والمستخدمين أيضًا للتأكد من أن المنظومة آمنة ومنظمة وتعمل بكفاءة وسلاسة. ويطور مديرو قواعد البيانات الأنظمة وإجراءات السلامة وإجراءات الإدارة الجيدة للبيانات، ويحللون الأجهزة والبرمجيات لضمان أمن البيانات، والتأكد من أن سياسات الأمان تتوافق مع اللوائح القانونية للشركة أو الحكومات الموجودة بها هذه الشركة. بالإضافة إلى ذلك يدرب مديرو قواعد البيانات زملائهم الموظفين على كيفية استخدام قواعد البيانات والالتزام بإرشادات الأمان وتحديث الأنظمة حسب الحاجة. 2. منمذج البيانات Data Modeler مُنمذج البيانات هو الشخص المسؤول عن تصميم قواعد البيانات وتجهيزها لنشرها للاستخدام وتحديثها وإصلاحها ومراجعتها. عادةً ما يُحلل منمذجو البيانات هياكل أو أنظمة البيانات الموجودة مسبقًا والتعامل مع مشكلات تكرار البيانات وحركة البيانات داخل النظام بصورة عامة، ويسعون لتسهيل عملية استرداد البيانات ضمن نماذج بيانات خاصة بهم، ويتعاونون مع بقية الفريق لإنشاء نماذج وقواعد بيانات لتبقى فترات طويلة ونماذج البيانات المفاهيمية والمنطقية والمادية لجميع أقسام الشركة وذلك لسهولة التحديثات والتطوير في المستقبل. ويعمل منمذج البيانات مع مهندسي ومحللي البيانات لتنفيذ حلول نمذجة البيانات من أجل تبسيط ودعم إدارة معلومات الشركة، ولضمان نجاحك كمنمذج للبيانات يجب أن يكون لديك معرفة عميقة بطريقة تخزين البيانات في قواعد البيانات، فضلًا عن مهارات التواصل لجمع المعلومات من الموظفين، وعمومًا من مسؤوليات منمذج البيانات نذكر: تحليل وترجمة احتياجات العمل إلى نماذج قواعد بيانات لبناء حلول طويلة الأمد. تقييم أنظمة البيانات الموجودة. العمل مع فريق التطوير لإنشاء نماذج بيانات وطريقة تدفق البيانات. تطوير أفضل الممارسات لترميز البيانات لضمان الاتساق داخل النظام. مراجعة تعديلات الأنظمة الموجودة للتوافق المتبادل بين قواعد بيانات الشركة. تنفيذ استراتيجيات البيانات وتطوير نماذج البيانات المادية. تحديث النماذج المحلية والبيانات الوصفية وتحسينها. تقييم أنظمة البيانات المنفذة للفروق والتناقضات والكفاءة. استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسين أنظمة البيانات. 3. مهندسو ومطورو البرمجيات Software Developer and Engineer وهم الأشخاص المتخصصون في تطوير البرمجيات وتطبيقات الأعمال وأنظمة التحكم في الشبكة وأنظمة التشغيل للشركات والمؤسسات. يلتقي مهندسو البرمجيات المحترفون مع العملاء لتحديد احتياجاتهم من البرامج والأنظمة ويعملون على بناء النماذج التصميمية المناسبة للمشروع حسب الطلب سواء مخططات باستخدام لغة النمذجة الموحدة UML أو أي طريقة أخرى، كما يصمم مهندسو البرمجيات مخططات لنظام البرمجي وقاعدة البيانات وينتقلون من التصميم الأولي أو المفاهيمي إلى المنطقي ومن ثم المادي في إطار عملهم على إنتاج البرمجيات، كما يعمل مهندسو البرمجيات على صيانة برمجيات وأنظمة الشركات وإجراء إصلاحات أو تحديثات أو تغييرات أخرى حسب الحاجة، ويساعدوا موظفي الشركة على تعلم كيفية استخدام هذه الأنظمة أو يطرحوا دليل نظري لتعلمها. يتكامل عمل مهندسي البرمجيات مع مطوري البرمجيات فالأول يخطط لما ستكون عليه البرمجية والثاني ينفذها بالطريقة المناسبة ويتعاونان خلال هذه الرحلة لضمان سيرها وفقًا للمطلوب ومن مسؤوليات مهندسي مطوري البرمجيات نذكر: تعاون مع الفريق لتصميم الخوارزميات والمخططات الانسيابية. إنتاج شيفرة برمجية نظيفة وفعالة بناءً على المتطلبات. دمج مكونات مختلف برمجيات الشركة مع واجهات برمجة التطبيقات الخارجية. العمل على تصميم برمجيات تتكامل مع قواعد البيانات القديمة. تصميم وتطوير برمجيات قابلة لجمع بيانات المستخدمين وتخزينها بطريقة منظمة في قواعد البيانات. تطوير خطط التحقق من البرمجيات وإجراءات ضمان الجودة. استكشاف أخطاء البرامج الحالية وتصحيحها. جمع وتقييم ملاحظات المستخدم وتنفيذ تحسينات بناء عليها. 4. محلل أمن المعلومات Information Security Analyst وهو الشخص المسؤول عن حماية المعلومات من المتسللين والمخترقين والهجمات الإلكترونية عمومًا وتكون الحماية من خلال تحليل قواعد بيانات الشركة ومعرفة هيكلتها وصلاحيات المستخدمين وإذا كان هنالك أي خطأ أو مشكلة ما. يلعب المحلل الأمني دورًا حيويًا في الحفاظ على أمان المعلومات الحساسة للشركة الموجودة في قواعد البيانات، ويجب أن يمتلك محللو أمن المعلومات بعض المهارات الأساسية التي ستساعدهم على تنفيذ أعمالهم مثل تنفيذ أنشطة القرصنة الأخلاقية لكشف نقاط الضعف وتحديد التهديدات المحتملة حتى تتمكن الشركة من حماية نفسها من المخترقين. كما يجب على المحلل اختبار الاختراق وذلك باختبار الشبكات وأجهزة الحواسيب وتطبيقات الويب والأنظمة الأخرى لاكتشاف نقاط الضعف القابلة للاستغلال. كما يجب على المحلل الأمني منع التطفل من خلال مراقبة حركة مرور الشبكة لاكتشاف التهديدات المحتملة ثم الاستجابة لهذه التهديدات على الفور الأمر الذي يساعد على إدارة الآثار السلبية للهجوم أو الاختراق وتقليل التأثير وتغيير ضوابط الأمان للوقاية في المستقبل. كما يجري المحلل في بعض الأحيان عمليات التحاليل الجنائية الحاسوبية لاكتشاف المخترق من خلال تتبع آثار المخترق وجمع البيانات وتحليلها ليبلغ عنها في نهاية المطاف. ويجرب المحلل أيضًا عمليات الهندسة العكسية على البرمجيات؛ لذلك من الطبيعي أن تتطلب وظيفة محلل أمن المعلومات خبرة عالية، وعمومًا من أهم مسؤوليات محلل أمن المعلومات نذكر: مراقبة الوصول الأمني للموارد. إجراء تقييمات الأمان من خلال اختبار الثغرات الأمنية وتحليل المخاطر. إجراء عمليات التدقيق الأمني الداخلي والخارجي. تحليل الخروقات الأمنية لتحديد السبب الجذري للثغرات. التحديث المستمر لخطط الشركة للاستجابة للحوادث والتعافي من الكوارث. التحقق من أمان موردي برمجيات الجهات الخارجية والتعاون معهم لتلبية متطلبات الأمان. 5. محلل بيانات Data Analyst تعتمد هذه الوظيفة على جمع البيانات لتحديد الاتجاهات التي تساعد قادة الأعمال على اتخاذ قرارات استراتيجية. يركز الانضباط على إجراء التحليلات الإحصائية للمساعدة في الإجابة على الأسئلة وحل المشكلات. يستخدم محلل البيانات لغات الاستعلام مثل SQL لعمل استعلامات لقواعد البيانات العلائقية. كما ينظف محلل البيانات البيانات ويضعها في تنسيق قابل للاستخدام، أو التخلص من المعلومات غير ذات الصلة أو غير القابلة للاستخدام أو اكتشاف كيفية التعامل مع البيانات المفقودة. يعمل محلل البيانات عادةً كجزء من فريق متعدد التخصصات لتحديد أهداف المؤسسة ثم إدارة عملية التنقيب عن البيانات وتنظيفها وتحليلها، وتشمل مسؤوليات محلل البيانات الرئيسية ما يلي: الاستعلام عن البيانات باستخدام SQL أو Excel. تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام الأساليب الإحصائية وتقديم التقارير. إنشاء لوحات معلومات باستخدام برنامج ذكاء الأعمال. إجراء أنواع مختلفة من التحليلات بما في ذلك التحليلات الوصفية أو التشخيصية أو التنبؤية أو الوصفية. تطوير وتنفيذ قواعد البيانات وأنظمة جمع البيانات. الحصول على البيانات من المصادر الأولية والثانوية والحفاظ على أنظمة البيانات. تحديد وتحليل وتفسير الاتجاهات أو الأنماط في مجموعات البيانات المعقدة. العمل مع الإدارة لتحديد أولويات الأعمال واحتياجات المعلومات. تحديد وتعريف فرص تحسين العمليات الجديدة. يسعى محلل البيانات إلى فهم الأسئلة التي تحتاج الشركة الإجابة عليها ويحدد فيما إذا كانت البيانات تستطيع الإجابة على هذه الأسئلة. يجب أن يفهم المشكلات الفنية المرتبطة بجمع البيانات وتحليل البيانات وإعداد التقارير وأن يكون قادرًا على التعرف على اتجاهات السوق وأنماط البيانات. يعمل محلل البيانات في الغالب مع البيانات المنظمة Structured Data للشركة مثل البيانات المتوفرة في قواعد البيانات، وينشئ التقارير ولوحات معلومات وتصورات أخرى حول البيانات المرتبطة بالعملاء والعمليات التجارية ويقدم هذه الرؤى للإدارة العليا وقادة الأعمال لدعم صانعي القرار. ومن بعض الأمثلة على البيانات التي يعمل هي احصائيات المخزون وتكاليف النقل والإمداد وأبحاث السوق وهوامش الربح والتكاليف وأرقام المبيعات وما إلى ذلك يمكن استخدام هذه البيانات لمساعدة الشركة في تقدير حصتها في السوق وطبيعة الزبائن والمبيعات وتحسين تكاليف النقل وما شابه. 6. عالم البيانات Data Scientist من أكثر الاختصاصات المرغوبة في وقتنا الحالي ويُعرف عالم البيانات بأنَّه الشخص الذي يستخدم الحواسيب ومعداتها وأنظمة البرمجة والخوارزميات بهدف تحليل البيانات الأولية وتحويلها إلى مجموعة بيانات سهلة القراءة والفهم كما يساهم في حل المشاكل وتفسير الظواهر الفعلية من خلال الاستعانة بنظريات من علوم أخرى مثل الرياضيات ونظم المعلومات والإحصاء وعلوم الحاسوب. يعود تاريخ نشأة هذا التخصص إلى ما يزيد على ثلاثين عامًا تقريبًا، وأكثر ما يميز عالم البيانات هو قدرته الاكتشاف أثناء سباحته في البيانات. ويجب أن يكون قادرًا على توفير هيكل لكميات كبيرة من البيانات غير النموذجية وجعل التحليل ممكنًا. كما يجب أن يستطيع تحديد مصادر البيانات الثريّة ويضموها إلى مصادر البيانات الأخرى التي يحتمل أن تكون غير مكتملة. يختلط على البعض مهام محلل البيانات مع عالم البيانات وبالرغم من أهدافهما المشتركة إلا أنه عادةً ما يكون عالم البيانات أكثر انخراطًا في تصميم عمليات نمذجة البيانات، وإنشاء الخوارزميات والنماذج التنبؤية لذلك يمكن أن يمضي علماء البيانات وقتًا أطول في تصميم الأدوات وأنظمة التشغيل الآلية وأطر البيانات. بالإضافة إلى ذلك يكون عالم البيانات أكثر تركيزًا على تطوير أدوات وطرق جديدة لاستخراج المعلومات التي تتطلبها الشركة لحل المشكلات المعقدة. يتطلب كلا المسارين درجة البكالوريوس -على الأقل- في مجالات متعلقة بالرياضيات مثل الرياضيات أو علوم الحاسوب أو الإحصاء. يمكن أن يقضي محلل البيانات الكثير من الوقت في التحليل الروتيني، وتقديم التقارير بانتظام. بينما عالم البيانات بتصميم طريقة تخزين البيانات ومعالجتها وتحليلها. ببساطة يستنتج المحلل المعلومات المنطقية من البيانات الموجودة بينما يعمل عالم البيانات على طرق جديدة لالتقاط وتحليل البيانات وتسليم هذه الطرق للمحللين. يستخدم علماء البيانات عادةً لغات البرمجة مثل بايثون Python ولغة R، بينما يستخدم محلل البيانات لغة SQL أو برنامج Excel للاستعلام عن البيانات أو تنظيفها أو فهمها. كما تختلف التقنيات والأدوات التي يستخدمونها لنمذجة البيانات، ومن المهم ملاحظة أنه يمكن أن يستخدم بعض المحللين المحترفين لغات البرمجة أو يدخلون إلى مجال عالم البيانات أو مجال مهندس البيانات الضخمة. يُنشئ علماء البيانات المحترفون نماذج التعلم الإحصائي لتقنيات البحث الخاصة بهم، والبحث عن أحدث اتجاهات التكنولوجيا والبيانات في السوق، وتعلم وسائل جديدة لتحليل البيانات لسهولة المراجعة والتواصل والتعاون مع الأقسام الأخرى داخل شركاتهم لمساعدتهم في إيجاد الحلول، مراجعة البيانات الأخرى أو تعليمهم كيفية قراءة البيانات. لذلك اعتبرت مجلة هارفارد بزنس ريفيو أن وظيفة عالم البيانات هي الوظيفة الأكثر إثارة وجاذبية في القرن الحادي والعشرين. أصبح قسم البيانات جزءًا أساسيات للعديد من الشركات كما يتضمن هذا القسم الأنشطة الأساسية مثل بناء قواعد البيانات المستدامة وإدارتها واستثمارها …إلخ، لأن القيمة التي تقدمها البيانات تصلح لأن تكون استثمارًا طويل الأمد هذا الأمر أدى ذلك إلى زيادة الطلب على علماء البيانات المهرة في مختلف الصناعات والمهن، وعمومًا من مهام عالم البيانات نذكر: تحديد مصادر البيانات ذات الصلة باحتياجات العمل. جمع البيانات المهيكلة وغير المهيكلة والبحث عن البيانات المفقودة وتعزيز عملية جمع البيانات. تنظيم البيانات في تنسيقات سهلة للاستخدام. بناء النماذج التنبؤية وخوارزميات التعلم الآلي. معالجة البيانات وتنقيتها والتحقق منها لإيجاد الأخطاء والمشاكل وحذفها باستخدام لغات البرمجة (مثل Python أو R). تحليل البيانات عن الاتجاهات والأنماط وإيجاد إجابات لأسئلة محددة. إنشاء البنية التحتية للبيانات. تطوير وتنفيذ وصيانة قواعد البيانات. تقييم جودة البيانات وإزالة البيانات أو تنظيفها. توليد المعلومات والأفكار من مجموعات البيانات وتحديد الاتجاهات والأنماط. إعداد التقارير للفرق التنفيذية وفرق المشروع. إنشاء تصورات للبيانات. التحليل الإحصائي باستخدام خوارزميات التعلم الآلي مثل معالجة اللغة الطبيعية أو الانحدار اللوجستي أو kNN أو Random Forest أو تعزيز التدرج. يواجه المدراء تحديًا حقيقيًا في معرفة كيفية تحديد تلك موهبة عالم البيانات، وكيفية جذبها إلى الشركة وجعلها منتجة. وبالرغم من أننا ذكرنا المهام الرئيسية لعالم البيانات إلا أنه يوجد ضبابية في معرفة كيفية أداء عالم البيانات وكيف يمكنه إضافة أكبر قدر من القيمة بالموازنة مع الأدوار الوظيفية الأخرى القديمة مثل المبيعات، بالإضافة إلى ذلك لا يوجد الكثير من الجامعات التي تقدم هذه الاختصاص الدقيق الأمر الذي يجعل عملية العثور على الشخص المناسب أكثر صعوبة؛ في الحقيقة يمكن تفسير هذه الصعوبات في أنها السبب المنطقي لارتفاع راتب عالم البيانات! 7. مهندس البيانات الضخمة Big Data Engineer يعد وظيفة محلل أو مهندس البيانات الضخمة من أرقى الوظائف التي تتعلق بقواعد البيانات ولفهم كيف يمكن أن تصبح مهندس بيانات ضخمة، دعنا نفهم في البداية معنى "البيانات الضخمة" Big Data. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان توليد البيانات محدودًا ولكن مع ظهور العديد من منصات الشبكات الاجتماعية والشركات العملاقة مثل فيسبوك وأمازون زادت ازديادًا كبيرًا فوفقًا لموقع Statista من المتوقع أن يصل الحجم الإجمالي للبيانات العالمية إلى 97 زيتابايت (أي 1021 بايت) في عام 2022 وسيصل في عام 2025 إلى 181 زيتابايت. وهذا بالفعل قدر كبير من البيانات. تتطلب البيانات الضخمة نهجًا هندسيًا مختلفًا عن البيانات العادية (مثل البيانات المهيكلة في قواعد البيانات) لأنها عبارة عن أطنان من المعلومات المختلطة وغير المهيكلة التي تتراكم باستمرار وبسرعة عالية، ولهذا السبب لا تستطيع طرق نقل البيانات التقليدية إدارة تدفق البيانات الضخمة بكفاءة. تعزز البيانات الضخمة تطوير أدوات جديدة لنقل وتخزين وتحليل كميات هائلة من البيانات غير المهيكلة. تعمل الشركات البارزة في العديد من القطاعات بما في ذلك المبيعات والتسويق والبحث والرعاية الصحية على جمع البيانات الضخمة بنشاط. كما يواجهون نقصًا في الخبرة اللازمة لإدارتها. لذلك شهدنا نموًا كبيرًا في الفترة الماضية لوظائف هندسة البيانات الضخمة وهي في الحقيقة تتطلب مهارات ضخمة أيضًا! يعكف مهندس البيانات الضخمة على استخراج البيانات من مصادر مختلفة وتحويلها وتحميلها على مستودع مركزي يُعرف أيضًا باسم مستودع البيانات Data Warehouse، تُخزن البيانات في هذه المستودعات لتكون جاهزة للاستخدام من فريق البيانات سواء محللين أو علماء …إلخ. غالبًا ما تكون وظيفة مهندس البيانات الضخمة خلف الكواليس وهم فعليًا الأشخاص الذين يبنون الطرق والجسور، لأنهم يجهزون البنية التحتية للبيانات الضخمة. ومن بعض مسؤولياتهم نذكر: تصميم بنية منصة البيانات الضخمة. الحفاظ على خط أنابيب البيانات. تخصيص وإدارة أدوات التكامل وقواعد البيانات والمستودعات والأنظمة التحليلية. إدارة وتنظيم البيانات. إعداد أدوات الوصول إلى البيانات لعلماء البيانات. الاجتماع مع المديرين لتحديد احتياجات البيانات الضخمة للشركة. تحميل مجموعات البيانات المتباينة وإجراء خدمات المعالجة المسبقة باستخدام Hive أو Pig. إنهاء نطاق النظام وتقديم حلول البيانات الضخمة. إدارة الاتصالات بين النظام الداخلي وبائعي البيانات (مثل بائعي الاستبيانات أو المقابلات …إلخ). التعاون مع فرق البحث والتطوير الخاصة بالبرمجيات. بناء منصات سحابية لتطوير تطبيقات الشركة. تدريب الموظفين على إدارة موارد البيانات. يجب أن يكون مهندس البيانات الضخمة ماهرًا جدًا في العديد من المجالات ومن أبرز هذه المجالات نذكر: البرمجة Programming: تعد مهارة البرمجة بديهية في قطاعات التكنولوجيا لأن البرمجة هي الطريقة المثلى لفهم كيفية التعامل مع البيانات فجميع الأجهزة والأنظمة التي حولنا ما هي إلا برمجيات وخوارزميات مختلفة صنعت لتعمل بطريقة معيّنة. يحتاج مهندس البيانات الضخمة إلى خبرة عملية في أي لغة برمجة مشهورة مثل لغة جافا Java أو C++ أو بايثون Python. التعامل مع قواعد البيانات ولغات SQL: بعد البرمجة تأتي المعرفة العميقة بمفاهيم قواعد البيانات وأنظمة إدارة قواعد البيانات DBMS ولغة SQL. تعد مهارة التعامل مع قواعد البيانات أساسية ساعد هذا في فهم كيفية إدارة البيانات والحفاظ عليها في قاعدة بيانات. تحتاج إلى معرفة كيفية كتابة استعلامات SQL لأي نظام إدارة قواعد بيانات علائقية مثل MySQL و Oracle Database و Microsoft SQL Server. التعامل مع مستودعات البيانات وعمليات تكامل البيانات ETL: تتمثل إحدى المسؤوليات الأساسية لمهندس البيانات الضخمة في تنفيذ عمليات ETL وهي عمليات استخراج وتحويل وتحميل Extract-Transform-Load البيانات إلى مستودع البيانات. لهذا، ستحتاج إلى معرفة كيفية إنشاء مستودع بيانات وكذلك استخدامه. ستستخرجُ البيانات من مصادر مختلفة، وتحول إلى معلومات ذات مغزى، وتحمل إلى مخازن بيانات أخرى. بعض الأدوات المستخدمة لهذا الغرض هي Talend و IBM Datastage و Pentaho و Informatica. التعامل مع أنظمة التشغيل Operating Systems: المهارة الرابعة التي تحتاجها هي معرفة أنظمة التشغيل. أدوات التشغيل هي الأساس لتشغيل أدوات البيانات الضخمة. ومن ثم فإن الفهم القوي لأنظمة Unix و Linux و Windows و Solaris أمر إلزامي. التعامل مع أدوات وأطر المخصصة للبيانات الضخمة: يجب أن يكون لديك خبرة في التحليلات المستندة إلى Hadoop والتي تعد واحدةً من أكثر أدوات هندسة البيانات الضخمة استخدامًا، لذلك من المفهوم أنك بحاجة إلى خبرة في التقنيات القائمة على Apache Hadoop مثل HDFS و MapReduce و Apache Pig و Hive و Apache HBase. التعامل مع أطر العمل أطر معالجة في الزمن الفعلي Real-time: يجب أن يكتسب مهندس البيانات الضخمة طريقة العمل مع أطر المعالجة في الوقت الفعلي مثل Apache Spark والتي تتعامل مع كميات هائلة من البيانات في الزمن الحقيقي إذ يمكنها معالجة البيانات التي تأتي من البث المباشر من عدة مصادر مثل Twitter و Instagram و Facebook وما إلى ذلك. التنقيب عن البيانات والنمذجة Data Mining and Modeling: إن مهارة التنقيب عن البيانات ومناقشة البيانات وتقنيات نمذجتها هي أساسية في مجال هندسة البيانات الضخمة. تتضمن عمليات التنقيب عن البيانات والجدل في البيانات خطوات للمعالجة المسبقة وتنظيف البيانات باستخدام طرق مختلفة والعثور على الاتجاهات والأنماط غير المرئية في البيانات وجعلها جاهزة للتحليل. والآن بعد أن تعرفنا على أهم الاختصاصات المتعلقة بقواعد البيانات لنستكشف كيف يمكننا الدخول في هذا العالم الشيّق. من أين أبدأ بتعلم تصميم قواعد البيانات؟ غالبًا ما تتضمن التخصصات الجامعية مثل علوم الحاسب وهندسة البرمجيات أو ما يشابهها من التخصصات على مواد تتعلق بقواعد البيانات يتعلم الطالب من خلالها أساسيات تصميم قواعد البيانات، وفي حال ليس لديك اطلاع على هذه أساسيات سنستعرض في هذه الفقرة المواضيع اللازمة لكل مرحلة تعليمية كما سننصحُ ببعض المقالات أو الكتب أو المساقات الدراسية. المفاهيم الأساسية في قواعد البيانات في البداية لا بد من التعرف على أساسيات تصميم قواعد البيانات والتي سيكون المواضيع على الشكل التالي: مفاهيم أساسية في قواعد البيانات: أنظمة الملفات التقليدية وعيوبها. تعريف قاعدة البيانات خصائصها ومميزاتها. الفرق بين البيانات Data والمعلومات Information والمعرفة Knowledge. أنواع قواعد البيانات. أدوات قواعد البيانات لغات قواعد البيانات. أنواع أنظمة إدارة قواعد البيانات Database Management Systems. مفاهيم نظام قواعد البيانات والهندسة المعمارية دورة حياة نظام المعلومات Systems Development Life Cycle. تطوير دورة حياة نظام قاعدة البيانات Database Life Cycle. - مفهوم نمذجة تصميم قاعدة البيانات. النمذجة باستخدام لغة النمذجة الموحدة Unified Modeling Language. النمذجة باستخدام الكيان والعلاقة Entity-Relationship. النموذج الكيان والعلاقة المحسّن Enhanced Entity-Relationship. المفاهيم المتقدمة في نموذج الكيان والعلاقة المحسّن (التعميم والتخصيص والتصنيف والميراث). مفاهيم أساسية لتحسين التصميم: الاعتماديات الوظيفية Functional Dependency. قواعد الاستدلال Inference Rules. عمليات التوحيد Normalization (النموذج الأول 1NF والثاني 2NF ..إلخ). مفهوم الجبر العلائقي Relational Algebra نشأته وأهميته. عمليات الجبر العلائقي. بعض المصادر المناسبة العربية: كتاب تصميم قواعد البيانات. كتاب ملاحظات للعاملين بلغة SQL 1.0.0 كتاب الدليل العملي إلى قواعد بيانات PostgreSQL. توثيق لغة SQL. المفاهيم المتقدمة في قواعد البيانات بعد أن تعرفنا على المفاهيم الأساسية سننتقل لاستعراض المواضيع المتقدمة المتعلقة بتصميم قواعد البيانات: إدارة الإجراءات أو المعامَلَات Transaction Management والتحكم في التزامن Concurrency Control ماهية الإجراء وتعريفه وخصائصه وحالاته. إدارة الإجراءات من خلال لغة SQL وسجل الإجراءات وطرق استردادها. مفاهيم التحكم في التزامن (التحديثات المفقودة Lost Updates - البيانات غير المثبتة Uncommitted Data - عمليات الاسترجاع غير المتسقة Inconsistent Retrievals). المجدول The Scheduler. التحكم في التزامن بطرق القفل Concurrency Control with Locking Methods التحكم في التزامن مع خلال Time Stamping. التحكم في التزامن بأساليب متفائلة. مستويات ANSI لعزل الإجراءات. إدارة عملية استعادة قاعدة البيانات. ضبط أداء قاعدة البيانات وتحسين الاستعلام مفاهيم ضبط أداء قاعدة البيانات هيكلية أنظمة إدارة قواعد البيانات أوضاع تحسين استعلام قاعدة البيانات إحصائيات قاعدة البيانات معالجة الاستعلام (طريقة تحليل استعلام SQL وتنفيذه وجلبه). مشاكل الاستعلام (اختناقات معالجة الاستعلام - الفهارس وتحسين الاستعلام). خيارات المحسن (استخدام التلميحات للتأثير على اختيارات المحسن). ضبط أداء SQL (انتقائية المؤشر - التعبيرات الشرطية). صياغة الاستعلام ضبط أداء DBMS أنظمة إدارة قواعد البيانات الموزعة Distributed Database Management Systems: تطور نظم إدارة قواعد البيانات الموزعة. خصائص أنظمة إدارة قواعد البيانات الموزعة ومكونات ومزاياها وعيوبها. المعالجة الموزعة وقواعد البيانات الموزعة. مستويات البيانات وتوزيع العمليات. الأداء وشفافية قاعدة البيانات الموزعة (شفافية التوزيع - شفافية المعاملات - شفافية الفشل). الطلبات الموزعة والإجراءات الموزعة (التحكم في التزامن الموزع - بروتوكول الالتزام ثنائي الطور). تصميم قاعدة البيانات الموزعة. مفاهيم أساسية عند تصميم قاعدة البيانات الموزعة (تجزئة البيانات Data Allocation - تكرار البيانات Data Replication - تخصيص البيانات Data Fragmentation). إدارة وأمن قواعد البيانات Database Administration and Security: مفاهيم متقدمة في أمن قواعد البيانات (نُهج الأمن Security Policies - ترقيع ثغرات أمنية). عناصر أمن قواعد البيانات ودورها (الأشخاص People - محطات العمل والمخدمات Workstation and servers - أنظمة التشغيل Operating system - التطبيقات Applications - الشبكة Network - البيانات Data). الفرق بين الحماية الأمنية في الأنظمة المجانية والمدفوعة. أدوات إدارة قواعد البيانات. الفرق بين إدارة قواعد العادية والسحابية. أهمية قاموس البيانات Data Dictionary في نهج الإدارة. تطوير إستراتيجية إدارة البيانات. أحد المصادر الجيدة التي تفيدك باللغة الإنكليزية كتاب Database Systems: Design, Implementation, & Management الطبعة الثالثة عشر لصاحبيه Steven Morris و Carlos Coronel. التخصص في قطاعات البيانات سنستعرض في هذا القسم المفاهيم الأساسية المشتركة في التخصصات المرتبطة بالبيانات وهي على الشكل التالي: ذكاء الأعمال ومستودعات البيانات Business Intelligence and Data Warehouses: الحاجة إلى تحليل البيانات. مفاهيم أساسية في ذكاء الأعمال (هندستها ومزاياها وتطورها ومستقبلها). مفاهيم أساسية بيانات دعم القرار (البيانات التشغيلية - بيانات دعم القرار). الفرق بين قواعد البيانات Database ومستودعات البيانات Data Warehouse وبحيرة البيانات Data Lake ومتاجر البيانات Data Mart. متطلبات قاعدة بيانات دعم القرار. مخطط النجمة Star Schemas (حقائق Facts - الأبعاد Dimensions - السمات Attributes). معالجة وتحليل البيانات عبر الإنترنت Online Analytical Processing. تقنيات تحليل البيانات متعددة الأبعاد. الفرق بين (تحليل البيانات Data Analytics - التنقيب في البيانات Data Mining - التحليلات التنبؤية Predictive Analytics). البيانات المرئية Data Visualization (أهمتيها - علم تصور البيانات The Science of Data Visualization). البيانات الضخمة و NoSQL: مفاهيم أساسية حول البيانات الضخمة (الحجم Volume - السرعة Velocity - التنوع Variety). قواعد البيانات المخصصة للبيانات الكبيرة (مثل NoSQL). قواعد البيانات السحابية Cloud Database: مفاهيم أساسية في اتصال قواعد البيانات وتقنيات الويب. اتصال قاعدة البيانات (ODBC و DAO و RDO). خدمات الحوسبة السحابية (خصائصها وأنواعها والفروقات بينها). أنواع قواعد البيانات السحابية. كيفية الانتقال إلى السحابة. الفرق بين قواعد البيانات القابلة للإدارة Self-Managed وقواعد البيانات المُدارة آليًا Managed Databases. كيف تتغير مهام مدير قواعد البيانات في السحابة. أمان البيانات والتطبيقات في السحابة. نقل قواعد البيانات الخاصة بك إلى السحابة (التخطيط Planning - نقل البيانات Data Movement - التحسين Optimization). بعض المصادر باللغة العربية: كتاب مدخل إلى الذكاء الصنعي وتعلم الآلة. كتاب الحوسبة السحابية أساسيات ومبادئ وتطبيقات للدكتور خالد بن ناصر آل حيان. التوظيف وفرص العمل في تخصصات البيانات يعد برنامج البكالوريوس أو المرحلة الجامعية الأولى الوسيلة التقليدية والشائعة للدخول في مجال البيانات ويمكن أن يختار بعض الطلاب إكمال دراستهم الجامعية والحصول على درجة الماجستير في المعلوماتية وعلوم البيانات في سعيهم للدخول في هذا المجال إلى أن هذا الطريق ليس الوحيد لدخول مجال البيانات، ولكن ظهرت في الآونة الأخيرة دورات تدريبية مركزة وتسمى أيضًا معسكرات تدريبية BootCamps وهي عبارة عن منهج دراسي مكثف قصير الأمد يركز على المهارات المركزة والمستندة إلى السوق بدلًا من أخذ مقدمات في مختلف التخصصات كما يحدث في برامج البكالوريوس، وبالرغم من أن المعسكرات التدريبية في بدايتها كانت تحتاج للتواجد الفيزيائي للطلاب مع الاساتذة إلى أن المشهد اليوم اختلف وأصبحت بالإمكان إجراء المعسكرات عبر الإنترنت عن بعد. في دراسة أجراها موقع إنديد Indeed جاء فيها أن 72% من أرباب العمل الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون بأن خريجي معسكرات التدريب المستجدين مستعدين تمامًا ليكونوا ذوي أداء عالٍ مثل المرشحين الحاصلين على درجات علمية في علوم الحاسوب، كما يعتقد 12% من مدراء التوظيف بأن خريجي المعسكرات التدريبية أكثر استعدادًا من أقرانهم المدربين في الجامعات. علاوة على ذلك، يعتقد العديد من أصحاب العمل أن حضور المعسكر التدريبي يمنح المتعلمين ميزة تنافسية. ففي استطلاع أجراه موقع هكر رانك HackerRank عام 2020 على مدراء التوظيف جاء فيه أنه ما يقرب من ثلاثة أرباع مديري التوظيف الذين شملهم الاستطلاع قالوا بأن معسكرات التدريب يمكن أن تُعلم الطلاب تقنيات ولغات جديدة بسرعة، واستشهد 61% من المدراء الذين شملهم الاستطلاع بالخبرة العملية لطلاب المعسكرات التدريبية، وقال 52% بأن خريجي المعسكرات التدريبية متحمسون لتحمل مسؤوليات جديدة. يمكن للطلاب الراغبين في الدخول إلى مجال البيانات ولا يريدون هدر وقتهم في الجامعات أن يبدأوا بتعلم علوم الحاسب والتي يأخذ فيها الطالب نظرة شاملة، عملت أكاديمية حسوب على توفير دورة متكاملة عن أساسيات علوم الحاسوب هي دورة علوم الحاسوب وهي دورة شاملة مدتها أكثر من 53 ساعة تشرح هذه الدورة مختلف المفاهيم بدءًا من أبسط الأساسيات أساسيات الحاسوب وعلومه والتفكير المنطقي وما هي الخوارزميات وكيف تفيد في البرمجة وتشرح الدورة أيضًا: الخوارزميات وهياكل البيانات: والتي ستساعدنا على فهم الطريقة الصحيحة لتنظيم البيانات. البرمجة: التي ستساعدنا على كيفية التلاعب بالبيانات ومحتواها من خلال كتابة الشيفرات البرمجية بلغة بايثون Python لتعديل محتويات البيانات. تصميم وبناء قواعد البيانات: والتي تفيدنا في التأسيس إلى مجال البيانات مع شرح تفصيلي للغة SQL للتعامل معها ونظرة على قواعد بيانات NoSQL. تطوير الويب: والتي على فهم المفاهيم الأساسية التي تبنى فيها صفحات الويب. إدارة الخوادم: والتي ستساعدنا في فهم ماهية المعلومات التي يمكن أن نجمها بالإضافة إلى ذلك مفاهيم متقدمة مثل البرمجة الكائنية ومفاهيمها المختلفة الأساسية والمتقدمة عبر لغة بايثون كما ستتعلم أيضًا أنماط التصميم Design Patterns، كما أنها في تحديث وتوسعة مستمرة، ومن أبرز ميزاتها أن هناك من يتابع سَيْرَك ويجيبُ على أسئلتك على امتداد الدورة وليس فقط مجرد فيديوهات تسلسلة ولذلك فهي دورة يُبنى عليها. أضف إلى ذلك أنه يمكنك العمل كعامل مستقل على حسب الاختصاص الذي تجيده من اختصاصات البيانات؛ فلو كنت مدير أو مطور قواعد بيانات فيمكنك استعراض الفرص المتاحة عبر مواقع العمل الحر مثل مستقل، ففي العمل الحر لن يسألك أحد بتاتًا عن شهادتك الجامعية وكل ما سيسألونك عنه هو خبراتك ونماذج لأعمالك السابقة نفذتها لا أكثر. أما عن فرص العمل المتوفرة في الشركات فهي تختلف باختلاف البلدان والشركات التي تريد العمل فيها، ولكنها تنضوي جميعًا تحت قسم التخصصات الذي تحدثنا فيه بصورة موسعة عن تخصصات قواعد البيانات انظر مثلًا إلى موقع بعيد، ستجدُ فيه طلبات توظيف من شركات مختلفة حول العالم العربي، وستجد أن معظم الوظائف لا تشترط أي نوع من أنواع الشهادات، بل تشترط معرض أعمال وخبرة سابقة فقط. وتكون رواتب المتخصصين في البيانات متعلقة بعدة عوامل منها التخصص والخبرة والأعمال المنجزة ويدخل في الحساب أيضًا اختلاف الشركات والأماكن والدول، لكن يمكننا القول بصورة عامة أن رواتبهم أعلى من المهندسين الآخرين، ويمكنك البحث عن المواقع التي تَعرِض لك متوسط الرواتب التي يتلقاها الموظفون حسب المهنة في بلدك ثم البحث فيها عن التخصصات السابقة لرؤية مُعدّل الرواتب في بلدك. اقتصاد البيانات Data Economy لا يخفَ على أحد الكميات الكبيرة التي تولدها الأجهزة الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي وجميع أنشطة مستخدمي الإنترنت ولم تشكل هذه البيانات الضخمة أداة مساعدة لعمل الشركة فقط وإنما أصبحت أصلًا Asset من أصول الشركة مثلها مثل أجهزة الحواسيب والمكاتب …إلخ، إذ فرضت هذه الأصول -غير الملموسة- نفسها كحقيقة لا مفر منها في تقييم الشركات، فمثلًا إذا اطلعنا على القيمة السوقية لشركة فيسبوك (غيرت الشركة اسمها لتصبح ميتا Meta) في عام 2021 سنجد بأنها وصلت إلى تريليون دولار، بينما بلغت قيمة أصولها الملموسة مثل المباني والعقارات والأجهزة والحواسيب …إلخ، نحو 150.7 مليار دولار، نلاحظ أن الفرق بين القيمتين يصل إلى 849.3 مليار دولار أمريكي، إلا أنه لا يمكننا قياس قيمة البيانات الحقيقية نظرًا لأن الشركة لها العديد من المنتجات الرقمية غير الملموسة مثل نظام الإعلان المؤتمت ونظام المتاجر الإلكترونية وغيرها، ولكن هذا الأمر يضعنا بطريقة غير مباشرة أمام سؤال مهم وجوهري وهو كيف نحدد قيمة البيانات؟ هل يمكننا اعتبار كمية البيانات كمصدر لقيمتها؟ أم أن تنوع البيانات له أهمية أكبر؟ ولكن ماذا عن جودة البيانات هل لها أهمية تُذكر؟ إذا أردنا الحصول على أجوبة دقيقة لا بدّ لنا من فهم دقيق لماهيّة اقتصاد البيانات Data Economy: والذي هو القيمة المالية والاقتصادية التي ينتجها تخزين كميات ضخمة من البيانات التجارية والحكومية وتحليلها واسترجاعها بسرعة كبيرة من خلال برمجيات معقدة وأدوات أخرى. سيساعدنا هذا التعريف في الانطلاق في فهم هذا الاقتصاد الجديد، وبالتأكيد لا يمكننا شرح كيفية تقييم سعر البيانات من خلال فقرة بسيطة لأن الأمر يحتاج إلى مقالات بل كتب! ازدادت النقاشات بين أوساط الاقتصاديين حول كيفية حساب قيمة البيانات والمعلومات كأصول غير ملموسة في الميزانيات، لا توجد حتى اليوم طريقة معتمدة عالميًا توفر حلًا واضحًا لتقدير قيمة البيانات والمعلومات وكل الحلول المطروحة هي اجتهاد من المستثمرين أو الباحثين، وبالرغم من أن بعض الأصول غير الملموسة الأخرى مثل براءات الاختراع وحقوق النشر وقوائم العملاء والعلامات التجارية وحقوق البث وغيرها، قابلة للإدراج في الميزانيات ولها طريقة في حساب قيمتها. في الحقيقة لا يقتصر جهلنا على قيمة البيانات فقط وإنما حتى القوانين الناظمة لها من جمع البيانات أو تنظيمها أو تداولها كل هذه الأمور ماتزال غير واضحة في بعض البلدان ويعود سبب البطء في سن القوانين هو لتجنب إعاقة الابتكار والذي بدوره يبطئ من دوران عجلة الاقتصاد. ولكن مما لا شك فيه أن الدول والشركات ستستفيد من من هذه الأصول وستُشكل بيانات المواطنين في يوم من الأيام إيرادات مستقلة تعزز من خزينة الدولة. يذكر أن قيمة سوق البيانات الضخمة قدرت بحسب موقع Research And Markets بنحو 70 مليار دولار أمريكي لعام 2020 كما توقع يصل قيمة السوق في عام 2027 إلى 243.4 مليار دولار أمريكي أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.2٪. الخاتمة تعرفنا في المقال على أهمية البيانات في عصرنا الحالي ومن هذه الأهمية جاءت أهمية قواعد البيانات التي تحتوي البيانات وتنظمها وكيف انبثق فروع جديدة من فروع علوم الحاسب وهو علوم البيانات وتصميم قواعد البيانات وإدارة قواعد البيانات …إلخ، كما اطلعنا في هذا المقال على خطوات تصميم قاعدة بيانات واستعرضنا بعدها التخصصات المرتبطة بالبيانات لننتهي بفهم كيف ستُنشئ البيانات الضخمة أسواقًا جديدة وختامًا بالرغم من أن منطقتنا العربية لا يوجد بها الكثير من الاستثمارات في البيانات إلا أن هذا الحال سيتغير في المستقبل القريب ولذلك استثمر الفرصة وكن من السباقين إلى هذا المجال. المصادر كتاب Database Systems: Design, Implementation, & Management الطبعة الثالثة عشر لصاحبيه Steven Morris و Carlos Coronel. مقال Data Modeling: Conceptual vs Logical vs Physical Data Model. مقال Data Modelling: Conceptual, Logical, Physical Data Model Types لصاحبه David Taylor. تقرير The Digitization of the World From Edge to Core. تقرير Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2025. مقال Top 10 High Paying Jobs That Demand SQL - GeeksforGeeks لمحرري الموقع. مقال Types of Database Jobs: Choose One of Them and Start Being Awesome لصاحبه Jakub Romanowski. مقال Database (Data) Testing Tutorial with Sample Test Cases لصاحبه Thomas Hamilton. مقال Database Testing Complete Guide (Why, What, and How to Test Data) لمحرري الموقع. اقرأ أيضًا دليلك الشامل إلى قواعد البيانات DataBase أمثلة عملية عن كيفية تصميم قواعد البيانات نمذجة البيانات وأنواعها في عملية تصميم قواعد البيانات النسخة العربية الكاملة من كتاب تصميم قواعد البيانات أنواع قواعد البيانات
-
بينما تمشي في يوم مشمس يوقفك أحد المارة في الشارع ويطلب منك أن تقترح عليه مشروبًا باردًا ليشربه في هذا الجو الحار، ما هو المشروب الذي ستقترحهُ عليه؟ هل ستقترح عليه كوكاكولا أم بيبسي؟ غالبًا أنك ستقترح عليه إحدى هاتين العلامتين أو كلاهما! شيء آخر خطر في بالك؟ ولكن ما الذي جعلك تفكر في هذه العلامات التجارية عندما سئلت عن المشروبات الباردة؟ علمًا أن السائل لم يسأل عن المشروبات الغازية وإنما سأل عن المشروبات الباردة عمومًا؟ ما الذي يجعل بعض العلامة التجارية تخطر على بالنا في بعض المواقف أكثر من علامات تجارية أخرى؟ يُعرف الوعي بالعلامة التجارية بأنه تذكر علامة تجارية معينة خلال موقف ما، عادة ما تنفق الشركات ملايين الدولارات لتضمين علاماتها التجارية في أذهان عملائها (خصوصًا اللاوعي)، وبالفعل نجحت الكثير من العلامات التجارية في أن تصبح في مفرداتنا اليومية، ويعد الوعي بالعلامة التجارية الخطوة الأولى لتحديد مكانة علامتك التجارية في السوق، وهي عملية مستمرة لا تساعد فقط في الحصول على المزيد من العملاء ولكن أيضًا تحافظ على العملاء الحاليين لشراء المزيد من المنتجات لاحقًا، وبالرغم من أن امتلاك الوعي لا يعني دائمًا أن الناس سيشترون منتجات علامتك التجارية إلا أن العلامة التجارية ستدخل مجموعة الوعي Awareness Set أو المجموعة المستحضرة Evoked Set أو مجموعة الاعتبار Consideration Set (سنشرح كل واحدة منها بالتفصيل لاحقًا في هذا المقال). إن بناء علامة تجارية ناجحة لا يحدث بين عشية وضحاها وإنما يتطلب الكثير من الجهد والبحث لبناء شيء فريد يحظى بإعجاب العملاء. بناء هوية العلامة التجارية ثم رعاية علامتك التجارية ثم زيادة الوعي بها وتطوير تجربة العملاء جميعها من الخطوات الإضافية التي ستساعدك على بناء قيمة علامتك التجارية Brand Equity، وفي حال عدم وجود وعي بالعلامة التجارية فلن يفكر المستهلك أبدًا في شراء منتجات علامتك التجارية إلّا في حالات نادرة (مثل حالة الشراء الاندفاعي والذي يعد نوعًا من أنواع الشراء التي تحدثنا عنها بالتفصيل في مقال مفهوم قرار الشراء وأنواعه يمكنك الاطلاع عليه لمزيد من المعلومات)، ولكن عند زيادة الوعي بالعلامة التجارية ستقلل من اعتمادك على المصادفة لأنك ببساطة ستزرعُ علامتك التجارية في أدمغتهم رغمًا عنهم. يعد الوعي بالعلامة التجارية أصلًا من أصول الشركة وينظر إليه مثل الأدوات المادية والبشرية من معدات وأجهزة ومواد وموظفين كما أنه يعلب دورًا أساسيًا في التقييم المالي للشركة Business Valuation، ولفهم أشمل لمكانة الوعي بالعلامة التجارية يجب أن نطلع على الصورة الكاملة للموضوع، وفي هذا الصدد لا بدّ من الإشارة إلى البحث المميزة للدكتور عبد الله عوض "بناء نموذج لمحددات قيمة العلامة التجارية" Building Brand Equity Model، الذي اقترح فيه نموذجًا شموليًا لكيفية بناء قيمة للعلامات التجارية من خلال ربطها مع المفاهيم التالية: الوعي بالعلامة التجارية Brand Awareness الوعي بالسعر Price Awareness الوعي بالإعلان Advertising Awareness الارتباطات الذهنية للعلامة التجارية Brand Association الجودة المدركة Perceived Quality الصورة الذهنية للعلامة التجارية Brand Image الثقة بالعلامة التجارية Brand Trust الولاء للعلامة التجارية Brand Loyalty قيمة العلامة التجارية Brand Equity اعتمد الباحث على أكثر من 20 بحث علمي ليثبت صحة وجهة نظره، وليربط المفاهيم مع بعضها بعضًا لتتشكلَ لدينا الصورة الكاملة لكيفية بناء قيمة حقيقية للعلامة التجارية. سنستعرض في هذا المقال مفهوم الوعي بالعلامة التجارية ماهيته وأنواعه تأثيره وأهميته، كما سنستعرض دور الوعي بالسعر والوعي بالإعلان كمؤثرين على الوعي بالعلامة التجارية في المقالات القادمة لنشرح في نهاية المطاف جميع العناصر المؤثرة في قيمة العلامة التجارية. الوعي بالعلامة التجارية Brand Awareness يعرف الوعي بالعلامة التجارية هو مدى معرفة مجموعة مستهدفة من الناس للعلامة التجارية وربطها بفئة منتجات معينة. ويعرف أيضًا بأنه مدى قدرة العملاء على تذكر علامة تجارية معينة أو التعرف عليها في ظروف مختلفة، وعمومًا يحدث الوعي بالعلامة التجارية عندما يُقدمُ العميل على: معرفة العلامة التجارية وهي بجانب العلامات التجارية الأخرى أثناء التسوق. التحدث لأصدقائه بخصوص فئة المنتج. قراءة أو سماع إعلان العلامة التجارية ومعرفتها. قراءة العميل لأخبار العلامة التجارية ومتابعته لها وما إلى ذلك. شراء العميل منتجات العلامة التجارية. يعد الوعي بالعلامة التجارية أحد الاعتبارات الرئيسية في سلوك المستهلك وإدارة الإعلانات وإدارة العلامات التجارية. تعد قدرة المستهلك على التعرف على العلامة التجارية أو استرجاعها أمرًا أساسيًا لاتخاذ قرار الشراء، ولا يمكن متابعة الشراء ما لم يكن المستهلك على علم أولًا بفئة منتج ومكانة العلامة التجارية ضمن تلك الفئة، لا يعني الوعي بالضرورة أن المستهلك يجب أن يكون قادرًا على تذكر اسم علامة تجارية معينة، ولكن يجب أن يكون قادرًا على تذكر السمات المميزة الكافية لمتابعة الشراء مثل الابتكار والأناقة لمنتجات آبل والقوة والمتانة لمنتجات توشيبا …إلخ. مستويات الوعي بالعلامة التجارية تتعدد مستويات الوعي بالعلامة التجارية بحسب المستهلكين ومدى تأثرهم بالرسالة الإعلانية والمنتجات والجودة المدركة لها، وعمومًا يكون مستويات الوعي على الشكل التالي: التعرف على العلامة التجارية Brand Recognition: وهي قدرة المستهلكين على التعرف على العلامة التجارية وتمييزها عن العلامات التجارية الأخرى وليس بالضرورة أن يتذكر العميل الاسم، وإنما التعرف عليها عند رؤيتها في المتجر. تذكر العلامة التجارية Brand Recall: وهو استدعاء تلقائي للعلامة التجارية من الذاكرة عندما يطلب العميل منتج من فئة منتجات ما. في الحقيقة لا يستطيع معظم المستخدمين أن يتذكروا أكثر من 3-5 أسماء تجارية إذ يتأثر الأمر بعدة عوامل مثل مستوى التعليم وتاريخ الاستخدام واستراتيجيات التسويق المستخدمة من قبل الشركة …إلخ. العلامة التجارية الأولى في الذاكرة Top of Mind: وهي أول علامة تخطر في ذهن المستهلك في فئة منتجات معينة. العلامة التجارية المسيطرة Brand Dominance: وهي العلامة الوحيدة التي يتذكرها المستهلك. يذكر أن هنالك بعض التصنيفات الأخرى لمستويات الوعي مثل: معرفة العلامة التجارية Brand Knowledge: وهي معرفة المستهلك بما تشير إليه العلامة التجارية. الآراء عن العلامة التجارية Brand Opinion: وهي وجود رأي للمستهلك حول العلامة التجارية مثل هذه العلامة التجارية راقية أو ذات جودة عالية …إلخ. وعمومًا يعد التصنيف الأول الأكثر شمولية ووضوحًا. يمكن أن تختلط المفاهيم بين استدعاء العلامة التجارية والتعرف عليها ولكنهما يختلفان في حقيقتهما، فمثلًا عندما تعتمد أهداف الحملات الإعلانية على التعرف على العلامة التجارية، يجب أن يُظهر التنفيذ الإبداعي تغليف منتجات العلامة التجارية أو اسم المنتجات، بينما عندما تعتمد أهداف الحملات على استدعاء العلامة التجارية فيجب أن نركز تقوية الارتباط بين فئة المنتج والعلامة التجارية. يستخدم المعلنون أيضًا الأناشيد أو الموسيقى الإبداعية لدعم استذكار المستهلكين للعلامة التجارية وغيرها من طرق تشجيع استدعاء العلامة التجارية، وفي حال كانت جميع الرسائل الإعلانية ناجحة ومناسبة ستتمكن هذه العلامة من الوصول إلى العلامة التجارية الأولى في الذاكرة، وبعدها تبدأ رحلة تمكين العلامة وتقويتها في ذهن العميل لتسيطر على فئة المنتج وبعدها يصبح العميل يعرف تمامًا ماهية العلامة التجارية وأسباب وجودها ورسالتها وفي حال اقتناعه بها سيتشكل لديه رأي إيجابي عن هذه العلامة ويمكن أن يشارك هذا الرأي مع أصدقائه أو أقاربه. يرتبط الوعي بالعلامة التجارية ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم مجموعات العلامات التجارية في ذهن المستهلك، وعمومًا لتتوضح الفكرة أكثر ألقِ نظرة على هذه الصورة التالية: تنتقل العلامات التجارية بين المجموعات بحسب معرفة المستهلك بهذه العلامات وتحتوي كل مجموعة على العلامات التجارية التالية: مجموعة كل العلامات التجارية في السوق Complete Market Set: كل العلامات التجارية التي لها منتجات تحل المشكلة أو تلبي الحاجة التي يواجهها المستهلك. مجموعة الوعي Awareness Set: وهي مجموعة العلامات التجارية التي يعرفها المستهلك من خلال بحثه. المجموعة المُستحضرة Evoked Set: وهي مجموعة العلامات التجارية التي يعرفها المستهلك ويعرف بأنها تحل له المشكلة أو تلبي الحاجة التي يواجهها، وهي مخزنة في ذاكرته. مجموعة الاعتبار Consideration Set: وهي مجموعة صغيرة من العلامات التجارية التي يوليها المستهلك اهتمامًا وثيقًا عند اتخاذه لقرار الشراء لحل مشكلة أو تلبية الحاجة التي يواجهها. تُعرف عملية نقل المستهلكين من الوعي بالعلامة التجارية والموقف الإيجابي للعلامة التجارية إلى البيع الفعلي باسم التحويل Conversion، بالرغم من أن الإعلان يعد أداة ممتازة لبناء الوعي وتشكيل موقف إيجابي تجاه العلامة التجارية إلا أنه يتطلب عادة دعمًا من عناصر أخرى في برنامج التسويق لتحويل المواقف إلى مبيعات فعلية، مثل عروض الأسعار الخاصة والعروض الترويجية الخاصة أو ضمانات استرداد الأموال بعد الشراء في حال عدم الإعجاب بالمنتج. في الحقيقة من الأدوار المركزية للإعلان هي خلق الوعي بالعلامة التجارية وتشكيل صورة ذهنية لها، من أجل زيادة احتمالية تضمين العلامة التجارية في المجموعة التي يثيرها المستهلك أو يأخذها بعين الاعتبار عند تفكيره بالشراء. لا يتعلم المستهلكون عن المنتجات والعلامات التجارية من الإعلان وحده بل يكتسب المستهلكون معلومات من مجموعة متنوعة من المصادر مثل نصائح الأهل والأصدقاء أو فيديوهات المراجعات وغالبًا ما يتخذون قرارات الشراء بعد البحث عن معلومات حول فئة المنتجات، وسيُصبح المستهلكون على دراية بعدد أكبر من العلامات التجارية التي تُعرف مجتمعة باسم مجموعة الوعي Awareness Set، وتتغير مجموعة الوعي مع اكتساب المستهلكين لمعلومات جديدة لتنتقل بعدها إلى المجموعة المُستحضرة. وفي حال كانت بعض العلامات التجارية مثيرة للاهتمام بالنسبة للمستهلك، فستدخل هذه العلامات إلى مجموعة الاعتبار. في الحقيقة إن إدخال العلامة التجارية في مجموعة الاعتبارات هذا هو الهدف النهائي لكل جهة تسويق أو علامة تجارية طموحة. تأثير الوعي بالعلامة التجارية على قرارات الشراء ذات المشاركة المنخفضة تعرف المشاركة المنخفضة في قرار الشراء Low Involvement Buying Decision بأنها عمليات الشراء التي لا تتطلب سوى القليل من التفكير مثل شراء المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية، بينما تكون المشاركة العالية في قرار الشراء High Involvement Buying Decision عندما يبحث المستهلك عن المعلومات الدقيقة ويوازن بين البدائل لتكوين الاتجاه المبدئي قبل عملية الشراء، وتتأثر عملية الشراء منخفضة المشاركة في الوعي القوي للعلامة التجارية ويرجع سبب انخفاض المشاركة في عملية الشراء عندما يفتقر المستهلكون إلى أحد الخيارات التالية: الدافع لشراء المستهلك وتمييزه للمنتج. قدرة المستهلك العلمية والمعرفية على الشراء. الظروف الملائمة للشراء. سنستعرض كل واحدة منها بالتفصيل. 1. الدافع لشراء المستهلك وتمييزه للمنتج بالرغم من أن المنتجات والعلامات التجارية تكون ذات أهمية حاسمة للمسوقين، لا يهتم المستهلكون بالمنتج أو الخدمة واختيار العلامة التجارية في العديد من الفئات ليس قرارًا مصيريًا بالنسبة لهم لذلك من المرجح أن يؤدي عدم وجود اختلافات ملحوظة بين العلامات التجارية في فئة منتجات معينة إلى ترك المستهلكين غير متحمسين بشأن عملية الاختيار ولذلك في هذه الحالة يجب التركيز على زيادة وعي المستهلك وماهيّة الاختلافات بين المنتجات بطريقة مبسطة وسهلة وسريعة. 2. قدرة المستهلك العلمية والمعرفية على الشراء لا يمتلك المستهلكون في بعض فئات المنتجات المعرفة أو الخبرة اللازمة للحكم على جودة المنتج حتى لو رغبوا في ذلك، ومن الأمثلة الواضحة هي المنتجات التي تتمتع بدرجة عالية من التطور التقني، مثل معدات الاتصالات السلكية أو اللاسلكية المزودة بأحدث الميزات، ففي هذه الحالة لن يتمكن المستهلكون من الحكم على الجودة حتى في الفئات منخفضة التقنية. ضع في اعتبارك طالب الكلية الذي لم يضطر حقًا للطهي أو التنظيف من قبل، أو التسوق في ممرات السوبر ماركت بجدية لأول مرة، أو المدير الفني الجديد الذي أضطر على إجراء عملية شراء باهظة الثمن لأول مرة. الحقيقة هي أن المنتج غالبًا ما يكون غامضًا للغاية ويصعب الحكم عليه بدون قدر كبير من المعرفة والخبرات السابقة. في مثل تلك الحالات، سيستخدم المستهلكون أي طريق مختصر أو إرشادي يمكنهم التوصل إليه لاتخاذ قراراتهم بأفضل طريقة ممكنة، وفي بعض الأحيان يختارون ببساطة العلامة التجارية الأكثر دراية بها ووعيًا بها. 3. الظروف الملائمة للشراء في بعض الأحيان تظهر بعض الظروف المفاجئة أمام إمكانية شراء المستهلك للمنتج مثل ضيق الوقت المستهلك أو أي ظروف أخرى خارجية تعيق عملية الشراء في هذه الحالة يمكن أن يعتمد المستهلكين على الاستدلال العقلي مثل الوعي بالعلامة التجارية للوصول إلى اختيار العلامة التجارية. أهمية الوعي بالعلامة التجارية يعد الوعي بالعلامة التجارية أحد المؤشرات الرئيسية لأداء الشركات في الأسواق؛ بل يعد أحيانًا دليلًا أوليًا لمدى قدرة العلامة التجارية على النجاح. يعتمد قرار الشراء لدى المستهلكين على جزء كبير من الوعي، ولأن المستهلكين لن يضعوا بعين الاعتبار العلامات التجارية التي ليسوا على دراية بها عند قرار الشراء، عكفت الشركات الكبيرة بالاهتمام بزيادة انتشار الوعي بمنتجاتها أما بالنسبة للشركات والعلامات التي ما تزال مترددة في ذلك فهذه أبرز النقاط التي تجعل الوعي محورًا أساسيًا للشركات في عصرنا الحالي: 1. الوعي القوي بالعلامة التجارية يفتح القلوب والمحافظ تعرف العلاوة السعرية Price Premium بأنها النسبة المئوية التي يكون فيها منتجك أغلى من منتجات الشركات المنافسة. تطمح الشركات لرفع أسعارها ورؤية المستهلكين يتمسكون بها حتى بعد رفع السعر، وبالرغم من أنه يُنظر لهوامش الأرباح العالية بأنها خطر محدق على وجود الشركة، ولكن في الحقيقة يمكن للعلامة التجارية التي تتمتع بوعي جيد لجودة منتجاتها أو ميزتها التنافسية عمومًا أن تفلت من ذلك، فمثلًا اذهب إلى أي مركز تجاري وشاهد أي إمرأة اشترت عطرًا أو حقيبة من حقائب تابعة لعلامة تجارية فخمة هل ستجدها نادمة؟ أم أنها تتباهى بها؟ في الحقيقة هذا السلوك ليس طبيعيًا فحسب، بل متوقع منها! لأن الشركة استطاعت إقناع النساء برفع توقعاتهم من منتجات العلامة التجارية وهكذا وضعت الشركة نفسها في مكانة مميزة جعلها تطلب أسعارًا أعلى بدون أن تخسر زبائنها. مثال آخر عن رفع سعر المنتجات وهي منتجات شركة آبل الأغلى ثمنًا بين منتجات منافسيها كيف استطاعت رفع سعر منتجاتها بالرغم من أن التوجه العام للسوق هو للأجهزة الأرخص ثمنًا، فتكمن الإجابة في قصة علامتها التجارية والمكانة الخاصة بها وتجربة استخدام المنتج ووعود الشركة للمستهلكين. في الحقيقة ركزت شركة آبل على تصميم منتجات عالية الجودة كميزة تنافسية أساسية لها، وهذا ما صرح عنه الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك لموقع بيزنز إنسايدر Business Insider أن "هناك دائمًا جزءًا كبيرًا من السوق غير المرغوب فيه" -في إشارة غير مباشرة منه إلى الأجهزة التجارية التي ينتجها المنافسون- وأردف أيضًا "ولكن شركة آبل لا تتاجر بالخردوات". عزز تيم كوك -وستيف جوبز قبله- من خلال تصاريحه للمساهمين رسالة شركة آبل الراسخة بأن الجودة لها ثمنها. ومن الواضح أن السوق استجاب جيدًا لهذه الفكرة، وبالفعل عندما أجرت قناة CNBC في عام 2012 دراسة استقصائية حول عدد الأجهزة التي لدى الأسر الأمريكية فوجدت بأن الأسرة الأمريكية لديها في المتوسط 1.6 جهاز من أجهزة آبل، وتخطط ربع هذه الأسر لشراء ربع جهاز (بمعنى يوجد أسرة من كل أربع أُسر من العدد الإجمالي للأسر ستشتري جهاز آبل على الأقل) في العام المقبل أي زيادة الإقبال على أجهزة آبل بالمجمل. أما بالنسبة لكيفية تأثير العلامة التجارية على محبة المستهلكين لأمر معين نذكر تجربة الشركة الأمريكية إير بي إن بي Airbnb والتي تعد مثالًا رائعًا عن ذلك، إذ تدير الشركة سوقًا عبر الإنترنت للسكن، يمكن المستخدمين (المضيفين والمستأجرين) من الإقامة مع عائلات لقضاء الإجازات والأنشطة السياحية، ويمكن لأصحاب البيوت إيجار الغرف والمنازل التي لا تلزمهم، فيمتد نشاط الشركة على أكثر من 190 دولة حول العالم. تتنافس Airbnb مع آلاف الفنادق ومواقع السفر، ومع ذلك بدلًا من محاولة المنافسة على السعر، قرر المؤسسون التنافس على العلامة التجارية الأمر الذي جعل لها تأثيرًا كأئيبًا في أول عامين لها بحسب تصريح أحد مؤسسي الشركة جو جيبيا Joe Gebbia لأنه شيء جديد آنذاك أن تشارك شقتك مع شخص غريب تمامًا، ولكن بدأت علامة Airbnb التجارية في تمثيل سلسلة من القيم التي حددها المسافرون وهي الاهتمام بالمجتمع والأصالة والاكتشاف والتعاطف الأمر الذي ساعد في بناء مصداقية للعلامة التجارية وسرعان ما أصبحت الشركة وكيلًا بين شخصين يريد أحدهما خدمة الآخر. يساعد الوعي بالعلامة التجارية الشركات على تغيير قواعد المنافسة من خلال ترسيخ قيم في أذهان المستهلكين وتعزيزها الأمر الذي يجعل المستهلكين لا يركزون على كيفية تكديس المواصفات الفنية للمنتجات المنافسة وإنما التركيز على رسالة العلامة التجارية، وهذا الأمر يجعل من المستهلكين مرنين مع هدف من أهداف العلامات التجارية وهي الاستجابة المرنة لارتفاع الأسعار وهي إحدى المزايا الأساسية لتطوير العلامة التجارية. 2. تشجيع العملاء على تبني تجارب ومنتجات جديدة عندما أطلقت شركة آبل Apple أول جهاز آيباد iPad استغرب الناس من منطق وجود هذا الجهاز والمغزى منه لأنه جاء كمفهوم جديد آنذاك، إذ ليس بحجم هاتف الآيفون iPhone لأنه أكبر منه وليس مثل حاسوب ماك بوك MacBook إذ هو أصغر منه، ومع ذلك سرعان ما تقبل الناس الجهاز وكان من أكثر المنتجات مبيعًا للشركة في رد فعل مفاجئ للسوق، ليحقق جهاز آيباد iPad مبيعات في عام 2013 أكثر من 93 مليون جهاز مباع. في الحقيقة خلصت العديد من الدراسات إلى أن العلامات التجارية القوية يمكنها تسريع تبني التكنولوجيا الحديثة وتحسين التصور لأداء المنتج. بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نلاحظ مدى انتشار اسم آيباد بين الناس على كل جهاز بهذا الحجم بالرغم من استخدام بقية الشركات لاسم جهاز لوحي أو تاب Tab أو هاتف كبير وهذا يدل على مدى ترسخ الاسم الأول لهذه الفئة من الأجهزة في أذهان المستهلكين. تعد نظارات غوغل Glass Explorer من أفضل الأمثلة على أن المستهلكين لم يكونوا مستعدين لتجربة شيء جديد فحسب، وإنما يمكنهم أن يدفعوا مبالغ عالية لقاء وصول حصري لبعض المنتجات، ففي عام 2013 فتحت شركة غوغل الوصول لعدد محدود من المقاعد للمشاهدة الحصرية لنظارتها مقابل 1500 دولار أمريكي فقط! في الحقيقة استطاعت شركة غوغل توليد قدر كبير من الثقة لدرجة أنها جذبت آلاف المستكشفين والمطورين المتلهفين للتصنيع والتغيير والإبداع باستخدام أحدث المنتجات لذلك كانوا على استعداد لدفع 1500 دولار (بالإضافة إلى الضرائب) لاختبار نظارات غير جاهزة للطرح في الأسواق، ولا نستغرب أبدًا من هذا التوجه للناس لأن العلامة التجارية القوية تجعلها ذات مصداقية. كما أن فضول المستكشفين والمطورين والمنافسين أيضًا سيدفعُهم لمعرفة كيفية استخدام الشركات الكبرى لبراءات الاختراعات التي تنتجها والتراخيص الإبداعية الممنوحة لها، لكي يتنافسوا معها أو يسارع المطورون في كسب شريحة جماهير جديدة، إذ تكسب العلامات التجارية القوية الثقة اللازمة لتقديم منتجات جديدة ويرحب بها فوريًا من قاعدة عملائها على عكس المنتجات التي لا تنتمي لعلامة تجارية. 3. أصول ثابتة للشركات وتسهيل رحلة تعلم المستهلك تتنامى أهمية الوعي بالعلامة التجارية في وقتنا الحالي وهو يعد من أهم أصول الشركة، فمثلًا في عام 1957 نشر شاب يدعى آرثر فرومر دليل سفر بعنوان أوروبا مقابل 5 دولارات في اليوم "Europe on $5 a Day" مستفيدًا من خبرته أثناء وجوده عضوًا في استخبارات الجيش الأمريكي في أوروبا آنذاك، وسرعان ما نمت العلامة التجارية لفرومر Frommer بسرعة لتصبح إمبراطورية تضم أكثر من 300 دليل وفي عام 1977 اهتمت شركة Simon & Schuster بشركة فورمر واشترت حقوق نشر أدلة السفر. ومن ثم في عام 2001 اشترت شركة John Wiley & Sons شركة فورمر لينتهي الأمر بشراء شركة غوغل Google هذه الأدلة في عام 2012، وكانت الشائعات قوية بأن غوغل تهدف لقتل أدلة السفر المطبوعة، وبالرغم من صعود وهبوط العلامة التجارية إلا أن قيمتها معترف بها تمامًا وهذا في الحقيقة ما دفع الشركات بصورة متكررة إلى شراء الشركة ودفع الثمن الأمر الذي يثبت بأن العلامة التجارية القوية تتجاوز تقلبات السوق. ينتشر الوعي بالعلامة التجارية من خلال قنوات مثل الإحالات والعلاقات العامة والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، وإذا نجحت أحد الحملات الإعلانية، فيمكن أن ينتشر الوعي كالنار في الهشيم، وتصبح العلامة التجارية موضوع نقاش وينشأ مجتمعًا يناقش طريقة استخدام منتجات العلامة التجارية الأمر الذي يساعد على زيادة انتشار المعلومات حول المنتجات وإزاحة المسؤولية عن العلامة التجارية لتثقيف المستهلكين حول طريقة الاستخدام. فمثلًا في بدايات شركة تيك توك TikTok لم تعلن الشركة عن نفسها مطلقًا وإنما نشر مستخدموها الوعي من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بهم أي من خلال التسويق الشفهي. كما أن الوعي يخلق تصورًا إيجابيًا في أذهان العملاء ويخفّض من منحى التعليم للمستهلكين الجدد الأمر الذي يساعد على استقطاب مستهلكين آخرين. رأينا جميعًا الشركات الأسطورية تغرق مرارًا وتكرارًا مثل نوكيا سوني أريكسون وكوداك وغيرها، ولكن بطريقة ما فإن العلامة التجارية ذات المكانة الجيدة لا تزال تحمي الشركات لفترة زمنية جيدة ويمكن جدًا أن تنقذك علامتك التجارية في يوم من الأيام، وفي بعض الأحيان تقدر قيمة الشركات المفلسة بالملايين لمجرد أن قصة علامتها التجارية كانت قيمة في زمن من الأزمان. 4. الوعي ميزة تنافسية واختصارات في عقل العملاء العلامات التجارية القوية تبني حواجز عالية لدخول المنافسين والعلامة التجارية الراسخة تعزز ميزتك التنافسية من خلال منع الآخرين من الاستيلاء على حصتك السوقية بسهولة، فمثلًا اعتاد السفر الجوي أن يكون صناعة ذات حواجز عالية وعدد قليل من المنافسين يمكنهم دخول هكذا نوع من الأسواق ولكن في الآونة الأخيرة تغيرت قواعد هذا السوق وشهد دخول الكثير من شركات الطيران الجديدة، وبدأت المنافسة على السعر تظهر من جديد واشتعلت حُروب العلامات التجارية ولكن شركة فيرجن أمريكا Virgin America أحبت أن تتميز في هذا السوق من خلال بناء تجربة عملاء أنيقة ورائعة وهذا ما صرح عنه أحد ملاك الشركة ريتشارد برانسون وفريقه على أن الشركة تعتمد على الأسعار المخفضة وتجربة العملاء الأنيقة والرائعة. سرعان ما أصبحت تجربة العملاء تلك ضمنية في قصة العلامة التجارية فيرجن أمريكيا بالإضافة إلى المزيد من المميزات مثل الوصول في الوقت المحدد، وتقليل رفض صعود المسافرين للرحلات، والتقليل من عدد الحقائب المفقودة أو التي يتعامل معها بطريقة سيئة مع الحرص على منع هذه الحالات تمامًا. في الحقيقة منح الإحساس القوي بالعلامة التجارية لشركة فيرجن ميزة تنافسية في السوق ولم يستطع أقرب منافسيها من أن يماثلها بعد لتُقيّم لاحقًا كأفضل شركة طيران شابة في الولايات المتحدة من حيث الجودة خلال عام 2013. في عالم سريع الخطى غالبًا تشكل العلامات التجارية القوية اختصارات عند اتخاذ القرارات للمستهلكين، ضع في اعتبارك آخر مرة ذهبت فيها لشراء دواء من الصيدلية، لنفترض مثلًا أنك تشعر بالمرض وتعلم أن كل ما تحتاجه هو مسكن للآلام، وتريد جلب مسكن للآلام من الصيدلية ولكن في الصيدلية يوجد على الأقل 20 علامة تجارية لمسكنات الآلام التي لا تحتاج لوصفة طبية، فكر معي بسرعة ماذا ستطلب؟ ما العلامة التجارية الأولى التي فكرت فيها للتو؟ هل فكرت في بانادول أو سيتامول؟ إن العلامة التجارية الأولى التي خطرت في ذهنك وأنت تحاول حل المشكلة المطروحة هي العلامة التجارية الأولى في ذاكرتك Top of Mind. في المثال السابق كانت المشكلة فيزيائية والألم الذي فكرت فيه جسدي، لكن فكر في الاحتياجات والمشاكل الأخرى التي تتطلب قرار الشراء. فكر في الألم الذي تحاول علامتك التجارية حله، معظم العلامات التجارية الراسخة لم تظهر فجأة وتصبح اختصارات في عقول عملائها. بل إنها وضحت المشكلة في البداية وعالجتها بمنتجاتها وهكذا أصبحت اختصارات مريحة للمستهلكين ومربحة جدًا للعلامات التجارية، ومن خلال التواصل الفعال حول ماهية علامتك التجارية وما تقدمه فإنك تبني معرفة تتداول وتتوارث بين مجتمعات المستهلكين. 5. دخول العلامة التجارية لمجموعة الاعتبار وللمصطلحات اليومية للمستهلك إن رفع الوعي بالعلامة التجارية يزيد من احتمالية دخول العلامة التجارية إلى مجموعة الاعتبار. في الحقيقة أظهرت الكثير من الأبحاث أن المستهلكين نادرًا ما يكونون مخلصين لعلامة تجارية واحدة وإنما لديهم مجموعة من العلامات التجارية التي يفكرون في شرائها ومجموعة أخرى -ربما أصغر- من العلامات التجارية التي يشترونها فعليًا بصورة منتظمة. نظرًا لأن المستهلكين يفكرون عادةً في عدد قليل من العلامات التجارية للشراء، فإن التأكد من وضع العلامة التجارية في الاعتبار يجعل العلامات التجارية الأخرى أقل احتمالية للنظر فيها أو استرجاعها. بالإضافة إلى ذلك، العلامة التجارية ذات التموضع لمناسب والوعي الصحيح يمكن أن تدخل إلى حياة المستهلك اليومية، فمثلًا منذ الانتشار الكبير لمحرك البحث غوغل في أوائل القرن الحادي والعشرين أصبحت كلمة غوغل في معظم أحاديث الناس للإشارة إلى البحث والاستكشاف الأمر الذي جعل معاجم اللغة الإنكليزية تضيف الفعل "Google" على أنه فعل يفيد بحثّ الشخص على الانترنت، نرى أيضًا ذلك في بعض المجتمعات العربية عندما تستخدم الفعل "غوغلها" للتعبير عن البحث والاستقصاء على الإنترنت، فلاحظ أن العلامة التجارية دخلت عميقًا في حياة المستهلك الأمر الذي يجعل استبدالها صعبًا جدًا وأشير إلى أنه لم يُضف أي معجم للغة العربية كلمة غوغل حتى الآن كما في المعاجم الإنجليزية. 6. تفضيل المستهلكين للعلامة التجارية وتعزيز ثقتهم بها يعزز الوعي بالعلامة التجارية ثقة المستهلك فمثلًا عندما ترى أشخاصًا يتفاعلون مع علامة تجارية ويتمتعون بتجربة جيدة فإن ذلك يبني ثقتك في هذه العلامة التجارية حتى لو لم تجربها بعد. لنفترض مثلًا أنك زرت دولة ذات ثقافة مختلفة عن المكان الذي نشأت فيه ووجدت ثلاثة مطاعم مختلفة؛ اثنان من المطاعم المحلية لهذا البلد، وواحد من المطاعم الموجود فعلًا في بلدك، في الحقيقة هناك احتمال كبير بأنك ستذهب إلى المطعم الأخير حتى ولو لم تأكل من فرع المطعم الذي في بلدك، ولكنك تعرف بعض المعلومات عن العلامة التجارية أو يمكن أن تكون عائلتك تناولت من هذا المطعم سابقًا الأمر الذي شكّل لديك معلومات أولية عن العلامة التجارية أو ببساطة أنت تثق في ممارسات النظافة الخاصة بهذا المطعم، وهكذا أنت فضلت العلامة التجارية التي لديك وعي بسيط بها عوضًا عن العلامات التجارية الأخرى التي يمكن أن تكون أفضل من التي في بلدك. كما سيُؤثر الوعي بالعلامة التجارية على تفضيلها عن شبيهاتها من العلامات التجارية في مجموعة الاعتبار، حتى لو لم يكن هناك أساسًا ارتباطات أخرى لتلك العلامات التجارية. فغالبًا ما يبني المستهلكين قرار الشراء أحيانًا من العلامات التجارية ذات الشهرة الواسعة والراسخة، وغالبًا ما يتخذ المستهلكين خيارات بناءً على اعتبارات الوعي بالعلامة التجارية عندما يكون لديهم مشاركة منخفضة. الخاتمة تعرفنا في هذا المقال على الوعي بالعلامة التجارية وفهمنا مستوياته وتأثيره على قرارات الشراء ذات المشاركة المنخفضة وتعمقنا في فهم أهمية الوعي وضرورة بنائه في أذهان المستهلكين وختامًا يعد الوعي أصلًا من أصول العلامة التجارية وكلما زاد وعي الناس بالعلامة التجارية زادت قيمتها. سنتابع في المقال القادم أهمية الوعي بالإعلان والوعي بالسعر وطرق بناء الوعي بالعلامة التجارية. المصادر كتاب Strategic Brand Management Building, Measuring and Managing Brand Equity الطبعة الخامسة لصاحبه Kevin Lane Keller. كتاب Lean Branding: Creating Dynamic Brands to Generate Conversion الطبعة الأولى لصاحبته Laura Busche. مقال Brand Awareness - Definition, Importance, Strategy, & Examples لصاحبه Aashish Pahwa. مقال The Influences of Brand Awareness on Consumers’ Cognitive Process: An Event-Related Potentials Study لصاحبه Zhang, Xuefeng. مقال What are Brand Awareness, Experience and Market Research? لصاحبه Stefanija Tenekedjieva. اقرأ أيضًا العلامة التجارية وأهميتها في قرار الشراء - الفرق بين العلامة التجارية والمنتج مدخل إلى مفهوم الولاء للعلامة التجارية لماذا نحتاج إلى الشعار؟ العلامة التجارية من منظور نفسي
-
تلعب البيانات أهمية كبيرة في أعمال وشركات اليوم بل إنه يستحيل أن نجد شركة قوية ومنافسة في السوق وليس لديها قاعدة بيانات قوية، هذه هي قواعد اللعبة في عصرنا الحالي، هل تريد المنافسة والسيطرة على السوق؟ إذا جهز نفسك لبناء قاعدة بيانات قوية ومتكاملة، ولفهم أهمية قواعد البيانات لا بدّ لنا في البداية من تبسيط المفاهيم والتعرف بدقة على ماهيّة قواعد البيانات والتي ببساطة هي مجموعة من المعلومات المنظمة في شكل مهيكل (مثل جداول) أو غير مهيكل (مثل المستندات)، ويمكن الوصول إليها وإدارتها وتحديثها بسهولة من خلال أنظمة إدارة قواعد البيانات مثل MySQL و MongoDB. تكمن أهمية قواعد البيانات في أنها تخزن المعلومات المتعلقة بتفاصيل المنتج البرمجي مثلًا إذا كانت المنتج متجر إلكتروني فستكون المعلومات مثلًا عدد المبيعات ومخزون المنتجات وملفات العملاء وأنشطة التسويق …إلخ، وتساعد قواعد البيانات في جعل عملك أقوى مما يزيد من أرباح شركتك آنذاك. لنتخيل أنه ليس لديك مكان مركزي لتخزين كل هذه المعلومات التي تصدرها الشركة في هذه الحالة لن يكون لديك أدنى فكرة عما يحدث بالفعل في شركتك، وعندها ستبدأ في وضع الافتراضات لما يحدث داخل شركتك، وتتخذ القرارات بناء على تكهنات بدلًا أن يكون بناء على الحقائق. لاحظ كيف يمكن توظيف قواعد البيانات في فهم ما يحدث بالضبط في مثال المتجر السابق من خلال قراءة المعلومات وتحليلها، في الحقيقة مع اكتشاف الشركات لأهمية قواعد البيانات ازداد الاعتماد عليها، وبدأت شركات البرمجيات بتطوير قواعد البيانات وأنظمتها وجعلها تواكب متطلبات البيانات الحديثة فظهرت لدينا قواعد بيانات كثيرة بعضها للشركات الصغيرة وبعضها للكبير بعضها مغلقة المصدر وبعضها مفتوح المصدر، ومع هذا التنوع وكثرة الخيارات تزداد الحيرة والقلق من اختيار نوع خاطئ يؤدي لكوارث لاحقة للشركة، فما هو نوع قواعد البيانات المناسبة للشركات الناشئة؟ وكيف نختار ما يناسبنا في ظل هذا التنوع الكبير بين قواعد البيانات وأنظمة إدارتها؟ سنحاول في المقال تسليط الضوء على اثنين من أشهر أنظمة إدارة قواعد البيانات وهما MySQL و MongoDB والذين يديران قواعد البيانات العلائقية Relational Database وقواعد بيانات غير العلائقية Non-Relational Database على التتالي، وسنقارن بينهما ونكتشف كيف فرضا نجاحهما وجدارتهما في سوق العمل الحديث، ولنتمكن لاحقًا من استخدامهما في المشاريع التي تناسبهما، وسنسعى لتجنب التحيز بين أنظمة إدارة قواعد البيانات ولكن بالتأكيد هناك بعض المشاريع التي تناسب إحدى الأنظمة أكثر من الآخرى وهذا أمر طبيعي. نبذة موجزة عن MySQL و MongoDB تُعرف لغة SQL بأنها لغة استعلام مهيكلة تستخدم لتخزين ومعالجة واسترجاع البيانات الموجودة في قاعدة بيانات علائقية Relational Database وهذه الأخيرة وهي مجموعة من عناصر البيانات التي تترابط مع بعضها بعلاقات محددة على شكل مجموعة من الجداول ذات الأعمدة والأسطر، ويعد التعامل مع هذه اللغة واضحًا لأن قواعد البيانات مهيكلة ومنظمة حتى مع المشاريع الكبيرة. أما لغة NoSQL فهي لغة استعلام غير مهيكلة تستخدم لتخزين ومعالجة واسترجاع البيانات من قاعدة بيانات غير علائقية Non-Relational Database وهذا النوع من قواعد البيانات لا يستخدمُ المخططات Schema لبناء قواعد بيانات وإنما يستخدم نماذج مرن مثل أزواج الاسم والقيمة للمتطلبات Name-Value أو المستندات وهذا ما يمنح قاعدة البيانات المرونة العالية في التكيف مع البيانات المتغيرة للمشاريع الحديثة، ويعد التعامل مع هذه اللغة صعبًا نسبيًا في المشاريع الكبيرة. تعد أنظمة إدارة قواعد البيانات DBMS -وهي اختصارا Database Management Systems- أنظمة برمجية تُستخدم لتخزين واسترجاع وتنفيذ الاستعلامات على البيانات المخزنة في قاعدة البيانات، وتعمل هذه الأنظمة كواجهة بين المستخدم النهائي وقاعدة البيانات، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء وقراءة وتحديث وحذف البيانات في قاعدة البيانات. قبل أن ندخل في تفاصيل الحديث عن هذين النظامين لا بدّ أن نوضح بأنه يمكن النظر إلى هذه المقارنة على أنها مقارنة بين نوعي قواعد البيانات SQL و NoSQL ولكن بطريقة غير مباشرة، كما أنه من الجدير بالذكر أن هنالك العديد من الأنظمة التي تدير قواعد البيانات من نوع SQL نذكر منها MySQL و PostgreSQL و Microsoft SQL Server وغيرها، وأيضًا هنالك أنظمة إدارة لقواعد البيانات NoSQL مثل MongoDB و BigTable و Redis و RavenDB و Cassandra و HBase و Neo4j و CouchDB وغيرها. ما هي MySQL؟ تعريف قواعد بيانات MySQL هو نظام إدارة قواعد بيانات علائقية RDBMS -وهو اختصارا Relational Database Management System- يستخدم لتحديث وإدارة وإنشاء قواعد البيانات العلائقية، صدر عام 1995 وسرعان ما بنى تاريخًا قويًا وسمعة عالية وموثوقية كبيرة بفضل مميزاته من السهولة والأمان ومع إتاحته كنظام مفتوح المصدر الأمر الذي الذي عزز شعبيته ومكّن المبرمجين من التعديل على الشيفرة البرمجية. أما قاعدة البيانات العلائقية Relational Database: فهي مجموعة من عناصر البيانات مرتبطة بعلاقات محددة مسبقًا فيما بينها، وتنظم هذه العناصر كمجموعة من الجداول ذات الأعمدة والصفوف، ويمكن تمييز كل صف في الجدول بمعرف فريد يسمى مفتاح أساسي، ويمكن جعل الصفوف الموجودة بين جداول متعددة مرتبطة باستخدام مفاتيح خارجية. يتوافق نظام إدارة MySQL مع العديد من الخوادم عبر جميع اللغات والبرامج الوسيطة، كما أن تصميمه متعدد الطبقات مع وحدات مستقلة الأمر الذي يوفر الحماية المطلوبة وهو يدعم الخيوط دعمًا كاملًا من خلال خيوط النواة Kernel Threads، كما يقدم أدوات مدمجة لتحليل الاستعلام وتحليل المساحة، ويمكنه التعامل مع كميات كبيرة من البيانات تصل حتى 50 مليون صف أو أكثر، ويعمل مع العديد من توزيعات يونكس UNIX ولينكس Linux. ما هو MongoDB؟ تعريف MongoDB هو نظام لإدارة قواعد البيانات غير العلائقية Non-Relational Databases مثل NoSQL و Cassandra، ويمكننا هذا النظام من إدارة المعلومات في قواعد البيانات سواء إضافة أو حذف أو تعديل أو استرداد، كما أن هذا النظام مفتوح المصدر وله أيضًا إصدارات تجارية أيضًا. ظهرت الشركة في البداية في عام 2007 عندما واجه المبرمجون الثلاثة وايت ميريمان وإليوت هورويتز وكيفين رايان مشكلة أثناء عمليات التطوير وقابلية التوسع لتطبيق الويب المشهور DoubleClick إذ كان يتطلب الموقع عرض 400,000 إعلان في الثانية، ولكن الاعتماد على مناهج قواعد البيانات العلائقية التقليدية أدى لبطئ كبير الأمر الذي حفزهم لتأسيس شركة 10Gen ولتطور الشركة بعدئذٍ ويغير اسمها لاحقًا إلى MongoDB Inc في عام 2013 ولتطرح اسهمها للاكتتاب العام في عام 2017. يدعم النظام أشكالًا مختلفة من البيانات وهذا لأن قواعد البيانات التي من نوع NoSQL بحد ذاتها تدعم هذه الأنواع ولا تتطلب قواعد البيانات أي مخططات مسبقة Database Schema مما يسمح بمرونة عالية في تطوير قواعد البيانات. في الواقع يمكن أن تكون المستندات في نفس المجموعة ومع ذلك لها هياكل مختلفة تمامًا فيما بينها. يعتمد نظام MongoDB أسلوبًا مختلفًا لتخزين البيانات إذ يمثل المعلومات كسلسلة من المستندات المشابهة لصيغة JSON الموجودة في لغة جافاسكربت (للتوسع في فهم صيغة JSON يمكنك الاطلاع على مقال ما هي JSON؟)، وتسمى الصياغة التي يخزن بها Binary JSON أو BSON. وتعرف BSON بأنها شكل ثنائي لتمثيل هياكل البيانات البسيطة أو المعقدة بما في ذلك المصفوفات الترابطية Associative Arrays (المعروفة أيضًا باسم أزواج الاسم والقيمة Name-Value)، والمصفوفات المفهرسة بالأرقام الصحيحة، ومجموعة من الأنواع العددية الأساسية. تتشابه الحقول الموجودة في هذه المستندات مع الأعمدة الموجودة في قاعدة البيانات العلائقية. وعادة ما يستخدم المتغير BSON لتبادل البيانات، يذكر أن شركة MongoDB طورت هذا المتغير عام 2009. مقارنة بين MySQL vs MongoDB يتشابه هذان النظامان في شكليهما إذ كلاهما نظام إدارة قواعد بيانات DBMS، وكلاهما يمكن الشركات من نشر وتوزيع تطبيقاتها السحابية أو تعديلها أو نشرها. علاوة على ذلك أنشأ مطورو كلا النظامين هذه القواعد في الأصل كقواعد بيانات مفتوحة المصدر لتكون الشيفرة البرمجية مجانية لأي شخص لاستخدامها وتوزيعها. هذه أبرز أوجه التشابه أما الاختلافات سنناقشها بالتفصيل. المجتمع والتطوير لننظر في المجتمع لتقييم تطوير هذه الأنظمة يشير المجتمع الأكبر إلى أن تطوير هذه الأطر مستمر على قدم وساق. كما أن كثرة استخدام المبرمجين لنظام قاعدة بيانات معين يجعل من السهولة الحصول على الدعم والمساعدة في المجتمعات التقنية. table { width: 100%; } thead { vertical-align: middle; text-align: center; } td, th { border: 1px solid #dddddd; text-align: right; padding: 8px; text-align: inherit; } tr:nth-child(even) { background-color: #dddddd; } وجه المقارنة قواعد بيانات MySQL قواعد بيانات MongoDB الموقع الرسمي MongoDB MySQL تاريخ أول إصدار 1995 2009 رقم الاصدار الحالي (الذي كان وقت كتابة المقال) 8.0.28 5.0.5 بحسب الاستبيان السنوي لموقع Stackoverflow جاء فيه سيطرة واضحة لنظام إدارة قواعد بيانات MySQL وهذا أمر منطقي نظرًا لقدمها وفعاليتها في معظم المشاريع آنذاك، ولكن سنجد أيضًا صعود قوي وسريع لنظام إدارة قواعد بيانات MongoDB على مر السنوات الماضية وذلك لأن تقنيات الويب تغيرت جدًا وأصبح كل شيء يتفاعل معه المستخدم في الموقع يولد بيانات وهذا الكم الكبير من البيانات تصعبُ إدارته من خلال MySQL، ولذلك ومع أن MySQL ستفوز في سباق الشعبية إلا أن MongoDB ستحجز لنفسها مكانًا في أوائل الأنظمة تطوير قواعد بيانات في المستقبل، وبحسب الاستبيان أيضًا نجد توافق بين جميع المستجيبين والمطورين المحترفين لقواعد بيانات الأكثر شيوعًا، والاختلاف الوحيد الذي نجده هو أن المطورين المحترفين يميلون أكثر قليلًا إلى استخدام Microsoft SQL Server على MongoDB. قابلية التوسع غالبًا ما يواجه المهندسون والمطورون تحديًا عندما يحتاج المشروع للتوسعة أو عند الزيادة الكبيرة لعدد المستخدمين والطلبات، ويكون ضمان توفر موارد موقع (سواء من قواعد بيانات أو الصور ..,إلخ) من أصعب التحديات، وهذا الأمر يحتاج للدراسة والتخطيط للتعامل مع عدد الزوار الكبير في أوقات ذروة الطلبات. في هكذا مواقف أول ما يخطر ببال المهندسين أننا سنحتاج لتوسيع قوة معالجة الخادم وسعة التخزين ومستويات التوفر للخادم …إلخ، ولكن هل تطوير الخادم هو الخيار الوحيد الذي لدينا؟ أم أن لدينا خيارات أخرى؟ وما هو التوسع بقواعد البيانات أفقيًا وعموديًا؟ ظهر مفهومي التوسع أفقيًا أو التوسع عموديًا في قواعد البيانات عند الزيادة الكبيرة في الاعتماد عليها وكمية البيانات الضخمة وعدد الزوار الكبير لمواقع وتطبيقات الويب الذين يطلبون البيانات ويمكن أن يختلط الأمر على المبتدئين بين لأن كليهما يشتملان على إضافة موارد إلى البنية التحتية التي نضع عليها قواعد البيانات، ولكن هناك فروقات واضحة بين الاثنين من حيث التنفيذ والأداء. يشير التوسع العمودي Vertical Scaling إلى التوسعة من خلال زيادة إمكانيات المكونات المادية للمخدم مثل زيادة قدرة وحدة المعالجة المركزية أو ذاكرة الوصول العشوائي …إلخ، بينما يشير التوسع الأفقي Horizontal Scaling إلى التوسع من خلال إضافة المزيد من الخوادم وتوزيع الحمولة عليها. أحد الاختلافات الأساسية بين الاثنين هو أن القياس الأفقي يتطلب تغيير منطق قاعدة البيانات وجعلها في أجزاء صغيرة من أجل وضعها بالتوازي عبر أجهزة متعددة وتوزيع الحمولة بينها، وغالبًا ما يكون التوسع الرأسي أسهل لأن المنطق لا يحتاج إلى التغيير وإنما فقط توسعة عدد المعالجات والأجهزة. يمكن لقواعد البيانات MySQL التوسع عموديًا وهذا الأمر يجعلها غير محبذة للمشاريع الضخمة أو التي تتغير بنيتها باستمرار، بينما نجد بأن قواعد MongoDB يمكنها التوسع أفقيًا وعموديًا ولذلك نجدها في المشاريع الكبيرة، ومن الجدير بالذكر أن هنالك عدة فروقات أخرى بين التوسع الأفقي والرأسي لن نناقشها في هذا المقال لكي لا يطول ونخرج عن الموضوع ويمكنك البحث عنها. بالرغم من ذلك هنالك بعض المبرمجين يحاولون المواربة عن مشكلة عدم إتاحة نظام قاعدة بيانات MySQL توزيع البيانات على مجموعة من المخدمات للقراءة فقط ولكن هذه الترقيعات لا يمكن مقارنتها مع الدعم الأصيل الموجود في MongoDB، ونشير أيضًا إلى أن التوسع العمودي في قواعد البيانات له حد أعظمي سواء من قدرة المعالج أو سعة الذاكرة العشوائية …إلخ. مخطط البيانات وتنوع البيانات في نظام قواعد البيانات MongoDB تعرض البيانات في أزواج مثل مستندات JSON، مما يتيح لقاعدة البيانات قيودًا أقل ومرونة أكبر بالمقارنة مع الطرق الأساسية بالتصميم والتي تعتمد على المخطط وأنواع البيانات والقيود والروابط، ولكن الأمر يتغير بالنسبة لنظام قواعد البيانات MySQL، فبالرغم من إمكانية تغيير المخطط مع مرور الزمن، إلا أن التعديلات ليست مرنة وديناميكية كما هو الحال في قواعد بيانات القائمة على المستندات مثل NoSQL. كما تتطلب MySQL إنشاءً مسبقًا لمخطط قواعد وتنظيم الجداول والأعمدة قبل تخزين أي بيانات، بالإضافة إلى ذلك يتطلب تعديل مخطط البيانات إعادة التفكير بعناية بكيفية تنفيذ التعديل من خلال لغة تعريف البيانات DDL (وهي اختصار Data Definition Language) أو لغة معالجة البيانات DML (وهي اختصار Data Manipulation Language) لأن نظام التعديل الذي تفرضه قواعد بيانات SQL صارم لذلك عندما يتغير مخطط قاعدة البيانات خصوصًا إن كانت التغييرات كبيرة، فنعيد بناء قاعدة البيانات ثم ننقل البيانات عليها من جديد، وفي الواقع هذا الاتساق هو من أكثر نقاط القوة في MySQL لأنه يحافظ على البيانات منظمة ومتسقة. وأما بالنسبة لتنوع البيانات فإن قاعدة بيانات MongoDB تسمح بتخزين المستندات والتي تختلف في المحتوى والحجم، أما MySQL نظرًا لأن مخطط البيانات أكثر تقييدًا وصرامة، فإن كل صف داخل الجدول يتطلب نفس الأعمدة (أي مثلًا يجب لعمود الاسم في جدول بيانات MySQL أن يأخذ نفس نوع البيانات ونفس الحجم وفي حالتنا كون Varchar(50) أي بحجم 50 محرف فقط) والتي يمكن أن تكون صعبة، ولذلك تتفوق قاعدة بيانات MongoDB على قاعدة بيانات MySQL عند التعامل مع كميات متنوعة وكبيرة من البيانات المعقدة. الأداء والسرعة تحتل سرعة وأداء قواعد البيانات مكانة كبيرة في سباق المقارنة وفي الحقيقة لا تتطلب كل المشاريع البرمجية سرعة كبيرة لنتخيل مثلًا نشاطًا تجاريًا يعمل بكميات صغيرة من البيانات ذات تنوع بسيط سنُلاحظ بأن السرعة ليست بالضرورة أمرًا مهمًا نظرًا لأن الميزات الأخرى (مثل الموثوقية واتساق البيانات)، ولذلك فإن الخيار الأفضل في هذه الحالة هو قواعد البيانات. تقبل MongoDB كميات أكبر من البيانات المهيكلة أو غير المهيكلة كما أنها أسرع من MySQL. ومع ذلك لا ينظر المهندسون إلى السرعة كعنصر محوري بقدر ما أنها ميزة إضافية لمميزات إحدى قواعد البيانات، في الحقيقة إن المقارنة بين السرعة ستكون منطقية في حال المقارنة بين نوعين من قواعد البيانات المهيكلة ولن نستطيع تطبيق ذلك لأن هذا سيُعد ظلمًا لقواعد البيانات MongoDB بإهمال أفضل ميزة بها وهي قواعد البيانات غير المهيكلة، وعمومًا تتمتع MySQL بسرعة جيدة في قواعد البيانات المهيكلة وتتحسن سرعتها من خلال الاستخدام الصحيح للفهارس، كما تتمتع MongoDB بأداء مرِن وسرعة كبيرة للبيانات غير المهيكلة، ولكن إنشاء فهارس على سمات بيانات متنوعة يصبح أمرًا صعبًا، الأمر الذي يجعل MongoDB تتطلب تحسينًا متكررًا لمخطط البيانات، ولذلك يكون هناك مخاطرة بمشاكل تتعلق باتساق البيانات. الحماية تستخدم نظام قواعد البيانات MySQL نموذج أمان قائم على الامتيازات Privileges، والذي يتطلب مصادقة المستخدم أي أن النظام يتطلب عمليات أمان وهي المصادقة Authentication والتفويض Authorization والتحقق Verification، بالإضافة إلى ذلك تستخدم قواعد البيانات MySQL اتصالات مشفرة بين العملاء والخادم وذلك من خلال طبقة مآخذ التوصيل الآمنة SSL بروتوكول أمان. تتشابه طريقة الحماية التي يوفرها نظام قواعد البيانات MongoDB إذ هو الآخر يعتمد على الامتيازات. بالإضافة إلى ذلك إذا كان التشفير مطلوبًا فيمكن تطبيق بروتوكول طبقة التوصيل الآمنة SSL أو تعطيله إن لزم الأمر، في الحقيقة يوفر نظامي MongoDB و MySQL نماذج أمان قوية والفارق غالبًا ما يكون في طريقة تطبيق المطورين والمهندسين للمارسات الأمنية الشائعة أما قواعد البيانات وأنظمتها فهي ذات أمان قوي. خصائص ACID تعد خصائص ACID وهي اختصار للكلمات التالية: الذرية Atomicity والاتساق Consistency والعزل Isolation والمتانة Durability من الخصائص المهمة جدًا عند التعامل مع قواعد البيانات، ويعد توافر هذه الشروط أساسيًا للوثوق بتعاملات قاعدة البيانات يذكر أن أول من طرح هذه الشروط هو العالم جيم جراي Jim Gray وذلك في أواخر الستينات القرن العشرين. تتكون تعاملات قواعد البيانات Database Transaction من مجموعة من العمليات المفردة. فمثلًا عند تحويل مبلغ من حساب بنكي إلى آخر، يخصم المبلغ من حساب المصدر ويضاف في الحساب المستقبل. فيكون لدينا عمليتان لكنهما معا تشكلات تعاملًا واحدًا، وعمومًا لنشرح بالضبط أهمية كل خاصية من هذه الخواص: الذرية Atomicity: وتعني أن تعاملات قاعدة البيانات إما أن تنفذ جميع عملياتها بصورة كاملة أو لا تُنفذ أيًا منها، بمعنى أنه لا يوجد حل وسط، ففي مثال التحويل البنكي إما أن تنفذ عمليتي الخصم والإيداع أو لا تُنفذ أية واحدة منها لأن تنفيذ أحدهما وفشل الآخر سينتجُ عنه خلل في صحة البيانات. الاتساق Consistency: وتعني أن تظل قاعدة الباينات ملتزمة بقوانين تكامل البيانات كما حددها مصمم قاعدة البيانات بعد تنفيذ التعامل، فمثلًا إذا حُدد الحد الأدنى للرصيد بمبلغ معين يجب أن ترفض قاعدة البيانات أي تعامل ينتج عنه في النهاية إخلال بهذا القانون. العزل Isolation: وتعني أن تنفذ التعاملات المختلفة بمعزل عن بعضها بعضًا، ويختص هذا الشرط بقواعد البيانات التي تنفذ عدة تعليمات متزامنة، فمثلًا إذا أراد العميل الكشف عن رصيده أثناء أجراء تعامل التحويل مالي يجب أن تمنحه قاعدة البيانات إما البيانات التي سبقت التحويل أو التي نتجت عنه (بفرض أنها نفذت بنجاح). المتانة Durability: وهي إذا ظهر للمستخدم نتيجة مفادها أن التعامل نُفذّ بنجاح، فإن ذلك يعني أن التعامل لن يُتراجع عنه مهما حدث، حتى في حالة حدوث أي أعطال لاحقة في قاعدة البيانات. يوفر كلا النظامين خصائص ACID وبالرغم من أن MongoDB تأخرت سنة كاملة لإضافتها ولكنها الآن متاحة، كما أن نظام قواعد البيانات جعل MongoDB هذه الخصائص غير مفعلة بصورة افتراضية إلا أنه يمكننا تفعيلها، ولكن تنفيذ هكذا خصائص سيتطلب التضحية بالسرعة والتوافر العالي. طريقة كتابة الاستعلام يعد الفرق بين البيانات المهيكلة وغير المهيكلة نقطة انطلاق مفيدة لأن البيانات المنظمة تتبع نموذجًا أو مخططًا محددًا جيدًا. بينما نجد بأن البيانات غير المهيكلة ليست منظمة وفقًا لأي نموذج محدد مسبقًا. ولذلك من المنطقي أن نجد نظام قواعد البيانات MySQL يستخدم لغة الاستعلام المهيكلة SQL عند طلب معلومات من جدول قاعدة بيانات، كما أنه لإنشاء جداول في قاعدة البيانات يتطلب معرفة بلغة تعريف البيانات DDL، ولتعديل البيانات يجب تعلم لغة معالجة البيانات DML وبذلك نستطيع التحكم الكامل بقواعد البيانات. أما بالنسبة لنظام قواعد البيانات MongoDB فهي تعتمد على لغة استعلام غير مهيكلة وهي MongoDB Query Language، والتي تعتمد بدورها على جافاسكربت وتحديدًا طريقة تبادل البيانات JSON الأمر الذي يجعل MongoDB تدعم لغات متعددة (مثل بايثون وجافا و C# و Perl و PHP وروبي وجافاسكربت) ويمكن كتابة استعلام مركب ومحدد لمختلف الحقول داخل مستندات المجموعة باستخدام عوامل تشغيل الاستعلام. لنستعرض المثال التالي لفهم كيفية الاختلافات التي تحدث بين الاستعلامات لنفترض أن لدينا قاعدة بيانات تحتوي على جدول به الأعمدة التالية: الاسم العنوان رقم حساب متوسط كمية الطلب السعر عدد مخزون المنتجات من قراءة سريعة للتسميات يمكننا معرفة أو توقع المدخلات في كل عمود وبالتالي يمكننا الاستعلام عن البيانات وتحليلها بسهولة لأن تدفق البيانات محدد جيدًا. أما بالنسبة للقواعد البيانات غير المهيكلة فإن البيانات بها لا تتناسب بدقة مع الأعمدة. فمثلًا يمكن أن يتضمن جدول بيانات غير مهيكلة ما يلي: مقاطع فيديو نشاط الجهاز المحمول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مستندات نصية صور هل هنالك طريقة لمعرفة ما هو مقطع الفيديو أو الأغنية الشائعة التي أدخلها المستخدم؟ غالبًا لا يمكننا معرفة أو توقع ذلك، ولهذا السبب لا يمكننا استخدام الأدوات التقليدية للاستعلام عنه لأن تغير البيانات ينتج عنه تغير طريقة التعامل معها، وعمومًا الجدول التالي سيمنحنا المعرفة مبدئية للفوارق بين طريقة طريقة الاستعلام في MySQL و MongoDB. وهذه نظرة سريعة لبعض التعليمات في كل من نظام إدارة قواعد البيانات MySQL و MongoDB. الاستعلام عن جميع الموظفين: من خلال MySQL تكون التعليمة: select * from Employee; من خلال MongoDB تكون التعليمة: db.Employee.find() الاستعلام في بنية قواعد البيانات المعقدة: من خلال MySQL تكون التعليمة: SELECT E.* from Employee E inner join Dept D on E.EMPID=D.EMPID Where D.City=’Irving’ من خلال MongoDB تكون التعليمة: db.Employee.find( { "Address.City" : "Irving" }).pretty() ادخال مجموعة من البيانات: من خلال MySQL تكون التعليمة: Insert into Employee values (‘Brian Lockwood’,45, ‘A’),(‘Charles’,35,’A’) من خلال MongoDB تكون التعليمة: document = [ { "Name" : "Brian Lockwood","Age" : "45", status:"A"}, { "Name" : "Charles","Age" : "35", status:"A"}] طريقة استخدام distinct لتصفية النتائج المكررة من استعلام معين: من خلال MySQL تكون التعليمة: Select distinct status from Employee; من خلال MongoDB تكون التعليمة: db.Employee.distinct( "status"); طريقة الاستعلام مشروط: في MySQL تكون التعليمة: Select * from Employee where Age>30 في MongoDB تكون التعليمة: db.Employee.find ( { Age: {$gt : "30"} }); يمكننا في MySQL تطبيق تعليمات الدمج لاسترداد البيانات من جدولين أو أكثر من جداول قاعدة البيانات كما أن تعليمة الدمج JOIN توفر العديد من أنواع الدمج مثل الدمج الداخلي أو الخارجي أو اليساري أو اليمني أو المتقاطع، بينما لا تقدم MongoDB عمليات دمج لنتائج الاستعلام وليس لديها تعليمات تعادل هذه الوظيفة بالإضافة إلى ذلك لا توفر MongoDB القوادح Triggers والتي هي وحدات منطقية مقادة بالأحداث مزروعة في قاعدة البيانات، وتُنفذُ قاعدة البيانات أوامر القوادح أوتوماتيكيًا وتكون هذه التعليمات خاصة بالتعامل مع بيانات موجودة في جداول محددة بينما MySQL توفرها. سهولة التعلم للمبتدئين يعد نظام قواعد بيانات MySQL سهل نسبيًا وذلك بسبب أنه متسق ومنظم وهيكليته واضحة ولذلك من الطبيعي أن يكون تعلمه سهل وبسيط رغم طول منحنى تعلمه لكثرة المفاهيم فيه (وأحيانًا تعقيدها) بينما في المقابل نجد بأن البنية غير المهيكلة والمرونة العالية يمكن أن تجعل عملية التعلم أصعب نظرًا لكثرة التفاصيل والسيناريوهات رغم أن تعلم بدء استعمالها وتنفيذها سهل وسريع ويكون غالبًا مدمجًا مع اللغة البرمجية نفسها (أي تكتب الاستعلامات بلغة جافاسكربت بدلًا من لغة SQL) لما تخفي عن المستخدم التعقيد الداخلي. أيهما أفضل MySQL vs MongoDB؟ يعد كل من نظامي MySQL و MongoDB من الأنظمة القوية لإدارة قواعد البيانات، وتعمل كل واحدة منها بصورة مختلفة عن الأخرى نظرًا للاختلاف في نوع قواعد البيانات التي يتعاملان معها، ومن الصعوبة تحديد قاعدة البيانات الأفضل إذ يعتمد الأمر كله على السياق بعض الشركات تعتمد على كلا النظامين للتعامل مع مهام مختلفة وهذا أمر جيد والبعض الآخر يفضل التعامل فقط مع MongoDB لزيادة التركيز وتخفيف التشتت. متى نستخدم MySQL و MongoDB؟ بالرغم من المزايا العديدة التي يتمتع بها نظام MongoDB إلا أن MySQL تفوقت عليها في الموثوقية واتساق البيانات. وإذا كان الأمان يمثل أيضًا أولوية فإن MySQL معترف به على نطاق واسع كواحد من أكثر نظم إدارة قواعد البيانات أمانًا. تعد قواعد البيانات العلائقية الخيار الأنسب للتطبيقات متعددة المستخدمين وكل مستخدم له صلاحيات مختلفة وتتطلب أمان عال وموثوقية، مثل أنظمة المحاسبة والمصارف والبنوك لأن MySQL تركز على الوفاء بخصائص ACID وسلامة المعاملات، بينما تركز MongoDB على السماح بمعدل معاملات مرتفع ولذلك نجدها لا تدعم خصائص ACID في الوضع الافتراضي، وعمومًا يوصى باستخدام نظام MySQL للشركات أو المؤسسات أو المشاريع ذات مخطط البيانات الثابت والتي لا تنوي توسيع نطاق تنوع البيانات، مما يتطلب صيانة سهلة ومنخفضة مع ضمان سلامة البيانات وموثوقيتها، وهي مناسبة أيضًا لمشاريع التجارة الإلكترونية والمواقع التي تتطلب بروتوكولات أمان وموثوقية عالية مثل المشاريع الحكومية. أما نظام إدارة قواعد البيانات MongoDB فهو الخيار الأنسب للشركات الحديثة أو المشاريع التقنية المتطورة ذات المخطط غير مستقر لأن طبيعة البيانات غير العلائقية تسمح باستخدام قواعد البيانات بحرية وبدون بنية محددة مسبقًا الأمر الذي يسهل التحديث البنية أو تطويرها، وتستخدم غالبًا في المشاريع التي تتطلب إدارة المحتوى المتنوع، ومشاريع إنترنت الأشياء Internet of Things، ومواقع التحليلات والإحصائيات في الزمن الحقيقي Real-Time، والمواقع والتطبيقات عالية الاستخدام إجمالًا. يعد موقع Shutterfly مثلًا مميزًا لكيفية الانتقال إلى قواعد البيانات MongoDB، وهو واحدٌ من أشهر مواقع مشاركة للصور عبر الإنترنت، واعتمد في البداية على استخدام قواعد البيانات العلائقية المقدمة من شركة أوراكل لكن قواعد البيانات العلائقية غير مرنة لطبيعة عمل الموقع ومكلفة عند التوسع، كما تسببت في بعض الأحيان باختناقات خصيصًا عند التعامل مع عدد كبير من البيانات، لأن الشركة لديها أكثر من 6 مليارات صورة بالإضافة إلى معدل عمليات يصل إلى 10000 عملية في الثانية، وسرعان ما أدركت الشركة بأن الانتقال إلى قاعدة بيانات غير علائقية تعتمد على المستندات سيُساعدها على زيادة قابلية تطوير الموقع وتحسين أدائه وزيادة إنتاجية وقت البرمجة. يتيح نموذج مستند MongoDB للمطورين تخزين البيانات بالطريقة التي هي عليها بدلًا من محاولة تحويلها لتناسب نوع قواعد بيانات معين، من خلال عملية Normalization وهي عملية تنظيم البيانات في قاعدة البيانات (لمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على مقال فهم عملية التوحيد Normalization المستخدمة عند تصميم قاعدة البيانات)، قارنت الشركة بين العديد من أنظمة قواعد البيانات البديلة الأخرى مثل BerkeleyDB أو CouchDB أو Cassandra لتستقر في النهاية على MongoDB لإدارة وتخزين بيناتها وأكدت الشركة أنها مسرورة بقرارها الانتقال من Oracle إلى MongoDB واستطاعت توفير 20% من النفقات المتعلقة بقواعد البيانات بعد هذا الانتقال بحسب تصريح أحد مهندسيها. إذا أردت الاطلاع على مقارنة شاملة وسريعة حول كل من MongoDB و MySQL، فيمكنك مشاهدة الفيديو الآتي: الخاتمة تعرفنا في هذا المقال على أهمية قواعد البيانات في الشركات وأخذنا نظرة سريعة إلى سرعة تطورها مع كثرة الاعتماد عليها وبعدها اطلعنا على نظامي إدارة قواعد البيانات MySQL و MongoDB وتعمقنا في فهم الاختلافات والتشابه بينهما من خلال الاطلاع على المجتمع والشعبية وقابلية التوسع ومن ثم فهمنا بين مخطط البيانات وتنوعها بين كِلا النظامين كما تعرفنا على تشابه سرعة وأداء النظامين ولنتعرف بعدها على طريقة حماية قواعد البيانات وإيفاء كل نظام بخصائص ACID ولندخل بعدها بالعمق أكثر من خلال معرفة كيفية كتابة الاستعلامات بينها ومن ثم سهولة تعلم المبتدئين لهذين النظامين وأجبنا بعدها على السؤال المكرر في الأوساط التقنية وهو أيهما أفضل MySQL vs MongoDB؟ كما اختتمنا المقال من خلال معرفة متى نستخدم كل منهما. وختامًا يعتمد القرار النهائي على متطلبات المشروع ونوعية بياناته الذي نعكف على تطويره لذلك يجب أن تكون متطلبات المشروع واضحة، وعمومًا ستقدم كلتا قاعدتي البيانات أداءً مُرضيًا للغاية إذا طبقت في سياق يناسبها. المصادر مقال ?What is MongoDB لصاحبه Jack Vaughan. مقال ?THE WORLD HAS CHANGED – WHY HAVEN’T DATABASE DESIGNS لكاتبه Avishai Ish-Shalom. مقال MongoDB vs MySQL: The Differences Explained لكاتبه Mauro Chojrin. مقال ?What are the main differences between MongoDB and MySQL لمحرري الموقع. مقال How to work with data using MongoDB Query Language لصاحبه Prashanth Jayaram. مقال MongoDB Query Language لمحرري الموقع. اقرأ أيضًا كتاب تصميم قواعد البيانات كتاب الدليل العملي إلى قواعد بيانات PostgreSQL توثيق SQL
-
تطورت أطر عمل جافاسكربت للواجهات الأمامية في السنوات الأخيرة بوتيرة سريعة للغاية، الأمر الذي جعل الكثير من المبتدئين يتيهون في اختيار ما هو الأنسب لهم، ولم يقتصر الأمر على المبرمجين فحسب وإنما يعاني بعض رواد الأعمال أيضًا في اختيار الإطار المناسب لمشروعهم، فإذا كنت من هؤلاء الأشخاص ولم تستطع تحديد إطار عمل جافاسكربت المراد استخدامه للواجهات الأمامية، فسيساعدك هذا المقال في اتخاذ قرار المناسب. سنغطي في هذا المقال جوانبًا مختلفة من أطر عمل Angular و Vue و React لنرى كيف تناسب احتياجاتك. هذا المقال ليس مجرد مقارنة بين هذه الأطر وإنما سنحاول جعله هيكلًا معياريًا للمساعدة في الحكم على أطر عمل جافاسكربت في الواجهة الأمامية بشكل عام. في حالة إصدار إطار عمل جديد في العام المقبل، ستعرف بالضبط ما هي الأمور التي يجب عليك النظر إليها في الإطار الجديد! تاريخ ونبذة موجزة لأطر العمل Angular vs React vs Vue قبل أن ندخل في التفاصيل التقنية لنتحدث أولًا عن التاريخ الموجز وراء هذه الأطر فقط لفهم مدى نضوجها وتطورها بمرور الوقت. في الجدول أدناه نلاحظ المعلومات الأساسية لكل إطار. table { width: 100%; } thead { vertical-align: middle; text-align: center; } td, th { border: 1px solid #dddddd; text-align: right; padding: 8px; text-align: inherit; } tr:nth-child(even) { background-color: #dddddd; } وجه المقارنة إطار العمل Angular إطار العمل React إطار العمل Vue.js تاريخ صدوره 2010 2013 2014 الموقع الرسمي angular.io reactjs.org vuejs.org الإصدار الحالي 13.x 17.x 3.x فريق التطوير شركة غوغل وجمهور المطورين شركة فيسبوك وجمهور المطورين جمهور المطورين فقط تاريخ موجز عن إطار العمل Angular صدر إطار العمل Angular (ويعرف سابقًا AngularJS) لأول مرة في عام 2010 والذي طورته شركة غوغل مما يجعله الأقدم بين الإطارات، وهو إطار عمل جافاسكربت مفتوح المصدر قائم على TypeScript. صُممُ هذا الإطار لمساعدة المطورين على حل المشكلات عند إنشائهم لتطبيقات الصفحة الواحدة SPA وليتمكّنوا من بناء صفحات ويب ديناميكيّة باستخدامهم لنصوص تصريحية بسيطة. يتبع هذا الإطار النمط الهيكلي MVC (وهي اختصار Model-View-Controller أي نموذج-طريقة عرض-مُتحكِّم) وبنية MVVM (وهي اختصار Model-View-View-Model أي نموذج-طريقة عرض-طريقة عرض-مُتحكِّم) وغيرها من الأنماط الهيكلية المختلفة، مما يجعلها قادرة على رفع مستوى الأمان والمرونة وسهولة التوسع في صفحات الويب، وكذلك ترتيب عملية تبادل المعلومات. حدث تحول كبير في عام 2016 عندما أصدرت غوغل إصدار Angular 2 إذ أسقطت "JS" من الاسم الأصلي AngularJS وأصبح Angular فقط، وبالرغم من ذلك لا يزال AngularJS (الإصدار 1) يتلقى تحديثات، سنركز المناقشة على أحدث إصدار مستقر وهو Angular 13، والذي صدر في نوفمبر 2021. تعد بنية Model–View–Controller بنيةً تفصل بين صفحة الويب التي تعرض المعلومات View ومخزن المعلومات Model باستخدام العقل المدبر أو المتحكم Controller، الأمر الذي من يسهل كتابة الشيفرة البرمجية وصيانتها وتعديلها ويزيد من نسبة الأمان. تاريخ موجز عن إطار العمل React إطار العمل React (والمعروفة أيضًا باسم ReactJS) وهي مكتبة جافاسكربت مفتوحة المصدر تُستخدَم لبناء واجهات المستخدم طورتها شركة فيسبوك (ميتا حاليًا) وصدرت في عام 2013، وتستخدم الشركة إطار العمل React في العديد من منتجاتها (مثل منصة فيسبوك وانستغرام وواتساب). صُمّم إطار العمل React بصورة أساسية لمساعدة المطورين على حل المشكلات المتعلقة بتوفير البيانات الكثيرة بطريقة فعالة لقواعد البيانات الكبيرة، ويعتمد إطار عمل React على مفهوم المكوّنات Components، إذ يجب عليك في البداية بناء مكوّنات مُغلَّفة تُدير حالتها الخاصّة، ومن ثمّ تُركِّب هذه المكوّنات مع بعضها لإنشاء واجهات مستخدم. تاريخ موجز عن إطار العمل Vue.js إطار عمل Vue.js (والمعروف أيضًا باسم Vue أو VueJS)، ويعد هذا الإطار الأصغر سنًا بين أعضاء مجموعة المقارنة. طور هذا الإطار إيفان يو Evan You (الموظف السابق في شركة غوغل) في عام 2014. بعد عمل إيفان مع إطار العمل Angular قرر إنشاء مكتبة جافاسكربت مماثلة باستخدام مزايا Angular وجعل إطار العمل الجديد أكثر خفة وسهولة، ولهذا السبب يوجد الكثير من القواسم المشتركة بين الإطارين. شهد إطار العمل Vue على مدار السنوات الماضية تحولًا كبيرًا في شعبيته، وبالرغم من أنه لا يحظى بدعم من شركة كبيرة مثل سابقيه، إلا أنه استطاع الحصول على حصة جيدة في سوق أُطر عمل جافاسكربت. يعتمد تطوير هذا الإطار كليًا على مشاركات جمهور المطورين. نظرة أعمق لمميزات ومساوئ كل إطار سنغوص الآن أكثر ونفهم أهم المزايا والعيوب الرئيسية لهذه الأطر والفروقات بينها وذلك لمساعدة المتخصصين أو المهندسين التقنيين في اختيار الأفضل لاحتياجات التطوير الخاصة بهم. سوق العمل كمبرمج مبتدئ يجب أن نهتم في البداية إلى اتجاهات السوق ومتطلباته وكما يتضح من اتجاهات أواخر عام 2018، فإن عدد الوظائف التي تتطلب مجموعة مهارات استخدام إطار Angular أو React هو نفسه تقريبًا، في حين أن Vue لا يزال جزءًا بسيطًا من هذه الحصة (حوالي 20٪ من نسبة عدد فرص العمل في بقية الأطر)، وعمومًا هذه الإحصائية قديمة وعامة وإذا رغبت في إحصائية أكثر حداثة فيمكنك تجربة البحث عبر Google Trends، والذي يستعرض اتجاهات البحث على مدار مدة زمنية معينة لوظائف React، ووظائف Angular، ووظائف Vue. تعمل مؤشرات غوغل أيضًا على تقسيمها حسب الموقع الجغرافي في حال رغبت في البحث في سوق العمل في بلدك. ومن الناحية النموذجية فإن أفضل رهان للمبتدئ من وجهة نظر سوق العمل الحالي هو أن يتعلم Angular أو React، نظرًا لأن شعبية إطار العمل Vue.js ما تزال محدودة فإن استخدامه محدودًا في الشركات الكبيرة، ويمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتبنى هذه الشركات إطار Vue.js في مشاريعها وهذا سيتطلب من الإطار الوصول إلى مستوى أعلى من النضج والذي بدوره يتطلب عددًا أكبر من المطورين يعملون لتحسين إطار العمل Vue.js. المجتمع والتطوير لننظر في المجتمع لتقييم تطوير هذه الأطر، سبق وأن رأينا في جميع الأطر كيف نشرت الإصدارات الإضافية بانتظام خلال السنوات الماضية، مما يشير إلى أن تطوير هذه الأطر مستمر على قدم وساق. دعونا نلقي نظرة على مجتمعات Angular vs React vs Vue فيما يتعلق بالإحصاءات الموجودة في مستودعات GitHub الخاصة بهم ونؤكد أن هذه الأرقام حتى تاريخ كتابة المقال (ولاحظ أن أرقام Vue تشمل أيضًا مستودع Vue 3.0 المنفصل): وجه المقارنة إطار العمل Angular إطار العمل React إطار العمل Vue.js عدد المراقبين 3.1 ألف شخص 6.7 ألف شخص 6.2 ألف شخص عدد النجوم 79 ألف نجمة 181 ألف نجمة 192 ألف نجمة عدد التفريعات 20.7 ألف تفريعة 36.8 ألف تفريعة 31.2 ألف تفريعة عدد المساهمين 1517 مساهم 1535 مساهم 404 مساهم عند المقارنة بين الأطر نلاحظ أن إطار العمل Vue لديه عددًا كبيرًا من المراقبين والنجوم والتفريعات، وهذا يعود لشعبيته بين المستخدمين. ومع ذلك، فإن عدد المساهمين في Vue أقل من Angular و React. أحد التفسيرات المحتملة هو أن Vue مطوّرة بالكامل من قبل مجتمع المصادر المفتوحة، في حين أن كل من إطار العمل Angular و React يطورهما عدد من موظفي غوغل وفيسبوك. من الإحصائيات المهمة أيضًا هي استطلاع الرأي السنوي الذي يجريه موقع Stackoverflow والذي استجاب إليه 67.593 ألف مبرمج جاء فيه تفوقًا واضحًا في استخدام إطار عمل React بالمقارنة مع بقية الأطر. المقياس الإضافي الذي يجب أن نلقي نظرة عليه وهو عدد مرات الاستخدام للإطار في موقع GitHub، والتي يجب تمكينها بواسطة مؤلف المستودع. يوضح هذا عدد المستودعات الأخرى الموجودة على GitHub والتي تعتمد على هذا المستودع. يُظهر إطار العمل Angular بأن عدد مستخدميه 2.1 مليون مستخدم، بينما يُظهر إطار العمل React حاليًا ما يقرب من 8.7 مليون مستخدم، بينما لا يُظهر إطار العمل Vue عدد مستخدميه. تحديث الشيفرات البرمجية نظرًا لأن بعض المشاريع كبيرة وتحتاج لدراسة كيفية تحديث على الشيفرة البرمجية وجعلها مواكبة لإطار العمل وأفضل الممارسات الخاصة به فيجب أن ننظر إلى كيفية تحديث الشيفرة لكل إطار. في الحقيقة غالبًا ما ستواجه العديد من المشكلات عند تحديث الشيفرة من إصدار إلى آخر، لذلك من المهم أن تبقى مطلعًا بصورة دائمة على تحديثات أُطر العمل لأن بعض التحديثات تكون مهمة وتتطلب تعديلات تتراوح بين بسيطة إلى كبيرة وهذا يؤثر على سير العمل كبيرًا، تخيل أنك كل فترة مضطر إلى تعديل الشيفرة التي كتبتها عند نزول كل تحديث، فهذا مرهق ومضيعة للوقت وذلك فقط للحفاظ على توافق مكونات إطار العمل. في إطار عمل Angular تكون التحديثات الرئيسية مجدولة كل ستة أشهر. هناك أيضًا فترة ستة أشهر أخرى قبل إهمال أي واجهات برمجة تطبيقات رئيسية، مما يمنحك وقتًا كبيرًا نسبيًا (سنة كاملة) لإجراء التغييرات اللازمة -إن وجدت- وتعديل الشيفرة بما يتناسب مع التحديث. في الحقيقة عندما يتعلق الأمر بالاستقرار فإن React هي المسيطرة إذ ذكرت شركة فيسبوك بأن الاستقرار له أهمية قصوى بالنسبة لهم، لأن العديد من الشركات الكبرى تستخدم هذا الإطار، وعادةً ما تكون الترقيات من خلال الإصدارات هي الأسهل في إطار العمل React، إذ تساعدك السكربتات البرمجية مثل سكربت react-codemod على تحديث الشيفرة البرمجية بسهولة. أما بالنسبة لإطار العمل Vue.js فيمكن اعتبارها الأسهل وهذا ما نلاحظه في قسم تحديث الشيفرة البرمجية في توثيق Vue 3 إذ أشار إلى أن هناك الكثير من التشابه بين Vue 2 و Vue 3 بينما 90٪ من واجهة برمجة التطبيقات هي نفسها وإذا أردت تحديث الشيفرة البرمجية من الإصدار 1.x إلى الإصدار 2.x فهناك أداة مساعدة لتحديث الشيفرة والتي تعمل على وحدة التحكم لتقييم حالة التطبيق الخاص بك. فعالية إطار العمل سنستعرض فعالية أُطر العمل من خلال أهم الخصائص التي نحتاجها في كل مشروع، من بينها الحجم الكلي للشيفرة البرمجية وأوقات التحميل، والمكونات المتاحة، ومنحنى صعوبة التعلم. الحجم وأوقات التحميل تعد أحجام الأطر صغيرة نسبيًا ولن تكون ذات تأثير كبير نظرًا لأن عمليات التخزين المؤقت Caching وعمليات التصغير Minification تُعدان من بديهيات التطوير والبرمجة في الوقت الحاضر. بالرغم من ذلك هنالك اختلاف كبير بين أحجام الأطر (على سبيل المثال Angular هي الأكبر حجمًا)، إلا أنها لا تزال صغيرة بالمقارنة بمتوسط حجم صفحة الويب (حوالي 2 ميجابايت وفقًا لبيانات موقع httparchive). بالإضافة إلى ذلك فإذا كنت تستخدم شبكات توزيع المحتوى CDN لهذه المكتبات فمن المحتمل جدًا أن يكون المستخدم نزّل بالفعل المكتبة في نظامه المحلي أثناء تحميل الموقع. في الحقيقة مع وجود الجيل الرابع والخامس من الاتصالات واتصالات الألياف الضوئية فايبر لن تكون هذه النقطة ذات أهمية ولذلك لن نتوسع بشرحها. المكونات المكونات هي من أهم الأجزاء في جميع الأطر الثلاثة، بغض النظر عما إذا كنا نتحدث Vue أو React أو Angular. يحصل المكون عمومًا على مدخلات، ويغير السلوك بناءً عليه. يظهر هذا التغيير في السلوك عمومًا كتغيير في واجهة المستخدم لجزء من الصفحة. يسهل استخدام المكونات عملية إعادة استخدام التعليمات البرمجية. يمكن أن يكون المكون عبارة عن سلة مشتريات على موقع التجارة الإلكترونية أو مربع تسجيل الدخول على شبكة اجتماعية. المكونات في إطار العمل Angular يتعامل إطار العمل Angular مع الوحدات modules والتي بدورها تضم المكونات، وتُعَدّ المكوِّنات أحجار البناء الأساسية قي تطبيق Angular، فيحتوي المكوِّن على صنف TypeScript مع مزخرِف @Component() وقالب HTML وملف التنسيقات، حيث يعرِّف مزخرِف @Component() المعلومات التالية في Angular: محدِّد CSS الذي يعرِّف الطريقة التي سيُستخدَم بها المكوِّن ضمن قالب ما، حيث تصبح عناصر HTML التي تستخدمها ضمن القالب الخاص بك والتي تطابق هذا المحدِّد نسخةً من هذا المكوِّن. قالب HTML الذي يوجّه Angular إلى كيفية إخراج هذا المكوِّن. مجموعة اختيارية من تنسيقات CSS التي تعرِّف المظهر الخاص بعناصر قالب HTML. المكونات في إطار العمل React يجمع إطار العمل React المكونات بطريقة مثيرة للاهتمام بين واجهة المستخدم وسلوك المكونات في نفس الشيفرة البرمجية لتكون مسؤولةً عن إنشاء عنصر واجهة المستخدم وإملاء سلوكه (يمكنك الاطلاع على مقال مكونات React الأساسية (React Components) لمزيد من المعلومات عن المكونات في إطار العمل React). المكونات في إطار العمل Vue عند النظر إلى Vue نجد أن واجهة المستخدم والسلوك أيضًا جزءًا من المكونات بطريقة مشابهة لمكونات React، مما يجعل التعامل مع المكونات أكثر سهولة. كما ستجعل الأمور قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح للمبرمج بدمج واجهة المستخدم وسلوك المكونات من داخل الشيفرة البرمجية. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا استخدام المعالجات المسبقة pre-processor في Vue بدلًا من CSS، وهذا أمر رائع. كما يعد إطار العمل Vue رائعًا عندما يتعلق الأمر بالتكامل مع المكتبات الأخرى، مثل Bootstrap. صعوبة التعلم من أهم الأسئلة التي ترد في ذهن المتعلم هو مدى صعوبة تعلم كل من هذه الأطر؟ سنحاول الإجابة على هذا السؤال. يكون لإطار العمل Angular منحنى تعليمي حاد وصعب التعلم نسبيًا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه حل كامل ومتكامل، ولإتقان Angular يتطلب منك تعلم المفاهيم المرتبطة به مثل TypeScript و MVC. في الحقيقة وبالرغم من أن تعلم Angular يستغرق وقتًا، إلا أن الاستثمار فيه يؤتي ثماره ولأن المتعلم سيفهم تمامًا كيفية عمل الواجهة الأمامية لتطبيقات الويب. يعد إطار عمل React أسهل نسبيًا ومع المرجع الرسمي الخاص به من شأنه أن يساعد الشخص في إعداد React في غضون ساعة تقريبًا. الوثائق شاملة وكاملة، مع حلول للمشكلات الشائعة الموجودة بالفعل على موقع Stack Overflow. لا يُعد React إطار عمل كاملًا مثل Angular، وتتطلب الميزات المتقدمة استخدام مكتبات خارجية. هذا يجعل منحنى التعلم الخاص بإطار العمل الأساسي ليس شديد الانحدار ولكنه يعتمد على المسار الذي تسلكه وتطبيق الويب الذي تريد بناءه. ومع ذلك، فإن التعلم السريع لاستخدام React لا يعني بالضرورة أنك تستخدم أفضل الممارسات (يمكنك الاطلاع على التوثيق الإرشادي الكامل لإطار React باللغة العربية من خلال موسوعة حسوب). يعد إطار العمل Vue أسهل في التعلم من إطار Angular أو React. علاوة على ذلك، تتداخل Vue مع Angular و React فيما يتعلق بوظائفها مثل استخدام المكونات. ولذلك فإن الانتقال إلى Vue من أي منهما يعد خيارًا سهلًا. ومع ذلك، فإن بساطة ومرونة إطار عمل Vue هي سيف ذو حدين - فهي تسمح بكتابة شيفرة برمجية سهلة البنية بهدف التبسيط ولكن هذا الأمر الذي يمكن يجعل المطورين يُهملون إعداد بنية قوية للشيفرة البرمجية الأمر الذي يصعب عملية توسعة الشيفرة البرمجية أو تصحيح الأخطاء والاختبار لاحقًا عندما يتوسع المشروع. وعمومًا بالرغم من أن Angular و React أصعب نسبيًا، إلا أن استخداماتها عند الإتقان لا حدود لها. على سبيل المثال، يمكنك دمج Angular أو React مع ووردبريس WordPress و WooCommerce لإنشاء تطبيقات ويب تقدمية PWA. أشهر الشركات التي تستخدم هذا الأطر سنستعرض أهم الشركات التي تستخدم هذه الأطر لنرى كيفية تبني هذه التكنولوجيا ونظرة العمالقة لهذه التحديثات. أشهر الشركات التي تستخدم إطار عمل Angular تستخدم شركة غوغل إطار العمل Angular لأنه يوفر لها أداءً عاليًا للوظائف ولإنشاء تطبيقات أكبر. كما يستخدم في تطوير Google Cloud Console. كان Microsoft Office قادرًا على إطلاق تطبيقين مستقلين بمساعدة إطار العمل Angular أما مع حالة شركة Upwork فإنها تستخدمه لتوفير تجربة سريعة الاستجابة لأعضاء الموقع. أشهر الشركات التي تستخدم إطار عمل React في الحقيقة الكثير من الشركات الكبيرة تستخدم React وهذا دليل قوي على مدى جودة إطار العمل. كما يستخدم هذا الإطار عادة لما يوفره من طريقة أسرع لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول وصيانتها، مع استخدام موارد قليلة بالمقارنة مع طرق برمجة التطبيقات الأصيلة. البعض يعدها من أفضل المكتبات لتطبيقات الواجهة الأمامية الموجودة في السوق حاليًا. ومن هذه الشركات التي تستخدم هذا الإطار نذكر تويتر Twitter وأمازون برايم Amazon Prime ويوديمي Udemy وإكسبو Expo وأوبر Uber وبنتريست Pinterest ونيتفليكس Netflix وصحيفة نيويوك تايمز New York Times والكثير من الشركات الأخرى. الشركات التي تستخدم إطار عمل Vue.js يعد إطار عمل Vue.js حديثًا نسبيًا ولكن هناك العديد من الشركات التي تستخدمه. ومن بعض الشركات التي تستخدم Vue نذكر شركة غوغل وآبل وتريفاغو Trivago ونينتندو Nintendo. تمكنت شركة غوغل من استخدام Vue لصفحة الوظائف الخاصة بها، بينما أضافت شركة نينتندو إطار العمل في موقعها على الويب، وأضاف موقع تريفاغو Trivago وهو أحد أشهر المواقع للبحث عن الفنادق في العالم إطار العمل Vue في مجلتهم. واستخدمت شركة آبل Apple إطار Vue لإنشاء دروس SwiftUI الخاصة بهم. بالرغم من حداثة هذا الإطار إلا أن الشركات وجدت فيه السهولة والفعالية المناسبة لإضافته إلى تقنياتها. الجدير بالذكر أن إطار عمل Vue.js غالبًا ما تستخدمه الشركات الصينية العملاقة مثل علي بابا Alibaba وبيدو Baidu وتنسنت Tencent وحتى شركة شاومي Xiaomi وغيرها الكثير، بدلًا من الأطر React أو Angular التي أنشأتها شركات غربية مثل فيسبوك وغوغل. لا نعرف تمامًا سبب هذا التوجه ولكن يُتوقع بأن يستمر السوق الصيني في النمو بسرعة باستخدام إطار العمل Vue خاصة لأنها مكتبة مستقلة مفتوحة المصدر دون أي ارتباط خارجي. كيف نختار الإطار الأنسب لمشروعنا؟ وهنا نأتي لأهم الأسئلة التي تخطر على بالنا وهي كيف نعرف أي الأطر مناسب لمشروعنا؟ وما هي أفضل طريقة لتعظيم فوائد كل إطار؟ كيف تعرف متى نستخدمها بناءً على مزايا وعيوب كل منها؟ إليك دليل سريع لمساعدتك على اتخاذ مثل هذه القرارات. متى نستخدم إطار العمل Angular بغض النظر عن شعبية وشهرة كل إطار يعد Angular الأكثر نضجًا بين الأطر، وله دعم جيد من المساهمين وهو حزمة متكاملة ومع ذلك، فإن صعوبة تعلم الإطار ومفاهيم التطوير في إطار Angular عمومًا يمكن أن تؤدي إلى إعاقة المطورين الجدد، وعادة ما يستخدم في المشاريع التالية: المشاريع الكبيرة والمعقدة. المشاريع القابلة للتوسع والموثوقة والمستقرة. المشاريع التي يمتلك مطوروها معرفة مسبقة بلغة TypeScript أو أنهم يستخدمونها بالفعل. متى نستخدم إطار العمل React يعد إطار العمل React الأكثر شيوعًا واستخدامًا في سوق العمل، ويبدو أن لهذا الإطار مستقبلًا مشرقًا. ويعد خيارًا جيدًا لشخص يريد بدء استخدام أطر عمل جافاسكربت للواجهة الأمامية والشركات الناشئة والمطورين الذين يحبون بعض المرونة. كما أن الإطار يمتلك القدرة على الاندماج مع الأطر الأخرى بسلاسة مضيفًا لنفسه ميزة كبيرة في أعين المبرمجين الذين يرغبون في بعض المرونة في الشيفرات البرمجية الخاصة بهم، وعمومًا يعد إطار العمل React حلًا مناسبًا للمشاريع التالية: المشاريع التي يمكن أن تتضمن مكونات قابلة لإعادة الاستخدام المشاريع البسيطة والمتوسطة التي تريد أن تنطلق فيها بسرعة المشاريع التي تتطلب مستوى عالٍ من قابلية التوسع المشاريع ذات مواعيد التسليم القصيرة متى نستخدم إطار العمل Vue.js هو الأحدث في الساحة وبدون أي دعم من شركة كبرى، ومع ذلك نجد بأنه يحقق أداءً جيدًا في السنوات القليلة الماضية ليخرج كمنافس قوي للأطر القديمة، وخاصة مع إصدار Vue 3.0. ربما بسبب اعتماد الكثير من العمالقة الصينيين على هذا الإطار، وعمومًا يمكنك استخدام إطار العمل Vue.js للمشاريع التالية: المشاريع والتطبيقات التي تحتاج لأداء عالي عندما تفتقر إلى مطوري الواجهة الأمامية المهرة فريقك لديه الوقت الكافي للتعرف على التكنولوجيا الجديدة الخاتمة تعرفنا في هذا المقال على الفوارق بين أطر عمل جافاسكربت فبدأنا بسرد موجز مختصر لتاريخ كل منها وفهمنا الفارق بينها في العديد من النواحي مثل سوق العمل ومجتمع المطورين وإقبالهم على تبني كل إطار وتعمقنا في فهم فعالية كل إطار من خلال حجم المكتبات وتأثيرها على أوقات تحميل الصفحة والفرق بين المكونات لنستعرض بعدها أشهر الشركات التي تستخدم هذه الأطر ومتى نستخدم كل واحد منها بناءً على المشروع الذي نعمل عليه ومتطلباتك، وعمومًا من الضروري دائمًا إجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ القرار حول أي إطار أنسب لك، خاصةً إذا كنت ستعمل في مشروع تجاري وليس في مشروع شخصي. بالنسبة للمهندس الحقيقي، لا يوجد فرق جوهري في الإطار الذي يختاره، لأنه يستغرق بعض الوقت فقط للتعود على الإطار الجديد. كل إطار له إيجابياته وسلبياته، مما يعني أنه لا يجب بالضرورة أن يكون هناك خيار صحيح دائمًا، وإنما لكل مقام مقال. تذكر أن أكاديمية حسوب تحتوي على مقالات تعليمية متنوعة حول أطر عمل جافاسكربت تلك بالإضافة إلى مئات المقالات حول لغة جافاسكربت نفسها ننصحك باستكشافها وذلك بزيارة قسم لغة جافاسكربت. المصادر مقال ?React vs Angular vs Vue.js — What Is the Best Choice in 2022 لكاتبته Romana Kuts. مقال Angular vs React vs Vue: Which Framework to Choose لكاتبه Shaumik Daityari. مقال Tech Trends Showdown?: React vs Angular vs Vue لكاتبه Andrei Neagoie. تقرير موقع httparchive Report: Page Weight. تقرير موقع Stackoverflow. اقرأ أيضًا مقدمة في مفاهيم Angular مدخل إلى الواجهات البرمجية API مقدمة في بناء تطبيقات الويب باستخدام إطار العمل Angular وقاعدة بيانات Firestore مكونات React الأساسية (React Components) أساسيات إطار العمل Vue.js
-
مع سرعة تطور الإنترنت والويب وزيادة اعتماد الشركات على الويب تجلت أهمية التصميم المرن والتخطيط سريع الاستجابة والأنماط التفاعلية مع المستخدم والتخطيط الشبكي لصفحات الويب والكثير من الأمور الأخرى، وبدأت تظهر جدلات آنذاك بين أهمية التصميم أم المحتوى؟ ولكن لا يمكننا النظر إلى هذين العنصرين على أنهما متنافسين بقدر ما هما متكاملين لأنه في الحقيقة ومع أن المحتوى هو العمود الفقري لأي موقع إنترنت إلا أن التصميم ما هو إلا أداة إيصال هذا المحتوى للمستخدم لذلك أهميته توازي أهمية المحتوى لأن واجهة الموقع ذات التصميم السهل تخلق انطباعًا أوليًا رائعًا في أذهان المستخدمين، وهذا هو سبب زيادة تركيز مطوري الويب على تطوير واستخدام أدوات تساعدهم في الوصول تصاميم رائعة بأقل مجهود ووقت ممكن. لذلك بدأت تظهر في السنوات القليلة الماضية أدوات ومكتبات وأطر عمل تسرع من عملية تطوير وواجهات المستخدم ويُعرفُ إطار العمل Framework في البرمجة على أنه أداة توفر مكونات أو حلول جاهزة لتخصيصها من أجل أي مشروع بهدف تسريع عملية التطوير، ويمكن أن يشتمل الإطار على مكتبة أو مكتبات مساعدة، كما يوفر إطار العمل الدوال القياسية منخفضة المستوى لتمكن المطورين من التركيز على صلب المشروع وعدم إضاعة وقتهم في الأمور المتكررة. من بين التي الأطر التي ذاع صيتها نذكر Bootstrap و Skeleton و Bulma و Tailwind CSS و Materialize. تتعددُ أهداف هذه الأدوات والأطر المخصصة للواجهات الأمامية فمنها ما تركز على بناء مكتبة مكونات كبيرة جاهزة للاستخدام في المشاريع، ومنها ما تركز على إتاحة الأساسيات لتمكن المطورين تخصيص مواقعهم، هذا التنوع جعل كل مطور يتجه إلى الإطار الذي يناسب متطلباته، ولكن من بين الأطر الذي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة Bootstrap و Tailwind CSS سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على هذين الإطارين وسنطلع على سر قوة وشعبية Bootstrap والاهتمام السريع والمتزايد لإطار Tailwind CSS ولنستكشفُ بعدها أيهما أفضل Tailwind CSS أم Bootstrap. نسعى لتجنب التحيز بين هذين الإطارين ولكن بالتأكيد هناك بعض المشاريع يتناسب معها إطار معين أكثر من الآخر وهذا أمر طبيعي، كما نفترض في هذا المقال بأن لديك معرفة أساسية بتقنيات تطوير الويب وكيفية عمل المواقع. نبذة موجزة عن Bootstrap و Tailwind CSS في ظل التطور السريع لتقنيات الويب يجب على المطورين دومًا تحليل أي تقنية جديدة من خلال الاطلاع على إيجابياتها وسلبياتها قبل اعتمادها في عملهم ومشاريعهم الجديدة، منذ ظهور إطار العمل Bootstrap عام 2011 أصبح عنصرًا أساسيًا من عناصر تطوير الويب، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر إطار عمل جديد وسرعان ما حظي باهتمام كبير في مجتمع المطورين وهذا الإطار هو Tailwind CSS. لنفهم ماهية كل من هذين الإطارين بالتفصيل. ما هو Bootstrap؟ بحسب تعريف الموقع الرسمي لإطار Bootstrap هو إطار عمل للواجهات الأمامية لمواقع الويب مجاني ومفتوح المصدر، طوّر هذا الإطار اثنان من المبرمجين وهما مارك أوتو Mark Otto وجاكوب ثورتون Jacob Thorton في مسابقة داخلية في شركة تويتر Twitter في أغسطس 2011، وهو يتكون من شيفرات برمجية بلغة HTML و CSS وجافاسكربت، وصمم خصيصًا لتسهيل عملية تطوير الويب لمواقع الويب المتجاوبة والتي تعتمد على التصميم للهواتف المحمولة أولًا Mobile First Design من خلال توفير مجموعة من المكونات تعمل على جميع أحجام الشاشات، بل إن هذا الإطار قائمًا على المكونات إذ يأتي مع مجموعة من المكونات الجاهزة للاستخدام وذلك لتسريع تصميم موقع الويب، كما أن الشيفرة البرمجية الخاصة بملفات التنسيق CSS موجه للكائنات، وهو يعمل مع معظم المتصفحات من بينها متصفح غوغل كروم Chrome وإنترنت إكسبلور Internet Explorer …إلخ. يعد إطار العمل Bootstrap سهل التعلم لأي شخص مبتدئ بلغة CSS، كما تتوافر الكثير من الدورات التعليمية عبر الإنترنت لمساعدتك على البدء. ولا تتطلب مكوناته سوى معرفة أساسية بلغة HTML و CSS و جافاسكربت لتعديلها. يأتي إطار العمل Bootstrap بنظام شبكة محدد مسبقًا يتكون من صفوف وأعمدة، مما يتيح للمطور إنشاء شبكة داخل شبكة بالإضافة إلى ذلك، يجعل نظام الشبكة واجهات الموقع أكثر وضوحًا للمستخدمين والمطورين. ومكونات هذا الإطار متوافقة مع أحدث إصدارات المتصفحات الشائعة. كما يمكنك أيضًا استخدام مكوناته في تصميمات أنظمة إدارة المحتوى الشائعة مثل ووردبريس WordPress وجوملا غيرها. ما هو Tailwind CSS؟ هو إطار عمل CSS أول من نوعه يقدم أدوات مساعدة بالدرجة الأولى Utility-First أكثر مما يقدم مكونات جاهزة إذ يتيح لك إنشاء واجهات مستخدم مخصصة مع الحد الأدنى من الشيفرة البرمجية لملفات تنسيق CSS. كما يمنحك تحكمًا كاملًا في واجهة واجهة المستخدم الخاصة بك من خلال الأصناف Classes الموجودة فيه. يساعد إطار عمل Tailwind CSS في السيطرة على التصميم ويجعله فريدًا لأن الإطار لا يفرض سمة افتراضية يجب عليك استخدامها مثل أطر CSS الأخرى. فمثلًا يمكنك إعطاء كل مشروع مظهرًا مختلفًا حتى إذا كنت تستخدم نفس العناصر (لوحة الألوان والحجم وما إلى ذلك). لذلك فهو من أطر العمل القليلة التي لا تفرض طريقة معينة لتصميم مشروعك. بل إنه من أسرع الأطر عندما يتعلق الأمر بدمج التصاميم مع ملفات HTML. بناءً على ما سبق، يمكنك بسهولة إنشاء تخطيطات لعناصر الواجهات الأمامية من خلال آلاف الأصناف المضمنة التي لا تتطلب منك سوى استدعائها في التنسيق للعنصر. لذلك لا يتعين عليك كتابة قواعد التنسيق CSS بنفسك. تعد أصناف CSS هذه هي السبب الرئيسي وراء سرعة البناء والتصميم باستخدام Tailwind، بالإضافة إلى ذلك يمكن إزالة جميع أصناف CSS غير المستخدمة عبر أداة PurgeCSS والتي تساعدك على إبقاء الشيفرة البرمجية لملفات التنسيق CSS النهائية صغيرة الحجم. مقارنة بين Tailwind CSS vs Bootstrap لندخل أكثر في التفاصيل ولنطلع على أهم الفروقات بين هذين الإطارين. المجتمع والتطوير لننظر أولًا في المجتمع لتقييم تطوير هذه الأطر، عندما نرى أن الإطار حصل على الكثير من التحديثات فهذا أمر إيجابي ويشير إلى أن تطوير هذه الأطر مستمر على قدم وساق. دعونا نلقي نظرة على مجتمعات Tailwind CSS vs Bootstrap فيما يتعلق بالإحصاءات الموجودة في مستودعات GitHub الخاصة بها ونؤكد أن هذه الأرقام حتى تاريخ كتابة المقال. table { width: 100%; } thead { vertical-align: middle; text-align: center; } td, th { border: 1px solid #dddddd; text-align: right; padding: 8px; text-align: inherit; } tr:nth-child(even) { background-color: #dddddd; } وجه المقارنة إطار العمل Bootstrap إطار العمل Tailwind CSS الموقع الرسمي Bootstrap Tailwindcss تاريخ أول إصدار 2011 2017 رقم الاصدار v4.6.1 v3.0.18 عدد المراقبين 7 آلاف شخص 567 شخص عدد النجوم 155 ألف نجمة 53.3 ألف نجمة عدد التفريعات 76.1 ألف مستودع مشتق 2.6 ألف تفريعة عدد المساهمين 1274 مساهم 214 مساهم يلعبُ قِدم إطار Bootstrap والذي يصل عُمره لأكثر من 12 سنة دورًا مهمًا في شعبيته ومن الطبيعي أن نجد له مجتمعًا كبيرًا من المطورين والأدوات والمنتديات وما إلى ذلك. أما إطار Tailwind CSS فلا يزال جديدًا وينمو بسرعة كبيرة ويتزايد مستخدميه ومطوريه يوميًا، ولنتذكر دومًا بأن المجتمع الأكبر للمطورين يمكن أن يساعدك في الحصول على المساعدة بصورة أسرع عند مواجهة أية مشكلة في التنفيذ. المكونات الجاهزة وقابلية التخصيص يوجد العديد من المكونات الجاهزة للاستخدام في إطار Bootstrap إذ يوجد أكثر من 40 عنصرًا جاهزًا مثل الشريط الرأسي للموقع Headerbar وعناصر التنقل Navigation وتذييل الموقع Footer والاستمارات Forms والنوافذ الشرطية Modals والعديد من مكونات واجهة المستخدم الأخرى. يتميز Bootstrap إطار بأسلوب مرئي متسق وتحتوي غالبية مواقع الويب التي تستخدم هذا الإطار على نفس عناصر التنقل والهيكل والتصميم، مما يجعلها تبدو غير احترافية. ولكن الأمر المفيد هو أنه إذا كنت مبتدئًا ولا تعرف الكثير عن لغة CSS فمن السهل جدًا استخدام الإطار وإنشاء قالب موقع ويب جيد. بالمقابل لا نجد ذلك مع إطار Tailwind CSS فلا يوجد مكونات جاهزة سواء من الإطار بحد ذاته ولكن يوجد القليل من المكونات المقدمة من المجتمع، وفي الحقيقة يجد المطورون بأن أفضل ميزة في Tailwind CSS هو أنه يقدم أدوات مساعدة بدلًا من مكونات جاهزة، ولذلك فأنه تتيح قابلية التخصيص بدرجة كبيرة أي أنه يمكنك إنشاء تصاميم وواجهات مستخدم مخصصة بطريقة ممتازة باستخدام الأصناف Classes التي يوفرها إطار العمل وبدرجة مقبولة من المجهود في كتابة الشيفرة البرمجية. يمكنك بسهولة الاستفادة من تصميم كل مكون على حدة بالطريقة التي تتطلبها واجهة المستخدم الخاصة بك. بنية الشيفرة البرمجية يعمل إطار Tailwind بطريقة مختلفة عن معظم أطر عمل CSS إذ يمزج بين قواعد الأنماط مع ملفات HTML الخاصة بك أي أن الشيفرة البرمجية الخاصة بالتنسيق باستخدام الأصناف ستكون موجودة بالكامل مع شيفرة HTML، وهذا يتعارض مع مبدأ "فصل الاهتمامات" Separation Of Concerns أو اختصارًا SoC، الذي هو أحد المفاهيم الرئيسية في علوم الحاسوب وهو تحديدًا من مبادئ تصميم الشيفرة البرمجية والتي تنص على فصل الشيفرات البرمجية لبرامج الحاسوب إلى أقسام متميزة وكل قسم يعالج مشكلة منفصلة. يفضل العديد من المطورين فصل بنية الصفحة عن تصميمها من خلال ملفات التنسيق، ولكن استخدام الكثير من الأصناف تجعل عملية كتابة الشيفرة البرمجية طويلة. أما في إطار العمل Bootstrap فنجد أن قواعد التنسيق مفصولة عن الهيكل الأساسي للصفحة وبالرغم من أن هنالك بعض المبرمجين يخطئون ويدمجون قواعد التنسيق داخل ملفات HTML إلا أن الإطار بحد ذاته لا يشجع على هذه الممارسات. بالإضافة إلى ذلك هنالك الفرق بين مبادئ التصميم في Bootstrap و Tailwind CSS فإطار العمل Bootstrap يستخدم منهجية Object Oriented CSS أو اختصارًا OOCSS لأنه يستخدم كائنات مثل عناصر التنقل والاستمارات …إلخ، وطرقًا لتفاعل المستخدم مع تطبيقات ومواقع الويب. بينما يوفر Tailwind CSS مجموعة أصناف يمكنك إضافتها أو إزالتها أو تحريرها في ملف الإعداد Tailwind.config.js الخاص بالإطار حتى تتمكن من تخصيص التصميم الخاص بك، كما يوجد أصناف لجميع أنواع الهوامش والحشو والخلفيات وأحجام الخطوط ومجموعات الخطوط والموضع ومن بعض الأمثلة عن هذه الأصناف نذكر flex و pt-4 و text-center و rotate-90 وغيرها، وإليك هذا المثال لفهم هذه الاختلافات. <!DOCTYPE html> <html> <head> <!-- Tailwind CSS --> <link href= "https://unpkg.com/tailwindcss@^1.0/dist/tailwind.min.css" rel="stylesheet"> <title>Tailwind CSS</title> </head> <body style="background-color: gray;"> <!--Card 1--> <div class=" w-full lg:max-w-full lg:flex"> <div class="border-r border-b border-l border-gray-400 lg:border-l-0 lg:border-t lg:border-gray-400 bg-white \rounded-b lg:rounded-b-none lg:rounded-r p-4 leading-normal"> <p class="text-gray-700 text-base"> This Card is made using Tailwind CSS. </p> </div> </div> </body> </html> بينما لاحظ كيف ستكون نفس الصفحة ولكن بإطار عمل Bootstrap: <!DOCTYPE html> <html> <head> <!-- BOOTSTRAP --> <link rel="stylesheet" href= "https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity= "sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous"> <title>BOOTSTRAP</title> </head> <body style="background-color: gray;"> <div class="card"> <div class="card-body"> This Card is made using BOOTSTRAP. </div> </div> </body> </html> في الحقيقة هذه النقطة من أكثر النقاط إثارة للجدل على مستودع إطار العمل في موقع Github ولكن مع ذلك نشهد زيادة كبيرة في الإقبال على هذا الإطار الأمر الذي يدل على وجود محبين لهذه الطريقة من الشيفرات البرمجية. دعم المتصفحات قد لا يلتفت الكثير إلى هذه النقطة ولكن قد يضطر المبرمج في مرحلة أو مشروع ما إلى النظر لأمر دعم المتصفحات، فيدعم إطار العمل Bootstrap أحدث الإصدارات لغالبية المتصفحات المدمجة في الأنظمة الأساسية مثل نظام التشغيل ويندوز ومتصفح إنترنت إكسبلورر Internet Explorer 10-11 (يذكر أن هذا المتصفح سينتهي دعمه في 22 حزيران عام 2022) أو مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge، وإذا كنت بحاجة لدعم النسخ القديمة من المتصفحات مثل مايكروسوفت إكسبلورر IE8-9، فننصحك باستخدام الإصدار Bootstrap 3. بالنسبة لإطار العمل Tailwind CSS فهو يدعم أيضًا أحدث الإصدارات من المتصفحات مثل كروم Chrome وفيرفوكس Firefox ومايكروسوفت إيدج وسفاري Safari. ولكن لا يدعم Tailwind CSS v3.0 أي إصدار من متصفح إنترنت إكسبلورر IE وإذا أردت دعم المتصفح IE 11 فنوصي باستخدام Tailwind CSS v1.9، والذي لا يزال خيارًا جيدًا ومنتجًا للغاية بالمقارنة مع الطرق القديمة لكتابة الشيفرات الخاصة لملفات التنسيق CSS. السرعة والأداء في إطار العمل Bootstrap يوجد عدد هائل من المكونات والوظائف وهذا يعني تضمين ملفات كبيرة الحجم إلى تبعيات المشروع. يمكن أن يؤدي استخدام الإطار في مشروعك إلى إبطائه وزيادة وقت تحميل الموقع وبالطبع إثقال كاهل الخادم أيضًا. لتجنب هذه المشكلة تأكد من إضافة الأصناف التي تحتاجها فقط واستخدم الإصدار المصغر أو المضغوط gzip من الملفات الإطار. بالمقابل بما أن إطار Tailwind CSS ليس به أي مكونات مُعدة مسبقًا الأمر الذي ينعكس على صغر حجم الملفات والتبعيات الخاصة به، وعمومًا إذا لم تكن بحاجة إلى مجموعة كبيرة من المكونات والوظائف التي توفرها Bootstrap فإن إطار Tailwind هي الخيار الأفضل للمشاريع البسيطة وخفيفة الوزن. سهولة التعلم للمبتدئين يعد إطار العمل Bootstrap سهل الاستخدام لديه منحنى تعليمي بسيط في البداية ويمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم كافة الأصناف والمكونات المتاحة كما أنه يوجد العديد من الدورات والمقالات الفيديوهات المتاحة عن هذا الإطار الأمر الذي يجعل رحلة التعلم سهلة نسبيًا. يتطلب إطار Tailwind CSS وقتًا أطول للتعلم، وحتى بالنسبة للمطورين ذوي الخبرة، يمكن أن يكون من الصعب تعلم كيفية استخدام الأصناف المُعدة مسبقًا والاستفادة منها بالطريقة المثلى، ولكن كما هو الحال مع أي تقنية جديدة فإن الممارسة وكثرة الاستخدام ستُمكننا من الاستفادة من كافة المميزات، بالإضافة إلى ذلك يفتقر إطار Tailwind CSS للمقالات والدروس والفيديوهات التعليمية وبالرغم من أنها قطعت شوطًا كبيرًا كتقنية ناشئة إلا أنها لا تزال متخلفة عن المنافسين مثل Bootstrap، بعبارة أخرى ضع في اعتبارك أن هذا سيؤدي لاستهلاك وقت إضافي لحل المشاكل. بيئات العمل ودعم اللغات في محرر الشيفرات يزيد عمر إطار العمل Bootstrap عن 12 سنة لذلك نجد بأن معظم محررات الشيفرات البرمجية مثل Sublime و Visual Studio Code و JetBrains تدعمه، وبالمقابل لا نجد هذا الدعم ضمني بالنسبة لإطار Tailwind CSS ولكن يمكن للمحررات المشهورة أن تدعمه من خلال تنزيل إضافة Tailwind CSS IntelliSense لمحرر Visual Studio Code والتي تقدم ميزات متقدمة مثل الإكمال التلقائي وتمييز بعض الجمل والفحص والتحقق من الكتابة الصحيحة في الحقيقة العديد من المحررات الأخرى لديها إضافات أو حلول شبيهة لدعم هذا الإطار. أيهما أفضل Tailwind CSS vs Bootstrap؟ المشكلة الأساسية في إطار العمل Bootstrap هي أن المواقع التي تستخدمه تبدو متشابهة إلى حد ما، وذلك لأن إطار العمل Bootstrap جرّد إنشاء المكونات لدرجة أنه أجبر المطورين على استخدام الأنماط المتوفرة فقط. الشيء نفسه ينطبق على أطر عمل أخرى من نفس المجموعة، ويمكن أن يجادل البعض بأنه يمكن تجاوز الإطار بتخصيص ملفات قواعد التنسيق CSS الخاصة بنا، ولكن مهلًا إذا تجاوزنا إطار العمل كثيرًا، فعندها نعود إلى نقطة مهمة وهي هل هناك فعلًا فائدة من استخدام هذا الإطار؟ لأننا فعليًا سننشئ تنسيقات خاصة بنا ولذلك سيكون إطار العمل مجرد تبعيات إضافية للموقع. أليس كذلك؟! بالمقابل لا يعيق إطار العمل Tailwind CSS قدرتنا على الإبداع في بناء واجهات مستخدم معقدة وإنما يتيح ذلك بسهولة دون فرض تصميم معين على جميع المواقع. كما أن استخدام مجموعة من أصناف الأدوات المساعدة التي تتيح لك العمل مع ما تحتاج إليه بالضبط، وعدم القلق أبدًا بشأن التغييرات التي تطرأ على عنصر معين لأنه التغييرات ستبقى على ذلك العنصر ولن تؤثر على العناصر الأخرى المشابهة. أي لا مزيد من التنقل جيئة وذهابًا بين ملفات HTML وملفات قواعد التنسيق في المحرر الخاص بك، وبعض المبرمجين لا يفضلون ذلك لأن الشيفرة البرمجية الخاصة بصفحات HTML ستكون فوضوية للغاية، وبالمقابل تكون الشيفرة البرمجية لإطار Bootstrap منظمة ونظيفة كما أن إطار Bootstrap يدعم التفاعل بالاعتماد على لغة جافاسكربت فيوفر مثلًا شرائط تنقل وقوائم وحقول إدخال جاهزة الأمر الذي يسهل دخول المبتدئين ويسرّع من العمل على المشروع إن لم يتطلب تخصيصًا. في الحقيقة يمكن أن يكون استخدام إطار Bootstrap مناسبًا أكثر للمبتدئين أو للمطورين الشاملين Full Stack وبالمقابل يكون إطار Tailwind CSS مناسبًا أكثر للخبراء ومطوري الواجهات الأمامية Front End Developer. متى نستخدم Tailwind CSS و Bootstrap؟ يسهل إطار العمل Bootstrap عملية تصميم المواقع على المصممين المبتدئين والذين يسارعون إلى بناء نموذج أولي من الموقع أو تطبيق الويب باستخدام مكتبة ضخمة تحتوي على عدد هائل من المكونات والمشاريع المُقدمة من قبل المجتمع، ولكن بمجرد أن يتطور التطبيق وتتعقد تصاميمه ومتطلباته يحدُ الإطار من عملية التصميم ومرونتها ويصبح عبئًا بدل أن يكون مساعدًا. بالمقابل يعدُ إطار Tailwind CSS حلًا ممتازًا للمطورين المطلعين على لغة CSS والذين يرغبون في تسريع عملية الإنشاء والتصميم على المدى الطويل. ولا يحبذ استخدام الإطار إذا لم تكن معتادًا على لغة CSS أو لا ترغب في قضاء الوقت في تعلم التفاصيل الدقيقة لها. وبالتأكيد أن الأمر يتعلق باحتياجات المشروع وحجمه وإمكانيات الفريق، يمكن أن يساعدك الإطار في توفير وقت التصميم وخصيصًا للمطورين الذين لا يفضلون استخدام المكونات الجاهزة، وبالتالي فإن قضاء الوقت في اختبار هذا الإطار أمر مفيد. وعمومًا إذ سنح لك الوقت في يوم من الأيام فأنصحك بتجربة إطار Tailwind CSS وخصيصًا إذا كنت مطور واجهات أمامية. الخاتمة تعرفنا في هذا المقال على لمحة سريعة عن سرعة تطور واجهات الويب واطلعنا على تسارع تطوير الأدوات والأطر المساعدة لتحقيق السرعة والإنتاجية في عملية التصميم في هكذا أجواء كما تعرفنا على أشهر إطاري عمل وهما Bootstrap و Tailwind CSS كما نظرنا إلى الاختلاف بينهما في المجتمع والتطوير وفي المكونات الجاهزة وقابلية التخصيص وفي بنية الشيفرة البرمجية ودعم المتصفحات لهذه الأطر والسرعة والأداء لكل إطار وسهولة التعلم للمبتدئين وبيئات العمل ودعم اللغات في محررات الشيفرات البرمجة لنختم المقال بفهم أي الإطارين أفضل ومتى نستخدم كل واحد منها. وختامًا يُتوقع من كل إطار عمل أن يسهل من عملية بناء المشاريع البرمجية من خلال توفير بنية أساسية للشيفرات البرمجية المتكررة، وجعل تركيز المبرمج على بناء وإعداد المميزات الإضافية الخاصة بالمشروع هذا هو الهدف وإذا شعرت بأن الإطار أصبح عبئًا على المشروع فعندها لا بد أنك تستخدم الإطار الخاطئ وعندها لا بد من البحث عن الحلول البديلة. المصادر مقال Tailwind CSS vs. Bootstrap: Is it time to ditch UI kits? - LogRocket Blog لصاحبه Obinna Ekwuno. مقال Top 15 Competitive Differences of Tailwind CSS VS Bootstrap لكاتبه Vinod Luhar. مقال 8 Reasons Why Trying out Tailwind CSS is Worth Your Time لصاحبه Matevz Petek. مقال What is a Framework in Programming & Why You Should Use One لصاحبه Ritesh Ranjan. اقرأ أيضًا مواضيع متقدمة في CSS مدخل إلى إطار العمل بوتستراب 5
-
في بداية كل تطبيق أو موقع إلكتروني تظهر إشكالية متكررة دومًا بغض النظر عن المشروع وهي نوع التكنولوجيا المناسبة لبناء الموقع (سواء لغة البرمجة أو إطار العمل) لأن الاختيار المناسب سيلعبُ دورًا مهمًا في نجاح المشروع فإذا اتُخذ قرار خاطئ فيمكن أن يفشل كل شيء في بداية المشروع أو في مراحل متقدمة منه، ولذلك يكون اختيار التكنولوجيا مهمة شاقة للشركات الصغيرة والناشئة التي تعمل عادةً بخبرات وموارد مالية محدودة، وكلما كانت الشركة أصغر كان تأثير القرار السيئ أكثر مأساوية لموارد الشركة. يتضمن أي موقع إلكتروني جانبين أساسيين وهما جانب العميل Front-end وهو الجانب المرئي من الموقع ويتضمن شيفرة برمجية من اللغة الهيكلية HTML و CSS لتنسيق الصفحات والعرض ولغة جافاسكربت، وجانب الخادم Back-end وهو غير مرئي للمستخدمين ويتضمن لغة برمجية لبرمجة منطلق الموقع وقاعدة بيانات لاستيراد البيانات وخادم وهو حاسوب لتشغيل الموقع أو التطبيق. تشغّل مواقع الويب عبر الكثير من لغات البرمجة ومن بينها Node.js و PHP وهما من أكثر التقنيات المستخدمة من جانب الخادم، ويمكن لكليهما تشغيل تطبيقات الويب بغض النظر عن تعقيد المشروع، وفي الوقت نفسه فإن الاختلافات بينها كبيرة لأن كل واحدة منها مبنية على مفاهيم وبنيات مختلفة. لنستكشف معًا من الأقوى في هذه المعركة المحتدمة بين لغة PHP مقابل Node.js. سنفترض في هذا المقال بأن لديك معرفة أساسية بتقنيات تطوير الويب وكيفية عمل المواقع. نبذة موجزة عن لغة PHP و Node.js قبل الغوص في التفاصيل وذكر الميزات والعيوب والمقارنة بينها لا بدّ لنا من التوقف قليلًا والتأمل في نقطة مهمة عند المقارنة بين PHP و Node.js إذ أنه لا يخفى على الجميع بأن PHP هي لغة برمجة ولكن ما هي Node.js هل هي لغة؟ أم مكتبة؟ أم إطار عمل؟ أم ماذا؟ في الحقيقة جميع تخميناتنا خاطئة لأن Node.js ما هي إلا بيئة تشغيل تسمح بتشغيل الشيفرة البرمجية للغة جافاسكربت، ومع ذلك بعض المبتدئين يسمونها لغة Node.js، وعمومًا يمكننا النظر إلى هذه المقارنة على أنها مقارنة بين مزايا لغة جافاسكربت ولغة PHP ولكن بطريقة غير مباشرة. ما هي Node.js تعتمد بيئة تشغيل جافاسكربت Node.js بصورة أساسية على محرك Chrome V8، وهو محرك جافاسكربت و WebAssembly عالي الأداء ومفتوح المصدر طورته شركة غوغل (اسمها حاليًا ألفابت)، والشيفرة البرمجية لهذا المحرك مكتوبٌ بلغة C++، ويُستخدم لتشغيل لغة جافاسكربت على متصفح الإنترنت كروم Chrome. توفر بيئة Node.js تطبيقات ذات أداء واستقرار عاليين. كما أنها تتيح إمكانية إنشاء خوادم قابلة للتطوير دون استخدام الخيوط Thread، باستخدام نموذج مبسط من البرمجة القائمة على الأحداث Event-driven Programming، والتي تستخدم عمليات رد النداء callback للإشارة إلى اكتمال المهمة، كما تبسط بيئة Node.js عملية التطوير لآلاف المبرمجين إذ jمكّنهم من إنشاء موقع أو تطبيق ويب من خلال لغة جافاسكربت سواء من جانب الخادم أو العميل. تسمح بيئة Node.js للمطورين بناء تطبيقات بسرعة بفضل مشاركة اللغة بين الواجهات الأمامية والخلفية الأمر الذي يزيد من الكفاءة والإنتاجية للمطورين. كما يساعد هذا المزيج على بناء تطبيق قوي ومكتمل الميزات بأقل استثمار من وقت وجهد، بالإضافة إلى ذلك تنخفض تكاليف الصيانة وتزداد سهولة اكتشاف الأخطاء والقدرة على استخدام لغة TypeScript مع التي تتيح المزيد من القوة وقابلية الاستخدام للشيفرة البرمجية. كما أن لغة جافاسكربت هي الأساس للعديد من أطر العمل للواجهات الأمامية الشائعة مثل React أو Vue وهذه الأطر أساسية لمعظم تطبيقات الويب الحديثة. تتيح أيضًا بيئة Node.js بناء تطبيقات بالزمن الحقيقي Real-time بفضل تجربة تدفق البيانات في الوقت الفعلي باستخدام لغة جافاسكربت المقادة بالأحداث، إذ يمكنك بسهولة إنشاء حلول برمجية عالية الأداء مع ميزات متقدمة مثل الدردشات وخدمات البث الحي للفيديوهات أو الصوت والمعاملات وما إلى ذلك. في الحقيقة هذه المرونة العالية للتغييرات وقابلية التوسع جعلت بيئة Node.js قوية في سوق تطبيقات الويب ذات الطبيعة السريعة والمتقلبة لأن الوجود في الأسواق يفرض على الشركات تظل مرنًة وأن تكون قادرةً على تغيير تطبيقاتها لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة وزيادة إمكانية الوصول إلى سقف توقعات المستخدمين. كما أن لغة جافاسكربت تعدّ من اللغات الأساسية في تطوير الويب ولذلك فإن المبرمجين سيتعلمونها حتمًا خلال رحلتهم في تطوير الويب، وسيصبح من الأسهل عليهم اختيار بيئة Node.js للواجهة الخلفية بدلًا من تعلم لغة PHP مما يسرع رحلة التعلم للمبتدئين. ولكن من عيوب بيئة Node.js أيضًا النقص في الأدوات والأطر المعقدة لبناء مشاريع الكبيرة كما أن السرعة الكبيرة في تطوير بنية اللغة جعلها في تغيّر مستمر وهذا الأمر يمكن أن يؤخذ بمنحى إيجابي أو سلبي بحسب كل شركة، بالإضافة إلى ذلك تقدم Node.js أداءً ضعيفًا عند إجراء عمليات حسابية مكثفة أو الاستخدام العالي لوحدة المعالجة المركزية. كما أن بنية Node.js المقادة بالأحداث جعل عليها بعضًا من القيود، ولكن بعد الإصدار 10.5 أضيفت وِحدة برمجية للتعامل مع الخيوط Threads في بيئة Node.js هذه الوحدة مفيدة جدًا في إجراء عمليات جافاسكربت كثيفة الاستخدام لوحدة المعالجة المركزية. لغة PHP لغة PHP وهي اختصار لعبارة Hypertext Preprocessor أنشأها راسموس ليردورف Rasmus Lerdorf في عام 1994. وهي لغة برمجة نصية مفتوحة المصدر من جانب الخادم مصممة خصيصًا لتطوير تطبيقات ومواقع الويب، كما أنها تستخدم أيضًا كلغة برمجة نصية للأغراض العامة، وتكون ملفات PHP لها امتداد .php ويمكن أن تحتوي على شيفرة جافاسكربت و HTML و CSS وحتى نصوص عادية أيضًا. وتعد لغة PHP واحدة من أفضل لغات الخادم في العالم. أظهر استطلاع أجراه موقع W3Tech جاء فيه أن 78.1% من مواقع الويب في العالم تستخدم لغة PHP للواجهات الخلفية بالمقارنة مع 1.8٪ من المواقع التي تستخدم جافاسكربت وبيئة Node.js. تحتوي لغة PHP أيضًا على دعم كبير لأطر العمل مثل Laravel و Symfony و Codeigniter و CakePHP، وجميع هذه الأطر مفتوحة المصدر ويمكن لأي شخص استخدامها أو تعديلها وتطويرها. كما أن لغة PHP بحد ذاتها قابلة جدًا للتخصيص وبمجرد أن يزدهر تطبيق الويب ويتوسع ستجد أن اللغة تلبي جميع احتياجاتك والتغييرات التي تتطلع لها. يعد الحصول على درجة عالية من التخصيص في تحسين وظائف موقع الويب الخاص بك ميزة تنافسية كبيرة وهذه الميزة توفرها لغة PHP لأنها تحتوي على جميع الوظائف اللازمة للعمل مع HTML والخوادم وقواعد البيانات، كما تتميز اللغة بمستوى عال من الأمان والمرونة وخصيصًا في النسخ الحديثة منها ومع مشاهدتنا لشركات تخسر مبالغ كبيرة من المال بسبب هجمات القراصنة، تزداد الحاجة لحلول مستقرة وقوية بل لإجراءات وقائية أيضًا وهذا ما توفره لغة PHP. تعد شيفرتها البرمجية آمنة نسبيًا وذات كما توفر أدوات لحماية البيانات المرسلة إلى قواعد البيانات. بالإضافة إلى ذلك، تشتهر لغة PHP بمرونتها وتوافقها عبر أنظمة التشغيل الأساسية مثل ويندوز ولينكس Linux وماك MacOS وما إلى ذلك. علاوة على ذلك تمنحك لغة PHP توافق مع مجموعة واسعة من الخوادم مثل Apache و iPlanet و Netscape وما إلى ذلك، بالإضافة إلى التكامل مع قواعد البيانات مثل MongoDB و MySQL وغيرها. ولكن كما أن لها مزايا لها عيوب أيضًا فمثلًا تكون عملية كتابة وحدات الاختبار البرمجي Unit Testing طويلة نسبيًا بسبب سوء معالجتها للأخطاء كما أن بعض المبرمجين ينظرون إلى أن نموذج خادم العميل الذي تتبعه لغة PHP عفا عليه الزمن لأن طريقة عمله التي تطلبُ الصفحة أولًا ومن ثم الاتصال بقاعدة البيانات وتعالج البيانات وتعرض النتائج في صفحة HTML. الأمر الذي يؤدي خسائر في السرعة والفعالية، ولكن من الجدير بالذكر أنه يمكن التغلب على عيب PHP بمساعدة Memcached هو نظام ذاكرة تخزين مؤقت موزع للأغراض العامة، ويستخدم لتسريع مواقع الويب الديناميكية التي تعتمد على قواعد البيانات عن طريق تخزين البيانات والكائنات في ذاكرة الوصول العشوائي مؤقتًا لتقليل عدد المرات التي يتطلب فيها الموقع قراءة البيانات من مصادر خارجية مثل قواعد البيانات، وبالرغم من ذلك هذا الأمر سيخلق تبعية إضافية لتطبيق الويب وهذه مشكلة أيضًا. دورة تطوير تطبيقات الويب باستخدام لغة PHP احترف تطوير النظم الخلفية وتطبيقات الويب من الألف إلى الياء دون الحاجة لخبرة برمجية مسبقة اشترك الآن مقارنة بين PHP vs NodeJS والآن بعد أن تعرفنا على كل لغة لنتعمق أكثر في فهم الاختلافات الدقيقة ولنستطيع بعدها تحديد ما هو مناسب لكل مشروع. المجتمع والتطوير تحدد قوة المجتمع وخبرته نوع التحديثات التي تأتي إلى مختلف الأطر والمكتبات والمشاريع التي ستطلق في لغة معينة، كما أن المجتمع الكبير يعني الدعم الكبير لأنه في بداية طريقك لتعلم البرمجة لا يمكنك الاعتماد على معرفتك فقط دون دراسة أي دورات وممارسات حديثة، ولتصبح محترفًا شاملًا ستحتاج حتمًا لطرح أسئلة على منتديات أجنبية مثل StackOverflow أو منتديات عربية مثل الأسئلة والأجوبة في موقع أكاديمية حسوب، كما أنه من مسلمات العمل في وقتنا الحالي أن فريقك لن يكون قادرًا على كتابة الشيفرة البرمجية لكل ميزة من الصفر، ولذلك فإنه سيستخدم حتمًا المكتبات الشعبية والمُختبرة الأمر الذي يقلل من وقت التطوير ويزيد من الإنتاجية، ويزيد من جودة المشروع الفردي أو المكتبة أو إطار العمل. تفهرس معظم مكتبات Node.js في سجل موقع npmjs.com، وبالرغم من أن بيئة Node.js جديدة نسبيًا إلا أن مجتمعها كبير ولديها العديد من المشاريع التي طورها المجتمع والتي تميل نحو الاحتياجات العصرية والحديثة لتطبيقات الويب. في الواقع تركز العديد من المشاريع على إضافة وظائف فريدة إلى بيئة Node.js بدلًا من مجرد استنساخ ونقل ميزات من لغات أخرى. بالرغم من قدم وعراقة لغة PHP إلا أنها ليست مرغوبة مثل لغة جافاسكربت وبالرغم من مجتمعها الكبير ومشاريعها المتنوعة، ولكن إحدى مشكلاتها الرئيسية أن مشاريعها الحديثة التي يطورها المجتمع تبدو قديمة بعض الشيء وغير مثيرة للاهتمام عند مقارنتها مع مشاريع Node.js، ومع أن مجتمع مبرمجي لغة PHP برمجوا بعض المميزات وأضافوها إلى ميزات اللغة الأساسية الموجودة بالفعل في لغات برمجية أخرى لكن يشعر بعض المطورين بالحاجة إلى مشاريع أكثر حداثة تتناسب مع متطلبات المستخدمين في العصر الحالي. أما من ناحية عدد المطورين فوفقًا لاستطلاع أجراه موقع Slashdata في عام 2020 جاء فيه أنه يوجد أكثر 12.4 مليون مطور للغة جافاسكربت (اللغة الأساسية لبيئة Node.js) حول العالم بالمقابل 6 ملايين مطور للغة PHP. مما يظهر تفوق واضح للغة جافاسكربت ويجعلها خيارًا جيدًا للشركات الناشئة لأن هنالك عدد كبير من المرشحين لوظيفة مطور لغة جافاسكربت. الشيفرة البرمجية إذا كانت الشيفرة البرمجية سهلة ومصممة بطريقة جيدة ستتمكن من إنجاز الكثير باستخدام شيفرة برمجية أقل. تتطلب بيئة Node.js المزيد من أسطر الشيفرات البرمجية لتنفيذ نفس وظائف PHP لأن بنية اللغة مختلفة وهذا يظهر أثناء البرمجة والسبب هو كون البيئة تطورت بأكملها باستخدام جافاسكربت. لذلك تتطلب Node.js أحيانًا سطورًا أطول نسبيًا لكن لا ننسَ أيضًا إمكانية العمل بلغة واحدة للواجهات الأمامية والخلفية. بالإضافة إلى ذلك تمكننا بيئة Node.js استيراد كل منطق الشيفرة البرمجية للواجهة الخلفية الأمر الذي يجعل من السهل بعد ذلك الوصول إلى الميزات التي خصصت على كلا الجانبين. كما تنقلُ بيئة Node.js الكثير من عبء العمل إلى جانب العميل. لذلك إذا كان لدى جمهورك المستهدف هواتف ذكية ذات قوة معالجة جيدة فإن Node.js مثالية لهذه الحالة. بالمقابل صممت لغة PHP لبناء ومعالجة صفحات الويب وجعلها ديناميكية كما تعتمد لغة PHP على شيفرة HTML لجعل كل الصفحات ثابتة في طرف المخدم بعد توليدها وتجهيزها ثم إرسالها إلى متصفح المستخدم أي لن يكون هنالك أي عمليات برمجية تُنفذ في طرف العميل (المتصفح غالبًا)، وبناءً على ذلك فإن تحميل صفحات الويب ستكون أخف على أجهزة المستخدمين ولن تحتاج لقوة معالجة أجهزتهم. كما أن اللغة تتطلب سطورًا أقل من التعليمات البرمجية لأداء وظيفة ما وبالتالي فهي أسهل، وعمومًا من السهولة فهم الشيفرة البرمجية سواء للغة PHP أو Node.js ولن يستغرق المطور المبتدئ وقتًا كبيرًا لإتقان أيًا من اللغتين. السرعة والأداء نقصد بالسرعة بأنها سرعة تنفيذ الشيفرة البرمجية بحسب كل لغة والسرعة العالية تؤدي لعملية تطوير أسرع ومشاريع أكثر فعالية من حيث التكلفة. تتنوع اللغات البرمجية في طريقة تنفيذها للشيفرة البرمجية فبعضها تكون متزامنة وأخرى غير متزامنة. تنفذُ اللغات البرمجية المتزامنة التعليمات سطرًا سطرًا ولا يُنفذ السطر التالي من التعليمات البرمجية حتى تنفذُ السطر الحالي. أما اللغات البرمجية غير المتزامنة تنفذُ جميع التعليمات البرمجية في نفس الوقت هذا الاختلاف في طريقة التنفيذ يؤثر تأثيرًا كبيرًا على سرعة كل لغة، ونقصد بالأداء كيفية تنفيذ التعليمات البرمجية بلغة PHP أو Node.js وأدائها على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل تحميل الصفحات والسلاسة. واللغة عالية الأداء تؤدي لنتائج أفضل لأداء تطبيق الويب والتي تؤثر تأثيرًا عميقًا على تجربة المستخدم. تعد بيئة Node.js من بيئات التطوير غير المتزامنة، وهذه الميزة الرئيسية لها وكونها غير متزامنة يعني أنها تعمل على تنفيذ الشفرة بأكملها دفعة واحدة ولا تنتظر عودة نتيجة دالة أو تابع معين. تقلل هذه الطريقة التأخر في تنفيذ الشيفرة البرمجية لتطبيق الويب بصورة كبيرة وتوفر تجربة استخدام سلسة (في بعض الأحيان يجب أن تكون قدرة الحوسبة والمعالجة لجهاز المستخدم مقبولة للحصول على تجربة استخدام سلسلة). بالرغم من أن لغة PHP متزامنة ولكن هناك بعض واجهات برمجة التطبيقات API تعمل بصورة غير متزامنة. هذا ما يجعل استجابة الموقع أبطأ وانتظار المستخدم في نهاية المطاف. في الحقيقة هذه المشكلة موجودة في معظم اللغات والتقنيات القديمة. والخوف الدائم في هكذا نوع من اللغات يكمن في تعطل البرنامج في انتظار الرد والذي يسمى "جحيم رد الاتصال Callback Hell" فإذا كانت هناك حاجة إلى ربط الكثير من الدوال ببعضها بعضًا ويتطلب التطبيق نقل البيانات من دالّة إلى أخرى فيجب الحذر عندها من الوقوع في هذه المشكلة. أطر العمل تساعدُ أطر العمل Framework المبرمج على التركيز على التفاصيل الدقيقة للمشروع وتزيح عن كاهله كتابة الشيفرات البرمجية المكررة والأكثر استخدامًا موفرةً الدوال الأساسية والمكتبات وواجهات برمجة التطبيقات من خلال إطار العمل. كلما كان إطار العمل أكثر شمولًا قل مقدار الشيفرة البرمجية الزائدة التي سيحتاجُ المبرمج لكتابتها. شهدت Node.js توسعًا كبيرًا في أطر العمل الخاصة بها في فترة قصيرة نسبيًا ومن بعض أطر العمل المشهورة نذكر Meteor و Total و Express و Sails وغيرها. بالرغم من حداثة هذه الأطر إلا أنها واعدة ومتطورة باستمرار وبالتأكيد تعزز الإنتاجية وتُقلل وقت التطوير واستهلاك الموارد ولكن أطر عمل لغة PHP تفوقها عددًا بهامش ضخم نظرًا لأقدمية لغة PHP وعمرها الذي يزيد عن 27 عامًا فهي تمتلك أطر عمل غنية جدًا وعادة ما تركز شركات تطوير تطبيقات الويب الحديثة على استخدام واعتماد على هذه الأطر في عملها ومشاريعها أي أنها أصبحت من مُسلمات تطوير البرمجيات في الوقت الحالي ومن بعض أطر العمل المشهورة نذكر Laravel و CodeIgniter و CakePHP و Phalcon. بالرغم من الفرق الكمي بين أطر عمل لغة PHP و Node.js إلا أنه يصعب تحديد أي إطار يعمل بطريقة أفضل من الآخر في اللغتين. وتجدر الإشارة إلى العديد من أطر PHP صممت لاستيراد ميزات مثل التنفيذ غير المتزامن المتأصلة في بيئة Node.js. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من أطر PHP لديها مشكلة واحدة مشتركة محتوى وشيفرة برمجية مختلطة ولكنها بالمقابل أطر عمل شاملة. التعامل مع قواعد البيانات الأمر المهم عند النظر لأي لغة سواء جديدة أو قديمة هي طريقة فحص مدى ملاءمتها مع قواعد البيانات الحديثة أو القديمة والعلائقية منها أو التقليدية. اشتهرت قواعد البيانات العلائقية والتي تُخزن البيانات على شكل جداول؛ الأمر الذي يسهل فهم العلاقات والتبعيات بين نقاط البيانات المختلفة. ولكن في السنوات السابقة ظهرت نوع جديد من قواعد البيانات وهي NoSQL والتي تسمح بتخزين البيانات بتنسيقات مثل المستندات وأزواج المفاتيح والرسوم البيانية وحتى قواعد البيانات غير المهيكلة وشبه المهيكلة والمنظمة، بالإضافة إلى أنها سهلة الاستخدام للمطورين. يمكن لبيئة Node.js العمل بسهولة مع قواعد بيانات المختلفة مثل NoSQL و MongoDB و CouchDB وغيرها كما أن لديها مكتبات كبيرة للوصول إلى قواعد بيانات SQL. نظرًا لقدم لغة PHP فهي مصممة للعمل مع قواعد البيانات العلائقية والتقليدية مثل MySQL و MariaDB بقوة في حين أنه من الممكن استيراد مكتبات للعمل مع قواعد بيانات NoSQL ولكن عملية التكامل مع هذه المكتبات طويلة وتستهلك جزءًا كبيرًا من وقت المعالجة. معالجة الطلبات هذا هو مقياس مدى سرعة معالجة اللغة للطلبات من جانب العميل. لا شك أن تنفيذ الطلب بدقة أمر بالغ الأهمية لتجربة المستخدم، ولكن يجب أيضًا القيام به باستخدام الحد الأدنى من الموارد والوقت. كما يساعدنا التعامل اللغة مع الأخطاء على فهم الصورة الشمولية وذلك لتحسين تجربة المستخدم. بفضل المعالجة غير المتزامنة للطلبات المتعددة، لا تنتظر بيئة Node.js انتهاء إحدى الأحداث قبل أن تبدأ العملية التالية. لا تضيع أوقات وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي في انتظار مجهول لمعالجة مخرجات دالة معينة، والمشكلة الوحيدة هو أنه إذا لم يُعالج حدث مرتبط بأحد الأحداث التالية في الوقت المناسب، فيمكن يتداخل سير عمل التطبيق ويؤدي ذلك لحدوث خطأ في عموم التطبيق، ولكن لحسن الحظ توفر اللغة آليات معالجة الأخطاء فعالة تمكن المبرمج من حماية النظام من التعثر الناتج عن التنفيذ الخاطئ. تتعامل لغة PHP مع طلب واحد وبالتسلسل وهذا الأمر يزيد من مدة استهلاك الموارد سواء وحدة المعالجة المركزية أو ذاكرة الوصول العشوائي في الواجهات الخلفية، ويخلق تأخرًا في النظام من خلال نهج الطلب الواحد، ولكن نظرًا لأن المعالجة تكون من جانب المخدم لن يتأثر تطبيق الويب بنوعية جاهز المستخدم فيمكن أن يعمل على الأجهزة الضعيفة أو القوية (لأن بعض تطبيقات Node.js تحتاج لمعالجة قوية) كما يمكن استخدام مكتبات خارجية للحصول على الوظائف غير المتزامنة. ولكن لن تكون بقوة الميزات الأصلية في بيئة Node.js. التعامل مع الوحدات Modules تعمل الوِحدات كتطبيقات فرعية داخل تطبيق الويب الأساسي، وهي تعالج مجموعة معينة من الوظائف وغالبًا ما تكون قابلة للتبديل أو التحديث مما يمنح البرنامج مرونة وقوة في العمل. غالبًا ما يشتكي بعض المطورين من أن مشاريع Node.js ليست مستقرة مثل المشاريع المطوّرة بلغة PHP نظرًا لأن اللغة والمجتمع لا يزالان ينموان ويتطوران بسرعة كبيرة فإن أنظمة مراقبة الجودة بالكاد موجودة. مع تقديم بعض الحلول الواعدة مثل مبادرة مراقبة الحزم والوِحدات npm-Audit الأمر الذي ساعد في التحقق من كل حزمة بحثًا عن تعليمات برمجية ضارة. بالمقابل تتمتع لغة PHP بميزة في هذا المجال منذ سنوات حتى الآن. في وقتنا الحالي تحتوي لغة PHP على مكتبة ثرية من الوِحدات النمطية وهي مستقرة نوعًا ما، ومع ذلك لا تزال Node.js تخطو خطوات كبيرة في هذا المجال. النظام البيئي Ecosystem النظام البيئي هو عدد المكتبات مفتوحة المصدر وواجهات برمجة التطبيقات والوحدات النمطية وأطر العمل والمشاريع التي ينشرها المجتمع والمطورون …إلخ. فيحتوي النظام البيئي Node.js على مجموعة واسعة من المكتبات وأطر العمل، لكنها متخلفة عن أرقام PHP. بالرغم من ذلك إلا أنها تعوضها بمشاريعها المتنوعة. نظرًا لأن Node.js تستخدم نفس اللغة للبرمجة من جانب الخادم والخلفية، فإن أنواع المشاريع المتاحة تتناسب بحرية مع عدد أكبر من حالات الاستخدام. بالمقابل يوجد العديد من الأنظمة المعتمدة على لغة PHP وهذه الأنظمة لها سيطرة كبيرة على مواقع الويب حول العالم مثل ووردبريس WordPress وجوملا وماجنتو وغيرها الأمر الذي انعكس على قوة النظام البيئي. وبما أن نسبة كبيرة من إجمالي مواقع الويب على الإنترنت تعمل بهذه اللغة فحتمًا سيكون هنالك مجتمع كبير والكثير من من المواد التدريبية والتكنولوجيا الداعمة على مر السنين لجذب مطورين جدد. أيهما أفضل PHP أم Node.js؟ بمجرد أن تفهم لغة جافاسكربت ستصبح اللغات الأخرى غير فعالة بالمقارنة معها لأنك تعلمت لغة واحدة وركزت كل مجهودك عليها فستكون النتائج أسرع وسيتعمقُ فهمك لكيفية سير العمل. يمكن لمطوري الويب الشاملين full stack web developers كتابة شيفرة مشروع كامل من جانب العميل والخادم بلغة جافاسكربت ولم تعد هنالك حاجة إلى التبديل بين اللغات أو التقنيات. كلما تعلمت لغة جافاسكربت زادت استمتاعك بها، وهذا الأمر لا ينطبق على لغة PHP. من الأفضل اختيار بيئة Node.js عند إنشاء تطبيقات ديناميكية أحادية الصفحة SPA أو Single Page Application باستخدام إطارات جافاسكربت للواجهة الأمامية مثل Angular أو React أو Vue.js. أما من جهة الخادم Node.js. يمكن لبيئة Node.js دعم أجهزة إنترنت الأشياء IoT بمفردها مثل أجهزة تتبع اللياقة البدنية والطائرات بدون طيار وحتى الروبوتات بالإضافة إلى منصات تدفق البيانات الثقيلة كونها قادرة على إدارة العديد من العمليات المتزامنة. بعض التوجهات في المشاريع في السوق تعتمد على مطوري MERN وهي اختصارًا (Node.js و React و Express.js و MongoDB) وبعض المشاريع تستخدم إطار Angular بدلًا من إطار React فتصبح MEAN ويمكن استعمال Vue.js ليصبح الاختصار MEVN. بالمقابل تعدُ لغة PHP اختيارًا جيدًا لمدونة أو مشروع تجارة إلكترونية وخصيصًا عندما يتطلب المشروع العديد من عمليات الدمج. الخاتمة تعرفنا في هذا المقال على الفرق بين لغة PHP وبيئة Node.js لتشغيل شيفرات جافاسكربت في الواجهة الخلفية للمواقع وتطبيقات الويب، وتعرفنا في البداية على نبذة مختصرة لكل منها وتعمقنا لاحقًا في المقارنة وفي إقبال المجتمع التقني عليها وحماسه لتطويرها ومدى تعقيد الشيفرة البرمجية وسرعة وأداء كل لغة كما اطلعنا على أطر العمل الخاصة بكل لغة وطريقة تعامل كل لغة مع قواعد البيانات وكيفية معالجة الطلبات وطريقة التعامل مع الوِحدات وختمنا المقارنة بالاطلاع على النظام البيئي الشامل لكل منها. ولنتذكر دومًا بأن كل من لغة PHP وبيئة Node.js تستمد قيمتها من حالة الاستخدام والمشروع الذي نعمل عليه فإذا كان المشروع موقع ويب ثابت يتطلب عددًا قليلًا من الطلبات من قاعدة البيانات، وكان جمهور التطبيق المستهدف يستخدم أجهزة منخفضة وبطيئة فستكون لغة PHP هي بالضبط ما تبحث عنه. وإذا كانت حالة الاستخدام الخاصة بك تتضمن مواقع ويب ديناميكية ترسل العديد الطلبات إلى خادم ولها واجهة مستخدم ديناميكية فأنت تريد استخدام Node.js. وختامًا تبرز أهمية اختيار اللغة المناسبة لإنشاء موقع أو تطبيق مستقر وموثوق في مشاريع الناشئة، وهذا هو السبب في لجوء بعض الشركات إلى استشارة المختصين في هذه الأمور للتأكد من تلبية جميع احتياجات المشروع المستقبلية ولا ننسَ بأنه مهما اختلفت اللغة تبقى مهارات فريق التطوير الويب هي الحكم في هذه النقطة. يمكنك الإطلاع على توثيق لغة PHP وتوثيق بيئة Node.js على موسوعة حسوب لمزيد من التفصيل حولهما. المصادر مقال Node.js vs PHP: In-depth Comparison With Pros & Cons [2021] لكاتبه Serhii Osadchuk. مقال Node.js vs PHP: Which One is Better for Backend Development لكاتبته Anastasia Kushnir. مقال Node.js vs PHP: A Honest Comparative Study With All The Answers لكاتبه Tejas Kaneriya. مقال PHP vs. Node.js - GeeksforGeeks لكاتبه Parikshit Hooda. اقرأ أيضًا الدليل السريع إلى لغة البرمجة PHP مقدمة إلى Node.js
-
منذ صعود الإنترنت وظهور مستعرض الويب الأول بواجهة مستخدم رسومية عام 1993 تغير شكل العالم ولم تعد المعلومة حكرًا على أحد، وانتقل كل شيء تقربيًا في العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي. كان متصفح الإنترنت هو الأداة القياسية للتفاعل مع هذا العالم الافتراضي ومع سرعة نمو شبكة الويب العالمية أصبحت متطلبات المواقع والمتصفحات تزداد يومًا بعد يوم الأمر الذي جعلها تتغير بوتيرة سريعة جدًا. كانت صفحات الإنترنت في بداية التسعينات بسيطة وثابتة وكانت التفاعل معها محدودًا جدًا ويفتقر إلى السلوك الديناميكي الأمر الذي جعل شركة نتسكيب تقرر إضافة لغة برمجية إلى المتصفح الخاص بها Navigator المشهور جدًا آنذاك وسلمت المهمة إلى مبرمجها الشاب بريندان إيش Brendan Eich وسرعان ما أطلق هذا المبرمج النشيط لغة برمجية تدعى جافاسكربت JavaScript في سبتمبر 1995 والتي غيرت طريقة تعاملنا مع المتصفح بطريقة لا رجعة فيها. كان الناس يسارعون في الدخول إلى عالم الإنترنت واستكشافه وعندما شاهدت شركة مايكروسوفت تطور متصفح شركة نتسكيب لم يروقها الأمر، ومع قرارها بدخول أنظمة الحاسب من خلال نظام ويندوز قررت دخول سوق متخصص أكثر وهو سوق متصفحات الويب من خلال متصفح إنترنت إكسبلور Internet Explorer، استخدمت شركة مايكروسوفت لغة جافاسكربت في متصفحها، وسرعان ما نشبت حرب بين إنترنت إكسبلور والمتصفح Navigator على واجهة جافاسكربت، لتقوم شركة مايكروسوفت بعدها بإجراء هندسة عكسية لمترجم جافاسكربت في المتصفح Navigator وإنشاء مترجم خاص بها عام 1996 يسمى JScript. جاء ذلك جنبًا إلى جنب مع الدعم الأولي للغة تنسيق الصفحات CSS وملفات HTML. كان ذلك نقلة نوعية في صفحات الويب واختلفت اختلافًا ملحوظًا عن الصفحات المخصصة لمتصفح Navigator. هذه الاختلافات جعلت من الصعب على المطورين بناء مواقعهم لتعمل بصورة جيدة في كلا المستعرضين. في هذه الأثناء ومع رؤية مطوري الويب لهذه اللغة وإمكانياتها أصبحت اللغة حديث الساعة بين المجتمعات التقنية وزاد الاهتمام بها سواء من تطوير وإجراء أبحاث لتحسينها ومن الأبحاث التي غيرت مسار حياة اللغة هو بحث جيسي جيمس جاريت Jesse James Garrett عام 2005 والذي صاغ فيها مصطلح Ajax ووصف مجموعة من تقنيات كانت لغة جافاسكربت عمودها الفقري، وذلك بهدف إنشاء تطبيقات ويب يمكنها تنزيل بيانات في الخلفية أثناء التصفح، وتجنب الحاجة لإعادة تحميل الصفحة من جديد. أدى هذا إلى صعود نجم جافا سكريبت وبدء عصر النهضة بقيادة المكتبات مفتوحة المصدر والمجتمعات التي تشكلت من حولها. أُنشأت العديد من المكتبات الجديدة آنذاك مثل jQuery و Prototype و Dojo Toolkit و MooTools وغيرها. كان تطور لغة جافاسكربت لافتًا ومفيدًا ومع أن الهدف الأساسي منها جعل الواجهات الأمامية للمواقع تفاعلية إلا أن محبة المطورين لها جعلهم ينقلونها للواجهات الخلفية للتطبيقات الإنترنت من خلال Node.js لتصبح بذلك لغة صالحة لتطوير الواجهات والأمامية والخلفية، ومع ازدياد اعتماد المطورين على لغة جافاسكربت في تطوير مواقعهم بدأت تظهر المشاكل لأن لغة جافاسكربت لم تكن مهيأة لهذا التعامل وخصيصًا مع المشاريع الكبيرة أو التطبيقات الضخمة الأمر الذي جعل من الصعب صيانة الشيفرة البرمجية أو حتى إعادة تصميم الشيفرة البرمجية Refactoring وهنا بدأت تظهر الحلول الجديدة ومن بينها حل سحري جاء على يد شركة مايكروسوفت بطرحها للغة TypeScript. سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على أبرز الاختلافات بين لغة جافاسكربت JavaScript ولغة TypeScript وسنسعى لتجنب التحيز بينها ولكن بالتأكيد هناك لغة قوية في مجال معين وأخرى ضعيفة وهذا أمر طبيعي. نبذة مختصرة عن لغات جافاسكربت Javascript و TypeScript لفهم سريع لهذه اللغات لا بد من الاطلاع أولًا على ماهيتها وأبرز خصائصها. لغة جافاسكربت لغة جافاسكربت JavaScript: وهي أشهر لغات البرمجة في العالم وتعد لغة عالية المستوى تساعد في إنشاء صفحات ويب تفاعلية وديناميكية. وهي من التقنيات الأساسية لتطبيقات الويب وتتميز بدرجة عالية المرونة من خلال الأنماط الديناميكية والمصرّف الفوري Just-in-time compilation. بالإضافة إلى ذلك فهي لغة متعددة النماذج نظرًا لقدرتها على دعم البرمجة الوظيفية Functional Programming وأنماط البرمجة الإجرائية Procedural Programming والبرمجة المبنية على الأحداث Event-driven Programming. تشغل لغة جافا سكريبت المواقع من جانب العميل (عندما تشغل الشيفرة البرمجية على متصفح المستخدم)، كما يوجد محركات مبنية لتصريف الشيفرات البرمجية للغة جافا سكريبت للسماح بالتطبيقات جافاسكربت من جانب الخادم (عندما تشغل الشيفرات البرمجية على خادم الويب وتخصص الاستجابة وفقًا لطلب كل مستخدم). أهم النقاط الرئيسة في لغة جافاسكربت JavaScript: لغة البرمجة الأكثر شيوعًا. لغة كاملة ومتعددة المنصات ومتعددة النماذج وديناميكية. التنفيذ من جانب العميل والخادم. تقنية التصريف والتحسين في الوقت المناسب JIT. التوافق مع جميع المتصفحات. طور بالأصل للشيفرات البرمجية الصغيرة. لغة TypeScript طور فريق مايكروسوفت البنية الأساسية للغة TypeScript في عام 2010 تقريبًا، وكان جوهر ما بنوه والغرض طويل المدى واضحين على الفور في الاسم: يجب أن تجعل لغة TypeScript لغة جافاسكربت أكثر قابلية للإدارة. كان الكثير من العمالقة التقنيين في شركة مايكروسوفت موجودين في ذلك الفريق التأسيسي الداخلي، وهو مؤشر جيد على أن مايكروسوفت كانت جادة بشأن المشروع. صدرت النسخة الرسمية الأولى عام 2012 وأطلقت TypeScript كمشروع مفتوح المصدر على Github. تعد مايكروسوفت الآن واحدة من أكبر المساهمين في العالم مفتوح المصدر. ومع ذلك، في ذلك الوقت، لا يزال عملاق البرمجيات يتمتع بسمعة ازدواجية تجاه البرمجيات مفتوحة المصدر، وبهذا القرار كان قادرًا على أن يكون قدوة في مجتمع التطوير من خلال تغيير ثقافة الشركة نحو المعايير المفتوحة. تبنى المجتمع التقني هذه اللغة واعجبوا بها ويعملون باستمرار على تحسينها وتطويرها منذ ذلك الحين. تعد لغة TypeScript: مجموعة شاملة من لغة جافاسكربت، تحقق نفس الأغراض والوظائف للغة جافاسكربت. إلا أنها بُنيت بالأساس للتعامل مع التطبيقات الكبيرة وتطويرها من خلال تمكين كتابة شيفرة برمجية قوية وتتضمن عناصر التحكم في أخطاء وقت الترجمة. بتعبير أدق، تعد TypeScript لغة برمجة تدعم أنواع المتغيرات الثابتة Static والديناميكية Dynamic، وتوفر أيضًا ميزات الوراثة Inheritance والأصناف Classes ومجالات رؤية المتغيرات وفضاء الأسماء Namespaces والواجهات Interfaces والاتحادات Unions (وهي أحد بُنى المعطيات مماثلة لوظيفة الهياكل Structure) والعديد من الميزات الحديثة الأخرى التي تجدها في البرمجة كائنية التوجه OOP. كما يمكن استخدام اللغة لتطبيقات الويب من جانب العميل والخادم. علاوة على ذلك، فإنها تتوافق مع مكتبات جافاسكربت أيضًا. من أهم النقاط الرئيسة في لغة TypeScript: أشمل من جافاسكربت ولكنها متوافقة مع مكتبات جافاسكربت. يمكن للشيفرة البرمجية المكتوبة اتباع مبادئ البرمجة غرضية التوجه OOP بطريقة أفضل من طريقة جافا سكريبت الأساسية. دعم الأنواع الثابتة. أسهل في التصحيح. توفر اللغة الأنماط الثابتة. يقدم دعم IDE الكامل. يمكن تحويل الشيفرة البرمجية الخاصة بك إلى شيفرة جافاسكربت. كشف الأخطاء قبل تنفيذ الشيفرة نظرًا لضبط الأنواع ووضوح الشيفرة المكتوبة دورة تطوير التطبيقات باستخدام لغة JavaScript تعلم البرمجة بلغة جافا سكريبت انطلاقًا من أبسط المفاهيم وحتى بناء تطبيقات حقيقية. اشترك الآن مقارنة بين JavaScript و TypeScript في الحقيقة بالرغم من أن العنوان يوحي لوهلة بأن هاتين اللغتين تتنافسان على أخذ حصة من السوق إلا أن المدقق سيرى بأن هاتين اللغتين مكملاتٍ لبعضهما بعضًا ولا يتنافسان لأن لغة جافاسكربت هي الأصل ولولاها لما وجدت لغة TypeScript وبالمقابل كان للغة TypeScript الفضل في إمكانية استخدام لغة جافاسكربت في المشاريع الكبيرة وهدف هذه المقارنة تحديد الأنسب في مشروع. في البداية لنستعرض بعض الأمثلة عن الاختلافات بين الشيفرات البرمجية، انظر مثلًا تعريف المتغيرات في جافاسكربت: var message = "Hello Everyone"; var num = 14; ويقابلها في TypeScript الشيفرة التالية: var message:string = "Hello Everyone" var num:number = 14 إذ يجب ضبط نوع المتغير بدقة. ومثال آخر متقدم، يكون استخدام الأصناف Classes في لغة جافاسكربت هكذا: // -- JavaScript with Babel -- // class Article { constructor(name) { this.name = name; } } // -- Babel compiled output -- // "use strict"; function _classCallCheck(instance, Constructor) { if (!(instance instanceof Constructor)) { throw new TypeError("Cannot call a class as a function"); } } var Article = function Article(name) { _classCallCheck(this, Article); this.name = name; }; أما في لغة TypeScript تكون على الشكل التالي: // -- TypeScript -- // class Article { name: string; constructor(name: string) { this.name = name; } } // -- TypeScript compiled output -- // var Article = /** @class */ (function () { function Article(name) { this.name = name; } return Article; }()); مثال آخر لكيفية استخدام الوِحدات Modules في لغة جافاسكربت: // -- JavaScript with Babel -- // export default class Article { } // -- Babel compiled output -- // "use strict"; Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true }); function _classCallCheck(instance, Constructor) { if (!(instance instanceof Constructor)) { throw new TypeError("Cannot call a class as a function"); } } var Article = function Article() { _classCallCheck(this, Article); }; exports.default = Article; أما في لغة TypeScript تكون على الشكل التالي: // -- TypeScript -- // export default class Article { } // -- TypeScript compiled output -- // define(["require", "exports"], function (require, exports) { "use strict"; Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true }); var Article = /** @class */ (function () { function Article() { } return Article; }()); exports.default = Article; }); المجتمع والتطوير من المجحف قليلًا مقارنة لغة موجودة في سوق العمل منذ أكثر من 20 سنة مع لغة حديثة لم يمضِ على وجودها الفعلي أكثر من 10 سنوات ولذلك من المنطقي أن نجد فرقًا كبيرًا بين محبة المجتمع التقني للغة جافا سكريبت ولغة TypeScript وهذا ما أثبتته الإحصائيات الخاصة بموقع Github لعام 2021 والسيطرة واضحة للغة جافاسكربت على حساب كل اللغات ومن بينها لغة TypeScript. بل إن الإحصائية المثيرة للاهتمام فعلًا هي الإحصائية الخاصة بموقع stackoverflow والتي جاء في ترتيبها الثالث لغة TypeScript كأكثر لغة يحب أن يتعلمها المطورون في سنة 2021. تصريف الشيفرة البرمجية Compilation ليست هناك حاجة لتصريف الشيفرة البرمجية عند استخدام لغة جافاسكربت. نظرًا لأنها لغة مفسرة Interpreted Language، لا يمكن العثور على الأخطاء إلا أثناء وقت التشغيل. بمعنى آخر، يجب أولًا تشغيل الشيفرة على المتصفح من أجل اختباره واعتباره صالحًا أم لا. ولذلك يمكن أن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للعثور على المشاكل والأخطاء في الشيفرة البرمجية. من ناحية أخرى تحتوي لغة TypeScript على ميزة خطأ وقت تصريف الشيفرة البرمجية Just In Time Compilation وهي عملية تدقيق الشيفرة البرمجية عند تصريفها. ويمكن أن تكتشف هذه العملية أخطاء في كتابة الشيفرة في حال لم يتبع المبرمج الصياغة الصحيحة والدلالات للغة TypeScript. هذه الميزة توفر للمطورين وقتًا ثمينًا قبل نشر وتشغيل تطبيقات الويب على الإنترنت. علاوة على ذلك، فإنها تساعد الشركات أيضًا على التخلص من الأخطاء في وضعية التطوير قبل الانتقال إلى وضعية الإنتاج للشيفرة البرمجية؛ أي أنها تحقق الفائدة للمطورين وأصحاب الشركات على حد سواء. أنواع المتغيرات تحتوي جافاسكربت على الأنواع ديناميكية فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون المتغير الآن عددًا صحيحًا وبعد ذلك على سلسلة. هذا يجعل من الصعب معرفة كيفية التعامل مع ما يوجد داخل متغير معين. علاوة على ذلك، لا يوفر الكتابة الثابتة. تعني الكتابة الثابتة أن المطور يعلن عن نوع البيانات التي يمكن أن يمتلكها المتغير. فإذا صرح المبرمج عن متغير وليكن "x" ليحوي فقط الأعداد الصحيحة، فسيظهر المترجم خطأ إن أسندنا قيمة سلسلة نصية لذاك المتغير في الشيفرة. ربما تكون الأنماط الثابتة الميزة الرئيسية لاستخدام TypeScript. لأنها تسمح للمطور بالتحقق من دقة النمط أثناء وقت الترجمة الشيفرة البرمجية. على سبيل المثال توفر جافاسكربت الأنماط الأساسية للغة مثل السلسلة string والرقم number، لكنها لا تتحقق من صحة تعيين المطور لقيم هذه العناصر أثناء البرمجة. ولكن لغة TypeScript تفعل ذلك. علاوة على ذلك، فإن استخدام الأنماط الثابتة في لغة TypeScript في بيئات التطوير الحديثة (مثل بيئة برنامج VS Code) يمكن أن يقدم معلومات إضافية واقتراحات صحيحة حول الشيفرة البرمجية المكتوبة مما يساهم في توثيق أفضل للشيفرة (وهو ما يقدره المطورون الآخرون أيضًا). يعد التنقل في التعليمات البرمجية وإعادة البناء من الميزات المتاحة التي يمكن أن تساعد المطور على تتبع مكان وجود والتوابع، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك تجعل لغة TypeScript من عملية اكتشاف المشاكل والأخطاء عملية سهلة. نوعية لغة البرمجة أضافت الرابطة الأوروبية لمصنعي الحاسوب ECMAScript معاييرًا محددة للغات البرمجة من خلال توفيرها قواعد وإرشادات وتفاصيل أخرى تصف ما يجب أن تتضمنه لغة برمجة مفسّرة. جافاسكربت هي لغة برمجة مفسّرة تتوافق مع مواصفات ECMAScript. يمكن أن تتغير هذه المواصفات، ويمكن إدخال مواصفات جديدة؛ وبالتالي هناك العديد من إصدارات ECMAScript. كان ECMAScript 6 أحد الإصدارات التي قدمت أبرز التعديلات (والمعروف أيضًا باسم ES6 أو ECMAScript 2015). إذ قدم هذا الإصدار الوِحدات، والصفوف، والدوال السهمية، وخصائص محسّنة للكائنات، وميزات أخرى ممتازة. ولكن السؤال الوجيه هل لغة جافاسكربت كائنية التوجه Object-Oriented Programming؟ في الحقيقة وبالرغم من إصدار مفهوم الأصناف إلا أن صياغة الشيفرة البرمجية هي وراثة النموذج الأولي Prototypal inheritance أي أن لغة جافاسكربت معتمدة على طريقة النموذج الأولي Prototype-based، وليس على طريقة الصفوف Class-based. ولذلك لا تعد لغة جافاسكربت لغة كائنية التوجه فقط بالرغم من قدرتها على اتباع بعض مبادئها. ولكن ماذا عن لغة TypeScript هل هي كائنية التوجه؟ من الصعب الإجابة على هذا السؤال بطريقة مباشرة لأن لغة TypeScript تحتوي على الصفوف Classes وميزات أخرى تسمح للمطور باتباع تقنيات ومبادئ البرمجة غرضية التوجه ولكنها لا تجبر المطور على اتباع هذه المبادئ مثلما تفعل بعض اللغات الأخرى (مثل لغة Java ولغة C#). لذلك لا تعد TypeScript عادة لغة برمجة موجهة للكائنات فقط. في الواقع، بدلًا من التعليمات البرمجية الموجهة للكائنات في TypeScript، يمكن للمطور أيضًا اختيار التعليمات البرمجية الإجرائية Imperative Programming أو الوظيفية Functional Programming. وبالتالي نستنتج بأن كلًا من جافاسكربت و TypeScript لغات متعددة النماذج. أي اللغتين أفضل للمبتدئين؟ في البداية يجب تعلم جافاسكربت أولًا وكلما فهم المطورون معلومات أكثر عن لغة جافاسكربت سيكون من السهل عليهم الانتقال إلى لغة TypeScript لأن اللغتين تشتركان في نفس بناء الجملة وكذلك نفس سلوك وقت التشغيل (باستثناء حقيقة أن لغة TypeScript لديها مدقق وقت التصريف). تمتلك لغة جافاسكربت الكثير من الموارد المتاحة بالإضافة إلى مجتمعها الضخم باعتبارها اللغة الأكثر شيوعًا حاليًا وفي معظم الحالات، يمكن لمطوري TypeScript أيضًا الاستفادة من هذه الموارد لأن الطريقة التي تنفذ بها المهام ستكون هي نفسها. هل لغة جافاسكربت JavaScript أفضل من TypeScript بعد النظر في الاختلافات الرئيسية بين اللغتين يبدو أن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلًا حتى تلحق لغة TypeScript بلغة جافاسكريبت في سباق الشعبية والتطوير، ولكن السؤال الأهم أيهما أفضل؟ الأمر يعتمد على حجم المشروع وعمومًا بالنسبة للمشروعات الصغيرة لا تبرز أهمية لغة TypeScript حقًا ويمكن ألا تستحق الجهد المبذول في التعلم. في هذه الحالة، تكون جافاسكربت أكثر فائدة لأنها تعمل في كل مكان (عبر الأنظمة الأساسية) وخفيفة على المتصفح. في الواقع، أحد عيوب TypeScript، بالمقارنة مع جافاسكربت هي أنها لا يعمل على كل المتصفحات مما يعني أنه يجب استخدام مترجم TypeScript أو محول الشيفرات Babel لتحويل شيفرة TypeScript إلى شيفرة جافاسكربت عادية مما يجعلها مفهومًة لجميع المتصفحات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للغة جافاسكربت أن تعمل بصورة أسرع، بالرغم من عدم ملاءمتها للتطبيقات الأكبر والأكثر تعقيدًا. كما أن لغة TypeScript تستغرق بعض الوقت وموارد وحدة المعالجة المركزية لترجمة التعليمات البرمجية، على عكس لغة جافاسكربت فإنها لا يعرض التغييرات في المتصفح على الفور (يستغرق بضع ثوانٍ). أولًا في TypeScript أسهل لإعادة بناء التعليمات البرمجية. ثانيًا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الأنواع الواضحة، مما يمكّن المطورين والفرق من فهم كيفية تفاعل الأجزاء المختلفة بصورة أفضل. أخيرًا وليس آخرًا، تحدد TypeScript المشاكل والأخطاء الأخرى عن طريق فحص وقت الترجمة. يمكن لهذه الميزات تحسين الكفاءة والتنظيم عند العمل في أنظمة واسعة النطاق وفريق كبير من المبرمجين. وعمومًا تعد لغة TypeScript مشابهةً جدًا للغة جافا سكريبت ويمكننا استخدامها مع جميع المكتبات والأدوات والأطر التي تمتلكها جافاسكربت، لذلك من الجدير بالتأكيد تجربته على TypeScript عندما يتعلق الأمر بمشاريع أكثر تعقيدًا. مصادر لتعلم لغة جافا سكريبت ولغة TypeScript وفرت موسوعة حسوب ترجمةً عربيةً لتوثيق لغة جافاسكربت وأيضًا لتوثيق لغة TypeScript يمكنك الرجوع إليهما وقتما تشاء وإضافتهما مصدرًا لتعلم هاتين اللغتين، كما تجد في أكاديمية حسوب قسمًا عن لغة جافاسكربت يحوي مئات المقالات التعليمية المفيدة بمختلف المستويات بدءًا من المستوى المبتدئ وحتى المتقدم كما تجد أيضًا مقالات تعليمية مفيدة في قسم لغة TypeScript. وأنصحك إن كنت مبتدئًا في جافاسكربت بقراءة سلسلة مقالات دليل تعلم جافاسكربت التي فيها أكثر من 90 مقالًا يتحدث عن لغة جافاسكربت بالكامل، وبعدها يمكنك الانتقال إلى سلسلة جافاسكربت متقدمة لمستوى أكثر تقدمًا في اللغة وبذلك أضمن لك أن تصبح خبيرًا بلغة جافاسكربت وكل ذلك من مصدر عربي. الخاتمة تعرفنا في هذا المقال على التاريخ الموجز لجانب بسيط من لغة جافاسكربت وفهمنا أبرز المراحل التي مرت بها وكيف تطورت إلى هذه المرحلة التي نشهدها في وقتنا الحالي وفصلنا بعدها في فهم كل من لغة جافاسكربت و TypeScript وانتقلنا بعدها لنستطلع الفروقات بينها من ناحية الشعبية والتطوير وأنواع المتغيرات ونوع اللغة البرمجية، وناقشنا أيهما يجب على المبتدئ تعلمه في البداية وانتهينا بمعرفة اللغة المناسبة لكل مشروع. ختامًا إن لغة جافاسكربت لغة قوية جدًا وهي اللغة الأكثر شعبية لسنوات عديدة في إحصائيات موقع Stackoverflow. ومع ذلك هذا لا يعني أنها مثالية (وهل برأيك يوجد لغة برمجة مثالية؟). عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المشاريع الكبيرة، يمكن أن تصبح الأمور فوضوية ومربكة في جافاسكربت. لذلك طورت شركة مايكروسوفت لغة TypeScript لهذا الاستخدام تحديدًا. ما رأيك أنت عزيزي القارئ هل فعلًا أحدهما أفضل من الآخر؟ شاركنا رأيك في التعليقات. المصادر مقال ?Typescript vs Javascript: Which one is better لكاتبتيه Mariana Berga وRute Figueiredo. مقال ?TypeScript vs JavaScript: What is the Difference لكاتبه James Hartman. مقال TypeScript vs JavaScript: 7 Major Differences You Must Know لكاتبه Jeel Patel. مقال Understanding Difference Between TypeScript and JavaScript لمحرري الموقع. اقرأ أيضًا مدخل إلى TypeScript الخطوات الأولى في بناء تطبيقات الويب باستعمال TypeScript الدليل السريع إلى لغة البرمجة جافاسكريبت JavaScript
-
يعد مجال البرمجة عمومًا وتطوير الويب خصوصًا من أكثر المجالات نموًا في السنوات القليلة الماضية، فنشهد شهريًا صدور تقنية جديدة سواء كانت مكتبة أو إطار عمل ومع صدور تقنية جديدة تختفي مقابلها تقنية أخرى ولتأخذ محلها في النظام البيئي للبرمجة عمومًا ولبرمجة الويب خصوصًا، الأمر الذي يجعل المبرمج يحتار في اختيار ما يتعلمه وحتى إدارته وخصيصًا إذا كان مبتدئًا في مجال البرمجة. فأصبح لدينا مثلًا مكتبات (خصوصًا مكتبات وأطر عمل جافاسكربت الكثيرة والمتنوعة) والتي تعتمد بدورها على مكتبات أخرى وتلك الأخيرة تعتمد على مكتبات وهلم جرًا، فإن احتجت في مشروع تطوير موقع مثلًا إلى مكتبة تحوي ميزة ما، فعملية تنزيل مكتبة أو إطار العمل يدويًا عملية صعبة ومعقدة وهنا يتطلب الأمر أداة تدير كل تلك الأمور وهنا جاءت فكرة مدير الحزم. سنغطي في هذا المقال الفكرة الكامنة وراء مدير الحزم وسنستعرضُ جوانبًا مختلفة من أشهر مديري حزم للغة جافاسكربت في وقتنا الحالي وهما Yarn و NPM لنرى كيف ستوفر الوقت والجهد وتناسب احتياجاتك المشاريع الحديثة. هذا المنشور ليس مجرد دليل حول مدير الحزم Yarn و NPM ولكنه يهدف إلى توفير هيكل للمساعدة في الحكم على مدير الحزم بشكل عام، وفي حالة طرح مدير حزم جديد في الشهر المقبل فإنك ستعرف بالضبط ما هي الأمور التي يجب النظر إليها! نفترض في هذا المقال بأن لديك معرفة أساسية بتقنيات تطوير الويب (مثل لغة HTML و CSS وجافاسكربت) وكيفية عمل المواقع بشكل عام. تاريخ ونشأة مدير الحزم منذ زمن ليس ببعيد كانت رحلة مطور الويب وتحديدًا مطور الواجهات الأمامية سهلة نسبيًا إذ كل ما سيحتاج تعلمه هو HTML و CSS وجافاسكربت وفي حال أراد زيادة الاحترافية والجودة في عمله فيمكنه الاطلاع على Bootstrap مثلًا أو بعض الحركات والخدع بلغة جافاسكربت، ولكن الأمر اختلف بصورة كبيرة فاليوم نتحدث عن مدير الحزم (مثل Npm) ومحول الشيفرة البرمجية (مثل Babel) ومجمع الحزم (مثل Webpack) بل حتى لغات جديدة (مثل لغة TypeScript) والكثير من التقنيات الأخرى الجديدة. الأمر الذي يجعل المبتدئين ينفرون من كل هذا التعقيد، ولكن مهلًا هل صناعة صفحة ويب تحتاج بالضرورة لهذه الدرجة من التعقيد؟ في الحقيقة نعم محاولة إرضاء مستخدمي القرن الواحد والعشرين وتحديدًا الجيل زد يحتاج منا مواكب مستوى الجودة الذي تعودوا عليه من استخدامهم لتطبيقات الشركات الكبرى مثل فيسبوك وانستغرام ..إلخ ولكن الأمر ليس صعبًا إذا فهما المشاكل التي استدعت وجود مثل هكذا حلول. سنوضح أهمية مدير الحزم من خلال المثال التالي: كانت الطريقة القديمة في كتابة الشيفرة البرمجية هي كتابة الهيكل العام للصفحة من خلال لغة HTML وفي حال أردنا تضمين تنسيقات ولغة جافاسكربت ليكون الموقع تفاعليًا يمكننا تنفيذ الأمر بطريقتين إما شيفرة سطرية أي وضع التعليمات البرمجية للغة جافاسكربت وتنسيقات CSS في نفس الصفحة لتكون على الشكل التالي: <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Inline Example</title> </head> <body> <h1> The Answer is <span id="answer"></span> </h1> <script type="text/javascript"> function add(a, b) { return a + b; } function reduce(arr, iteratee) { var index = 0, length = arr.length, memo = arr[index]; for(index += 1; index < length; index += 1){ memo = iteratee(memo, arr[index]) } return memo; } function sum(arr){ return reduce(arr, add); } /* Main Function */ var values = [ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ]; var answer = sum(values) document.getElementById("answer").innerHTML = answer; </script> </body> </html> بالرغم من أن هذه الطريقة جيدة نسبيًا إذ كل الشيفرة موجودة أمامنا إلا أن هذه هي الطريقة المثالية لبناء شيفرة برمجية غير قابلة للصيانة وذلك بسبب عدم إمكانية إعادة استخدام الشيفرة البرمجية في صفحات الويب الأخرى في حال احتجنا لها وعدم وجود ثبات في التبعية بين الشيفرة البرمجية أي إذا اعتمدت دالة معينة في وظيفتها على نتيجة دالة أخرى فيجب علينا حينها الانتباه بأن تكون محققة قبلها والحرص على عدم تغيير ترتيب تواجد الدوال في الشيفرة البرمجية. وبالإضافة إلى التضارب في المتغيرات العامة Global Variables خصيصًا عند ازدياد ضخامة المشروع. سرعان ما اكتشف المطورون حتمية استخدام ملفات خارجية منفصلة وتجزيئ الشيفرة البرمجية إلى أجزاء صغيرة وتحميلها تباعًا في ملف واحد يعد بمثابة المدخل يسمى عادة index.html. وبهذه الطريقة يمكننا استدعاء مكتبات منفصلة. هذا الأمر حل لنا بعضا من المشاكل التي كنا نواجهها في الطريقة القديمة وسمح لنا بإعادة استخدام الشيفرة البرمجية أكثر من مرة ومن أي مكان نريده، وبذلك نكون تخلصنا من فكرة نسخ الشيفرة البرمجية من مكان ما ولصقها في مكان آخر متى ما أردنا استخدام هذه الشيفرة. سيكون شكل ملف index.html هكذا: <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>External File Example</title> <!-- الملف الرئيسي الّذي سيستدعي ملفات جافاسكربت --> </head> <body> <h1> The Answer is <span id="answer"></span> </h1> <script type="text/javascript" src="./add.js"></script> <script type="text/javascript" src="./reduce.js"></script> <script type="text/javascript" src="./sum.js"></script> <script type="text/javascript" src="./main.js"></script> </body> </html> لكن مهلًا هل هذا كل ما سنحتاجه لإضافة ملفات خارجية لموقعنا؟ في الحقيقة بالرغم من حل جزء من المشكلة ظهرت لدينا مشكلة أخرى وهي في حال ظهر تحديث جديد لمكتبة ما هل ستبحث عن جميع الأسطر التي تحتوي على التضمين للمكتبة التي تريدها ونعوضها بالنسخة الجديدة هذه العملية اليدوية مرهقة جدًا أليس كذلك؟ ظهور مدير الحزم Package Manager عندما ضجر مجتمع المطورين من هذه المشاكل التي تستهلك الوقت والجهد حاولوا حل هذه المشكلة وهنا ظهر لنا الحل السحري لإدارة المكتبات الخارجية وهو مدير الحزم Package Manager: (ويشار إليه أيضًا بنظام إدارة الحزم) وهو مجموعة من أدوات البرامج التي تعمل على أتمتة عملية تثبيت الحزم وترقيتها وتكوينها وإزالتها بطريقة متسقة. عندما نتعامل مع مدير الحزم سنواجه مصطلحين جديدين وهما الحزمة Package : وهي أرشيف يحتوي الملفات المطلوب تثبيتها ومعها بيانات توصيفية (أو تسمى أحيانًا ميتا Meta) مثل رقم الإصدار والمزايا الموجودة فيها ومتطلبات التثبيت (التبعيات الخاصة بها) والعلاقات بين الحزم مثل التوافقية والإحلال والتعارض وماذا يُشغّل قبل وبعد التثبيت (من شيفرات برمجية وسكربتات) …إلخ. بمجرد تثبيت الحزمة في مشروعك ستصبح اسم الحزمة تبعيّة Dependency: وهي جزء من برنامج معين تابع لجهة خارجية من المحتمل أن يكون كتبه شخص آخر ويعمل بشكل مثالي على حل مشكلة واحدة نيابة عنك. يمكن أن يحتوي مشروع الويب عدد من التبعيات ويمكن أن تتضمن تبعيات المشروع تبعيات فرعية لم تثبتها صراحةً في مشروعك. مع أن التعريفين متشابهان بطريقة ما إلا أننا تعمدنا ذلك للتوضيح وجهتي النظر التي يمكننا استنباطها من رحلة مبرمج الويب. وعمومًا يمكن لمدير الحزم أن يساعدنا على: معرفة ما هي الحزم المثبتة. معرفة ما هو الإصدار المثبتة من حزمة معينة. تثبيت حزمة غير موجودة عندك (البحث عن مصدر موثوق لها وتنزيلها من الإنترنت ثم تثبيتها) أو تحديثها أو حذفها. تشغيل الحزم دون تنزيل (الميزة متاحة في مدير الحزم npm باستخدام الأمر npx). مشارك الشيفرة البرمجية مع أي مستخدم npm في أي مكان. تقييد الشيفرة البرمجية على مطورين معينين. إنشاء حساب شركات لتنسيق وصيانة الحزم والتشفير والمطورين. تشكيل فرق مطورين افتراضي باستخدام حساب الشركات. إدارة إصدارات متعددة من تبعيات التعليمات البرمجية والتعليمات البرمجية. تحديث التطبيقات بسهولة عند تحديث الكود الأساسي. ابحث عن مطورين آخرين يعملون على مشاكل ومشاريع مماثلة. من الأمثلة البسيطة على التبعية المفيدة التي يمكن أن تحتاجها في مشروعك هي مكتبة لحساب التواريخ النسبية كنص يمكن للبشر قراءته بسهولة. بالطبع يمكنك كتابة الشيفرة البرمجية بنفسك، ولكن هناك فرصة قوية أن يكون شخص آخر حل هذه المشكلة بالفعل - فلماذا نضيع الوقت في إعادة اختراع العجلة؟ علاوة على ذلك، من المحتمل أن ما تكون التبعية مختبرة وموثوقة في العديد من المواقف المختلفة، ومتوافقة مع جميع أنواع المستعرضات القديمة أو الحديثة مما يجعلها أكثر قوة من الحل الخاص بك. لا يقتصر وجود مدير الحزم على مشاريع الويب فحسب وإنما يوجد في أنظمة الحاسوب مثل لينكس وتكون مهمته مشابهة إذ يعمل على إدارة البرمجيات المُثبتة على جهاز الحاسوب؛ ويتعقب البرامج المثبتة، ويسمح للمستخدم بتثبيت البرامج الجديدة بسهولة أو ترقية البرامج إلى إصدارات أحدث أو إزالة البرامج المثبتة مشابه جدًا لبرنامج Google Play على الهواتف المحمولة إلا أن الأخير مزود بشاشة رسومية سهلة الاستخدام. بحلول منتصف العشرينات من القرن العشرين أصبح مدير الحزم يتعامل مع نظام التشغيل Windows أيضًا، ويستخدم مدراء الحزم مع مختلف لغات البرمجة مثل: لغة البرمجة بايثون Python ولغة Ruby، ويطلق على مدير الحزم أيضًا مدير تنصيب النظام System Install Manager. في توزيعات لينكس المختلفة لا تُتناقل ملفات الحزم (عبر وحدات التخزين القابلة للإزالة كالفلاشة أو القرص المضغوط مثلًا مثل برامج ويندوز) بل توضع هذه الملفات في مستودعات على الإنترنت وعندما يطلب المستخدم حزمة معينة تجلب الحزمة تلقائيًا من المستودع. يتحكم المستخدم في المستودعات التي يريد أن يثق بها وغالبًا في التوزيعات الكبيرة مثل فيدورا وديبيان تحتوي مستودعات التوزيعة الرسمية عشرات الآلاف من الحزم البرمجية. أنواع مدراء الحزم هنالك الكثير من مدراء الحزم بحسب بيئة التطوير أو اللغة المستخدمة ومن أشهر مدراء الحزم نذكر: Composer: يستخدم في المشاريع المبنية على لغة البرمجة PHP. Gems: هو مخصص للغة البرمجة Ruby ويستخدم مع إطار العمل Rails. npm: هو مدير حزم مخصص لبيئة Node.js المعتمدة على لغة البرمجة جافاسكربت، ويمكن استخدام هذا المدير في أي مشروع برمجي على الويب. yarn: هو مدير حزم طورته شركة فيسبوك عام 2016 لبيئة Node.js التي تعمل بلفة جافاسكربت ويسعى هذا المدير لتوفر السرعة والاتساق والاستقرار والأمان بطريقة أفضل من npm بالرغم من أنه مبني على نفس الشيفرة البرمجية الخاصة ب npm. pip: وهو مدير حزم يستخدم في البرمجيات التي تعتمد على لغة البرمجة بايثون (مثل: Django و Flask). Bower هو مدير حزم للواجهات الأمامية مصمم خصيصًا للمكتبات مثل jquery و angular و bootstrap وما إلى ذلك. يتألف أي مدير حوم من ثلاثة مكونات وهي: الموقع الإلكتروني: يستخدم موقع الويب لاكتشاف الحزم وإعداد ملفات التعريف وإدارة الجوانب الأخرى لتجربة مدير الحزم، فعلى سبيل المثال يمكنك إعداد مؤسسات لإدارة الوصول إلى الحزم العامة أو الخاصة. السجل: وهو عن قاعدة بيانات عامة كبيرة تحتوي على الحزم والمعلومات الوصفية المرتبطة بها. واجهة سطر أوامر CLI، تسمى سجل npm: وهي الطريقة التي يتفاعل بها المطورين مع مدير الحزمة. سنناقش في هذا المقال الفرق بين مدير الحزم NPM و Yarn لنساعد المبرمج المبتدئ على اتخاذ قراره. نبذة وتاريخ موجز عن مديري الحزم NPM و Yarn مدير الحزم NPM (وهو اختصارًا لـ Node Package Manager) وهو مدير حزم للغة جافاسكربت. إنه المدير الافتراضي لبيئة Node.js التي تعمل بلغة جافاسكربت. ظهر لأول مرة في عام 2010 وسرعان ما انتشر بين المطورين نظرًا للحلول التي قدمها. مدير الحزم Yarn (وهو اختصارًا لـ Yet Another Resource Negotiator) وهو مدير مشابه لمدير npm. طورته شركة فيسبوك وهو مفتوح المصدر والهدف من تطويره (في ذلك الوقت) هو إصلاح مشكلات الأداء والأمان التي يعاني منها npm. table { width: 100%; } thead { vertical-align: middle; text-align: center; } td, th { border: 1px solid #dddddd; text-align: right; padding: 8px; text-align: inherit; } tr:nth-child(even) { background-color: #dddddd; } وجه المقارنة مدير الحزم npm مدير الحزم Yarn تاريخ صدوره 2010 2016 الموقع الرسمي npm yarn الإصدار الحالي v8.3.2 v3.1.1 فريق التطوير جمهور المطورين فقط شركة فيسبوك وجمهور المطورين لنفهم تطور كل مدير لنسافر بسرعة عبر الزمن لرؤية الصورة الكبيرة: 2010: صدور مدير الحزم npm بدعم Node. 2016: صدور مدير الحزم Yarn. أظهر أداء أفضل بكثير من مدير الحزم npm. كما أنه ينشئ ملف yarn.lock الذي يجعل مشاركة ونسخ المشاريع المتماثل والتبعيات أسهل بكثير وأدق. 2017: صدور npm 5 والذي أصبح ينشئ تلقائيًا ملف package-lock.json ردًا على إصدار مدير الحزم yarn لملف yarn.lock. 2018: صدور npm 6 بأمان محسّن وأصبح الآن يتحقق npm من الثغرات الأمنية قبل تثبيت التبعيات. 2020: صدور تحديثات لمدير الحزم Yarn 2 و npm 7. تأتي كلتا الحزمتين مع ميزات جديدة رائعة كما سنرى لاحقًا في هذا البرنامج التعليمي. 2021: صدور تحديثات Yarn 3 و npm 8 بتحسينات ومزايا مختلفة. يعتمد مديرا الحزم على بيئة Node.js وهي بيئة تشغيل مفتوحة المصدر تعمل عبر مختلف أنظمة التشغيل الأساسية لتنفيذ الشيفرة البرمجية للغة جافاسكربت خارج المتصفح. تعد بيئة Node.js حلًا مثاليًا لبناء خدمات خلفية قابلة للتطوير بشكل كبير وكثيفة البيانات وفي الوقت الحقيقي تعمل على تشغيل تطبيقات العملاء مثل الواجهات البرمجية APIs ومواقع بث الفيديو عبر الإنترنت، وتطبيقات الصفحة الواحدة، وتطبيقات الدردشة عبر الإنترنت، وما إلى ذلك. تستخدم العديد من الشركات الشهيرة بيئة Node.js لتطوير تطبيقاتها (مثل Netflix و Uber وغيرها الكثير غيرهما). أحد أسباب شعبية بيئة Node.js هو توفر حزم ومكتبات أطر عمل متنوعة ومفتوحة المصدر مساندة لعمل بيئة Node.js ومن أشهرها Express.js و Lodash و AsyncJS و Meteor و Sails وغيرها. ويمكن استخدام هذه الحزم في مشاريع التي تعتمد على لغة جافاسكربت وأطر العمل الخاصة بها. مقارنة بين npm vs yarn في وقتنا الحاضر يتسارع مدراء الحزم في السباق، ولكن لا تزال هناك العديد من الاختلافات التي تساعد في تحديد أيهما سنختار سنستعرض أهم الجوانب التي يجب النظر إليها عند اعتمادك لأي مدير حزم. المجتمع والتطوير لننظر في المجتمع لتقييم تطوير كل من npm و yarn لنلقي نظرة على مجتمعاتها خصيصًا فيما يتعلق بالإحصاءات الموجودة في مستودعات GitHub (نؤكد أن هذه الأرقام حتى تاريخ كتابة المقال). المجتمع الأكبر للمطورين يمكن أن يساعدك في الحصول على المساعدة بصورة أسرع عند مواجهة أية مشكلة في التنفيذ، وبالرغم من أن Yarn أحدث بالمقارنة مع npm إلا أنه يلحق بالركب بسرعة من حيث الشعبية. على سبيل المثال إذا قارنا بين عدد التنزيلات بين npm و Yarn في بين السنوات 2017 وحتى 2022 يمكننا أن نرى بأن npm هو الفائز الواضح هنا، ولكن إن نظرنا إلى الأرقام في مستودعات الحزم سنجد أن الأمر معكوس لصالح yarn. وجه المقارنة مدير الحزم npm مدير الحزم Yarn عدد المراقبين 173 ألف شخص 572 ألف شخص عدد النجوم 5.4 ألف نجمة 40.4 ألف نجمة عدد التفريعات 1.5 ألف تفريعة 2.8 ألف تفريعة عدد المساهمين 731 مساهم 521 مساهم الأداء والسرعة يتمثل أحد الاختلافات الرئيسية بين NPM و Yarn في كيفية تعاملهما مع عملية تثبيت الحزم. إذ يعمد Yarn على تثبيت الحزم بالتوازي أي يجلب حزم متعددة ويثبتها في وقت واحد. فإذا كنت تثبت خمس حزم، واثنتان تستغرقان وقتًا طويلًا للتثبيت، فسيُثبت Yarn الحزم جنبًا إلى جنب. من ناحية أخرى تثبت NPM كل الحزم بطريقة تسلسلية أي كل حزمة بمفردها. في الحقيقة إن التثبيت المتوازي هو أحد الأسباب التي تجعل Yarn يتفوق على NPM في سباق الأداء. يوجد في كلاهما ميزة على ذاكرة تخزين مؤقت غير متصلة بالإنترنت وتدار بطريقة فعالة من خلال عملية تخزين كل حزمة مؤقتًا وحفظها على القرص، ويمكنك بعد ذلك تثبيت نفس الحزمة في مجلد مختلف من خلال ذاكرة التخزين المؤقت حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت، ويسمى هذا المفهوم بعمليات التثبيت الصفرية Zero installs، وبالرغم من أن Yarn لها بعض المزايا في السرعة إلا أنه بالمقارنة نجد بأن سرعات Yarn و npm متقاربة نسبيًا وخصيصًا في إصداراتها الأخيرة. تثبيت الحزم يوضح ملف yarn.lock في مدير الحزم yarn وملف package-lock.json في مدير الحزم npm قائمة بجميع التبعيات أو الحزم المطلوبة تثبيتها حتى يعمل المشروع. هذا الملف "يقفل" إصدارات التبعية الخاصة بك. بهذه الطريقة عندما يقوم شخص آخر بتشغيل الأمر install yarn أو install npm، سيتلقى إصدارات التبعيات الدقيقة المدرجة في ملف القفل. هذا يضمن أن فريقك لديه إصدارات الحزمة المتطابقة تمامًا مع متطلبات المشروع. كما أنه يساعد في منع الأخطاء التي يمكن أن تظهر بسبب إدخال إصدارات حزم محدثة غير مختبرة. الأمن والحماية أحد الانتقادات الرئيسية لمدير الحزم npm هو الأمان لأن إصدارات npm السابقة تحتوي على بضع ثغرات أمنية خطيرة، ولكن اعتبارًا من الإصدار 6 من المدير npm اصبح يدقق الحزم أثناء التثبيت ويخبرك إذا عثر على أي ثغرات أمنية. يمكننا إجراء هذا الفحص يدويًا عن طريق تشغيل الأمر npm audit على الحزم المثبتة. إذا عثر على أي ثغرات أمنية سيقدمُ لنا توصيات أمنية. توضح الصورة التالية تقارير التدقيق npm عن الحزم غير الآمنة: كما ترى في لقطة الشاشة أعلاه، يمكننا تشغيل الأمر npm audit fix لإصلاح ثغرات الحزمة، وسيصلح أشجار التبعية إذا كان من الممكن القيام بذلك. يستخدم كل من Yarn و npm خوارزميات تجزئة التشفير لضمان سلامة الحزم. يعتمد مدير الحزم Yarn على تقنية تدقيق المجموع Checksum ويشار إليها أيضًا المجموع الاختباري لضمان تكامل البيانات وهذه الخوارزمية مخصصة للكشف عن الخطأ الرياضي. إنها كتلة من البيانات المشتقة من البيانات الأصلية لاكتشاف الأخطاء عند نقل البيانات من جهاز حاسوب إلى آخر. يتحقق من أي خطأ قد يكون حدث أثناء نقل البيانات أو تخزينها. هذا يساعد على ضمان سلامة البيانات. قبل نقل البيانات، سينشئ المرسل رسالة تحسب المجموع الاختباري. وستُرفق هذه الرسالة (الحزمة) بالبيانات الأصلية. بعدها سيحسبُ المتلقي المجموع الاختباري وإذا تساوت قيمتا المجموع الاختباري مع بعضهما، فعندها لا يوجد أي خطأ وتقبل البيانات؛ خلاف ذلك ترفض البيانات. أما مدير الحزم npm فيعتمد على خوارزمية التجزئة الآمنة SHA-512 للتحقق من سلامة الحزم التي سيُثبتها. إذ يخزن سلاسل SHA-512 لكل حزمة مثبتة في ملف package-lock.json، كما هو موضح في الشيفرة البرمجية أدناه. "lodash": { "version": "4.17.21", "resolved": "https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.17.21.tgz", "integrity": "sha512-v2kDEe57lecTulaDIuNTPy3Ry4gLGJ6Z1O3vE1krgXZNrsQ+LFTGHVxVjcXPs17LhbZVGedAJv8XZ1tvj5FvSg==" } سيستخدم المدير NPM مفتاح SHA-512 لإجراء فحص سلامة في كل كتلة حزمة في ملف package-lock.json، كما يدقق كل حزمة أثناء التثبيت وإعلامك بنقاط الضعف المحتملة. سهولة التعلم والاستعمال أحد الأشياء التي يجب مراعاتها قبل اختيار مدير الحزم هو معرفة الواجهة سهلة الاستخدام. يتضمن ذلك كيف تبدو الأوامر. في الحقيقة إن NPM و Yarn لهما واجهات مختلفة لسطر الأوامر وكلاهما سهل الاستخدام ولديهما تجربة مستخدم جيدة. يتضح هذا عند استخدام أمر مثل npm init و yarn init. كلاهما لديه دليل تفاعلي يساعد المستخدمين على تهيئة مشروع Node.js. وجه المقارنة مدير الحزم npm مدير الحزم Yarn تثبيت التبعيات npm install yarn تثبيت حزمة معينة npm install package_name@version_number أو npm install package_name yarn add package_name@version_number أو yarn add package_name إزالة حزمة معينة npm uninstall package_name yarn remove package_name تهيئة مشروع جديد npm init yarn init تشغيل سكربت npm run script_name yarn script_name كيف نختار مدير الحزم الأنسب لمشروعنا؟ غطينا أوجه التشابه والاختلاف المختلفة بين مديري الحزم npm و yarn ، لكننا لم نحدد أيهما أفضل وأيهما يجب أن نختار. كما هو الحال دائمًا، تعتمد الإجابة على المشاريع التي نعمل عليها ومتطلباتها. وعمومًا يمكنك اختيار مدير الحزم npm إذا كنت راضيًا عن سير العمل الحالي، ولا تريد تثبيت أداة إضافية. أما إذا أردت بعض الميزات الرائعة المفقودة في npm فيجب عليك اختيار Yarn وتذكر بأن كِلا المديرين يتطوران باستمرار ويصححان المشاكل الموجودة بهما بل ويضيفان ميزات جديدة. الخاتمة تعرفنا في هذا المقال عن أهمية مدير الحزم في مشاريع الويب الحديثة واستعرضنا موجز تاريخي سريع عنها وفصلنا في مهامها وأنواعها وانتقلنا بعدها للتعرف على الفوارق بين مديريّ الحزم Yarn و npm فبدأنا بسرد موجز مختصر لتاريخ كل منها وفهمنا الفارق بينها في العديد من النواحي مثل مجتمع المطورين وإقبالهم على تبني كل مدير وتعمقنا في فهم فعالية كل مدير من خلال طريقة تثبيت للحزم وتأثيرها على الفرق البرمجية وسلاسة التطوير وفهمنا متى نستخدم كل واحد منها وعمومًا يمكن أن يكون الفرق ريثما تصدر تحديثة جديدة ولكن في الوقت الحالي يعد الخيارين رائعين في إدارة شجرة تبعيات المشروع وصيانتها. المصادر مقال Yarn vs npm: Everything You Need to Know لكتاتبه Ivaylo Gerchev. npm vs yarn. مقال Difference between npm and yarn لكاتبه Parikshit Hooda. مقال Choosing Between NPM and Yarn لكاتبه Joseph Chege. مقال YARN VS NPM: WHY AND HOW TO MIGRATE FROM NPM TO YARN لكاتبه Viktor Tsymbal. مقال ?NPM vs. Yarn: Which Package Manager Should You Choose لكاتبه Alfrick Opidi. اقرأ أيضًا دليلك الشامل إلى مدير الحزم npm في Node.js مدخل إلى الملحن composer: مدير الاعتماديات والحزم في PHP 18 مثالا لاستخدام مدير الحزم YUM أساسيات إدارة الحزم: apt ،yum ،dnf ،pkg
-
إن التطور الرقمي الّذي نعيشه اليوم غير كثيرًا من أسلوب حياتنا اليومية. فأصبح كلّ شيء في متناول أيدينا ونحن في منازلنا بل وعلى أسرتنا. لم تعد المسافات أو اللغات تشكل عوائقًا لاقتحام الشركات الأسواق العالمية بل أصبحت القوانين والأنظمة تشجع جدًا على ذلك ليرتفع بذلك التنافس بين العلامات التجارية. في مثل هكذا أجواء تنافسية وجميع المنافسين على بعد كبسة زر فقط من العميل أصبح وجود خطة محكمة للحفاظ على ولاء العملاء أمرًا لا مفر منه، بل وأصبح واجبًا على الشركات والعلامات التجارية تبني طرقًا جديدةً في التواصل مع عملائها، ولكن كيف يمكننا تعزيز ولاء العميل؟ هل هنالك خلطة سحرية أو وصفة جاهزة لهذا الأمر؟ في الحقيقة إن مرحلة تطوير العميل من غير موالي إلى الولاء الحقيقي (الّتي سبق أن شرحناها في مقال أنواع ولاء العملاء للعلامات التجارية) يتطلب الكثير من الجهد والوقت والأدوات ومن بين هذه الأدوات الّتي يمكننا استخدامها لتطوير ولاء العملاء هو برامج ولاء العملاء. مفهوم برنامج الولاء Loyalty Program إن برامج ولاء العملاء هي "برامج تسويقية تكافئ الأعضاء بطرق مختلفة وتحفزهم على زيادة الشراء". تتتبّع هذه البرامج السلوك الشرائي للعملاء وتكافئهم على ولائهم للعلامة التجارية. هذه البرامج هي وسيلة لمكافأة العملاء الدائمين وتشجيعهم على البقاء مخلصين. يمكن أن تشمل المكافآت البضائع المجانية أو المكافآت المالية أو القسائم أو حتى المنتجات المتقدمة. ومع ذلك فإن برنامج الولاء الجيد لا يتعلق فقط بالمكافآت بل هو قناة يمكن للعلامة التجارية من خلالها تعزيز علاقات العملاء مع العلامة التجارية. وتعد برامج الولاء من العوامل المؤثرة وبشدة على العلاقة بين العميل والشركة وتهدف إلى الحفاظ على مستوى المبيعات والأرباح، بالإضافة إلى زيادة ولاء عملاء الشركة الحاليين والمحافظة عليهم وتشجيعهم على شراء منتجات الشركة الجديدة. ينتشر استخدام برامج الولاء في متاجر البيع بالتجزئة وشركات الطيران وفي شركات الاتصالات وغيرها من القطاعات ويختلف كلّ برنامج عن الآخر في طريقة كسب النقاط والمكافآت والاشتراك. دعونا نلقِ نظرة أدق على أنواع برامج الولاء. أنواع برامج الولاء للعلامة التجارية في الحقيقة إن المحور الأساسي لبرنامج الولاء هو العميل وبما أن متطلبات العميل وتوقعاته متغيرة بحسب كلّ مجال من مجالات حياته الأمر الذي أجبر العلامات التجارية على تطوير أنواع مختلفة من برامج ولاء فظهرت برامج النقاط والبرامج المتدرجة والبرامج المدفوعة والكثير غيرها وجميع البرامج تتشارك هدف واحد ألا وهو الاحتفاظ بالعملاء المخلصين. وعمومًا لدينا 7 أنواع مختلفة من برامج الولاء وهي على الشكل التالي: برامج البطاقات المادية. برامج الولاء القائم على النقاط. برامج الولاء القائمة على استعادة المال. برامج الولاء المتدرجة. برامج ولاء التحالف. برامج الولاء المدفوعة. برامج الولاء المختلط. ولكن هل جميع هذه البرامج تخلق الولاء الحقيقي حقًا؟ كيف يمكننا التأكد من أي نوع من برامج الولاء الأفضل لعلامة تجارية معينة؟ هل خلط الكثير من برامج الولاء مع بعضها بعضًا سيجلب لي نتائج أفضل؟ سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة في الفقرات القادمة وسنُناقش الأنواع الأكثر شيوعًا لبرامج الولاء وسنشرحُ إيجابيات وسلبيات كلّ منها بالإضافة إلى ذكر مثال عن شركة تستخدم هذا النوع من البرامج، لنساعدك على معرفة نوع برنامج الولاء المناسب لعلامتك التجارية. 1. برامج البطاقات المادية يعد هذا البرنامج من أقدم برامج ولاء العملاء وقد شاع استخدامه في محلات البقالة وشركات الطيران قديمًا ويُقدم للعميل إما بطاقات ممغنطة أو ألبوم من الصور ليجمع العميل الصور ويحصل على الجائزة وفي بعض الأحيان تكون بطاقات ورقية مثقوبة عند كلّ عملية شراء. وعند حصول العميل مثلًا على تسع أوراق مثقوبة سيحصل على هدية معينة. هذا البرنامج لديه عائق منخفض أمام دخول العملاء، ومع ذلك فإن القيمة المقدمة فيه لا تكفي لخلق ولاء حقيقي لأنه يكافئ العملاء على عمليات الشراء التي من المحتمل إجراؤها على أي حال. من الأمثلة على ذلك هو برنامج الولاء Subway Club (لم يعد هذا البرنامج متاحًا) الّذي يقدمهُ مطعم Subway الأمريكي المتخصص في بيع الوجبات السريعة. البرنامج بسيط جدًا وهو عندما يجمع المستهلك 8 طوابع في الألبوم الّذي أعطته إياه الشركة يحصل على شطيرة مجانية. الايجابيات سهل على العميل فهم القيمة المقدمة. حاجز الدخول إلى برنامج الولاء منخفض لأن العضوية مجانية (بما ان العميل لا يحتاج لدفع نقود اضافية للدخول في برنامج الولاء). يمكن أن يشجع العملاء على تكرار الشراء في مدة زمنية معينة. سلبيات يمكن أن تتعرض هذه الطريقة للاحتيال أو السرقة بحكم أنها بطاقات فيزيائية. تكلفة إنشاء بطاقات حصرية وفريدة يمكن أن يكون عاليًا مما يؤدي لصعوبة استمرارية هذا البرنامج عند الزيادة الكبيرة في عدد العملاء. لا تضيف بيانات تفصيلية عن العميل مما يؤدي إلى صعوبة تخصيصها وجعل تجربة العميل فريدة من نوعها. لا تعزز كثيرًا من ولاء العميل بالموازنة مع البرامج الأخرى. 2. برامج الولاء القائم على النقاط تعدُ برامج النقاط رائعة في جذب الكثير من العملاء للتسجيل ولكنها ليست رائعة في استمرار المشاركة بسبب انخفاض التمايز وانخفاض القيمة المقدمة في برنامج الولاء. يضطر العملاء في هذا النوع من برامج الولاء للإنفاق مقدمًا للحصول على مكافآت تأتي لاحقًا. هذا الأمر سينعكس سلبًا على تجربة العملاء بحكم أن لديهم الآن خيارات أكثر من أي وقت مضى وهم أقل ولاء من أي وقت مضى. لذلك لا تقدم برامج النقاط القيمة الّتي يتطلع إليها المستهلكون المعاصرون للالتزام بالعلامة التجارية. من ناحية أخرى تكون هذه البرامج سهلة الانضمام إليها. مع برامج النقاط يمكن للعملاء الّذين يجمعون عددًا قليلًا من النقاط عدم رؤية القيمة الإضافية التي تقدمها العلامة التجارية كما أنها ليست رائعة في زيادة مستويات المشاركة والإنفاق، لذلك يمكن أن يستغرق هذا البرنامج وقتًا لتحقيق الربحية. أفضل مثال عن برنامج الولاء المعتمد على النقاط هو برنامج Petco Pals Rewards. يكسب العميل مقابل كلّ دولار ينفقه نقطة واحدة، وعندما يجمع العميل 100 نقطة يُمنح قسيمة بقيمة 5 دولارات. أي عند إنفاق 100 دولار يحصل على 5 دولارات لاستخدامها في شراء المنتجات. وتنتهي صلاحية النقاط بعد 45 يومًا من تاريخ الإصدار وإذا كان حساب العضو غير نشط لمدة 180 يومًا (مما يعني عدم وجود نشاط شراء) يعاد رصيد النقاط إلى 0. وهذا الأمر سيجعلُ من الصعب على المتسوقين غير المتكررين الاستفادة من هذه المكافأة. علاوة على ذلك إذا أنفق أحد العملاء 100 دولار على عملية شراء واحدة فلا يمكنه استخدام مكافأة 5 دولارات حتى عملية الشراء التالية في وقت يكون فيه الإشباع الفوري أمرًا بالغ الأهمية وهذا الأمر محبط من وجهة نظر العملاء. عمومًا لنستعرض أهم الإيجابيات والسلبيات الخاصة ببرامج الولاء المعتمدة على النقاط. الايجابيات حاجز الدخول إلى برنامج الولاء منخفض لأن العضوية مجانية. يساعد في الحصول على أعضاء لبدء جمع البيانات عن الشرائح المثالية للخدمات أو المنتجات. مخاطر هذا البرنامج قليلة من وجهة نظر العميل. سهل التجهيز والبناء. سلبيات لا يقدم قيمة كافية لجذب المزيد من العملاء المتفاعلين من الدرجة الأولى. لا يقدم الإشباع الفوري الّذي يطلبه المستهلكون المعاصرون. يعني انخفاض معدل المشاركة فرصًا أقل لجمع البيانات حول احتياجات العملاء ورغباتهم. ليس هناك تمايز كبير بين شرائح العملاء. الفوائد المالية البحتة لا تبني الولاء الحقيقي. 3. برامج الولاء القائمة على استعادة المال مشابه جدًا لبرامج النقاط ولكن بدل أن يأخذ العميل نقاط وهمية يسترد هنا أموال حقيقية، لا يقدم هذا البرنامج تمايزًا كبيرًا ولا يكافئ كلّ شخص بحسب إنفاقه وغالبًا ما يكون الجميع العملاء سواسية في مبلغ المال (الحسم مثلًا) المسترد كما أن هذا البرنامج لا يقدم تحفيزًا كبيرًا للعملاء لزيادة تفاعلهم. في برنامج CVS ExtraCare يكسب العملاء 2٪ من مكافآت ExtraBucks في كلّ مرة يستخدمون بطاقة الولاء الخاصة بهم. يمكن استخدام هذه الدولارات في كلّ خدمات الشركة. المهم هو أن العملاء الّذين لا ينفقون 50 دولارًا في عمليات الشراء أو العملاء الّذين لا يصلون إلى حد أدنى قدره 1 دولار في المكافآت بنهاية فترة الكسب لن يتلقوا أية مكافآت ولن ترحل أرباحهم إلى حساباتهم الشخصية. يمكن أن يصعب ذلك إدراك القيمة للمستهلكين الّذين لا يتسوقون بكثرة. الايجابيات حاجز الدخول إلى برنامج الولاء منخفض لأن العضوية مجانية. يمكن أن يؤدي استرداد المكافآت الحصرية من المتجر إلى زيادة المبيعات عند استرداد النقد. سهل التجهيز والبناء. سلبيات يكافئ العملاء المربحين وغير المربحين على حد سواء. لا يقدم إشباعًا فوريًا للعملاء. ليست مقنعة للمستهلكين الّذين لا يشترون بكثرة. لا يوجد تمايز كبير بالموازنة مع برامج الولاء الحديثة. 4. برامج الولاء المتدرجة تقدم برامج الولاء المتدرجة مكافآت مختلفة بناءً على مستوى استهلاك العميل وكلما ارتفع إنفاق العميل كلما ارتفع مستواه في برنامج الولاء. يمكن أن تكون هذه المستويات طريقة رائعة لزيادة مشاركة العملاء لأنها تضيف مستويات من التفرد إلى البرنامج. على عكس برامج الولاء السابقة يتمايز العملاء عن بعضهم بعضًا ويصبح الأمر متعلقًا بالمكانة فمع كلّ مستوى تأتي فوائد أفضل، إذ تضيف هذه المستويات عنصر التحفيز إلى البرنامج مما يؤدي لتحقيق البرنامج على معدل مشاركة عالٍ. يسمح هذا البرنامج برؤية العملاء لمستواهم بالنسبة للآخرين في البرنامج والاستفادة من الرغبة التنافسية للحصول على مكانة أعلى، ونظرًا لأن المستويات الأعلى توفر مزايا أفضل فإن هذه البرامج بطبيعتها تجعل العملاء الأكثر قيمة يشعرون بأنهم يحصلون على قيمة أكثر بل يمكن أن تجعلهم يشعرون وكأنهم كبار العملاء في الشركة. برامج الولاء المتدرجة هي في الأساس برامج نقاط معززة تضيف عناصر من التلعيب إلى البرنامج وتلعب على حب التفرد، ويمكن أن يقدم البرنامج مزايا تجريبية ويبدأ العملاء في الإنفاق للوصول إلى منطقة الولاء المتميزة لأن أفضل الفوائد تتطلب الإنفاق، لكن لا يزال البرنامج يتطلب عمليات شراء في البداية للحصول على المزايا والمكافآت لاحقًا. إن هكذا برامج تقدم قيمة كبيرة للعملاء من الدرجة الأولى وعندما يشعر العملاء بالتقدير، فمن المرجح أن يصبحوا من سفراء للعلامة التجارية. ومع ذلك، هذه البرامج لا تقدم الكثير من القيمة للأعضاء من الطبقة الدنيا. من النقاط المهمة الأخرى التي يجب أن يحققها البرنامج هو التوازن المنطقي بين إمكانية الوصول للمستوى التالي بطريقة واقعية من خلال الموازنة بين السهولة والصعوبة لكي لا يمل العميل من البرنامج. في الحقيقة يكون تصميم مثل هكذا برامج قائم على فكرة التلعيب أو اللوعبة Gamification والّتي هي من العناصر المسببة للإدمان الموجودة في ألعاب الفيديو فعند وجود أشياء مثل المستويات والكؤوس عند التقدم في برنامج الولاء سيجعل العملاء يعودون مرارًا وتكرارًا. ببساطة إن هذه التفاصيل الصغيرة تجعل برنامج الولاء ممتعًا. من أفضل الأمثلة على ذلك هو برنامج ولاء بيوتي إنسايدر من سيفورا Sephora. معظم العملاء يحبون برنامج الولاء الخاص بها ليس فقط بسبب النهج المتدرج وإنما لتوفيرها مكافآت تجريبية على عكس برامج النقاط البحتة. نجد هنا أن العملاء الّذين ينفقون 350 دولارًا يدخلون فئة VIP ويحصلون على هدايا مجانية وتجديدًا واحدًا سنويًا. وأما العملاء الّذين ينفقون 1000 دولار سنويًا فذلك سيرفعهم إلى أعلى مستوى يدعى Rouge ويتيح لهم الوصول إلى خط ساخن خاص والوصول إلى العروض الحصرية المميزة. الإيجابيات يركز البرنامج على العملاء ذوي الإنفاق الأعلى ويمنحهم أفضل المكافآت. يمكن تقديم تجربة أفضل عبر المستويات بالموازنة مع برامج النقاط التقليدية. المزيد من فرص التخصيص والتمايز للعملاء. يشجع على زيادة عمليات الشراء الإضافية لرغبة العملاء في تحقيق مستوى أعلى. أعضاء المستويات العليا أقل عرضة لإلغاء اشتراكهم في البرنامج. السلبيات ليست جذابة بنفس القدر لعملاء الطبقة المنخفضة الّذين لا ينفقون كثيرًا. يمكن أن يكون البدء في البرنامج شاقًا من المستوى الأدنى والوصول للمستويات العليا ويمثل حاجزًا أكبر للدخول موازنة ببرامج النقاط المجانية. أكثر تعقيدًا وتتطلب شرحًا سهلًا لفهم كيفية عمل كلّ مستوى. 5. برامج ولاء التحالف نظرًا لأن التمايز أمر بالغ الأهمية في سوق اليوم فمن الأفضل أن تستثمر العلامات التجارية في برامج الولاء الخاصة بها للتميز عن المنافسين وتعد برامج التحالف مثيرة للاهتمام إذ تشارك فيها العديد من الشركات والعلامات التجارية بدلًا من شركة واحدة. من الناحية النظرية هذه البرامج جذابة إذ يمكن للعملاء ربح النقاط واستخدامها في أي من العلامات التجارية المشاركة. ومع ذلك فهذه البرامج غير فعالة في خلق ولاء فعلي للعلامة التجارية (أو العلامات) المُؤسِسة لهذا البرنامج وإنما يكون الولاء للبرنامج نفسه. كما أن هذه البرامج تفتقر لإرضاء كلّ العملاء بحكم أنها ذات مقاس واحد للجميع. الايجابيات يمكن للعملاء ربح المكافآت بسرعة أكبر ولديهم المزيد من الخيارات حول كيفية استخدامها. تحصل كلّ علامة تجارية على إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع. توزيع تكاليف برنامج الولاء على الشركات المشاركة مثل تكاليف التسويق وتمويل المكافآت …إلخ. السلبيات صعوبة إدارة البيانات المجمعة بسبب توزيع المكافآت. صعوبة تحديد نسبة ولاء العميل لكلّ علامة مشاركة في برنامج الولاء. لا يمنح ميزة تنافسية أو تميز للعلامات التجارية المتحالفة في السوق. إمكانية استغلال بعض نقاط الضعف في برنامج الولاء مثل كسب العملاء نقاطًا من علامة تجارية معينة واستبدال النقاط لشراء خدمات من علامة تجارية أخرى في البرنامج. 6. برامج الولاء المدفوعة ويطلق عليها أيضًا برامج الولاء المميزة تطلب برامج الولاء هذه من الأعضاء دفع رسوم مقدمًا مقابل مزايا يمكنهم استخدامها في أي وقت. إنه إرضاء فوري للعملاء الّذين يسعدهم الدفع مقابل هكذا مزايا وذلك على عكس البرامج التقليدية. يجب على الشركة اكتشاف ما الذي يجعل العملاء على استعداد للدفع مقابل برامج الولاء وما هي أكثر المشاكل التي يواجهونها وما هي تطلعاتهم. تحتاج هذه البرامج لخبرة متخصصة لتأسيس برنامج قوي يمكن إدارته وتحسينه بسهولة معقولة كما أنها تحتاج إلى تدريب الموظفين وتجهيز خدمة العملاء لتلقي الكثير من الاستفسارات وتقديم خدمات مميزة للأعضاء المشتركين في هذا البرنامج لأن أفضل عملائك يدفعون مقابل هذه العضوية لذلك يجب أن تكون هذه التجربة هي الأفضل. مع هذا النوع من البرامج لا بدّ من توخي الحذر لأنها غير صالحة لجميع الخدمات، ولذلك من المحتمل أن تكون مطالبتك للعملاء بدفع رسوم العضوية بمثابة عائق كبير جدًا أمام دخول العميل العادي بناء على ذلك يجب دراسة فكرة البرنامج جيدًا قبل تجهيزه. أدرك تجار التجزئة بأن هكذا نوع من برامج الولاء يمكن أن يكون مفتاح التميز لجعل الشركة أو العلامة التجارية متأصلة في الحياة اليومية لعملائها وهو أكثر أهمية من أي وقت مضى. نظرًا لأن هذه البرامج تجلب مزيدًا من المشاركة وتزيد من متوسط قيمة سلات الشراء. بالإضافة إلى ذلك يمكنهم جمع بيانات مفيدة جدًا عن أفضل عملائهم. ووفقًا لتقرير لشركة ماكنزي حول برامج الولاء المدفوعة فإنه من المرجح أن ينفق أعضاء برامج الولاء المدفوعة حوالي 60٪ أكثر من الأعضاء العاديين، بينما بالنسبة لبرامج الولاء المجانية تكون احتمالية زيادة إنفاق الأعضاء بنسبة 30٪ فقط عن العملاء العاديين. في الحقيقة إن المفتاح الأساسي لهكذا نوع من البرامج هو الاستماع لما يطلبه عملاؤك حقًا وبناء برنامج حول ذلك. يمكن أن يتطلب الأمر تعيين وكالات أو أشخاص متخصصين في بناء برامج الولاء، ويمكن أن تكون النتائج مذهلة حقًا عند تنفيذه بصورة صحيحة. يعد برنامج أمازون برايم Amazon Prime من أشهر برامج الولاء المدفوعة إذ يدفع العميل 119 دولار سنويًا ليحصل على أفضل مزايا التسوق الممكنة بغض النظر عن وقت التسوق. بدءًا من التوصيل المجاني ومرورًا باشتراكات مجانية في خدمات أمازون الأخرى مثل خدمة بث الفيديو كما يحصل الأعضاء على الكثير من القيمة من البرنامج طوال حياتهم اليومية. الايجابيات يجذب أفضل عملائك. يرى العملاء أصحاب التفاعل العالي القيمة ويتفاعلون أكثر. فوائد البرنامج سهلة الفهم للعملاء. يمكن استخدام رسوم العضوية لتعويض تكاليف البرنامج أو كمصدر دخل إضافي. يساعد في جمع بيانات العملاء ذوي القيمة العالية. يمكن تقديم مكافآت أكثر جاذبية لكبار العملاء. السلبيات تعد الرسوم حاجزًا كبيرًا لدخول العملاء من الطبقة الفقيرة. إمكانية وجود عدد أكبر من أسئلة العملاء والقضايا التشغيلية بسبب أنهم سيدفعون مالًا لقاء هذا البرنامج. يتطلب وقتًا كبيرًا للدراسة والإعداد والتجهيز. يتطلب موظفين أصحاب مهارات عالية لإدارة البرنامج بصورة فعالة. 7. برامج الولاء المختلط برنامج الولاء المختلط هو مزج أكثر من نوع واحد من أنظمة الولاء. يمكنك دمج نظامين مختلفين على سبيل المثال نظام الطبقات ونظام النقاط. يتيح هكذا نوع من البرامج الاستفادة من المزايا الّتي يوفرها كلّ نوع من برامج الولاء الأمر الّذي يساعد على معالجة نقاط الضعف الخاصة بها وجعل البرنامج متكامل، ولكن يفضل عمومًا ألّا تدمج الكثير من البرامج المختلفة لأنها ستُربك العملاء ولن يعرفوا كيفية استخدام البرنامج أو التسلسل في مستوياته. فمثلًا يجذب برنامج النقاط المجاني معظم عملائه العرضيين أي غير الثابتين على علامة تجارية معينة لأن حاجز الدخول للبرنامج منخفض، ومع دمجه مع برنامج الولاء المدفوع يصبح الأمر أكثر تشويقًا وجاذبية بسبب عرض القيمة الكبيرة. ومع دمجه مع برنامج المستويات يمكن للأعضاء بالتحرك لأعلى ولأسفل دون الخروج من برنامج الولاء. وفقًا لدراسة أجراها موقع ClarusCommerce في عام 2020 على بيانات برامج الولاء المدفوعة جاء فيها أن 67٪ من العملاء المشاركين في برنامج الولاء المجاني يمكن أن ينضموا إلى برنامج الولاء المدفوع لنفس الشركة في حال توفره. من أفضل الأمثلة على ذلك هي شركة رعاية صحية أمريكية CVS والتي تمتلك سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة فتقدم CVS برنامج ولاء CarePass مقابل 5 دولارات أمريكية شهريًا. توفر فئة الولاء المتميز هذه خدمة توصيل مجانية للوصفات الطبية المقبولة بالإضافة إلى الشحن السريع والمجاني والخصومات الفورية على بعض المنتجات والمكافآت الشهرية. كما يمكن للعملاء الوصول إلى خط الساخن للتحدث مع أحد الصيادلة مباشرة وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. إنه برنامج رائع لأولئك الّذين يقدرون هذه الفوائد. وبحسب مقال منشور في موقع فوربس ينفق أعضاء برنامج الولاء CarePass ثلاث إلى أربع مرات أكثر من متوسط العملاء العاديين. دمج برامج الولاء مع نظام الإحالات لتحقيق نجاح في برنامج الولاء لا بدّ من دمجه مع العديد من الأمور الخاصة الّتي تساعد على نجاح برنامج الولاء وازدهاره ومن بين هذه الأمور هي التسويق بالإحالة. في الحقيقة يتيح التسويق بالإحالة الوصول إلى دائرة الأصدقاء والمعارف الخاصة بالعميل، ويركز على استخدام العملاء المخلصين لكسب المزيد من العملاء ومن المرجح أن يأخذ المستهلكون توصية من أقرانهم واقربائهم والبيئة المحيطة بهم تؤثر على قرارهم أكثر من تأثير الإعلانات التقليدية. العملاء المحالون هم أيضًا أكثر قيمة لشركتك من العملاء المكتسبين بوسائل أخرى. العميل الّذي أحاله أحد الأصدقاء لديه بالفعل رأي إيجابي عن شركتك، وهو ما يعادل زيادة احتمالية شرائه للمنتجات كما يتمتع العملاء المحالون أيضًا بفرصة أكبر لأن يصبحوا عملاء على المدى الطويل؛ وفقًا لدراسة أجرتها هارفارد بزنس ريفيو Harvard Business Review فإن العملاء الّذين يحيلهم أحد الأصدقاء هم أكثر عرضة بنسبة 18٪ للبقاء مع شركتك. من أفضل الأمثلة على ذلك هو متجر مستلزمات أحواض الأسماك Marine Depot والذي شهد زيادة بنسبة 35٪ في معدل التحويل عندما جمعوا بين مكافآت العملاء والتسويق بالإحالة لإنشاء مجتمع حول علامتهم التجارية. بفضل الوفرة الحديثة للتكنولوجيا والوسائط الاجتماعية أصبحت عملية الإحالة سهلة لعلامتك التجارية وعميلك سعيد جدًا في مشاركته في هذا النشاط الأمر الّذي يعود بالفائدة على الشركة والعميل. إذا كان لديك بالفعل برنامج ولاء العملاء فيمكنك استخدامه كبنية تحتية أساسية لبرنامج الإحالة بما في ذلك حسابات الأعضاء والنقاط والعملاء المتحمسين الّذين نحتاجهم بشدة لبداية ناجحة لحملة تسويق بالإحالة. سيؤدي تسويق الإحالة لزيادة عائد الاستثمار بسهولة على استثمارك الحالي في برنامج الولاء. وفي الوقت نفسه لديك أيضًا جميع المعلومات الّتي تحتاجها للإعلان الفعال والمستهدف عن برنامج الإحالة الجديد الخاص بك. يمكن أن يكون دمج برامج الولاء مع برامج الإحالة فعال بصورة تفوق التوقعات. دمج برامج الولاء مع المسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي إن الانتشار الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي بين الناس بمختلف اهتماماتهم وثقافاتهم جعل هذه الشبكات محط أنظار للشركات الناشئة للبحث عن زبائن لها. فبحسب إحصائية لموقع Statista في عام 2021 يوجد 2.797 مليار مستخدم لشبكة الفيسبوك، و 2.291 مليار مستخدم على لشبكة يوتيوب، و 1.287 مليار مستخدم لشبكة انستغرام، و 396 مليون مستخدم لشبكة تويتر. على ضوء هذه الأرقام ستكون هذه الشبكات بمثابة منجم حقيقي للشركات لإيجاد عملائها المحتملين. ولكن كشركات تجارية لا بدّ لنا من طريقة لتشجيع الناس على المشاركة مع العلامات التجارية في هذه المنصات. ومن أفضل الطرق الممكنة لذلك هي استخدام هذه المنصات للترويج لمسابقات لعلامتك التجارية. يمكن وضع شرط الدخول في هذه المسابقات التسجيل في برنامج الولاء المجاني، وعندها فقط تؤخذ مشاركتهم بالحسبان ويدخلون على السحب الإلكتروني. يعد الفوز بجائزة مجانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من أفضل الطرق لتقديم تجربة إيجابية للعملاء. هذا يعني أنك لن تحصل فقط على وصول ومشاركة من الجمهور فقط وإنما يمكن أن تساعدك هذه المسابقات على تحويل هذا الولاء المجاني إلى ولاء حقيقي. تسمح مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي للمستهلكين بإظهار إنجازاتهم أمام أقرانهم. يشارك المستهلك الحديث بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي. ومع أن المستهلك العادي يتمتع بفترة اهتمام قصيرة نسبيًا ولكن من المرجح ألّا يتفاعل مع العلامات التجارية الّتي لا تقدم مكافآت مثيرة للاهتمام. من خلال إضافة جانب وسائل التواصل الاجتماعي إلى المسابقات، يمكن للشركات توفير قاعدة اهتمام مستدامة للعملاء المحتملين. واحدة من المزالق الرئيسية لبعض المسابقات هو عدم وجود قيمة في الجائزة في حين أن هذا يمكن أن يجذب مجموعة عملاء أقل قدرة على النهوض بإيرادات الشركة أو العلامة التجارية، إلا أنه يمكن أن يقلل أيضًا من قيمة السعر للمستهلكين المتميزين. ومع ذلك، فإن أفضل مكافآت مسابقة وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطوي دائمًا على قيمة نقدية، ويمكنك التبرع بالأموال إلى الجمعيات الخيرية أو لحماية البيئة الّتي يمكن أن تجذب قاعدة عملاء أوسع وأن تحسن الصورة العامة الشركة في ذهن المستهلكين. يوصي العديد من خبراء التسويق بأن تضع المكافأة المالية بما لا يقل عن 2.5 ضعف قمية متوسط السلة العادية للمتجر. من خلال مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي ستضرب عصفورين في حجر واحد فمن جهة تحث الجمهور على الاشتراك في برنامج الولاء، ومن جهة أخرى تمنح هذه التفاعلات خوارزميات وسائل التواصل الذكية تثق في صفحتك وتقترحها للأشخاص المناسبين لزيادة تفاعلهم على هذه الشبكة الاجتماعية مما سيؤدي إلى حصول علامتك التجارية على ترويج مجاني، ولكن لا يخلو الأمر من المشاكل ومن أكبر المشاكل الّتي ستواجهك عندما تريد بناء الولاء من خلال الشبكات الإجتماعية هي زيادة معدل النقرات مع ازدياد معدل وصول المنشورات. يمكن أن يكون لديك العديد من المنشورات الشائعة على الشبكات الاجتماعية، ولكن يمكنها أن تكون أيضًا بلا قيمة إذا لم يكن هنالك مستخدمون يتفاعلون مع العلامة التجارية بالطريقة الصحيحة سواء في زيادة المبيعات أو الانضمام إلى برنامج الولاء أو أيً كان هدفك من المسابقة. عمومًا هنالك العديد من المسابقات التي يمكنك إنشاؤها على هذه الشبكات الإجتماعية نذكر منها مسابقات التقاط الصور أو السيلفي ومسابقات الإعجاب أو التعليق ومسابقات كتابة المقال وغيرها من أنواع المسابقات. الخاتمة مما لا شك فيه أن برامج الولاء أصبحت ضرورة لأي علامة تجارية ويعتمد اختيارك لنوع معين من البرامج على فهمك القوي للجمهور المستهدف الّذي تسعى وراءه فإذا كنت تحاول ببساطة جذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين للاشتراك في برنامج الولاء الخاص بك فيمكن أن يكون برنامج الولاء المجاني التقليدي هو الأنسب لك سواء برنامج النقاط أو برنامج استعادة الأموال أو برنامج المستويات أو برنامج التحالف. بالرغم من أن هذه البرامج لا تحتوي على العديد من العوائق للدخول بها إلا أنها لا تساعدك كثيرًا في تمييز علامتك التجارية. من ناحية أخرى، إذا كنت مهتمًا بجعل العملاء الأكثر إلتزامًا ويتفاعلون مع علامتك التجارية فيمكن أن تكون برامج الولاء المدفوعة هي بالضبط ما تبحث عنه للارتقاء بعلاقتك مع عملائك للمستوى التالي. من المحتمل أن يجذب برنامج الولاء المختلط عملاء من جميع المستويات وبالتأكيد سيُساعدك جدًا دمج نظام الاحالات مع برنامج ولاء العملاء لكسب دائرة المعارف الضيقة للعميل وبالتأكيد إذا كنت تسعى لدوائر أكبر فإن إقامة المسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي ستفي بالغرض حتمًا. ختامًا يمكن أن يجذب برنامج الولاء المجاني العملاء العرضيين وبمجرد دخولهم يصبح من السهل كثيرًا إثبات القيمة الّتي يمكن أن تقدمها للعملاء والّتي ستؤدي في النهاية إلى زيادة المشاركة وحب العلامة التجارية. ولكن هناك حقيقة مؤكدة مع جميع أنواع برامج الولاء ألا وهي أنه "لن ينجح برنامج الولاء إلا إذا كان رضا العميل هو محوره". وتشجيع العملاء على التسجيل ليس سوى الخطوة الأولى لأن ما تقدمه لهم كأعضاء في البرنامج هو الّذي سيحدد ما إذا كانوا سيُواصلون العودة أم لا، والطريقة الوحيدة لمعرفة جودة ما تقدمه علامتك التجارية هو من خلال الاستماع لردود أفعال العملاء وتعليقاتهم وملاحظاتهم. المصادر مقال ?7 Types of Loyalty Programs: Which is Right for Your Brand لصاحبه Paul Wolfer. مقال Generate Loyalty & Conversions with Social Media Contests لصاحبته Grace Miller. مقال Loyalty Program Best Practices: Referral Marketing To Mix لصاحبته Grace Miller. اقرأ أيضًا ولاء العملاء: كيف تغري عملائك؟! مستقبل برامج ولاء العملاء قياس أداء برنامج ولاء العملاء دليلك لتحفيز العملاء وبناء الولاء