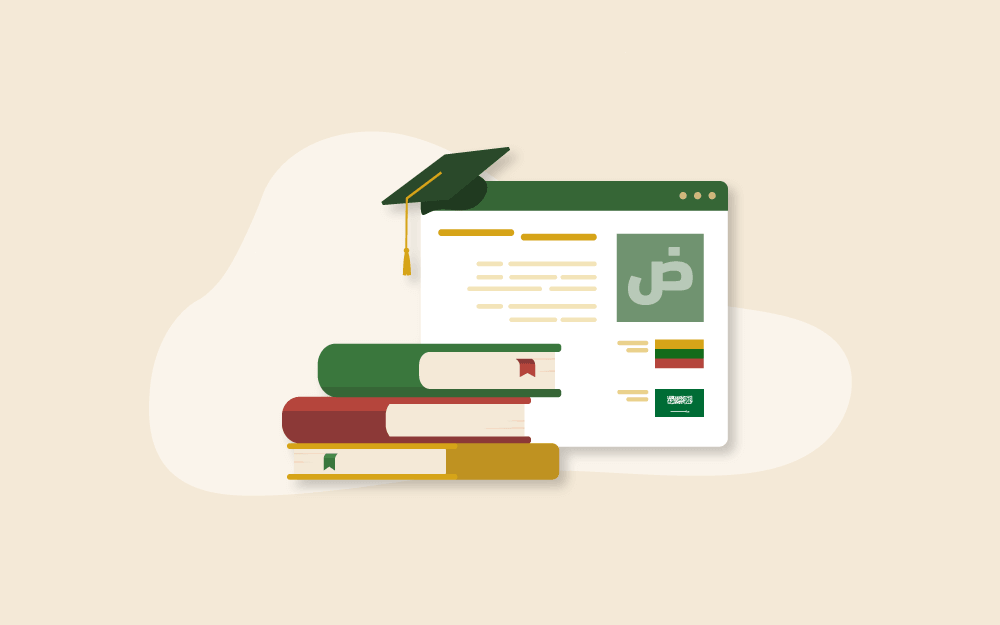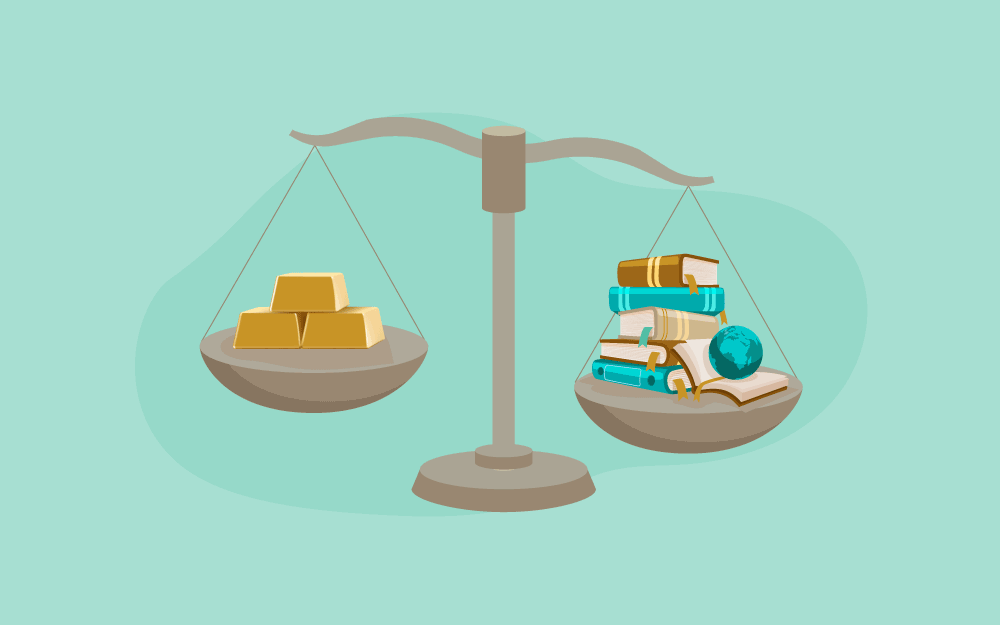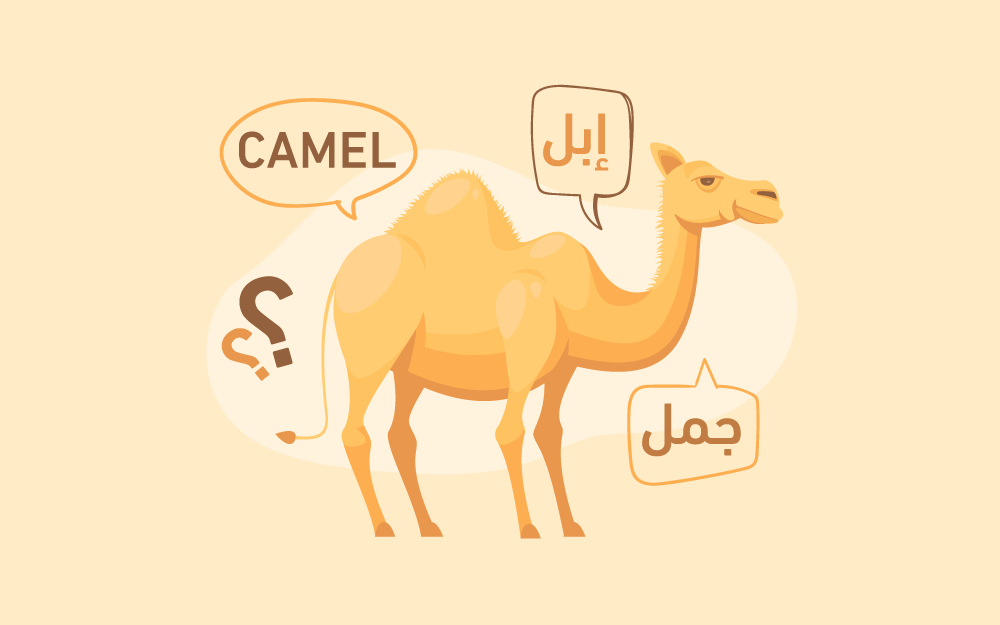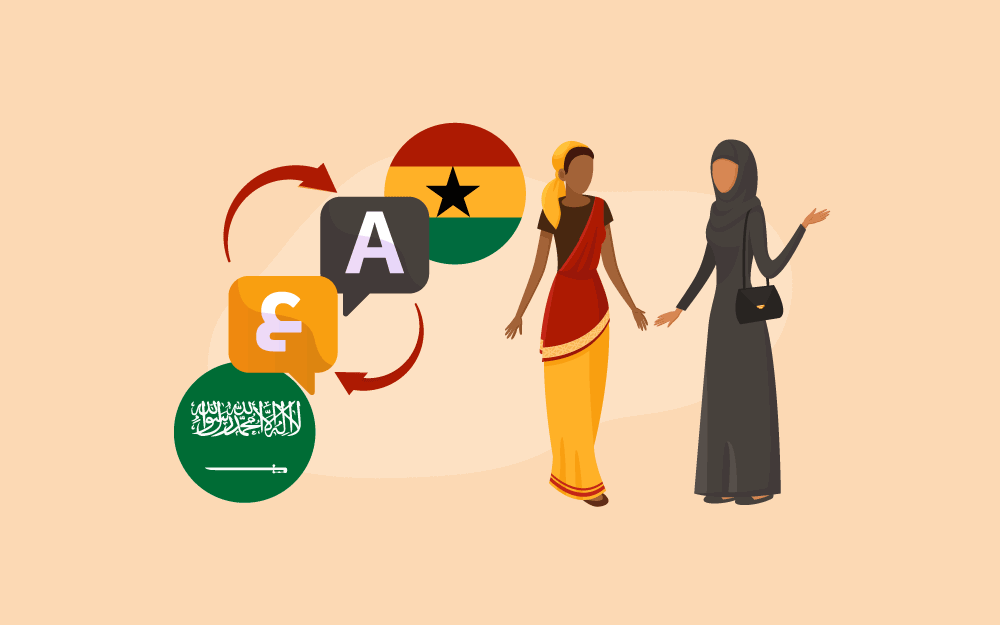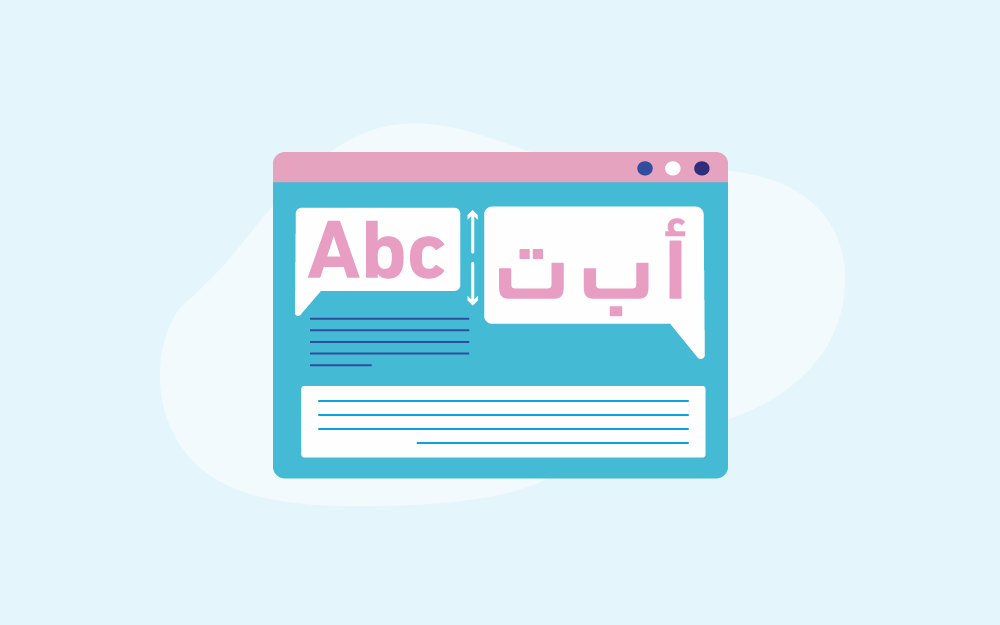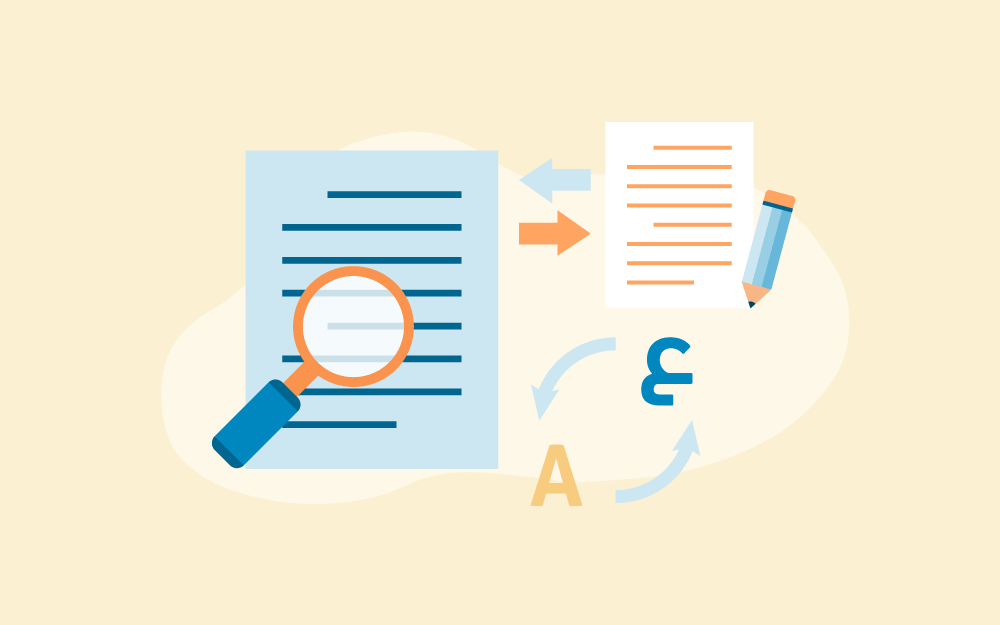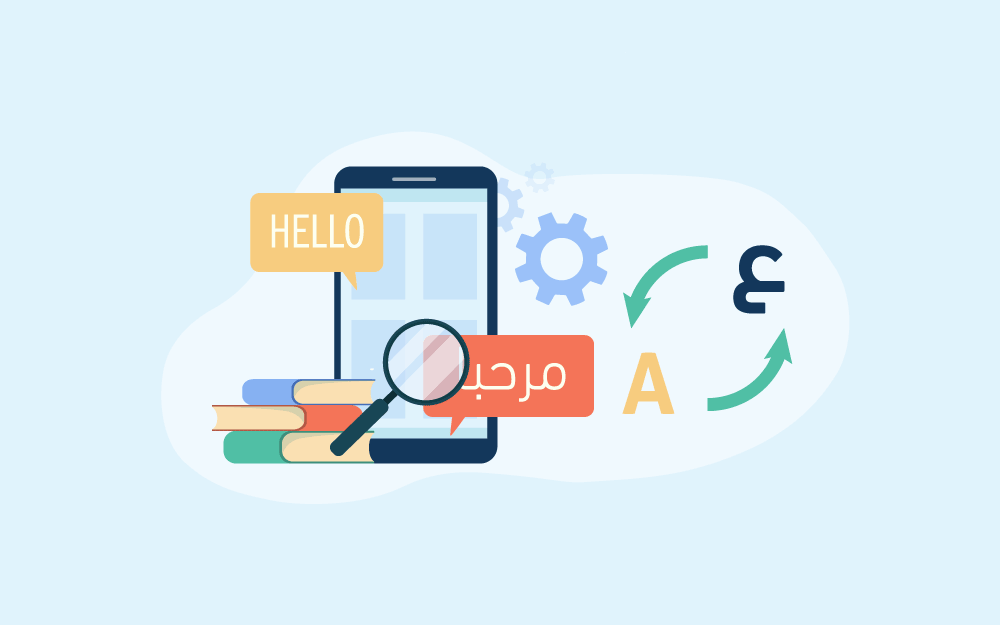البحث في الموقع
المحتوى عن 'الترجمة والتعريب'.
-
من أخطر الأفكار والتصورات السائدة عن الترجمة أنها استعاضة عن كلمات لغة ما (الإنكليزية مثلًا) بمرادفاتها بلغة أخرى (وهي العربية في سياقنا)، وهذا خطأ جوهري جدًّا، وسائد جدًّا؛ بحيث إنني فضلت أن أخالف بسببه الترتيب المألوف للكتب العلمية؛ التي تبدأ بالتعاريف الأكاديمية الجامدة، وأن أخصص الفصل الأول من هذا الكتاب لبحث ظاهرة الترجمة على المستوى التجريدي وما يكتنفها من مشكلات "الترادف" أو "التقابل"؛[1] التي كانت لفترة طويلة -وربما ما تزال- السؤال الرائد في مجال الترجمة.[2] وهذا ليس غريبًا، فمن المعتاد أن يتعلم الطلاب في فصول اللغات الأجنبية (بأي بلد في العالم) معاني ألفاظها بأن يبحثوا عمَّا يقابلها في لغتهم، فيقال لهم: إن المدينة معناها "city" وأن البيت معناه "house". ومن ذلك الوقت نشأ الطلبة وقد استقر في أذهانهم هذا "الارتباط الأبدي" بين الكلمة الأجنبية ومرادفها في لغتهم (حسب ظنهم)،[3] فأمسى من العسير إقناعهم بأن لهذه الكلمات أي معنى أو دلالة[4] غير ما اعتادوا عليه[5] (حسبما يقول المترجم محمد عناني).[6] ومن الضروري أن نطرح هنا سؤالًا أساسيًا: لو احتجنا لوصف ظاهرة الترجمة لشخص لا يعرف ما هي الترجمة، فكيف نصفها له؟ قد نلجأ لتعريف الترجمة المعتاد أكاديميًّا، فنقول: "إنها نقل لمعنى منطوق[7] أو مكتوب من لغة[8] إلى لغة غيرها".[9] إلا أن هذا التعريف الجامد لا يجيب عن السؤال تمامًا؛ لأنه يصف هدف الترجمة؛ وهو نقل المعنى من لغة إلى غيرها، ولكن هل هذا أمر ممكن وهل هو ما يصنعه المترجمون في مهنتهم؟ سنجد الإجابة عن هذا السؤال محفوفة بمئات الأوراق البحثية والكتب والنظريات التي وضعها علماء اللسانيات؛ إذ لاقت ظاهرة الترجمة اهتمامًا واحتفاءً متزايدًا من المجتمع العلمي منذ سبعين عامًا تقريبًا، وكان هذا السؤال من أهم أسسها وموضوعات بحثها. وإجابته باختصار هي: "لا"، إذ لا يمكن للمترجم -على الأرجح- نقل معنى كامل بين أي لغتين في العالم، ولكنه يستطيع تقريب هذا المعنى، فيكاد ينجح حينًا ويحيد عن مسعاه حينًا.[10][11] بحث علماء اللغة أفكارًا ونقاشات مثيرةً كثيرةً بهذا الخصوص، وسنتطرق إليها بتفصيل معقول فيما بعد، وأما ما عليكَ أن تضعه في الحسبان في هذه المقدمة؛ فهو أن ظاهرة الترجمة -كما يتخيلها الناس- لا وجود لها في الواقع، فلو كنت تتقن أي لغة غير لغتك الأم (ولو لم تكن تتقن واحدة فإن هذا الكتاب ليس ذا قيمة بالنسبة لك)، فلا بد أنك تدرك من تجربتك الشخصية استحالة تبديل كلامك بين لغتين دون اختلاف وقعه النفسي واللغوي في نفوس مستمعيك،[12] مهما كان اختلافًا بسيطًا. هل تقبل اللغة الترجمة؟ لدى معظم الناس انطباع عن اللغة بأنها وسيلة لنقل "المعنى"، فلنا أن نشبهها بمركب يبحر بالمعاني والأفكار، فيحملها من ذهن شخص إلى آخر دون تغيير.[13] ومن الواضح أن الترجمة ضمن هذا التعريف طبيعية جدًّا، فإذا كان "المعنى" مستقلًّا في وجوده عن اللغة؛ فمن البديهي أن كل لغات الإنسان تصف الأفكار نفسها بكلمات وأصوات مختلفة قليلًا بعضها عن بعض، ومن السهل -بالتالي- أن نترجم هذه الأفكار بين اللغات؛ لنستطيع تناقلها على دائرة أوسع.[14][15] ربما يوهمنا هذا التصور التقليدي بأن جميع اللغات تتحدث عن الأفكار نفسها بكلمات متفاوتة، فيفيد هذا التصور -على سبيل المثال- بأن كلمة "السماء" في اللغة العربية تصف فكرة تجريدية يفهمها جميع البشر، ويصلح التعبير عنها بأي لغة أخرى بكلمات بديلة منها "sky" في الإنكليزية و"Himmel" بالألمانية و"آسمان" بالفارسية، ولكن هذا الافتراض كله (الذي تقوم عليه ظاهرة الترجمة بالنظرة المعتادة نحوها) ليس صحيحًا. فكلمة "sky" ليست مرادفة في معناها لــــ"سماء"، ولا -غالبًا- لأي كلمة أخرى في أي لغة من لغات الأرض، مهما بدت قريبةً منها. تدلنا السنوات المئة الأخيرة من أبحاث اللسانيات والترجمة على أن اللغة والمعنى ظاهرتان مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا، فكل لغة على وجه البسيطة لها خواصّها الثقافية والإنسانية والذهنية التي لا تتماثل مع غيرها، ومع أن معاني الكلمات قد تتقارب جدًّا بين بعضها، إلا أنه لا وجود -غالبًا- لكلمتين "مترادفتين" حقًّا وأبدًا،[16] وعلى هذا الأساس فإن الترجمة -بتعريفها المعتاد- ليست ظاهرةً حقيقية، فكيف لنا أن ننقل المعنى بين أي لغتين إذا لم تكن فيهما أي كلمات متماثلة في معناها ودلالتها؟ المرادفات من أولى المشكلات التي تقابلنا إن حاولنا أن نفترض "ترادف" الكلمات بين اللغات هي كثرة الكلمات التي لها دلالات عديدة،[17] والتي يجهد واضعو المعاجم والقواميس في حصرها وتعدادها[18] (إذ تسمى هذه الكلمات "المظلات الدلالية")،[19] فإذا كان للكلمة العربية خمسة معان أو ستة تختلف بحسب سياقها[20]، وإذا كان للكلمة الألمانية خمسة معان أخرى بحسب استعمالها، فكيفَ لنا أن نزعم أن هاتين الكلمتين "مترادفتان" وهما تدلان على عشرة معان متغايرة؟[21] لنعُد إلى كلمة "السماء" مرَّة أخرى، فهي تصف ظاهرة طبيعية، شهدها الإنسان منذ أقدم الأزمنة حيثما عاش ونطق كلامًا (على عكس "الإنترنت" مثلًا: الذي ينحصر وجوده؛ معنى ولغة، في ثقافات حديثة زمنيًّا). وليس لكلمة السماء أي أهمية تميزها عن غيرها، وإنما هي المثال الأول الذي سوف نستدل منه على اتصال ظاهرة اللغة بالمعنى، وعلى اتحادهما الوثيق. فماذا تعني "السماء" إذًا؟ بحسب لسان العرب، تعني كلمة السماء أشياء منها الآتي: سقف كل شيء وكل بيت. السماوات السبع: أطباقُ الأَرَضِين. كل ما ارتفع وعلا؛ سما يسمو. كل سقف أو كل ما علاكَ فأظلك (مثل السحاب). وبعض هذه المعاني قريبة من معنى كلمة "السماء" في زمننا، مع أن استخدامنا لها لا يتماثل تمامًا مع أيّ من المعاني أعلاه (فنحن لا نقول عن كل ما علا أنه "سماء" بل إن فوق السماء فضاءً ونجومًا ومجرات)، وهذا ليس مستغربًا؛ فمعجم لسان العرب قديم، ولا يتصل بالضرورة بحديث الناس ولغة العصر. وعندما نقول "السماء" بدلالتها الحديثة؛ فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الغلاف الجوي للأرض -كما نعرفه علميًّا- بما فيه من سحب وهواء وغير ذلك، وتختلف هذه الكلمة في بعض السياقات عن مصطلح "الفضاء" الذي يصف (بالعربية المحدثة) الفضاء الخارجي، وما فيه من شمس وقمر ونجوم وكواكب ومجرّات، وهذا التمييز لم يكن موجودًا في العربية التراثية، فقد كانت "السماء" كلمةً جامعةً لكل ما علا سطح الأرض. ولا تزال بعض هذه المعاني دارجةً بطريقة أو بأخرى، ربما بسبب الكتب التراثية التي حفظت شيئًا من دلالات الكلمة القديمة، فالسماء في اللغة العربية قد تدل على السماوات السبع، وهذا المعنى مستقل ومختلف دلاليًّا عن المعنى الأول، فالسماوات السبع المذكورة في القرآن والأحاديث لها معنى ديني، ولا يمكننا أن نزعم أنها نفس "السماء" بمعناها الفيزيائي، ولولا هذا لما وقع الجدل الكثير بين علماء الدين في ماهيتها وفي كيفية ربطها بالعلم الحديث. وللسَّماء -كذلك- دلالة دينية في عقائد أخرى قد تختلف عن السماوات السبع، ومنها القول في بعض المعتقدات والنصوص التي قد تعترض المترجم: إن "الله تعالى في السماء" و"الدعاء للسماء"، وهذا معنى ثالث غير ما سبق. ولكلمة السماء -أخيرًا- معانٍ منها "العلو" و"الارتفاع" غير المحدد، مثل قول العامة عن شخص عن شخص أنه (طار عالسَّما) أو أن كرةً ارتفعت عاليًا جدًا وكأنها "وصلت السما". ومن معاني الكلمة العامية كذلك الاشتقاق منها فتصبح صفةً مثل: حال اللون السماوي (أي الأزرق الفاتح ببعض اللهجات). كما أن للكلمة معاني تراثيةً اندثرت تمامًا ولم نتوقف عندها، مثل: دلالتها على المطر والسحاب وما شابه، ويشير هذا الكلام كله إلى أن كلمة "السماء" العربية لها دلالات كثيرة جدًا تتفاوت بحسب سياقها، لو كان علميًّا أو دينيًّا أو عاميًّا. وتسمى هذه العلاقة بين الكلمة وسياق استعمالها في اللغة بـالإيحاء الثقافي.[22][23] فعندما تسمع كلمة "السماء" في القرآن قد تتفكر بالله، وعندما تسمعها في برنامجٍ وثائقي قد تفكر بالفضاء، وهذان إيحاءان مختلفان كل الاختلاف، وينتج عنهما اختلاف أساس في دلالة الكلمة، حتى ولو كان معناها التجريدي متماثلًا في الحالتين. وهذه هي دلالات السماء باللغة العربية، فماذا عن غيرها من اللغات؟ تتضمن معاجم اللغة الإنكليزية، ومنها أوكسفورد وكامبريدج، قائمةً بمعاني كلمة "sky" منها: السماء بصفتها كل ما يعلو الأرض. السماء كما تظهر من بلد أو مكان معين.[24] السماء بمعناها الديني. ومعظم هذه المعاني موجودة في العربية المحدثة؛ لأنها انتقلت إليها عن طريق الترجمة، لكن هل هذا يجعلها مترادفة؟ يوجد فارق كبير جدًا بين العربية والإنكليزية في هذه الحالة، وهو أن كلمة "sky" الإنكليزية لها بديل بلغتها ذاتها. والترادف ليس موجودًا حقًا في أي لغة كما رأينا، وهذا يعني أن اللغة الواحدة -كذلك- لا تترادف فيها كلمتان ترادفًا تامًّا، لكن من الممكن الاستعاضة -في حالات محددة- عن كلمة "sky" ببديل لها هو "Heaven" أو "heavens"، وهاتان كلمتان محملتان بإيحاءات دينية وتراثية لا تنال منها "sky" إلا نصيبًا قليلًا. وتترتب على هذا الاختلاف نتيجةٌ جوهرية، وهي أن الناطق باللغة الإنكليزية يستطيع التبديل بين كلمتي "sky" و"Heaven" ليتحدث عن السماء بإيحائها العلمي حينًا وبإيحائها الديني حينًا آخر، وأما الناطق باللغة العربية، فهو مجبر على استخدام كلمةٍ واحدةٍ محملة بهذين الإيحاءين معًا. ولدى أحد مواقع الإنترنت التبشيرية مقال، على سبيل المثال، عنوانه "Sky - and Heaven"، فهل من سبيل لترجمة هذا العنوان، إلا على أنه يعني: "السماء - والسماء"؟ إذا كان المعنى ظاهرةً تجريدية منفصلة عن اللغة، فيجب أن يكون لكل جملة (في أي لغة) ترجمة تقابلها في كل اللغات الأخرى، لكن هذا قطعًا غير صحيح، إذ لم نأت هنا إلا بأمثلة محدودة على آلاف الجمل والأفكار التي تستعصي ترجمتها من أي لغة إلى غيرها، لا بسبب صعوبة تفسير معانيها؛ وإنما بسبب مشكلة تكمن جذورها في اللغة نفسها،[25] وقد نجد ما يدلنا على أصلها في بعض نظريات علم اللسانيات. البنائية، والنسبية اللغوية اللغة هي وسيلة تواصل مشتركة بين البشر كافة، وهي وسيلتنا في تناقل وتبادل كل ما نعرفه عن العالم -تقريبًا- فيما بيننا،[26] وليس من الغريب أن الفيلسوف "ميشيل فوكو" أطلق القول المعروف: "من اللغة تأتي السلطة"، لكن من الصعب الجزم بالعلاقة بين اللغة وحياة الإنسان وتفكيره، ففي هذا جدال كبير عمره أكثر من مئة عام، وبدأه باحث فرنسي في بداية القرن العشرين. سوسير ونظرية البنائية اللغوية توفي في صباح الثاني والعشرين من فبراير سنة 1913 "فيرديناند دو سوسير" (الذي تستحيل تهجئة اسمه بدقة بالعربية)، والذي لقب أبًا لعلم اللسانيات الحديث.[27] ولم يهتم سوسير بنشر أبحاثه وأعماله في حياته، لكنَّ طلبته المخلصين انكبوا على جمع ما سجلوه من كلامه في دفاترهم ونشروا خلاصة محاضراته في كتاب بعد وفاته،[28] وكان له ولهم الفضل في ولادة نظرية "البنائية اللغوية" (Structuralism) التي سيطرت على دراسات اللغة لسنين طويلة وتجلت في جميع فروعها، ومن ضمنها دراسات الترجمة. وقد يحتاج شرح هذه النظرية بتفاصيلها الكثيرة إلى كتاب، أو كتب، على أن فكرتها الأساسية ليست معقدة كثيرًا، إن كنت مستعدًا لتقبلها، والإقرار بها. روَّج سوسير لأفكارٍ كثيرة، ونظريات رائدةٍ، تصب في جوهرها في اتجاه واحد؛ إذ كان يرى أن اللغة ليست إلا إشارات اعتباطية ابتدعها البشر للتخاطب فيما بينهم،[29] فهي لا تصف الأشياء في العالم على حقيقتها، وإنما تأسرها في نطاق موازنات ذهنية؛ أساسها الموازنة بين الأشياء وتحري الاختلاف فيها.[30] وبعبارة أخرى: فإن كل ما يستطيع الإنسان الحديث عنه، ليس إلا مفارقات ذهنية، وتفكيرنا (الذي تحكمه اللغة) مأسور بهذه المفارقات.[31][32] وقد تخال هذا الكلام دون معنى إن لم تسمع تفسيره أولًا. تصل البنائية اللغوية إلى هذا الاستنتاج الجريء بخطى بطيئة حثيثة، فهي تبدأ بتحليل دقيق للطريقة التي يستوعب بها الإنسان اللغة، وتحاول إثبات أن "المعنى" ظاهرة ممتزجة مع اللغة،[33] ولنأخذ مثالًا بديهيًّا لفهم هذا الجانب من نظرية سوسير: وهو مثال الاتجاهات. حيث يدرس الأطفال الاتجاهات عادة في صفوفهم المدرسية الأولى، ويتعلمون حينئذ أن يصفوا البلاد والأماكن بناءً على اتجاهاتها، فهناك قطب "شمالي" وقطب "جنوبي"، ولبلاد العرب شطر "مشرقي" وشطر "مغربي"، وقد تبدو هذه الاتجاهات التي يدرسها طلاب المرحلة الابتدائية منطقية وعلمية جدًّا في طرحها؛ فهي تقسّم العالم إلى أربعة محاور على أساس هندسي وجغرافي بحت. لكن هل وظيفة الاتجاهات الفعلية هي أن تدلنا على الجغرافيا فقط؟ يتلقن الأطفال بعد المرحلة الابتدائية دروسًا أخرى كثيرة في مواد منها التاريخ والثقافة العامة والتربية الوطنية، كما يشاهدون أخبارًا في التلفاز ويسمعونَ نقاشاتٍ عنها بين آبائهم وأصدقائهم، وعلى مر هذه السنين الطويلة يكتسب كل لفظ لديهم معاني وإيحاءات وإشارات لم تكن مألوفة لهم من قبل؛ ومن أكثر الكلمات تأثرًا بهذا الوسط الثقافي واللغوي في البلاد العربية (وكثير من البلدان الأخرى) هي جهتا "الشرق" و"الغرب". وقد تظن أن إيحاءات هاتين الكلمتين لا تتداخل معًا، فمن المفترض أن لا تتصل معانيهما المُسيَّسة الجديدة بدلالتهما الجغرافية الأصيلة، وقد نفترض ننا نستطيع الحديث عن الاتجاهات بمعناها الجغرافي فنقول أن بلدًا "في الشرق" دون قصد معنى سياسي، لكن ذلك ليس صحيحًا أبدًا، فقد يفاجأ بعض الناس بأن دمشق تقع على خط طول غرب موسكو، وأن تونس العاصمة أقرب إلى الغرب من برلين وستوكهولم، بل ولو كان "العالم الغربي" مصطلحًا يمت للجغرافيا بصلة؛ لأُلحقت القارة الأفريقية بأكملها تقريبًا بأوروبا. والسبب في صنع هذين الإيحائين -الجغرافي، والسياسي- هو أن "الشرق" و"الغرب" كلمتان متناقضتان في أساسهما، فهما تخلقان حاجزًا في ذهن الإنسان، حيث يرى أن كل ما هو "غربي" عكس ما هو "شرقي"، وتستمد الكلمتان معانيهما هنا (حسب سوسير) من هذا التناقض، وكذلك الحال مع كثير من الكلمات المألوفة لنا، إن لم يكن في معظمها. فالبشر معتادون على إعطاء صفتين متضادتين لكل ما حولهم: فهناك شخص "طويل" وآخر "قصير"، وواحد "سمين" وآخر "نحيف"، وتوجد ثمار "كبيرة" على عكس "الصغيرة"، وقد يكون الماء "باردًا" بعكس ما يكون "ساخنًا". ويظن سوسير أن هذه الكلمات المتضادة في معانيها هي حجر الأساس لظاهرة اللغة كلها، ويسمي العلاقة بينها: "الثنائية القطبية" أو "Binary Opposition"، ولعلها أكثر كلمة يكررها في نظريته؛ فهو يرى أن جميع الألفاظ والمفردات التي نستخدمها في اللغة لا تصف حقائق واقعةً نشعر بها ونلمسها، وإنما تعبر عن موازنات ذهنية تأسر فهمنا واستيعابنا للعالم بأطر ضيقة لا مفر منها، وهي أطر "الموازنة" و"الاختلاف": فمعنى الأشياء يتحدد بحسب اختلافها عن غيرها، ووسيلة استيعاب الاختلاف هي الموازنة الثنائية.[34] وقد يبدو ادعاؤه غريبًا بالنسبة لنا إذا فكرنا بالكلمات المتضادة بتعريفها الضيق: فقد تكون اللغة حافلةً بآلاف الكلمات المتضادَّة، لكن فيها -كذلك- آلافًا من الكلمات التي ليست لها أضداد، ومنها معظم أسماء المحسوسات: فما هو ضد السيارة، أو القطة، أو المكعب، أو التفاحة؟ والحقيقة أن سوسير لا يعفي هذه المحسوسات من فكرة الموازنة الثنائية، بل يراها جزءًا جوهريًّا من تلك الموازنة. وتتضح وجهة نظره عند التعمق أكثر في تعريفات هذه المفردات، فعلى سبيل المثال: كيف نعرف ما هو الكلب؟ لقد صنفت "منظمة الكلاب العالمية"[35] حتى يومنا أكثر من ثلاثمئة سلالة للكلاب تختلف في أطوالها وأحجامها وألوانها ومظهرها، فمنها ما يصل وزنها إلى 150 كيلوغرامًا[36] ومنها ما لا يتجاوز 500 غرام،[37] وعلى هذا الفرق الكبير، فإن معظم الناس يعرفون الفرق بين الكلاب، وغيرها من الحيوانات. فكيف ذلك؟ كما هو متوقع، تنبثق إجابة النظرية البنائية في اللغة على هذا السؤال من الموازنة الثنائية، فعندما نرى كلبًا (وسواء أكان من الكلاب هائلة الجثة؛ التي تتقفى بها الشرطة المجرمين، أم من الكلاب الضئيلة التي تتنافس في مسابقات الجمال) فإننا نوازن -ذهنيًا- بينه وبين غيره من الحيوانات التي نعرفها، فقد نفكر بالقطة والفأر والأرنب والذئب والنمر، حتى يتضح لنا أنه ليس أيا منها. وما يجعل الكلب كلبًا -بالنتيجة- هو اختلافه عن سائر الحيوانات الأخرى حينما يوازَن بها، ولنا أن نأتي -هنا- بأمثلة كثيرة: فالمربع هو "مربع" لأنه ليس مستطيلًا ولا دائرة ولا مثلثًا، وإنما هو متساوي الأضلاع وله أربع جهات، وهكذا فإنه يختلف عن كل الأشكال الأخرى.[38] وعدد الموازنات الثنائية التي يستدعيها ذهن الإنسان لانهائي، إذ بإمكاننا أن نوازن بين مئات الأشياء أو الآلاف منها لتعريف مفردة واحدة.[39] وإثبات هذا الأمر سهل جدًّا، فلو ظهر أمامك في حصة الرياضيات الشكل غير المنتظم أدناه وطلب منك تعريفه، فسوف تجاهد وتحار وترتبك؛ لأنه لا يطابق في أوصافه شكلًا من الأشكال التي تعرفها، وإذا لم تستطِع إسقاطه على أحد هذه الأشكال فإنَّه يبقى فكرةً غائمةً تعجز عن وصفها (عدا أن يكون "شكلاً غير منتظم")، بل لن تجيد تذكره ولن تستطيع رسمه مرة أخرى من ذاكرتك بدون أن تكتمل الموازنة التي تعطيه معناه. إن عليك تذكر هذا الشكل (أو أي شكل "غير منتظم" أو "غير مسمى" مثله) إن لم ترتبط صورته باسم يسمى به، وهوية تميزه بها عن غيره من الأشكال - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY لقد أعادت نظرية سوسير تعريف ظاهرة "المعنى" بالتفريق بين عالمنا المحسوس وبين مفردات اللغة التي تصف هذا العالم، فعلى سبيل المثال: يرى سوسير أن كلمة "الكرسي" في اللغة العربية (أو ما يماثلها في المعنى باللغات الأخرى) لا تصف كرسيًّا حقيقيًّا؛ وإنما هي مجرد موازنة ذهنية في عقل الإنسان،[40] فقد تتخيل في ذهنك لدى سماع هذه الكلمة صورة كرسي خشبي، بينما قد يتخيل شخص آخر كرسيًا جلديًّا للمكتب، أو كرسيًّا معدنيًّا للحديقة، وقد لا يكون لأي من هذه الكراسي وجود في عالم الواقع،[41] لكن أهمية هذه الصور هي أنها المرجع الذي توازن به الكراسي الحقيقية، لتحاول تقريبها إلى شيء تعرفه وتتذكره. ويسمي سوسير هذه الصورة الذهنية للكرسي: الدالة (Signifier)؛ أما الكرسي الحقيقي فهو: المدلول (Signified)، وما نسميه "اللغة" هو اتحاد الدالة والمدلول. وينطلق سوسير من هذا التعريف، ليزعم أن اللغة كلها ليست إلا دوال اعتباطية ابتدعها البشر،[42][43] وهذا يعني -مرة أخرى- أن اللغة والمعنى (أو الدال والمدلول) هما وجهان لعملةٍ واحدةٍ، ولا سبيل لفصلهما. النسبية اللغوية جاء بعد سوسير عالمان وضعا نظرية مهمة جدًّا في سياقنا هنا، مع أن صداهما في المجتمع الأكاديمي -على حجمه الهائل- كان قصير الأمد إلى حد ما،[44] وتسمى نظريتهما "نظرية النسبية اللغوية"، أو: "نظرية وُرف وسابير"، إما تيمنًا بواضعيها[45] أو تيمنًا بنظرية النسبية لآينشتاين؛ إذ أملا أن يكون لنظريتهما دور حاسم في اللغة كما كانت النسبية حاسمةً في الفيزياء. وتنص نظرية وُرف وسابير على: أن اللغة هي العدسة التي ننظر بها إلى العالم، فهي عنصر أساس في تكوين أفكارنا؛ لا في صياغتها فقط.[46] وليست اللغة هنا مؤثرًا منعزلاً عمَّا سواه، إنما يخبرنا وُرف وسابير أن لكل ثقافة (وقد تكون هذه الثقافة العربية بعمومها، وقد تكون ثقافة بلد أو حي أو عائلة) طريقة تفكير تختلف عن غيرها، ولأن اللغة من جوهر ثقافة الإنسان؛ فهي تمتزج بتفكيره.[47] ويقترب سوسير من هذه النظرية في وصفه للغة بأنها: نظام من الدوال، مما يعني أنها لا تسعى لأن تكشف لنا عن عالمنا كشفًا دقيقًا -كما نظن- بل إن اللغة تختلق هذا العالم، وترسمه على صورته التي نشعر بها.[48] وليس المقصود هنا أن كل ما نراه حولنا وهم لا يمت إلى الواقع بصلة، ولكن الواقع واللغة مقترنان معًا في كيان واحدٍ لا سبيل لتجزأته،[49][50] حتى إن العالم لا يكاد يوجد دون اللغة. وهذه حجة عصية على النفي منطقيًّا، لأن مناقضتها تتطلب حتمًا استدعاء مثالٍ يقال ويحكى باللغة، فيبقى أسيرًا لها ولإمكاناتها.[51] من الضروري عدم التسرع بإسقاط نظرية النسبية اللغوية وكأنها حقيقة، فكثير من علماء اللغة لا يقتنعون بها مطلقًا[52] لأنها نظرية لا تقبل الاختبار،[53] أو يعدونها تفسيرًا ينحصر في كيفية مسِّ اللغة بتفكير الإنسان، وليس أن اللغة هي الأساس الواحد لتفكيره.[54] وهذه الانتقادات لا تنقض النظرية بالضرورة وإنما تعيد صياغتها،[55] فسواء أكانت اللغة هي التي تصنع تفكير الإنسان (كما قال وُرف وسابير) أم ثمرةً لمنظومة ذهنية متكاملة نولد معها وتأسر تفكيرنا (كما تشير اللسانيات الحديثة)،[56] فإن النتيجة واحدة: وهي أن كل لغة تمثل وجهة نظر تجاه العالم تخص قومًا من الأقوام أو ثقافة من الثقافات، وتثبت لنا التجربة أن اختلاف هذه الثقافات ولغاتها قد يعيق نقل المفاهيم والأفكار بينها.[57] ولا يكون ذلك بالضرورة بعجز الآخر عن فهم طريقة تفكيرك، فالناطق باللغة العربية، قادر كل القدرة على أن يتعلم أنواع الثلج التي يفرق بينها الإسكيمو بالعشرات[58] مثلما أن الإسكيمو أهل لاستيعاب الفرق بين أسماء الإبل الثلاثمئة بالعربية إن علمناهم إياها، على أن كلًّا من هاتين اللغتين تشجع الناطقين بها -دون ريب- على التفكير بأسلوب مختلف.[59] وما يعنينا في دراسات الترجمة من نظرية فرديناند دو سوسير، ومن تبعه من العلماء أمران: أولًا، أن ألفاظ اللغة اعتباطية، فلا تصف المحسوسات وإنما تتصل بتفكيرنا فيها. وثانيًا، أن اللغات ربما تكون جزءًا من منظومة تشكل العالم ولا تصفه فقط. وسوف نتوسع في هاتين النقطتين لأهميتهما لموضوع الكتاب، واللتين ستثبتان -شيئًا فشيئًا- فائدتهما القطعية لنا في فهم ظاهرة الترجمة. _____ اقرأ أيضًا المقال التالي: النسبية اللغوية والترجمة: هل تؤثر اللغة على أفكارنا؟
-
تحدثنا في المقال السابق اللغة ومفهوم الترجمة بين اللغات عن اللغة ومفهوم الترجمة بين اللغات والذي كان مقدمة بسيطة حول مفهومة الترجمة بين اللغات وسنكمل الحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل في موضوع النسبية اللغوية بين اللغات وعلاقة ذلك في الترجمة وتأثيرها على أفكارنا كما سنتطرق في آخره إلى إشكالات بيرمان الاثنا عشر في الترجمة. بحر أخضر وأشجار زرقاء انتقد كثير من علماء اللغة نظرية وُرف وسابير أو نقضوها بنظريات لاحقة، ومن أهمهم نعوم تشومسكي ونظريته التوليدية في اللغة؛ التي تقول: إن جميع اللغات تشترك في جوهر واحد، ولو اختلفت في قواعدها ونحوها وصرفها ظاهريًّا. لكن لأفكار وُرف وسابير أهميتها الشديدة في فلسفة اللغة، ومن الجدير بنا التوقف عند واحد من أشهر أمثلتها حول اختلاف اللغات بطريقة وصفها للعالم وما فيه من محسوسات: وهو الألوان.[1][2] الألوان جانب فيزيائي ومادي من العالم، فالمستقبلات البصرية في عين الإنسان تميز بدقة كبيرة بين البني والأسود والأبيض والأحمر والأصفر، وكذلك بين درجات كل لون من هذه الألوان.[3] ويعرف سائر الناس من آسيا إلى أفريقيا وأوروبا -كما أظهرت الدراسات- الفروق بين الألوان بسهولة، سواء أكانوا من الرُّحَّل أم المزارعين أم أساتذة في جامعات مرموقة.[4] ومع ذلك؛ فإن للغة دورًا مهمًّا في رؤيتنا للألوان يتجلى في حاجتنا لأن نعطي اسمًا لكل لون، ومن قدرتنا على أن نتفق على أسماء هذه الألوان.[5] فكم -يا ترى- يبلغ عدد الألوان التي سماها الإنسان؟ تختلف أسماء الألوان في اللهجات العامية عنها في العربية الفصحى، كما تختلف هاتان عن أسماء الألوان في الروسية[6] والتايلندية وأي لغة أخرى، ولنقل عبثًا أن لغات العالم مجتمعة فيها أسماء لألف لون أو أكثر، فهل لهذا العدد معنى حقًّا؟ يستطيع جهاز الحاسوب أو الهاتف الذي تقرأ به الآن التمييز بين ستة عشر مليون درجة من طيف الألوان المرئي،[7] وتميز عين الإنسان عددًا هائلاً من هذه الألوان، على أنه لم يخصص في لغته لها إلا حفنةً من الأسماء، ومعاني هذه الأسماء ليست متماثلةً -دائمًا- بين اللغات.[8][9] نشرت في سنة 1969 دراسة موسعة في هذا المجال، حاول فيها باحثان أمريكيان تقصي الطريقة التي تميز بها لغات الإنسان أسماء الألوان،[10] وتوصل هذان الباحثان إلى استنتاجين كبيرين: الأول، هو أن جميع البشر يرون الألوان مثل بعضهم، فجميعهم -مثلاً- يلاحظون اختلافًا بين الأصفر والأزرق.[11] والثاني، هو أن كل اللغات تتطوّر فيها مفردات الألوان بترتيب ثابت تقريبًا،[12] ويبدأ هذا الترتيب من لونين أساسيَّين دائمًا هما: الأبيض والأسود؛ لأنهما يصفان النور والظلام،[13] وبين لغات البشر اختلافات شاسعة في عدد الألوان التي لها مفردات بعد هذين اللونين الأساسيين. من أشهر الأمثلة على ذلك؛ أن الأخضر، والأزرق كانا يعتبران لونًا واحدًا في كثير من اللغات قبل احتكاكها بالعالم الأوروبي، مثل: اليابانية[14] والصينية[15] والكورية[16] والفيتنامية[17] وأغلب اللغات المعزولة التي ينطق بها عدد قليل من الناس في أفريقيا وأستراليا والأمازون، ففي كثير من هذه اللغات اسم واحد يجمع بين لون البحر ولون أوراق الشجر،[18] كأن نقول: إن البحر أخضر، أو: إن الأشجار زرقاء. وذهبت دراسة شهيرة أخرى إلى أن الإغريق القدماء لم يعرفوا إلا كلمتين للألوان: هما الأسود والأبيض، فقصدوا بالأول جميع الألوان القاتمة، وبالثاني جميع الألوان الفاتحة،[19][20] وما زالت بعض اللغات المعزولة في عالمنا لا تميز من الألوان إلا بين الأبيض والأسود.[21] وتدل دراسات مطوَّلة للأشعار على أن العرب في الجاهلية ربما قصدوا بالألوان معانيَ فضفاضةً كذلك، فكان "الأسمر" لديهم اللون الغامق (لا البني وحده) و"الأزرق" يدل على اللمعان واللؤلؤ (لا الأزرق كما نعرفه).[22] ولا يعني هذا أن بصر العرب في الجاهلية كان مختلفًا عن بصرنا، أو أن الصينيين القدماء لم يفلحوا في إدراك الاختلاف بين الأخضر والأزرق؛ لكن الاختلاف هو أن هؤلاء القدماء نظروا نحو الأخضر والأزرق بصفتهما درجتين من لون واحد،[23][24] كأن تقول: إن الأحمر القاتم (أو الغامق، أو القاني، كلون الدم) يختلف عن الأحمر الوردي (كلون النمر الوردي)، والاختلاف هنا في المسميات وليس في حاسة البصر لدى الإنسان، إلا أن له أهميته التي لا يستهان بها.[25] تختلف خضرة الخيار والفليفلة الحلوة عن خضرة أوراق الخسّ، على أنك تعتبرهما في ذهنك درجة غامقة وأخرى فاقعة من لون واحد، ولعل الفلاح الصيني الذي عاش قبل خمسمئة عام كان -بالمثل- يعتبر السماء خضراء باهتة والأشجار خضراء فاقعة، فكلاهما يقع في لغته تحت اسم واحد، وحتى لو كانت مستقبلات الفلاح الصيني البصرية متطابقةً وظيفيًّا وبيولوجيًّا مع مستقبلاتك أنت، فإن بينكما اختلافًا شاسعًا في نظرتكما لغابة تعلوها السماء أو شاطئ تغطيه الأشجار؛ فأنت ترى في المشهد تنوعًا بين لونين، أما سكان آسيا القدماء فقد كانوا يرون غابة وبحرًا لهما اللون نفسه مع اختلافٍ بالدرجة، وإذا أردنا ترجمة قصة فيها فقرةٌ توازن زرقة مياه الشاطئ بنضرة أشجار الصنوبر، إلى اللغة اليابانية القديمة[26] فإن التباين اللغوي بين هذين اللونين سيختفي، ويغدو تكرارًا توكيديًّا لامتزاج الشاطئ وشجرة الصنوبر باللون نفسه، مما ينقض المغزى كله.[27] ترتيب ابتداع كلمات للألوان في لغات الإنسان، بحسب دراسة برلين، وكاي في عام 1969. منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY-SA 4.0 (عملي الشخصي) تضمَّنت النظرية التي نشرها الباحثان الأمريكيان -أيضًا- قائمةً طويلةً بالألوان، مصنفة بحسب مرحلة ظهورها في اللغة، فاللغة التي فيها اسم واحد للأخضر والأزرق -بحسب الدراسة- ليس فيها كذلك مفردات للبني ولا الأرجواني،[28] إذ إن تمييز كل لون يرتبط بدرجة معينة من التعقيد، أو التطور المعجمي في تلك اللغة.[29] ويظن البعض أن كثرة مفردات الألوان في عصرنا سببها انتشار الأصباغ الصناعية والألوان المحوسبة، التي أدت إلى تعدد الألوان وتعاظم الاهتمام بها.[30] وقد فندت الدراسات التي تبعت هذين العالمين فكرة "الترتيب" الراسخ لمفردات الألوان، وذلك بسبب كثرة ما اكتشف من لغات تشذ عن هذا الترتيب،[31] لكن الفروقات في تسمية الألوان بين اللغات قائمة ومتفشية. بل إن مشكلة الألوان هذه تقودنا إلى أزمة جديدة: فالحاجزُ أمام الترجمة لا يقتصر على اختلاف الإيحاءات لكلمات متقاربة في معانيها المحسوسة والتجريدية؛ بل يتجاوز هذا الأمر بكثير، فبعض اللغات قد تخصص كلمات لمحسوسات ليست لها أوصاف في اللغات الأخرى،[32] وقد يعجز أبناء تلك اللغات عن استيعاب ماهية هذه المحسوسات أو فهمها حتى لو حاولت تفسيرها لهم، وذلك لأنها مستمدة من معرفة جديدة بالعالم[33] وليس باللغة فحسب. تؤدي تباينات الألوان (وغيرها من المحسوسات) إلى فجوات هائلة بين اللغات على المستوى الثقافي، فالتمييز بين لون البحر والأشجار (السائد في عصرنا) لم تعنَ به كثير من الشعوب التي عاشت في الماضي، والتي لم ترَ ضرورةً ولا هدفًا من التمييز بينهما. وبالمثل؛ فإن لدى تلك الثقافات -أيضًا- كثير من المفاهيم الثقافية التي لا تكترث أنت بها ولا تفكر بأهميتها، وقد تجد بعضها مدهشة. استعارات غير مستردة يذكر حديث رواه علي بن أبي طالب عن العيوب التي تفسد الأضحية: «أمرنا رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين، والأذن، ولا نضحي بمُقابَلَةٍ ولا مُدابَرةٍ، ولا خَرْقاء ولا شَرْقاء». وفي هذا الحديث مفردات عدة تصف أنواعًا من المواشي بحسب عيوبها؛ والتي ربما يعرف بعضها من له اطلاع في اللغة والفقه، لكن من غير المحتمل أن يسمعها أحدٌ في حياته اليومية أبدًا؛ والسبب أن هذه المفردات -مثل اللغة كلها- تخدم حاجة للتواصل الإنساني، ومن الواضح أن أوصاف "الخرقاء" و"الشرقاء" لم تعد ضرورية في التواصل بالنسبة لمعظم الناطقين باللغة العربية في عصرنا، وهم الآن أمة متمدنة في معظمها،[34] لكن هذه المصطلحات كانت مفيدةً جدًا لهُم حينما كان نمط حياتهم يعتمد على الرعي. وتتميز -بالمثل- كل لغة بثروة معجمية تخصها وتميزها عن غيرها، فتخدم حاجاتها وتراثها وتاريخها المميز، ومن المستحيل الاستعاضة عن هذه الثروة بـ"ترجمة" إلى لغة أخرى؛[35] ففي كل لغة إطلالة جديدة على العالم؛ سواء أكانت هذه الإطلالة حكرًا على الناطقين بها أم لا.[36] تعد اللغة العربية الآن خامس أكثر اللغات انتشارًا على وجه الأرض، إذ يتراوح عدد المتحدثين بها -تقديريًّا- بين ربع وثلث مليار إنسان، ويعيش هؤلاء في جميع أنحاء العالم: ما بين سكان الوطن العربي والمغتربين خارجه. على أن اللغة العربية نشأت في مساحة صغيرة (إذا ما قورنت بانتشارها الحالي) في جزيرة العرب، وكان لهذه النشأة تأثير كبير عليها يظهر بسهولة عند دراسة العربية التراثية؛ مثل: الكثرة غير العادية فيها للكلمات التي تصف الإبل، وهي أهم الحيوانات التي عاش معها سكان جزيرة العرب. فلغة العرب -مثل كل لغة في العالم- أسيرة لموروثها الثقافي الذي انبثقت عنه.[37] ولا تنحصر أهمية هذا الموروث في أنه يأتي بكلمات تتفرَّد بمعانيها كل لغة عن سواها، بل هي تصف طريقة تفكير جديدة غير مألوفة لنا،[38] فلا شك أن نظرة عرب الجاهلية إلى العالم الذي تسوده الإبل والصحراء والبادية؛ كانت مختلفةً جدًّا عن نظرة أي شخص يعيش في مدينة حديثة، وكما يقول الأديب عمر الأمين: «لكل لغة ينابيعها الأصيلة؛ المعبرة تعبيرًا عفويًّا فذًّا عن أحوال الشعب الأول الذي أبدعها، ومفرداتها أنقى من تلك التي تطرأ عليها في مجاري تطورها واحتكاكها بغيرها عبر العصور».[39] تتميز كل لغة بمعجم فريد تستمده من موروثها التاريخي، والثقافي،[40] ومن هذه الكلمات ما يصف أشياء يراها، ويتعامل معها كل الناس، لكن لها مفردات غير مألوفة في بعض اللغات دونًا عن غيرها. ومن السهل أن نأتي بأمثلة سريعة على هذه الكلمات من اللغة الإنكليزية المحدثة التي أدخلت مصطلحات كثيرة ليس لها مقابل في لغتنا في مجالات التكنولوجيا والعلوم خصوصًا، بينما على أن في لغات العالم الأخرى كثيرًا من الكلمات الغريبة التي لم تسمع بها من قبل قط، ومن أفضل أمثلتها لغة الباسكان. كانت الباسكان أو "الرابانوي" اللغة الأصلية للقاطنين بجزيرة إيستر في المحيط الهادئ، والمشهورين بنحتهم تماثيل عملاقة تقلد هيئة وجه الإنسان وجسمه بطريقة مبهرة، وعدد الناطقين بهذه اللغة الآن بين 800 إلى 2,700 شخص فقط، وينشأ أطفال هؤلاء القوم حاليًا على اللغة الإسبانية، وهي اللغة الرسمية لدولة تشيلي (التي تحكم جزيرتهم)، وأما من يتعلمون لغتهم الأصلية فهم قلة يبذلون الجهد والوقت لاكتسابها في مرحلة متأخرة من حياتهم، لذلك أصبحت واحدةً من اللغات الكثيرة المهددة بالانقراض في العالم. وقد كان الناطقون بهذه اللغة نائين بأنفسهم عن معظم أبناء البشرية على مر تاريخهم، إذ إن عليهم الإبحار من جزيرتهم لمسافة تزيد على ألفي كيلومتر للوصول إلى أي مكان مأهول بالبشر، ولهذه العزلة الهائلة نتيجة طبيعية جدًّا، وهي أن لغة سكان الجزيرة تطورت بطريقة غير مألوفة عن معظم اللغات الحديثة واكتسبت مفردات لا وجود لها في أي لغة أخرى، وإحدى كلماتها الرائعة هي "tingo". ليس من الصعب استيعاب معنى كلمة "تينغو"، لكن ترجمتها إلى كلمة واحدة في اللغة العربية (وأي لغة غيرها) أقرب للمستحيلات؛ فمعناها هو التالي: "أن يأخذ شخص أشياء من منزلك بحجة الاستعارة، مرة تلو الأخرى، حتى تصبح كل أشيائك ملكًا له". وقد لا تبدو هذه الفكرة غريبةً جدًّا بحد ذلك؛ فلعلك شاهدتها في مسلسل هزلي أو في قصة مصورة ذات يوم (أو تستطيع تخيلها)، لكن هل يتبادر إلى ذهنك أنها فكرة تستحق تخصيص كلمة لها؟ لهذا السبب، ولأسباب أخرى بالتأكيد؛ نالت كلمة "تينغو" من أحد المؤلفين البريطانيين إعجابًا انتهى بتأليفه كتابًا كاملًا عنوانه: "تينغو، وكلمات عجيبة أخرى من جميع أنحاء العالم".[41] غلاف كتاب "تينغو" وكلمات عجيبة أخرى من جميع أنحاء العالم. مقتبسة تحت ترخيص الاستخدام العادل وربما يمكن إبدال هذه الكلمة الغريبة عنا -ومثيلاتها من كل اللغات- بجمل مطولة؛ تفسر معانيها وتشرح مغزاها بمفردات عربية. لكن الجملة لا تساوي الكلمة؛ لا في بلاغتها ولا في مقصدها،[42][43] والأفكار تضيع حينما تفتقد كلمات تثبتها في ذهن الإنسان فيصعب تذكرها.[44] فهل تستطيع وصف الإبل لمن لم يرها قط فتقول بأنها: "دابَّة مثل حصان كبير أحدب الظهر؟". وهل تستطيع ترجمة عبارة "creepy house" إلى اللغة العربية إلى: "منزل يبعث على مشاعر من الخوف الممتزج بعدم الراحة"؟ من المستبعد أن يشعر أي شخص يعرف معاني هذه الكلمات بالرضى عن هذه الترجمات الهزيلة؛ فهي ليست إلا دليلًا على الحاجز اللغوي والذهني القائم بين اللغات، والذي لا سبيل لردمه. وليس من المستغرب -مع هذه الحال- أن تجد نفسك مضطرًا -أحيانًا- لاقتباس كلمات من اللغة الإنكليزية أو الفرنسية في حديثك اليومي، رغمًا عن الإزعاج الذي تسببه هذه الكلمات لمحبي اللغة العربية، ومثلما أن الجملة لا تحل مكان الكلمة؛ فمن المستبعد أن تنجح الترجمة وحدها بردم حواجز ثقافية تفصل بين اللغات والأمم، وتفسير الكلمة الواحدة بشروحات مطولة لن يلقي في ذهن القارئ الانطباع المقصود نفسه، ومن لم يسمع عن الشيوعية من قبل؛ فلن يستوعب معانيها الفكرية "الأيدولوجية" المعقدة بفضل حاشية قصيرة أضافها المترجم. وهذه كلها عقبات تعيق ترجمة المفردات لا أكثر، فماذا لو تعمقنا في قواعد اللغات وأصولها؟ تصريف اللغات عاش عالم أنثروبولوجي أمريكي (اسمه "مايكل فيكس") بين سكان جزيرة "بابوا نيوغينيا" لمدة عامين، أجهد نفسه فيهما ليتقن لغة هؤلاء السكان، وكان يحمل معه -أينما ذهب- مفكرة يسجل فيها كل كلمة يسمعها، وقد أثار استغرابه أمر؛ وهو: أن أهل هذه الجزيرة لهم ما لا يقل عن خمس كلمات أو ستّ تتبع فعل "ذهبَ"، وفي كل مرة يذهبون إلى مكان مختلف يضيفون إلى الفعل كلمة مختلفة، وأدرك أن هذه الكلمات تضيف معنى جوهريًّا إلى الفعل، وهو تحديد الجهة التي يذهب إليها قائله، فلا يكتمل الفعل دون هذه الإضافة. ولو كنت تتحدث بلغة "نيوغينيا" -إذًا- فلا تستطيع أن تقول: «أنا ذاهب إلى البيت»، بل يجب أن تقول: «أنا ذاهب شمالًا إلى البيت»، أو: «أنا ذاهب شرقًا إلى السرير»،[45] وإلا خالفت أصول اللغة، كما لو جئت في اللغة العربية -مثلاً- بمجرور مكان مرفوع. ومهما كثرت اختلافات اللغات في المفردات والمعاني؛ فهي لا تعبر إلا عن جانب واحد من الحواجز بين اللغات، فهو حاجز على المستوى الدلالي (أو مستوى الكلمة)، ولكن فروق اللغات تمتد إلى البناء القواعدي التركيبي بأكمله؛ نحويًّا وصرفيًّا.[46] فنحن معتادون على قواعد لغوية ربما نفترض أنها تنطبق على جميع اللغات أو معظمها، مثل: ضرورة تمييز الأسماء والأفعال في العدد أو غيره. على أن هذه ليست قواعد سائدة. فاللغة الصينية لا تجبر المتكلم على تمييز العدد، إذ يمكن لشخص أن يقول: "جلبت [تفاح] من السوق"، دون أن يعدّد التفاحات التي جاء بها، ولا أن يفصح عما إذا كانت تفاحة أم تفاحتين أم تفاحات أكثر،[47] كما أن بإمكانه أن يقول: إنه "[يجلب] تفاحة من السوق"، دون تحديد الزمن الذي جلبها فيه، فلعله جلبها سلفًا، أو سيجلبها مستقبلًا، إذ إن الزمن -كذلك- إضافة اختيارية في تصريف اللغة الصينية، وهذه طريقة في الكلام قد يصعب علينا استيعابها.[48] بل إن لغات أخرى (مثل: كثير من لغات الأمريكيين الأصليين) تجمع في الكلمة الواحدة بين الاسم، وفعله، بحيث إن جملة "رميتُ الحجر" لها مفردة واحدة تختزل معناها كاملاً: ويعبر هذا عن نظرة "واحدة" للعالم لا تنفصل فيها المحسوسات عن الأفعال،[49] وتضيف لغات أخرى (مثل الأمويشا في البيرو) تصريفًا لأسماء الأشخاص الموتى بعلامة إعرابية (تشبه إضافة تاء مخاطب أو متكلم في العربية)، بحيث تعرف دومًا ما إن كان الشخص المذكور من الأحياء أم من الأموات.[50] ولا تقتصر هذه الاختلافات على لغات غريبة يتحدثها سكان الجزر والأدغال، بل هي موجودة بين أي لغتين تقريبًا، ومن السهل أن تكون عائقًا كبيرًا في الترجمة. فمن الفروقات الكبرى بين العربية والإنكليزية تصريف الأفعال، إذ إن الفعل العربي يلزمُ بذكر زمن الفعل والضمير المصاحب له، كأن نقول: "ذهبنَ" (ذهب [فعل] + نون النسوة [ضمير فاعل] + [زمن الماضي])، وأما الأفعال الإنكليزية فهي تلزمُ بذكر الزمن، وتترك الضمير (مثل went، فقد يكون من ذهب فردًا أو جماعة؛ ذكورًا أو إناثًا). ولا حاجة في اللغة الصينية لتصريف الفعل للضمير ولا للزمن.[51] ويستغل أدباء كل لغة هذه الخصائص الصرفية، فيتحدث مؤلفو الأدب الأجنبي -أحيانًا- عن شخصية جديدة دون الإفصاح عما لو كانت رجلًا أم امرأة، ولا يمكن محاكاة هذا الأسلوب بالعربية كما سنرى فيما بعد. وكما يقول اللغوي، والمترجم الشهير "رومان جاكوبسون": لا تختلف اللغات «بما يمكنك أن تقوله فيها، وإنما بما أنت ملزم بقوله فيها»، فقد ترغمنا قواعد اللغة على التعبير عن زمن الفعل، أو اتجاه المسير، أو عن عدد الأشخاص الذين نتحدث عنهم، وما إذا كانوا ذكورًا أم إناثًا، وقريبين أم بعيدين، [52]، وهذا جانب تتميز فيه كل لغة بتصريفها ونحوها،[53] ويترتب عليه أن الترجمة منها إلى غيرها تغير هذه التراكيب وما تحمله من معلومات بحسب ما تفرضه قواعد اللغة المنقول إليها.[54] فمن العسير علينا -مثلاً- أن نترجم بدقة روايةً يقال فيها على الدوام ما إذا كان الناس يمشون شرقًا أم غربًا، ومن المستحيل ترجمة رواية صينية إلى العربية دون إضافة تصريف للأفعال بحسب زمنها، والأسماء بحسب عددها وجنسها، سواء شاء المترجم ذلك (ورفض عنه المؤلف) أم لا. وقد يكون من الصعب أن نتقفّى أسباب هذه الاختلافات القائمة بين اللغات، لكن من الأكيد أنها ليست عبثية بالضرورة: فمعرفة الاتجاهات في جزيرة "بابوا نيوغينيا" لها قيمة لا يستعاض عنها للسكان الأصليين، إذ ليست بحوزة هؤلاء أجهزة حديثة لاتصال بعضهم ببعض، ولا نظام تحديد المواقع الجغرافية، ولا طرقات محفورة، ومعبدة أو لافتات يعرفون فيها أين يذهبون، بل عليهم أن يجدوا طريقهم في الغابات، والجبال منذ نعومة أظافرهم.[55] ولا شك بأن في اللغة الصينية وغيرها أسبابًا لما تتسم به من مرونة في التصريف، فلو كان الصينيون حريصين على معرفة أزمنة الذهاب والإياب وعدد التفاحات التي يجلبها أصدقاؤهم من السوق، لكانت قواعد لغتهم ستعبر عن ذلك. إذًا، تصنع اللغة -كما رأينا- حواجز ذهنية بين الناس بسبب اختلافات في ثقافاتهم، وكذلك بسبب اختلاف لغاتهم وقواعدها،[56] وهذه حواجز من الصعب تجاوزها بالترجمة، ويبقى عائق ذهني أخير تصنعه اللغة بين الناس؛ ولم نناقشه بعد في هذه المقدمة، مع أننا سنحتاج إلى التطرق إليه عند التعمق بالترجمة تطبيقيًّا، وهذا العائق هو اختلاف طريقة استيعاب اللغة بين الناطقين بها أفرادًا. تلال معشوشبة أم جرداء؟ لنتخيل قليلًا شخصين افتراضيين، ولنسمهما سامر وسيف. وُلِدَ سامر وسيف في المدينة نفسها، ونشأ كلاهما على لغة واحدة هي العربية العامية، ثم تعلم الاثنان العربية الفصحى في المدرسة، وشيئًا من الإنكليزية، لكن بينهما اختلافًا واحدًا: فهما من طبقتين مختلفتين اقتصاديًّا. فقد تربّى سامر في عائلة ميسورة، إذ أهداه والداه سيارة جديدة وهو في المدرسة الثانوية، وسافر إلى الولايات المتحدة وأوروبا قبل أن يدخل الجامعة. وأما سيف، فيغادر المدرسة بعد الظهر ليعمل صبيًّا في ورشة للسيارات في حي شعبي قديم، وهو لم يغادر مدينته -قطّ- ولا يكاد يقابل أي أشخاص من خارج حيّه. ولنطرح الآن سؤالًا عن هذين البطلين الافتراضيين: هل يفكر سامر وسيف بالعالم بالطريقة نفسها؟ وهل تدل اللغة لديهما على معانٍ وإيحاءات متماثلة؟ يرى سامر، وسيف في كل يوم مئات السيارات، ومن البديهي أن السيارات في أي مكان في العالم متشابهة جدًا، فجلّها منتجات مستوردة تصنعها شركات مشهورة ترن أسماؤها في آذان الجميع (ميتسوبيشي، تويوتا، هوندا، وهلم جرّا)، لكن تجربة الاثنين مع هذه المركبات مختلفة جدًّا. فإذا سمع سامر كلمة "سيارة" فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه هو سيارة فارهة نظيفة، يركبها في كل صباح ويشغّل التكييف ويقودها بسعادة إلى عمله، وأما سيف؛ فإن الكلمة توحي له على الفور بسيارة مهترئة متهالكة، مثل السيارات التي يغسلها في ورشته طوال النهار. ومن جهة أخرى، إذا سمع سيف كلمة "أمريكا" فإنه يفكر بأرض خيالية يعيش فيها ممثلو هوليوود وتأتي منها شطائر ماكدونالدز، وأما سامر فهو يسمع كلمة "أمريكا" ويرى أمامه طرق نيويورك المزدحمة وأشجار السنترال بارك وناطحات سحاب مانهاتن؛ التي تجوَّل بينها حتى صار يعرفها مثل حيه. وسامر وسيف هنا هما مثال على ارتباط اللغة بتجربة الإنسان، فكل كلمة نستخدمها في حياتنا اليومية توحي لنا بإيحاء قائم على تجربتنا الشخصية مع العالم، وهذه التجربة تأسر فهمنا للغة وتقيده ضمن الخلفية الذهنية التي يتميز بها كل إنسان عن سواه. وقد تبدو (على هذا المستوى) ترجمة الكلام ضرورية بين جميع الناس، لا بين اللغات فحسب، فكل منا يقصد بالكلمة الواحدة معاني ومدلولات تخصه، وقد يزيد المترجم على ترجمته كلمات تعكس ميوله الشخصية لا ميول المؤلف، أو يعجز عن فهم الإيحاءات التي يحاول المؤلف نقلها لقرّاءه، فنضيف بهذا عقبةً وحاجزًا جديدًا يستحيل على أي مترجم أن يخترقه، مهما حاول وسعى جاهدًا لذلك.[57] وهذا ما يتحدث عنه الباحث محمد عناني بقوله إن اللغة كائن إنساني حضاري، وهو يكتب في ذلك: فاللغة -بالنتيجة- لها صفة شخصية، وعقبات الترجمة لا تقتصر على الحواجز الثقافية والفكرية والقواعدية بين اللغات، بل إن مشكلتها في "المعنى" ذاته الذي ليست له صفة ثابتة بين الأفراد والأشخاص، ناهيك عن المجتمعات الإنسانية. ويمكننا الإلمام تمامًا بزوايا النقص الحتمي في ظاهرة الترجمة (الذي تناولناه من جوانب عدة حتى الآن) من قائمة جمعها عالم من علماء اللغة، وهي تلخص كل خلل في المعنى أو الثقافة يقتضيه نقل الكلام بين اللغات. إشكالات بيرمان الاثنا عشر وضع باحث اللغة الفرنسي؛ "أنطوان بيرمان"، قائمة في كتبه حصر فيها اثني عشر سمة، يقع فيها نقص وتحوير أثناء الترجمة، فتختفي فيها لمسة المؤلف الأدبية على حسابِ وضوح معنى الترجمة. وفيما يلي "ترجمة" لإشكالات بيرمان الاثني عشر حسبما رتبها صاحبها:[59][60] القواعد: التلاعب بقواعد اللغة وتراكيبها لتلائم اللغة الجديدة، مثل إعادة ترتيب الكلمات في الجملة وتغيير العلاقة بينها تماشيًا مع اختلاف اللغتين. الإيضاح: تفسير كلمات وجمل قصد المؤلف أن يتركها مبهمة. التطويل: تميل كثير من الترجمات لأن تكون أطول من الأصول؛ لأن فيها إيضاحًا وتفسيرًا مبالغًا فيهما. البلاغة: يتلاعب كثير من المترجمين باختيارات الكلمات في النص، ظنًّا منهم أنهم يبدلونها بما هو أبلغ. التحريف: إبدال كلمات الأصل بما يختلف عنها في انطباعاته غير المباشرة، مثل: الرمزية الدينية لشيء (كالصليب أو القربان)؛ أو الكلمات التي تحاكي أصواتًا حقيقية، مثل: "فحيح" الأفعى. التبسيط: إبدال كلمات عدة لها معان متفاوتة في الأصل؛ بمرادف واحد في الترجمة، مثال ذلك: أن في الإسبانية ثلاث كلمات معناها "وجه" ولا سبيل لمقابلتها في الترجمة إلا بكلمة عربية واحدة، مما يبسط التنوع المعجمي. القوافي: تقع هذه المشكلة في الشّعر -كثيرًا- وفي النثر -أحيانًا-، وذلك لاستحالة نقل المزايا الصوتية (من سجع وتناغم، وتلاعب بالكلمات، والقوافي) بين اللغات. الصرف: صعوبة نقل التشابه الصرفي المقصود بين مجموعة من الكلمات، والذي يحمل قيمةً لغوية محدّدة، مثال ذلك: أن أسماء الأمراض في العربية يتبع فيها -بالقياس- وزن فُعَال (سُعَال، وزُكَام، وعُضَال). التناسق: عادة ما تكون أصول النصوص متناسقة في شكلها ونمطها ورسالتها كاملة، وأما الترجمة؛ فإن كل جزء منها يكتسب لونًا جديدًا بسبب الإشكالات الاثني عشر هذه، فيضيع التناظر فيما بينها. الأمثال: يرى "بيرمان" أن تبديل الأمثال الأجنبية بنظائر لها من لغة الترجمة تضيع الخصوصية الثقافية للأصل، ومن أمثلة ذلك لو بدلنا جملة: "كل الطرق تؤدي إلى روما" بــــ"كل الطرق تؤدي إلى بغداد". اللهجات: قد يعجز المترجم عن نقل اللهجات الدارجة والعامية باللغات الأخرى إلى اللغة التي يترجم إليها، مع أهمية دلالاتها الثقافية والاجتماعية، كأن يتعذر عليه نقل لهجة الأمريكيين السود التي تميز مجتمعهم وثقافتهم. اللغات: تعجز الترجمة عن نقل تعددية اللغات في أحد النصوص، كأن تتمازج عدّة لغات في عمل واحد يكون تارة بالإيطالية، وتارة بالإسبانية، فضلًا عن تبديلات اللكنة، واللفظ التي تميز من يتحدث بلغة أجنبية. وعند ترجمة عمل أدبي تتزاحم على المترجم هذه الصعوبات كلها، وذلك لكثرة ما يملأ هذه الأعمال من لمسات فيها هذه الإشكالات من التشبيهات الصورية، والتلاعب بالألفاظ، والموسيقى، والشعر، وهذا ما يدفع كثيرًا من هواة الأدب للاستياء من قراءة كتاب بغير لغته الأم، بل ولعدم تقبّل قراءة الكتب المترجمة إطلاقًا إذا ما أتقنوا لغتها الأصلية. وقد يبدو هذا (وما سلف من عقبات وحواجز) مصدرًا للإحباط لمن يسعى إلى دخول عالم الترجمة، فهل يعني ذلك أن وظيفة المترجم ليست ذات قيمة؟ كما مرَّ بنا، لا شك أن بين لغات الإنسان فروقات كثيرة وحواجز ذهنية[61] وقواعدية وفردية بحيث يستحيل نقل الكلام بينها دون ضياع شيء من معناه ومغزاه ووقعه، وهذا يعني أن الترجمة -بتعريفها المعتاد- مستحيلة، وأن مهنة المترجم شاقة جدًا. لكن النتيجة التي نسعى إليها هنا ليست الدعوة لليأس من الترجمة واعتزالها، وإلا لما احتجنا لباقي صفحات هذا الكتاب، وإنما بوسعنا حل المشكلة بإعادة تعريف مهنة المترجم: فعمله لا يخضع (نتيجة لما سلف) إلى قواعد العلوم الصرفة والمنطقية، بل يعتمد في معظمه على الإبداع والفن.[62] _____ اقرأ أيضًا المقال السابق: اللغة ومفهوم الترجمة بين اللغات المقال التالي: فن الترجمة وأنواعها وأساليب الترجمة الحديثة
-
وصفتُ هذه السلسلة في مقدّمتها بأنها "متقدّمة في كثير من مواضعها"، وما قصدتهُ بذلك هو أن نفعها ليس كبيرًا لمن ليس له باع بالترجمة ولمن لا يستطيع مقاربة ما يقرأه بشيءٍ من الخبرة التي اكتسبها بنفسه، لكن هذا لا يعني أنه يجب على قارئ السلسلة امتلاك خبرة واسعة طويلة، ولا أن يكون مترجمًا متمرسًا في مهنة مدفوعة. وقد أجلت هذه السلسلة الحديث عن المسائل العملية والمهنية التي يقتضيها العمل المهني حتى مقالها الأخير هذا، ذلك لأني كتبتهُ شغفًا بنفع الترجمة العلمي والثقافي وبمعضلاتها الأكاديمية، لكن لن تكتمل فائدة السلسلة دون دليلٍ إلى كيفية دخول سوق العمل والانتفاع منه وتعلم كيفية استلام المشاريع والعمل عليها وتسليمها. وسوف تجد أن ما سنناقشه -في هذا المقال الأخير- لا يدور في فلك مختلف عمَّا تناولناه فيما مضى من فصول، بل إن العمل في الترجمة ودخول سوق العمل يتطلب الإلمام بجلّ ما ورد في الفصول الماضية من علوم الترجمة النظرية منها والتطبيقية. الخبرة تسبق العمل تذكر مقدّمة هذه السلسلة أن إحدى الأفكار الساذجة عن الترجمة هي أن "كلّ ما يلزمها هو إتقان لغة أجنبية"، لأن هذه المهنة (كما يتضح من الفصول الماضية) لا تقتصر على إتقان اللغة ولا على حب العلم، وإنما على الخبرة والممارسة، لكن هنالك معضلة كبرى قد يصطدم بها المترجم في موضوع الخبرة تشبه معضلة "البيضة والدجاجة" الشهيرة: فكيف لك أن تكسب عملًا دون خبرة؟ وكيف تكسب خبرة دون عمل؟ ولهذه المعضلة حلّ بسيط نسبيًا، يعد أحد مبادئ الحياة العامة وهو: "من لم يُعْطِ لا يأخذ"، أو -ببساطة- أن الخبرة يجب أن تسبق العمل، إذ قد لا يكون هذا الحل هو ما يأمله المترجم المستجد ويطمح إليه، لكنه حلٌ واقعيٌ. فقبل أن تنهال عليك عروض وظيفية بمئات الدولارات، عليك أن ترضى بالتبرع بجهدك ووقتك بدون مقابل لفترة من الزمن حتى تدخل سوق العمل وتحصل على أول عمل في الترجمة، ولا تظن أن هذا التطوع هو خسارة أو تضحية منك، بل هو فرصة للتدريب والتعلم. لا مهرب من أن يبدأ المترجم مهنته بالتطوع، فمن شبه المستحيل (بل ومن غير السليم، برأيي) أن يبدأ أي أحد عمله في الترجمة بمقابل مادي، حتى ولو استطاع إلى ذلك سبيلًا، إذ المترجم المبتدئ ليس مكسبًا رخيصًا أو مجانيًا، بل هو في العادة عبء قد يُكلِّف إصلاح عمله أكثر من أدائه عنه. وقد يظن بعض المستجدين أن في بدء عملهم بالتطوع غُبنًا أو استغلالًا لهم، لكن هذا خطأ يتضح له خلال سنين معدودة لاحقة في العمل، ولاشك أن الدهشة تملأ وجه كل مترجم أعاد النظر في أولى أعماله -بعد كسب الخبرة والممارسة- لما قد يجد فيها من ركاكة وأخطاء وزلات. لهذا السبب يمضي الطلاب سنواتٍ طوالٍ في الجامعات يدفعون لقاءها ثروات لاكتساب العلم والمعرفة قبل دخول سوق العمل، إلا أن من حظ المترجمين الحَسَن أن اكتساب هذا العلم لا يكلِّفهم قرشًا واحدًا، بل يستلزم منهم وقتًا فحسب. وليس من الضروري أن يتطوع هؤلاء المترجمون المستجدون بكامل وقتهم لصالح شركة تنتفع على حسابهم، بل أمامهم مئات الفرص في شتى القطاعات لخدمة المحتوى العربي واللغة العربية وكسب الخبرة في الوقت نفسه، والتي يمكن الالتحاق بها بسهولة عبر الإنترنت ومن أمثلتها: مواقع الويكي التعاونية: وأشهرها موسوعة ويكيبيديا الحرة وموسوعة حسوب وغيرها من الموسوعات العربية. مبادرات المحتوى العربي التطوعية: هذه المبادرات كثيرة، ومن أمثلتها المعروفة: الباحثون السوريون والسعودي العلمي وناسا بالعربي ومؤسسة بالعربي وغيرها. المواقع التعليمية: منها كثير من المواقع العربية والعالمية التي تعتمد على المترجمين مثل أكاديمية حسوب ومحاضرات تيد Ted وغيرها. المجلات الإلكترونية المترجمة: تقبل كثير من المجلات ومواقع الأخبار الإلكترونية المساهمات التطوعية، والتي يمكن إرسالها بالبريد الإلكتروني. ليست كل الترجمة سواء انتبه، عليك أن تفهم سوق الترجمة وما هي فرصه الوظيفية وأيها هي التي تلبي طموحاتك قبل أن تبدأ البحث عن وظيفة بالترجمة، وحتى قبل أن تختار الأماكن التي ترغب بالتطوع فيها ونشر ترجماتك الأولى، فشرح المقال الثاني من هذه السلسلة نوعين أساسيَّين من أنواع الترجمة: هما الترجمة المهنية والترجمة الأدبية،[1] لكن ذلك المقال لم يتطرق إلى الاختلافات الوظيفية والعملية بينهما ولا إلى المهن التي يُفْضِيَان إليها، وهي مهنٌ لا تكاد تربط بينها صلة. كما أنه لم يتطرق إلى ما تحتاج إليه لأن تكون مترجمًا. المؤهلات استشهدت هذه السلسلة سابقًا بقاعدة معروفة في الترجمة، وهي قاعدة تقتضي أن المترجم يترجم إلى لغته الأم حصرًا، فمن نشأ بلسان عربي لا يترجم إلا إلى العربية، حتى ولو تعلَّم عشر لغات أخرى وأتقنها "إتقانًا تامًا"، ولعل هذه السلسلة نجحت في تبرير هذه القاعدة وتوضيح أن بالغ الأهمية تعطى للغة التي يكتب فيها المترجم موازنةً مع اللغة الأم، لكن لم تتطرّق السلسلة آنذاك قط للمؤهلات الأكاديمية والمهنية التي تُخوِّل شخصًا للعمل في الترجمة. يُقَال أن المترجمين نوعان: منهم مختصّون باللغة، أي درسوا علم اللسانيات أو لغة أجنبية أو آدابًا أو ترجمة، ومنهم مختصون بعلوم مختلفة، مثل الأطباء أو المهندسين أو المبرمجين الذين امتهنوا مهنة الترجمة؛ ولكل حالة من هاتين الحالتين مزاياها ومشكلاتها،[2] فالمترجم المختصّ باللغة يتقن أصول الكتابة والإملاء والصياغة السليمة أو الإبداعية، لكنه قد يجابه مصاعب عديدة في ترجمة نص اختصاصي (في علم الرياضيات مثلًا)، وأما المختص فيستطيع ترجمة نصوص في مجال اختصاصه -والموضوعات القريبة منه- بكفاءة تامة، إلا أن لغته قد تكون ركيكة ضعيفة الصياغة. ليست الترجمة حكرًا على هذا ولا ذاك: فكل منهما له مكانه ويستطيع تعويض المهارات التي تنقصه بالتعلم والتدريب، لكن معرفة اختصاصك قد تساعدك على تحديد مهنتك.[3] فمهن الترجمة ليست سواء، واختصاص المترجم قد يؤهله للنجاح في مهن محدّدة أكثر من سواها. التوجه والهدف إذا كان هدف المترجم هو أن يكسب دخلًا وأن يستقر على وظيفة ثابتة فخياره الأفضل هو الترجمة المهنية أو التجارية، فلو سمعت عن وظيفة بدوامٍ كامل في شركة للترجمة فمن شبه الأكيد أن موضوعها مهني وتجاري، أي أنها تختصّ بنصوصٍ مثل الوثائق الرسمية والتقارير والبرامج الإلكترونية وأوصاف المنتجات وكتيبات التعليمات، وهلم جرًا. وتحتاج بعض أنواع الترجمة المهنية إلى خبرة في اختصاصات معيّنة قد لا تُغْنِي عنها المعرفة اللغوية،[4] فترجمة الوثائق القانونية -مثلًا- قد تحتاج إلى محامٍ.[5] ووظائف الترجمة التجارية قليلة،[6] لكن مردودها المادي عالٍ نسبيًا، فقد يصل إلى آلاف الدولارات شهريًا خلال بضع سنين، ولها شركات ضخمة وعابرة للقارات. أود الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن هدف الترجمة المهنية الأساسي هو الربح والمادة وقد لا يكون ذلك هدفًا لبعض المترجمين، فكما ذكرنا في بداية هذه السلسلة، الترجمة "ليست منجم ذهبٍ"؛ ويكثر أو يغلب على المترجمين أن يختاروا مهنتهم شغفًا منهم باللغة أو العلم وليس بالربح، ولذلك قد لا يجدون شغفًا ولا متعة في وظيفة تجارية حتى لو كانت تدر عليهم المال؛ وليس السبب المُنفِّر من الترجمة التجارية موضوعها فقط، فمن عُشَّاق اللغة من يستمتع بترجمة النص مهما كان موضوعه، لكن المشكلة الأكبر هي طريقة العمل في هذه الشركات: إذ إن أساس تقييم عمل المترجم في هذه الشركات هو سرعة الإنجاز بعيدًا عن النظر لجودة العمل، وغالبًا ما يُتغاضَى عن مسائل الركاكة والحرفية التي انتقدناها في هذه السلسلة، ولن يلقى تقديرًا ولا ترحيبًا بإبداعه اللغوي، فنسبة وظائف الترجمة التي تطلب مهارات الترجمة الآلية أو الاستعانة بالبرامج الحاسوبية تصل إلى 95%، ونسبة الوظائف التي تعتبر فيها هذه مهارات إجبارية حوالي 66%،[7] وذلك لأنها أدوات تساعد على زيادة سرعة العمل ورفع الأرباح.[8] قد يكون ذلك مناسبًا لبعض المترجمين أو من يريدون امتهان الترجمة لكسب المال وتأمين متطلبات الحياة المالية، ولكن لو لم يرغب المترجم بمثل هذه الأمور، فعليه أن يبني مهنته في قطاعات الترجمة الأخرى، ولا نقلل هنا من أهمية الهدف المالي ولكن قد يمتهن البعض مهنة الترجمة كمهنة ثانوية وليست أساسية. عمومًا، للمترجمين فرص كثيرة للعمل بوظائف غير ثابتة، بل إن العدد الأكبر منهم يعمل في وظائف حرّة أو بدوام جزئي؛[9] وهذه الفرص في ارتفاع سريع جدًا يفوق وظائف الترجمة بدوامٍ كامل،[10] وهذه الزيادة كبيرة جدًا في العالم العربي لأسباب عدّة، منها ازدياد الثقة والاعتمادية على الإنترنت في التوظيف وقلة تكاليف العمل مع المترجمين عن بعد وتسارع الاستثمار بالمحتوى العربي على الإنترنت. وكثير من العاملين في الترجمة الحرة (أو معظمهم) يستفيدون منها كوظيفة إضافية لزيادة دخلهم،[11] إلا أن من الممكن الاعتماد عليها بالكامل كمصدرٍ للدخل إن كان للمترجم عدد كافٍ من العملاء؛[12] انظر مثلًا قسم الترجمة واللغات في منصة مستقل للعمل الحر أكبر منصة عمل حر في العالم العربي تعرف حجم السوق والطلب على أعمال الترجمة. ولهذه الفرص مجالات شتى قد يجد فيها المترجم ما يشبع أي اهتمام عنده، فمنها العمل مع مواقع الإنترنت والمجلات والصحف بموضوعاتها المتنوعة، من علوم طبيعية واجتماعية ورياضة وصحة وسياسة وأخبار وغير ذلك، كما أن هذه هي طريقة العمل المعتادة في واحدٍ من أهم قطاعات الترجمة، وهو الترجمة الأدبية للكتب والروايات والأشعار وغيرها؛ وتتضمن فرص الترجمة الحرة كذلك ترجمة الأفلام والمسلسلات وغيرها من أنواع الفيديو التي يُرْفَق معها نص مترجم، وهذه فئة جديدة نسبيًا وعليها طلب كبير تسمى "الترجمة المرئية"،[13] وقد تطرّقت إليها هذه السلسلة عرضيًا فقط. للترجمة الحرة ميزات عدة، من أهمها الحرية والاستقلالية الكبيرة للمترجم،[14] ولها صعوباتها كذلك، فقد يكون العثور على أول عميل مضنيًا، والبحث عن العملاء يبقى -دومًا- عبئًا مستمرًا[15] يستهلك وقت المترجم وساعات عمله؛[16] ولن يستطيع المترجم الحر الاعتماد على عمله إن لم يحصل على فرص عملٍ كافية، فهو يحتاج إلى كمية كبيرة من العمل للحصول على دخل مستمر، بغض النظر عن أسعاره،[17] والطريقة الأفضل لضمان هذا الأمر هي أن يقيم المترجم الحر علاقة عمل مستمرّة مع عددٍ من العملاء الذين لديهم عملًا منتظمًا.[18] تحظى الترجمة الأدبية بمكانة استثنائية في أسواق الترجمة العالمية، فهي أصعب أنواع الترجمة وأكثرها حاجة للإبداع وتتطلب امتلاك سعة في اللغة والمفردات والاطلاع والتفنن الأدبي، ولهذا فمن المعتاد أن يقتصر العمل فيها على المؤلِّفين الذين لديهم خبرة مسبقة في فنون الكتابة الأدبية،[19] لكن سوق الترجمة العربي ليس مثل العالمي، والواقع -المرير- هو أن ترجمة الأدب فيه لا تحظى بتقدير جدير بالذكر إلا من دور نشر معدودة، وفرص العمل فيها لا تعتمد على الخبرة والإتقان الأدبي بقدر ما هي رهنٌ للمعرفة الشخصية والأسعار الرخيصة؛ ورغم أن الترجمة الأدبية قد تكون حلم كثير من المترجمين الشغوفين إلا أن فرص العمل فيها قليلة ومتباعدة، ويصعب أن توفّر مصدرًا للدخل دون فرص عمل إضافية.[20] التخصص كثيرًا ما ينصح المترجم الحر باختيار مجال أو مجموعة من المجالات للتخصّص بالترجمة فيها، فكل موضوع له تفاصيله الدقيقة ومصطلحاته المُخصَّصة، ولذلك لا يستطيع المترجم الجيّد الاقتصار على سعة مهاراته اللغوية، وإنما عليه أن يعرف المجالات التي يترجم إليها كذلك، وهذا أمرٌ يتطلَّب صبرًا وخبرة،[21] إلا أن هذه فكرة أجنبية وما زالت غير منتشرة كفاية في سوق الترجمة العربية الذي تعد فيه كل الترجمة سواء وكل المترجمين قادرين على ترجمة أي شيء، من الترجمة الفورية أو الشفهية إلى ترجمة أبحاث الفيزياء النووية. لا يتخصَّص جميع المترجمين بمجال في الترجمة دون غيره ولا بنوع واحد من الوظائف، فكثيرٌ منهم يقبلون شتى الفرص المتاحة لهم بأنواعها العديدة، خصوصًا في سوق تنافسي مثل السوق العربي؛ ولا عيب في هذا الأمر، لكن على المترجم المحترف الذي يحرص على مستقبله أن يُخطِّط مسبقًا لفرص الترجمة التي يحرص عليه وأن يُطوِّر خبرته ومهاراته فيها، وذلك ليكون أداؤه متميزًا حينما ينال الوظيفة التي يتمنَّاها، وتذكر دومًا أن أجر المترجم المتخصص لا يتساوى مع أجر المترجم العام الذي يترجم أي شيء. البحث عن وظيفة طرق البحث عن العملاء كثيرة، وفيها كثير من الخبرة والمهارات التي لا تنحصر في الترجمة وحدها، والتي تُفصِّلها مراجع عديدة أفضل من هذه السلسلة. وأما لو كان المترجم بحاجة إلى نصيحة خاصة بمهنته فأنصحه ببناء سمعة جيدة وتأسيس شبكة علاقات قوية في مجاله، وليس هذا لأن السمعة والعلاقات هي مزية تخص مجال الترجمة دون سواه، وإنما لأنهما أفضل وسيلة للحصول على عمل وتأمين دخل كافٍ من الترجمة، إذ من العسير على المترجم الحر أن يكسب ما يكفيه دون سمعة طيبة وشبكة علاقات واسعة تأتيه بوظائف مستمرة بدلاً من قضاء يومه كاملًا بالتقديم لمئات الوظائف وترجمة عشرات العينات. طرق بناء العلاقات كثيرة، وهي ليست -كذلك- أمرًا تتفرَّد به الترجمة ولا موضوعًا تختصّ به هذه السلسلة، لكن قد ينفع المترجم في هذا السياق أن يأخذ بنصيحة وردت في كثير من الصفحات السابقة بخصوص الترجمة، وهي أن يأخذ الأمور في سياقها، فمعظم المراجع المختصَّة بموضوع بناء العلاقات أجنبية، وبالتالي فإنها تُقدِّم نصائح قد تكون مُجرَّدة من سياقها وقيمتها؛ ومن أمثلة ذلك أن كثيرًا من الكتب الأجنبية تنصح المترجم بالبحث عن عملاء في "معارض التجارة"[22] أو في "الفعاليات الاجتماعية" و"لقاءات العلاقات العامة" للمترجمين المحترفين،[23] وهذه أوصافٌ خيالية لأشياء لا أثر لها في الوطن العربي ولا تنفع المترجم العربي شيئًا؛ وفي سياق بناء العلاقات والحفاظ عليها، أحيلك إلى مرجع عربي مهم يناقش هذا الأمر عبر مقالات متنوعة وهو قسم "التعامل مع العملاء" في قسم العمل الحر في أكاديمية حسوب ففيه مراجع ومقالات قيمة مثل مقال "كيفية إنشاء علاقات قوية مع العملاء والحفاظ عليها" ومقال "كيف تحافظ على علاقات إيجابية مع عملائك السابقين". يستطيع المترجم أن يبني شبكة علاقاته بوسيلتين مختلفتين عادة، وخصوصًا في السياق العربي، وهما العلاقات الواقعية والعلاقات الإلكترونية؛ فالبلاد العربية مترامية الأطراف ولا يمكن بناء علاقات عبرها إلا بالاستعانة بالإنترنت، إلا أن الإنترنت لا يصل المترجم إلا بفئة محدّدة من العملاء الذين عندهم استعداد لتوظيف شخص لم يقابلوه وجهًا لوجه وقد لا يعرفونه شخصيًا، والحقيقة أن هذا أمرٌ آخذٌ بالانتشار في المنطقة العربية ولا يجب أن نفعله. عمومًا، للعلاقات الواقعية والافتراضية مزاياها ومساوئها، إلا أن طرق العمل فيها مختلفة جدًا، فقد يكون بناء العلاقات الواقعية في مجال الترجمة -حصرًا- شديد الصعوبة عربيًا، وذلك بسبب ندرة أو انعدام المجتمعات المخصّصة للمترجمين رغم أنك تجد في كثير من البلدان العربية جمعيات للمترجمين، بل إن هناك جمعية للمترجمين العرب فيها آلاف الأعضاء من شتى أنحاء الوطن العربي[24] وقد يكون الالتحاق بمثل هذه الجمعيات مفيدًا، لكن مشكلة معظمها أو جميعها أنها لا تُنظِّم فعاليات وظيفية (مثل التي تصفها الكتب الأجنبية) لمساعدة المترجمين والعملاء على اللقاء معًا، وبالتالي فإن هذه الجمعيات تبقى كيانات افتراضية وأقرب لنقابات من مجتمعات للعمل. لذلك فإن المترجم العربي الذي يحتاج علاقات عمل مضطرٌّ للبحث في المجتمع المهني بعمومه وليس في مجتمع خاص بالمترجمين فقط، وهذا أمرٌ صعب ومضنٍ وقد لا يأتي بنتيجة إلا لمن لديهم شبكة واسعة من العلاقات مسبقًا. رغم ذلك، لا شك بأن بعض المراكز والمؤسسات الثقافية بالمدن العربية الكبرى تقيم محاضراتٍ -بين الفينة والأخرى- لها علاقة بالترجمة والنشر والمحتوى العربي، وقد لا يجد المترجم عملاء في هذه الفعاليات بحد ذاتها، لكنها فرصة ثمينة جدًا في التعرف إلى مجتمع المترجمين والكتاب والمدونين، وقد تعود بفرصٍ كثيرةٍ على الأمد البعيد. ذلك بالنسبة للعلاقات الوجاهية، إلا أن الإنترنت هو الوسيلة الأقوى والأسرع حاليًا للوصول إلى العملاء وتكوين سمعة في سوق العمل الحالي، فإحدى أقدم الطرق في العمل عبر الإنترنت هي إطلاق موقع أو مدونة، والغالب أن هذه الطريقة فقدت جل نفعها بسبب زيادة "المركزية" في الإنترنت، أي أن معظم الناس يستخدمون عددًا قليلًا من المواقع عوضًا عن تصفح الإنترنت بعمومه، كما أن المواقع الشخصية قد لا تظهر في نتائج محركات البحث الآن بسبب فيضان المحتوى الرقمي. لكن الموظف الحر ما يزال قادرًا على استغلال الموقع الشخصي للتعريف بنفسه، أي أنه يستطيع استخدامه كبطاقة شخصية يرسلها للعملاء بدلًا من بطاقات العمل الورقية، كما أن نشر محتوى ومقالات عن الترجمة في هذه المواقع قد يزيد فرص ظهورها للعملاء والمترجمين في الإنترنت وتعرفهم على صاحبها. وأما الميزة الأهم للإنترنت فهي أنه يزخر بمجتمعات ومنصات عمل مثل منصة مستقل ومنصة خمسات ومجتمع خمسات ومنصات نشر عربية مثل أكاديمية حسوب، وهو أمر لا وجود له في سوق العمل العربي الواقعي. لابد أن أشير أيضًا إلى أنَّ أماكن المجتمعات الإلكترونية، خصوصًا الصغيرة والفردية منها، في تغير دائم، فقد ملأت المنتديات الإنترنت العربي قديمًا وأما الآن فكثيرٌ منها أو أغلبها انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي ولم تعد موجودة؛ فمنصات العمل العربية كثيرة حاليًا، وهي وسيلة مباشرة لطلب موظف حر في أي مجال، وكثيرًا ما تكون الترجمة من أكثر هذه الوظائف طلبًا، رغم كثرة المنافسة عليها كذلك. أضف إلى ذلك، يزدهر الإنترنت العربي بعدد هائل من منصات المحتوى والمقالات والتدوين التي يستطيع المترجم نشر ترجمته أو مقالات عن الترجمة فيها، انظر مثلًا صفحة "اكتب معنا" لأكاديمية حسوب، فكثير من هذه المنصات (خصوصًا الصغرى) تُرحِّب بمساهمة أي كاتب طالما أن أسلوبه سليم وأن عمله تطوعي، وهذا "التطوع" هو استثمار له عائدٌ كبير في السمعة وفي بناء علاقات مع أصحاب المواقع ومجتمع المحتوى العربي. لا توجد أي وسيلة سحرية بين هذه الوسائل، فهي كلها بدايات لبناء السمعة أو التعرف إلى بعض الأشخاص أو البحث عن عمل، لكنها كلها تُقدِّم خطوات تدريجية للالتقاء ببعض العملاء والمترجمين وبناء علاقات تتطور بالتدريج، والتي سوف يحصل منها المترجم -عاجلًا أو آجلًا- على مشروع يعمل فيه. الاتفاق يسبق العمل اطلعت مرة على أحد الكتب المتخصّصة عن كيفية الاتفاق على مشروع للترجمة وتنفيذه والذي يعرض قائمة فيها 156 خطوة مُطوَّلة لذلك،[25] وليس من الضروري أن تكون كل اتفاقات الترجمة بهذا التعقيد، ولكن الترجمة ليست مسألة سهلة وتنطوي على عددٍ هائل من القرارات المتوالية التي يتخذها المترجم (وقد وردت أمثلتها) في اختيار المصطلحات والتعابير والأسلوب، وقد لا يدرك معظم العملاء هذه الصعوبة أو ربما يستخفّون بها؛ لهذا ومثل أي عمل، يجب أن يبدأ مشروع الترجمة باتفاق، ويسير المترجمون المحترفون في هذا الاتفاق حسب خطواتٍ محدَّدة تضمن تفاهمًا تامًا على تفاصيل العمل التقنية والمالية قبل الشروع فيه، وتساعد -كذلك- في إثبات احترافية المترجم وإلمامه بمهنته. الهدف يدل على الطريق تناول مقال تعريب المفردة والمصطلح من هذه السلسلة أهم نظريات الترجمة الأكاديمية المتداولة حاليًا، وفصَّل في كيفية تطبيق بعضها في عمل المترجم، وتتميز في هذا السياق نظرية "الترجمة الوظيفية" في أنها تؤهِّل المترجم لعقد اتفاق واضحٍ واحترافي مع العميل بأن يطرح عليه سؤالين: ما الذي تريد ترجمته؟ ولماذا؟ كل من يريد ترجمة نص له هدفٌ واضح وجمهور محدّد من القراء، حتى ولو لم يعرف كيف يصف أهدافه وجمهوره؛ فهناك من يريد ترجمة دعاية إعلانية في شركته لجذب الزبائن، أو ترجمة تقرير لمجلس إدارة الشركة لإطلاعهم على نتائج العام المنصرم، أو ترجمة رواية لدار نشر ليشتريها القراء، ويستطيع المترجم بناءً على ذلك أن يُقرِّر منهج الترجمة وأسلوبها وأتعابها بناءً على معرفة الهدف والجمهور، وأن يُوضِّح أسلوبه باحترافية لصاحب العمل. يُوضِّح مقال تعريب المفردة والمصطلح المشار إليه أعلاه أن المنهجين الأساسيَّين والمتناقضين في الترجمة هما الترجمة الحرفية والترجمة بتصرّف، واختيار المنهج المناسب يعتمد حصرًا على هدف صاحب العمل وجمهوره. فمن يريد ترجمة دعاية إعلانية يحتاج إلى أن يؤثِّر على جمهور واسع من القراء، وبالتالي يجب أن تكون الترجمة بتصرف وربما أن تتضمن كلمات من اللهجات العربية العامية للتأثير بالجمهور؛ وأما ترجمة التقرير فيجب أن تكون متوازنة لتصف الفكرة المطلوبة لمجلس الإدارة ولتلتزم -كذلك- بالتعابير المدروسة التي اختارها المدير التنفيذي أثناء كتابة التقرير؛ وأما ترجمة الرواية فيجب أن تكون شبه حرفية لتلتزم بأسلوب المؤلف المشهور الذي يتطلَّع معجبوه لشراء الرواية المترجمة. اختلاف التوقعات يساعد الاتفاق على الهدف من الترجمة وجمهورها وأسلوبها في التخطيط لعمل المترجم لكن هذا الاتفاق غير كافٍ، فالترجمة غنية بالتفاصيل، ومن السهل أن تختلف التوقعات حيال هذه التفاصيل، خصوصًا من العملاء المستجدّين؛ إذ على المترجم أن يفترض -دومًا- أن عميله لا يعرف شيئًا عن الترجمة ولا شروطها ولا متطلباتها حتى يثبت العكس، مما يعني أن المترجم قد يضطر لتلقين العميل أصول عمله قبل عقداتفاق سليم.[26] من ذلك، يجب توضيح ما يأتي: أولًا، يجب الاتفاق على منصة العمل وآليته، فلو كان موضوع الترجمة برنامجًا حاسوبيًا أو موقع إنترنت أو مقطع فيديو، فيجب أن يتفق المترجم مع صاحب العمل مسبقًا فيما إن كان عليه ترجمة النص خارجيًا (أي على ملف "مايكروسوفت وُرد")، أم أن عليه استعمال منصة جديدة يُدْخِلُ النص فيها.[27] ثانيًا، يجب الاتفاق على نوع النص وطبيعته، إذ إن البديهي والطبيعي هو أن يُقدِّم صاحب العمل للمترجم نصًا مُرَاجعًا وخاليًا من الأخطاء، وإلا فلا بد من أن تنتقل هذه الأخطاء إلى الترجمة.[28] ثالثًا، يجب على المترجم أن يراجع النص المطلوب وأن يناقش ويُوضِّح مسبقًا أي أبعادٍ للنص قد يستعصي تعريبها لأسباب ثقافية أو لغوية.[29] رابعًا، يجب الاتفاق على رغبة صاحب العمل بالتدخُّل في دقائق الترجمة أو في تفويضها للمترجم مثل طريقة تعريب المصطلحات[30] والأسلوب وغير ذلك، فلو كان صاحب العمل مهتمًا، فيجب توضيح درجة اهتمامه وكيفية الاتفاق معه على خصوصيات النص هذه، وتزداد ضرورة هذا الاتفاق إن كان النص متخصصًا (مثل مقال علمي) أو ذا خصوصية ثقافية (مثل الأفلام وألعاب الفيديو).[31] خامسًا، لو كان صاحب العمل على اتصال مباشر بمؤلّف النص (مثلاً لو كان تقريرًا)، فعلى المترجم التأكد من استعدادية صاحب العمل لتفسير وتوضيح مواضع الغموض في النص أو الأمور التي لا يفهمها، فهذا الطلب ليس علامة على قلة دراية المترجم (كما قد يظن العميل المستجد)، بل على احترافيته وحرصه.[32] سادسًا، يجب الاتفاق دومًا على المسؤول عن مهمة المراجعة والتحرير والتدقيق اللغوي، وهو جزء ضروري من الترجمة؛ والبديهي هو أن يتولى صاحب العمل ترتيب المراجعة، إذ إن المترجم لا يستطيع مراجعة عمله بنفسه، إلا لو اتفق مع مدقّق لغوي يعرفه.[33] التجربة ليست استغلالا السيرة الذاتية ليست دليلًا كافيًا على المترجم المتقن لما في مهنة الترجمة من فن، وهذا من سوء حظ المترجمين، إذ لا يكفي أنهم يبدؤون مهنتهم بالتطوع أغلب الأحيان، بل عليهم أن يتطوعوا -أيضًا- بترجمة عينة قبل الحصول على أي عمل؛ وهذا الأمر ليس استغلالًا، فكل العملاء ذوي الخبرة يطلبون عينة قبل الشروع في العمل، وهذه العينة لا يفترض أن تفيدهم بشيء، إذ إن صاحب العمل الجاد يُقدِّم عينة موحَّدة لجميع المترجمين المحتمَلين ليستطيع تقييمهم على أساسٍ واحد، ولا يُقسِّم النص بين المترجمين المتقدمين لتوفير المال. من الأفضل للمترجم أن يتطوَّع لتقديم عينة من عمله سواء أطلبها صاحب العمل أم لم يطلبها، إذ إن في ذلك بادرة ثقةٍ، وفيه أكبر ضمانة على توافق المترجم وصاحب العمل في أسلوب ترجمة النص وتوقعاتهما منه، مما قد يُجنِّب المترجم عملًا كثيرًا في التنقيح والتعديل إن لم يرضَ صاحب العمل عن النتيجة،[34] كما أن العينة تساعد المترجم نفسه في التعرّف إلى النص وتقدير العبء المطلوب لإنجازه. الوقت والمال يصف هذا المثال الساخر كيفية استخفاف أصحاب العمل قليلي الخبرة بأعباء الترجمة وأتعابها؛ فصحيحٌ أن الترجمة أسرع بكثير من التأليف، لكن عبء الترجمة والجهد والوقت والتكلفة لها تتوافق طرديًا مع الجهد الذي وضعه الكاتب في تأليف النص الأصلي المراد ترجمته، ولهذا فإن العمل على ترجمة بحث أكاديمي استغرق شهورًا لتأليفه ليس مثل ترجمة مستند أمضى أحد الموظفين ساعة في كتابته. يتراوح الوقت الذي تستغرقه الترجمة (حسب خبرة المترجم والنص الذي يعمل معه) بين 250 إلى 1,000 كلمة في الساعة، علمًا بأن هذا الحد الأعلى نادر وقد يصعب بلوغه دون الاستعانة ببرامج حاسوبية (مثل برامج الترجمة بمعونة الحاسوب CAT)؛[36] ومن الطبيعي أن صعوبة النص لها أثر كبير، فقد يمضي المترجم نصف وقته أو أكثر في مراجعة الكلمات أحيانًا، ورغم ذلك فمن الصعب أن تتدنى سرعته عن هذا الحد إلا في حالات قليلة جدًا. ويظهر استبيان لجمعية المترجمين الأمريكيين أن متوسط سرعة المترجم هو نحو 500 كلمة في الساعة،[37] ويستطيع المترجم أن يقيس سرعته أثناء ترجمة العينة الأولى، وبها يُقدِّر الوقت الذي يلزمه لترجمة النص كاملًا، وبذلك يعرف عبء العمل وسعره، وهذا من فوائد ترجمة عينة من النص المراد العمل عليه كما أشرت. إذًا، يُقَاس سعر الترجمة حسب الحالة والسياق، كما أن الأسعار تتغير مع الوقت، ولذلك فإن الطريقة الأفضل لمعرفة السعر الصحيح في حالة من الحالات هي بسؤال أحد أصحاب الخبرة مع توضيح العوامل والظروف التي تخصّ المشروع والمترجم، وأهم العوامل التي تؤثر على السعر هي: خبرة المترجم: لا شك أن السعر يتناسب طردًا مع الخبرة صعوبة النص: النصوص الاختصاصية والأدبية أغلى طول النص: قد يقل سعر الكلمة إن كان النص طويلًا بلد المترجم: حسب مستوى الدخل في ذلك البلد بلد صاحب العمل: قد يرتفع السعر لو كان مع عميل من بلدٍ معيشته مرتفعة ومتوسط دخل الفرد فيه مرتفع يُقَاس سعر الترجمة بطرقٍ عدة، أشهرها في السوق العربي هي عدد الكلمات وعدد الصفحات، والأخيرة هنا ليس إلا وحدة قياس، إذ يجب أن تعادل "الصفحة" الواحدة دائمًا 250 كلمة/صفحة، وأما قياسها وكأنها صفحات فعلية فهو غير دقيقٍ ولا يجب أن يتّبع آنذاك؛ وقد تستخدم وحدات أخرى للقياس في حالات خاصة، أهمها هو عدد الدقائق في حالة ترجمة الفيديو،[38] وسعر الساعة في حالات نادرة (ربما تقتصر معظمها على الموظفين). وقد يُستخدَم عدد الكلمات والصفحات في طريقتين لاحتساب سعر الترجمة: إما بناءً على عددها في النص الأصلي أو في النص المترجَم، إذ إن هذه المسألة ترجع إلى الاتفاق بين المترجم وصاحب العمل؛[39] وقد يكون الاتفاق على طول النص الأصلي أفضل، لأنه يساعد على تحديد السعر مُقدَّمًا ويجنب أي خلاف يزعم فيه العميل أن المترجم حاول إطالة النص لزيادة أجرته.[40] كتابة الاتفاق وتوثيقه من المسلَّم به أنه يجب الاتفاق كتابةً على كل الأمور الواردة في مشروع الترجمة، وأهمها -بالطبع- السعر حسب الوحدة المتبعة (أي حسب الكلمة أو الصفحة مثلًا)، وسعر ترجمة النص كاملًا (يجب فصله عن سعر الوحدة، خصوصًا في النصوص التي يحتمل أن تتغير)، والفترة اللازمة للتسليم، ويجب أن يتوافق عليها الطرفان بوضوح تامّ قبل البدء بالمشروع. ومن المعتاد العمل على الترجمة في العالم العربي بدون أي عقود ولا وثائق مكتوبة أو موقَّعة، ولا يُنْصَح أبدًا بهذا السلوك إلا إن كان العمل عبر منصة رقمية مثل مستقل لأن هذه المنصات فيها عقودٌ إلكترونية وحتى الاتفاق عليها يعد بمثابة عقد وتوثيق وفيها فريق دعم فني يعمل على حل الخلافات إن حصلت، فعقد العمل غالبًا ما يُجنِّب الطرفين نزاعات لا حاجة لها فيما بعد خصوصًا إن كان العمل لشخص تربطك فيه علاقة قوية، فكما يقال في المثل الشامي: أوله شرط آخره سلامة، أي إن وجد اتفاق وشروط واضحة في العمل، انتهى برضى الطرفين وحصل التفاهم ونُبذَ الخلاف. الترجمة الترجمة هي الموضوع الذي تناولته هذه السلسلة كاملةًا بفصولها وصفحاتها كافةً، ولن تكفي السلسلة كلها (ولا هذا القسم الصغير بالتأكيد) للإسهاب في كل دقائقها وحيثياتها، على أن السلسلة بأكملها لم تتطرَّق -إلا عرضًا- للجانب الوظيفي من عملية الترجمة، أي كيفية ترجمة النص وتسليمه إلى العميل في سياق مشروع فعلي، وهي الخطوة الأخيرة التي تأتي بعد الاتفاق على كل ما سبق. على المترجم الحريص أن يقرأ النص ولو سريعًا إن أمكنه (من حيث سعر العمل ووقته) قبل الشروع بترجمته، وعليه أن يرجع لصاحب العمل بأي استفسارات أو ملاحظات لديه؛[41] ففي كثير من الحالات، مثل ترجمة نص اختصاصي أو بحث علمي، قد يضطر المترجم للاطلاع على موضوع النص والقراءة عنه أو مشاهدة فيديوهات تعليمية أو شروحات مبسّطة، إذ إنه لن يستطيع ترجمة المعنى بدقة دون أن يتحقَّق أولًا من فهمه هو لهذا المعنى.[42] يؤدي المترجم عمله بأن يقرأ النص الأجنبي جملة جملة، ويراجع أي كلمات لا يعرفها أو يشك بمعناها في سياقها، حتى ولو شكًا بسيطًا، ثم يصيغ معناها بلغة عربية سليمة،[43] وعلى المترجم في هذه الخطوة أن يُوثِّق مسألتين فائقتي الأهمية: الأولى هي الجمل التي يستعصي عليه فهمها أو يشك في معانيها ليراجعها لاحقًا ويستفسر من صاحب العمل عن الإجراء الأنسب نحوها،[44] والثانية هي تسجيل الكلمات التي يجب النظر في تعريبها وهذه تحتاج لمراجعة وتوثيق. فُصِّلَت طرق تعريب المصطلحات في مقال آفات الترجمة على اللغة من السلسلة، والجانب المهم إجرائيًا عند تعريب مصطلحٍ ما هو استخدام مسرد ذاتي يُوثِّق فيه المترجم التعريب الذي اختاره،[45] فالتعريبات الواردة في المعاجم تتعدّد للمصطلح الواحد ولا مفرَّ من التَخيُّر بينها، ويجب ألا يتبدل هذا الاختيار ضمن النص نفسه، وقد لا يحتاج المترجم لتسجيل التعريب في مسرد إن كان يترجم نصًا قصيرًا، لكن هذه الحاجة قد تصبح ماسة في حالة ترجمة سلسلة من المقالات والنصوص في الموضوع نفسه، وهذه بالضبط هي الوظيفة التي تخدمها برامج الترجمة المحوسبة، فهي تحفظ هذا المسرد تلقائيًا في كل نص يعمل عليه المترجم ضمن ما يسمى "ذاكرة الترجمة". بعد تعريب المصطلحات الناقصة وتصحيح الجمل المبهمة يستطيع المترجم أن يُسلِّم مسوَّدة لصاحب العمل مع ملاحظات حول أي أجزاء من النص قد تجب مناقشتها أو التدقيق فيها (إن رغب العميل بذلك)، وعلى المترجم أن يتوقع بعد التسليم مراجعةً وطلبات إضافية من صاحب العمل، مثل تصحيحات في الترجمة أو تعديل أمور معينة قبل اعتماد النص النهائي.[46] لا بأس بأن يتواصل المترجم مع صاحب العمل بعد انتهاء المشروع للحصول على تقييمه وملاحظاته الإيجابية والسلبية، وذلك لتحسين أدائه مستقبلًا، كما أن هذا النوع من التواصل يحفظ علاقته مع صاحب المشروع ويزيد من إمكانية حصوله على فرص عمل أخرى مستقبلًا.[47] ومن الأسلم أن يؤرشف المترجم ملفاته النصية ويحتفظ بها بعد انتهاء كل مشروع، فقد يحتاج للرجوع إليها أو الاستشهاد بها في مهنته ومشاريعه القادمة وعرضها في معرض أعماله إن سمح صاحب العمل بذلك.[48] اقرأ أيضًا المقال السابق: اللغة ومفهوم الترجمة بين اللغات فن الترجمة وأنواعها وأساليب الترجمة الحديثة آفات الترجمة على اللغة أدوات الترجمة الضرورية لعمل المترجمين المستقلين
-
كان "محمد بن مكرم بن علي" (المشهور بلقب: "ابن منظور") كاتبًا في ديوان الإنشاء في القاهرة، حيث اشتغل بنسخ وتحرير الرسائل في بداية العهد المملوكي بمصر، وعُيّن -فيما بعد- قاضيًا بمدينة طرابلس الغرب، وكان "ابن منظور" محبًّا للكتب واللغة، ومن أحب أعمالها له اختصار الكتب المطولة، فقيل إنه اختصر "تاريخ دمشق" و"الأغاني" و"العقد الفريد" فقلصها إلى ربعها أو أقل. ولعل هذا الشغف بالاختصار والتسهيل هو ما قاده إلى جمع وترتيب أمهات المعاجم (مثل "تهذيب اللغة" و"جمهرة اللغة" و"المحيط الأعظم" و"الصّحاح")، فوضع -منها- أشهر أعماله وأشهر المعاجم العربية كافة، وهو: "لسان العرب". لقد خدم لسان العرب اللغة العربية خدمة عظيمة دون ريب، إذ يُقدّر ما فيه من من مدخلات بنحو 80,000 مفردة في عشرين مجلدًا، وهذا عدد هائل لمعجم صدر في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر للميلاد ويعادل ضعف ما جمعته كبرى المعاجم العربية قبله.[1] لكن هل ما زال ينفع "لسان العرب" طالب اللغة والترجمة في أيامنا؟ كُتب لسان العرب قبل نحو سبعمئة عام، وتغيرت -منذئذ- طريقة كتابة المعاجم وتصنيفها (بل ووظيفتها) من نواح معتبرة، ولعل كثيرًا من هذا التغير أو معظمه يعزى إلى واحد من أكبر مشروعات اللغة في التاريخ، وهو "معجم أكسفورد" للغة الإنكليزية، وما كان له من بصمة على سائر المعاجم بعده، والتي أثرت على عمل المترجم وأدواته كل تأثير. الأستاذ والمجنون اجتمع في لندن في سنة 1857 لغويون يتشاطرون إحساسًا بأن المعاجم الإنكليزية فيها ضعف وقصور كبير، فوضعوا قائمة بسبع مشكلات جوهرية في تلك المعاجم تستدعي تحديثها وتجديدها،[2] وأجروا دراسة استنتجوا منها أن عدد المفردات الإنكليزية التي غفلت عنها المعاجم أكبر بكثير مما فيها، وبدأ هؤلاء اللسانيون مشروعًا هائلًا لتوثيق جميع مفردات اللغة الإنكليزية مع تقصي أصلها التاريخي وسياقات استعمالها. إلا أن حجم المشروع تجاوز قدراتهم المتواضعة بكثير، فطلبوا من أرقى الجامعات في العالم -حينذاك- أن تحمل الراية عنهم، وهي جامعة أكسفورد. عالم اللسانيات الأسكتلندي جيمس موري، الذي كان له الدور الأكبر في وضع حجر الأساس لمعجم أكسفورد الإنكليزي. - منشورة تحت ترخيص CC BY. المصدر: ويكيميديا كومنز وقد وُظف لإدارة هذا المشروع أساتذة كبار متوالون، وسرعان ما قدم كل منهم استقالته بسبب ضخامة المهمة وصعوبتها الهائلة؛ حتى جاء الدور على الأسكتلندي جيمس موري، وهو مدرس وباحث زعم أنه يتقن عشرين لغة. وقرر موري نشر إعلانات في الصحف البريطانية تناشد عامة الناس لمساعدته بجمع كل ما تصل إليه أيديهم من اقتباسات مكتوبة لأي مفردة إنكليزية، بما فيها: «الكلمات النادرة والبائدة والقديمة والجديدة والغريبة».[3] وأجاب دعوته -طوعًا- ألف شخص في كل يوم؛ فأرسلوا قصاصات فيها شتى الاقتباسات بالبريد، وجُمعت هذه القصاصات في مكتب الأستاذ موري حتى بلغ عددها (بعد أكثر من عشر سنين من العمل) نحو مليونين ونصف مليون قصاصة.[4] كان من أكبر المساهمين بهذه القصاصات طبيب سابق اسمه وليام تشيستر ماينور، فكان يضيف في العام الواحد ما يصل إلى 12,000 مفردة للمعجم.[5] وقد اتُّهمَ ماينور بقتل رجل؛ قبل ذلك بسنوات، لكنه أبرئ من التهمة لتشخيصه بالجنون، وكرس سنين من حياته بعدئذ في جمع اقتباسات لمعجم أكسفورد، فصار صديقًا مقربًا للأستاذ موري ومعينًا له في وضع المعجم، وخلدت قصتهما في كتاب مشهور (وفلم سنمائي لاحقًا) عنوانه: "الأستاذ والمجنون"،[6] فألهما بذلك مشاريع معجمية شتى تبعت مشروعهما. استغرق وضع معجم أكسفورد -من بدايته إلى نهايته- أكثر من سبعين عامًا، لكنه استحق عناءه؛ فأتى بأشمل معجم في تاريخ اللغة الإنكليزية وغير وجه المعاجم وأسلوبها جذريًّا (ولو أنه يتقاسم هذا الفضل مع معاجم فرنسية وألمانية).[7] وما يميز معجم أكسفورد أمران أساسيان: الأول هو شموليته وكماله، فهو يتقصى كل المفردات المعروفة في اللغة بكل وثائقها واستعمالاتها، فيخصص مدخلًا لكل مفردة ويتقصى سائر معانيها بحسب سياقها ويصف اختلافات المعنى الدقيقة في كل سياق. وأما الأمر الثاني فهو إلمامه التاريخي: إذ يقتفي هذا المعجم تاريخ اللغة من أقدم النصوص المعروفة فيها، وينظر في أصول كلماتها مفردة مفردة؛ وفي كيفية تغير استخدامها بمرور الوقت، فيثبت كل معنى من معانيها القديمة والجديدة ويضيف إليها المفردات المستحدثة سنويًّا: ولهذا فهو معجم تاريخي، يغطي الإنكليزية الحديثة من أول أيامها وحتى اللحظة الحاضرة. مثال على واحدة من ملايين القصاصات الورقية التي أرسلها متطوعون للمساعدة في وضع معجم أكسفورد للغة الإنكليزية، وهي قصاصة عليها كلمة "flood" (فيضان). - منشورة تحت ترخيص CC BY. المصدر: ويكيميديا كومنز والمعاجم التاريخية ضرورة في كل لغة، فالمفردات العربية في كتاب "كليلة ودمنة" لا تأتي بنفس معانيها في "صحيفة الأهرام" مثلًا، واللغة العربية في أيامنا ليست مثلما كانت أيام "لسان العرب"، والمعاجم التراثية (رغم أنها كنوز لغوية) لا تصلح للمترجم المعاصر ولا تغنيه. فاللغة العربية بحاجة ماسة إلى معجم تاريخي شامل يجاري العصر، والمعجم العربي الوحيد من هذا النوع -حاليًّا- هو "معجم الدوحة التاريخي"، والذي قد يكون أعظم مشروع شهدته اللغة العربية في الأعوام المئة الأخيرة أو أكثر، على أنه ما يزال في خطواته الأولى من مشواره الطويل المنشود.[8] القاموس أم المعجم؟ يستخدم كثير من الناس (بشكل أو بآخر) القواميس بوتيرة شبه يومية، ومن المعتاد أن يحمل المترجم المبتدئ معه قاموسًا أو يلجأ إلى بدائله الرقمية كلما عرضت له كلمة لا يعرف معناها، حتى أصبح واحدة من أولى أدواته، على أن هذا خطأ جسيم. فالمرجع الحقيقي والوحيد الذي يجدر بالمترجم أن يتسلَّح به في معظم الأحوال هو: إما "معجم أكسفورد" وما يماثله بالإنكليزية، أو معاجم عربية قليلة مثل "معجم الدوحة التاريخي" و"القاموس المحيط"، ودونًا عن القواميس بسائر أنواعها. فلم ذلك؟ معجم الدوحة هو المشروع الوحيد القائم حاليًّا لإنشاء معجم تاريخي للغة العربية. - منشورة تحت ترخيص CC BY تأتي في معجم المورد الحديث التعاريف الآتية لمعاني بعض الأفعال الإنكليزية: "to advance" (يُسرِّع، يُحسِّن، يُعزّز).[9] "to develop" (يوسّع، يطوّر، يُنمّي).[10] "to evolve" (ينشئ، يطوّر).[11] "to further" (يُعزّز).[12] "to promote" (يُرقِّي، يعزّز، يُحسّن، يُسرِّع).[13] ولا يظن القارئ غير المطلع إلا أن هذه الكلمات كلها تعني شيئًا واحدًا تقريبًا: وهو التحسين والتعزيز والتطوير، لكن المطلع قد يعرف أن لها في الإنكليزية معاني دقيقة وسياقات واضحة تختص بكل منها، فإما أن تصف التطور بسياقه الحضاري والعملي؛ أو تطور الكائنات الحية؛ أو التقدم في مشروع؛ أو الترقية في عمل؛ أو الترويج لشيء. ولا يلام القاموس هنا لأن المشكلة ليست فيه، وإنما في فكرة القواميس ثنائية اللغة بكل مكانٍ وزمان. "القاموس" بالأصل "مرادف" للمعجم، لكن الاصطلاح الحديث خص القاموس[14] بالمراجع التي تبين معاني الكلمات في لغتين أو أكثر؛ بتبيان الكلمات المترادفة في هاتين اللغتين، أما المعجم فإنه يعرف معاني الكلمات بلغة واحدة (وغالبًا مع لفظها واشتقاقاتها وأصولها التاريخية). وللغة العربية العديد من المعاجم التراثية والحديثة، ومن أشهرها "لسان العرب" و"الصّحاح في اللغة" و"القاموس المحيط"، وللإنكليزية عشرات المعاجم المشهورة والعريقة مثل أكسفورد وميريام ويبستر[15] وغيرهما. وصناعة المعاجم قديمة وعريقة أما القواميس ثنائية اللغة فإنها جديدة، والجيد منها شحيح، أشهره: "المورد" لمنير البعلبكي. و"مترجم غوغل" المعروف[16] هو -أيضًا- قاموس متعدد اللغات. ومعظم الناس معتادون على الرجوع -عند الحاجة- إلى القواميس الإنكليزية العربية أو العربية الإنكليزية (مثل المورد وغوغل) وليس إلى المعاجم، ولكن الخبر السيئ هنا هو أن قيمة القاموس في عمل المترجم تكاد تنعدم، إلا في تعريب المصطلحات التقنية جدًا. فلعل الهدف الرئيس للقواميس هو مساعدة متعلمي اللغات على التوثق من معاني الكلمات الجديدة عليهم، ولكنها وسيلة غير دقيقة؛ بل ومغلوطة جدًّا لترجمة عمل أدبي أو مهني، والسبب هو أن طريقة عمل القاموس بأكملها قائمة على التقريب والتشبيه بدلًا من تفسير المعاني الحقيقية للكلمات. فالقاموس -في جوهره- هو قائمة كبيرة من الكلمات بلغة أجنبية (كالإنكليزية)؛ مع "مرادفاتها" بلغة ثانية (كالعربية)، إلا أننا أثبتنا مطولًا (في المقال الأول من هذه السلسلة) استحالة ترادف الكلمات والمعاني بين أي لغتين في العالم، وهذا يعني أن القاموس ليس إلا محاولةً فاشلةً وواهمةً لتقريب المعاني للقارئ. فكيف للمترجم أن ينقل معنى نص إلى جمهوره، وهو نفسه يستعين بمصدر قاصر وناقص للمعنى؟ يتفوق المعجم أحادي اللغة بإلمامه الهائل بألفاظ لغته، إذ يستحيل على أي قاموس ثنائي اللغة أن ينافس في هذا المضمار معجمًا أنفقت عليه ملايين الدولارات على مر عشرات السنين، ولا يمكن -بحال- مقارنة "المورد" بـ"أكسفورد" (ولا القواميس العربية الإنكليزية بالقاموس المحيط وغيره). وما يعنيه ذلك هو أن المعجم يتجنب فخ "الترادف"؛ فهو يوثق الوقع الدقيق لكل مفردة بحسب سياقاتها ومعانيها العديدة قديمًا وحديثًا، بدون أن يربطها بمعنى خادع بلغة أخرى. وقد يبدو استعمال المعجم صعبًا قليلًا أول الأمر؛ لأن استيعاب شرح الكلمة في لغة أجنبية يستلزم وقتًا وجهدًا، إلا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة معنى الكلمة ووقعها الحقيقي أثناء الترجمة، وأما اختصار الطريق بمطالعة القاموس فيؤدي -في معظم الأحوال- إلى إساءة في الفهم وأغلاط في الترجمة يتحمل المترجم وزرها عن آلاف القراء. استعمال المعاجم والقواميس الخطوة الأولى التي يباشر بها المترجم حينما تعترضه كلمة لا يعرف معناها؛ هي: إمّا الرجوع إلى معجم معروف في اللغة الأجنبية (للتوثّق من معنى الكلمة) أو إلى معجم عربي (للتوثّق من معنى بديلها أو ترجمتها المقترحة)، كما يمكنه -ويجدر به- الرجوع إلى القواميس الثنائية المتخصّصة بالعلوم والتقنية لتعريب المصطلحات الصعبة، فهذا هو السياق الوحيد الذي تفيد فيها القواميس.[17] وأنصح -شخصيًا- بالبدء من معجم "ويكاموس" أو Wiktionary، وهو معجم يشبه موسوعة "ويكيبيديا" ويحتوي على ستة ملايين كلمة بمئات اللغات، مما يجعله واحدًا من أوسع المعاجم المتوفرة في عصرنا. لعل أشمل القواميس الإنكليزية العربية هو "المورد"، إلا أنه قاموس عام في محتواه ولا يهدف إلى تفصيل المصطلحات التقنية، ولأن أدب المعاجم العربية ما يزال متأخرًا وغير مواكب لتطورات اللغة الحديثة؛ فسوف يحتاج المترجم في الموضوعات العلمية والتقنية إلى الرجوع لقواميس متفرقة ومبعثرة حسب مجال الاختصاص، ومن المستحسن أن تكون صادرة عن مجامع اللغة العربية أو هيئات معتمدة أخرى. تقتصر هذه القواميس عادة على مجال محدد، فتأتي عناوينها على شاكلة: "قاموس الفيزياء العربي" و"قاموس الأحياء المُيسَّر" مثلًا. ومن أهمّ القواميس العربية المتخصصة والمرموقة "المعجم الطبي الموحد"؛ الصادر عن "منظمة الصحة العالمية" و"اتحاد الأطباء العرب"، كما يتوفر في المكتبات كثير من القواميس المتخصّصة بمجالات مثل: التقنية والزراعة والهندسة وغيرها (مع تفاوتها في الجودة والموثوقية). وإذا كنت تترجم موضوعات في مجالات علمية محددة فيفترض أن تشتري قواميس متخصصة تعينك على العمل فيها، على أن تتوثق من مؤلفيها أو ناشريها وتتأكد أنهم ضليعون باللغة العربية وأصولها.[18] المعجم الطبي الموحد (صادر عن منظمة الصحة واتحاد الأطباء العرب). - منشورة تحت ترخيص الاستخدام العادل. المصدر: موقع المعجم وخارج إطار القواميس والمعاجم العربية، يجب على المترجم إتقان استعمال المعجم الإنكليزي والأجنبي، وهذه مهارة أساسية لا يمكن التغاضي عنها: فالمعجم هو رفيقك ومعينك في استيعاب معاني المفردات وسياقاتها ووظائفها اللغوية. واستعمال المعجم يحتاج قدرًا من الممارسة والاطلاع لا يستهان به؛ فتخصص لدراسته مواد دراسية مكتملة في الجامعات، وفيما يلي شرح سريع لمدخلات المعجم وكيفية الاستفادة منها. أجزاء المعجم يحتوي المعجم مدخلًا مفصلًا لكل كلمة في اللغة، ولا شك في أن أهم قسم في المدخلة هو تفسير معنى الكلمة؛ أو معانيها المتعدّدة، ولكن في المعجم كثير من المعلومات المفيدة الأخرى، والتي قد تكون لها قيمة عظيمة في الترجمة؛ وفي التعريب على وجه الخصوص. أصل الكلمة تتضمن المعاجم الإنكليزية الكبيرة تحقيقًا تاريخيًّا في أصل كل كلمة من كلمات اللغة، سواء أكانت كلمة إنكليزية أصلية أم مستعارة من لغة أخرى. فلو بحثت عن كلمة Sugar في معجم أكسفورد ستجد شرحًا لكل شكل تاريخي للكلمة وصولًا إلى أصلها العربي "سُكَّرْ"، ولو بحثت في كلمة Square ستجد أن أصلها يأتي من اللغة اللاتينية. وقد قضى علماء اللسانيات سنين طويلة في بحث أصول الكلمات وطرق استخدامها في الكتب القديمة لجمع هذه المعلومات، وللأسف فإن تقصيها العربي ما زال ضعيفًا ومقتصرًا على الجزء الأول من معجم الدوحة التاريخي. وقد يفيد تقصي أصل الكلمة في تعريبها أو في تحديد خواصها الصوتية. المعنى والاستخدام أهم أجزاء المعجم هو شرح معاني الكلمة مع أمثلة واقتباسات على استعمالاتها، وقد تجد هذا الشرح في القاموس لكنه يأتي موجزًا تنقصه الدقة. فلو بحثت -مثلًا- عن كلمة energy في قاموس المورد تجد أن ترجمتها "طاقة"، ولو بحثت عن كلمة power ستجد أن ترجمتها "طاقة" أيضًا، إلا أن الكلمتين تختلفان في المعنى، والوسيلة الوحيدة لك لإدراك الفرق الدقيق بينهما هي في الرجوع إلى معجم إنكليزي. ولمعظم الكلمات الشائعة في اللغات معان دقيقة عدة، وقد تصل أحيانًا إلى أكثر من عشرة معان للكلمة الواحدة، ولا داعي للفزع إن رأيت مثل هذا العدد الكبير، لأن صانعي المعجم يرتبون هذه المعاني بحسب كثرة استخدامها، وبالتالي ففي العادة فإن المعنيين الأول والثاني منها يتضمنان ما تبحث عنه في الغالب، ولو كان المصطلح متخصصًا فستجد ملحوظة بمعناه في كل مجال من مجالات استخدامه.[19] مثال على أقسام المعجم من مدخلة "species" (نوع حي) في قاموس أكسفورد، وتظهر فيها معاني الكلمة متبوعة بأصلها التاريخي ثم بلفظها الصوتي. - منشورة تحت ترخيص الاستخدام العادل البحث في المعجم معظم المعاجم الحديثة متاحة حاليًا على الإنترنت، فلم يعد من اللازم تعلم مهارات البحث في المعجم لاستخدامها. ويمكن البحث في المعاجم الإنكليزية المطبوعة بسهولة لأن كل الكلمات فيها مرتبة أبجديًا، والصيغة الرئيسية التي قد لا تجدها في المعجم الإنكليزي هي تصريفات الأفعال المضارعة (مثل إضافة -ing في كلمة taking، التي تجدها في مدخل "take"). وأما المعاجم العربية فيختلف أمرها قليلًا، والسبب هو أن للأفعال العربية اشتقاقات كثيرة جدًّا نسبةً إلى غيرها، حيث إن تخصيص مدخلة مستقلة لكل فعل منها قد يكون صعبًا جدًّا، ولهذا السبب يجب الرجوع إلى جذور الأفعال الثلاثية (وأحيانًا الرباعية أو الخماسية) للعثور عليها في المعجم، وقد يحتاج ذلك إلى شيء من الخبرة في الصرف. الأبجدية الصوتية في كل معجم متكامل كتابة للفظ كل كلمة بنظام يسمى "الأبجدية الصوتية العالمية"،[20] وهي أبجدية اخترعها علماء اللغة قبل مئة وثلاثين عامًا لإيجاد وسيلة لكتابة اللفظ الفعلي (وليس التهجئة) لجميع الأصوات في شتى لغات العالم؛ ومن ثم تقصي لفظها الدقيق دون الحاجة لسماعها. وقد لا تكون قراءة الأبجدية الصوتية سهلة في أول الأمر، غير أن تعلمها يعد مهارة عظيمة للمترجم، إذ لن يتطلب اكتسابها سوى ساعات قليلة تنفعك بعدها في قراءة أي كلمة بأي لغة. تتضح فائدة الأبجدية الصوتية في الترجمة حين اقتباس الألفاظ الأجنبية بالنقحرة، أي بنقل لفظها الأجنبي إلى اللغة العربية (نقلًا حرفيًّا)، وهو ما قد يصادفه المترجم كثيرًا في نقل أسماء الأعلام والشخصيات، التي قد تكون لها أصول من لغات عديدة وألفاظ غير مألوفة. وتختلف اللغة الإنكليزية عن العربية بأنها لا تلفظ دومًا مثل ما تكتب، ففيها كثير من الحالات التي لا تتبع اللفظ القياسي، وتعينك الأبجدية الصوتية على تجاوز المشكلة. وكثيرًا ما يكون سبب الشذوذ في اللفظ هو أن أصل هذه الكلمات من لغات أخرى، مثل "croissant" ذات الأصل الفرنسي التي تلفظ في الإنكليزية: "كْرْوَاسَانْ" (بمد طويل، وتهجئتها تحاكي تهجئة الكلمات الفرنسية). تحتوي الأبجدية الصوتية العالمية ما مجموعه 107 حروف صائتة وصامتة و52 إضافة لفظية، وربما يختلف رسم هذه الحروف من معجم إلى معجم بدرجة بسيطة لذا عليك التوثق منها (ولو أن معظمها تبقى موحدة بين المعاجم). وتكتب الأبجدية الصوتية بأحرف لاتينية محصورة بين شرطات مائلة، ولفظها مقاربٌ غالبًا -وليس دائمًا- للفظ هذه الحروف المألوف لنا في اللغة الإنكليزية، فكلمة knight تكتب في الأبجدية الصوتية بصورة: /Na:It/ (أي: "نَايْت")، وكلمة "بَيْت" باللغة العربية بصورة: /baIt/. وهذه أمثلة بسيطة قد تنجح في قراءتها دون الحاجة لأي تدريب، إلا أن قراءة الأبجدية قد تحتاج تدريبًا أكثر كحال اللفظ البريطاني للـ"كرواسان"، فهو: /ˈk(ɹ)wæsɒ̃/. رسم يوضح رسم كثير من حروف العلة بالأبجدية العالمية بحسب مخارج لفظها (ليست كل هذه الحروف شائعة ولا ضرورية للمترجم بالضرورة). - منشورة تحت ترخيص CC-BY. المصدر: ويكيبيديا من الصعب تخصيص مساحة من هذا الكتاب لتلقين كيفية قراءة الأبجدية الصوتية (ولو أن مراجعها كثيرة على الإنترنت)، لذلك يقتصر هذا القسم على جدول فيه مقدمة متواضعة لأهم الحروف الصوتية في اللغة الإنكليزية. ومعظم الحروف الصامتة تكتب بتهجئة مماثلة للفظها المألوف باللغات الأوروبية، فمثلًا: حرف /n/ لفظه مثل النون بالعربية، و/m/ يماثل الميم، وهلمّ جرا. لكن في الأبجدية العالمية حروفًا إضافية ربما لا تألف شكلها، ومن أهمّها: table { width: 100%; } thead { vertical-align: middle; text-align: center; } td, th { border: 1px solid #dddddd; text-align: right; padding: 8px; text-align: inherit; } tr:nth-child(even) { background-color: #dddddd; } الشكل (في الأبجدية الصوتية العالمية) مثال بالإنكليزية اللفظُ العربي ɸ Focus ف θ Thin ث ð This ذ ʃ She ش ʒ Joy ج x Loch خ q - ق ɣ - غ وأما الصوائت (أي حروف العلة) فهي أكثر تعقيدًا بقليل، لأنها تختلف كثيرًا من لغة إلى لغة، والصوائت الإنكليزية أكثرُ من العربية، لذا يستصعب البعض تعلمها. ومن أهم الصوائت في قراءة الكلمات ما يأتي: table { width: 100%; } thead { vertical-align: middle; text-align: center; } td, th { border: 1px solid #dddddd; text-align: right; padding: 8px; text-align: inherit; } tr:nth-child(even) { background-color: #dddddd; } الشكل (في الأبجدية الصوتية العالمية) اللفظُ العربي i كسرة u ضمة a فتحة _____ اقرأ أيضًا المقال التالي: آفات الترجمة على اللغة المقال السابق: تعريب المفردة والمصطلح
-
من كل سبعة كتب منشورة سنويًّا في البلاد العربية كتاب مترجم على الأقل،[2] وهذه نسبة لا يستهان بها، ولها تأثير غير معلوم على الأمد البعيد، خصوصًا إذا ما قورنت بنسبة الكتب المترجمة عن لغات أخرى إلى الإنكليزية، والتي تتراوح بين 2.5 إلى 3% من سوق النشر الأمريكي فحسب. ولا تقتصر تداعيات هذه المشكلة على كثرة الكتب الأجنبية، بل إن لها تبعات اقتصادية أيضًا، إذ يحصد مؤلفو الكتب الإنكليزية جل أرباح الطباعة والنشر في أرجاء العالم لكثرة ما تترجم كتبهم إلى اللغات الأخرى (بما فيها العربية)، وأما المؤلفون العرب والشرقيون -وغيرهم- فلا يحصدون إلا القليل الهزيل. كما أن للمشكلة أبعادًا ثقافية: فأهل اللغة الإنكليزية قادرون على نشر أعرافهم وثقافتهم بكتبهم وآدابهم دون أن يتلقوا -في المقابل- شيئًا يذكر من ثقافات العالم الأخرى،[3] فهم يكتبون باللغة الأصل لنصف الترجمات المنشورة في العالم حاليًّا، لكن الإنكليزية تستقبل من اللغات الأخرى 6% فحسب من الترجمات المنشورة عالميًّا. ويعبّر اختلال النسب المذهل هذا عن تأثير لغوي وثقافي عظيم للسان الإنكليزي منفردًا على العالم أجمع،[4] ويخشى كثيرون -بسببه- أن الإنكليزية صارت خطرًا يتربص بكل لغة وكل ثقافة سواها. نسبة الأوراق البحثية المنشورة بالإنكليزية؛ مقارنة بالأوراق المنشورة باللغات الرسمية لثماني دول عالمية (منذ عام 1996 إلى 2011). - المصدر: Research Trends العربية المتغيرة أمسى برج خليفة منذ سنة 2010 أعلى "ناطحة سحاب" في العالم، فهو أطول بمرة ونصف من أي ناطحة سحاب سبقته (بارتفاعه الذي يتجاوز ثمانمئة متر)، على أن العرب لم يعرفوا ناطحات السحاب لأمد طويل، فأولاها بنيت في الخليج في عقد التسعينات،[5] بل وإن مهد هذه البنايات الشاهقة -عالميًا- فكان في نيويورك في سنة 1857.[6] ولهذا السبب كانت الإنكليزية أول لغة تبتدع كلمة تصف هذه البنايات، وذلك بنحت لكلمتي "sky" ("سماء") و"scraper" ("قحَّافة")، وانتقل هذا المعنى حرفيًّا إلى لغات كثيرة جدًّا، منها: الفرنسية والإيطالية والبرتغالية[7] والعربية ("ناطحة سحاب")، ويسمى هذا النقل الحرفي للمفردات -بين اللغات- "المحاكاة" (calquing)، كما يقال لها أحيانًا "النُّحل"[8] أو "التوطين"،[9] ومعناها: استنساخ الكلام بمعناه الحرفي بين اللغات، وهذه ظاهرة سائدة في عصرنا بكل مكان وكل لغة. لا تقتصر المحاكاة على الكلمة المنفردة، بل قد تُحاكى ألفاظ وأمثال وجمل متكاملة، ومن أمثلة الجمل المحاكاة -غالبًا- التي تكثر حديثًا: "ليس بعد الآن" (not anymore)،و"صنعتُ صديقًا" (made a friend)، و"هيا يا صاح" (come on dude)، و"اذهب إلى الجحيم" (go to hell)، وهذه كلها تُرجمت إلى اللغة العربية حرفيًّا؛ وليس بالمعنى، فذاعت على ألسنة الناس. وأظهرت دراسات على لغات أخرى (منها البرتغالية)؛ أن هذا النوع من المحاكاة قد يبدأ من الكتب المترجمة ترجمةً حرفيةً، ثم ينتقل إلى اللغة فيصبح ظاهرةً طبيعيةً فيها،[10] مثلما نرى في الأمثلة التي وردت أعلاه: فهي أمثلة لا تقتصر على الترجمة وإنما تجدها -كذلك- في الكتابات العربية الأصيلة والحوارات العامية، مما يعني أنها تغلغت في اللسان العربي، بل وتغلغلت -معها- ثقافة كاملة ألِفها الناس ووقعوا تحت تأثيرها، فلم يمانعوا في العادة من محاكاتها حرفيًّا بهذا الأسلوب.[11] سنة التغير ربما تدخل عشرات أو مئات الكلمات الأجنبية على أي لغة في فترة حياة الإنسان، ولكن من المستبعد أن تتغير قواعد هذه اللغة النحوية والصرفية في حياته، فهذه التغييرات تستغرق أمدًا طويلًا، ومن الأسلم -إجمالًا- أن يبقى النحو والصرف وقواعد اللغة شبه ثابتين بمرور الزمن (ما عدا ما تقتضيه "الضرورة الشعرية"، كما يُقال).[12] لكن بعض قواعد وأصول العربية -وغيرها من اللغات- ربما تكون في حالة تغير سريع ومنهجي بسبب الترجمة والعولمة، وهو تغير يتناقض مع موروثها الثقافي، إذ يقول في ذلك جرجي زيدان:[13] وإقحام التعابير الدخيلة على اللغة هو أمر لا بد منه، فتاريخ كل لغة في العالم قائم على التبادل والتلاقُح المستمر مع لغات أخرى تؤثر فيها بمفرداتها وأفكارها، ولكن الإكثار من الدخيل -بتسارعه الحالي- قد يؤدي إلى ركاكة الكلام، فيمسي وكأنه غير عربي أو كأنه «أعجمي مكتوب بكلمات عربية». وحسب زيدان فإن اقتباس الكلام الأعجمي من مكملات الحديث: «وإذا عده بعض اللغويين فسادًا في اللغة فلأن بعض كتابنا يبالغون في ذلك الاقتباس». من علامات التغيير التي لاحظها باحثون كثر؛ أن الترجمات العربية أصبحت تستنسخ بناء الجملة الإنكليزي الذي يتّسم بالجمل القصيرة المتوالية (بدلًا من الجملة الطويلة، وسنأتي على ذلك في فصل "تعريب الجملة")، كما تستنسخ -هذه الترجمات- أدوات الربط الأجنبية بين الجمل؛ مثل "بالرغم من" و"في حين أن كذا.. لكن كذا"،[14] وهذا يغاير أسلوب التعبير العربي الذي تغلب فيه الجمل الطويلة المتتابعة الموصولة بالواو والفاء. ومما يثبت أن هذه السمات دخيلة هو أنها تستفحل في النصوص المترجمة، وليس في النصوص العربية الأصيلة، بل وأنها تكثر في المؤلفات العربية الحديثة،[15] وهو ما يدل على أن تأثير اللغات الأجنبية قد تغلغل في العربية فغير أصلها لا ترجماتها فحسب. وهذه ليست حال العربية وحدها، بل تثبت دراسات عديدة وقوعها في شتى اللغات، ومنها -مثلًا- دراسة أظهرت أن الجمل الإنكليزية القصيرة تغلغلت في الكتابة الأكاديمية البرتغالية وحلت مكان الجمل المركبة الطويلة (وهي السائدة في الأدب البرتغالي سابقًا). وهذا ليس إلا مثالًا متواضعًا على ظاهرة تقع في سائر لغات العالم بخواصها كافة. لكل لغة طريقتها في الوصف والتعبير، مثل أسلوب الانتقال بين جملة وأخرى وتدفق الكلام والفقرات، وحتى ولو نجح المترجم -كل النجاح- بتعريب الكلمات وترجمة الجمل؛ فقد لا ينجح في سبكها معًا في فقرات وصفحات وفصول يستوعبها القارئ، فالكتابة هي فن تختص به كل ثقافة ولغة عن سواها.[16] ويتسم أسلوب التعبير العربي -مثلًا- بأنه يعتمد على تكرار الكلام وهيئته عدة مرات بقصد التوكيد، وهو ما يراه الإنكليز حشوًا مزعجًا لأنهم يفضلون الاختصار والتحديد في الكلام،[17] وحسبما نرى، ربما يمحو التأثير الناجم عن الترجمة الخاصية البلاغية للعربية؛ ويستبدل بها الأسلوب البلاغي الإنكليزي. يرى كثير من الباحثين أن كل ترجمة تتأثر بعادات وأعراف سائدة بين المترجمين، إذ إنهم يعتادون على ترجمة كل تعبير أجنبي معروف إلى اختيار تلقائي ثابت، دون تمعن فيه. [18] على سبيل المثال: من المعتاد في الإنترنت العربي المعاصر ترجمة جملة من نوع "Directed by" إلى "تم إخراجه بواسطة.." (كما سيأتي فيما بعد)، ومهما كان سياق هذه الجملة فإن ترجمتها العربية تظل ثابتة، إذ ترجع هذه الترجمة إلى أعراف الترجمة السائدة عربيًا، وفي تعبير "تم بواسطة" محاكاة حرفية لأصله الإنكليزي، وهذا النوع من المحاكاة يفسد اللغة ويُغرِّبها. وقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن 26% تقريبًا من الجمل الواردة في اللغة البرتغالية أصبحت محاكاة حرفية -جزئيًّا أو كليًّا- لجمل إنكليزية،[19] ومن يدري كم تكون نسبة هذه الجمل في كلامنا العربيّ؟ رأينا في الفصل السابق أن من الصعب -بمكان- حسم الصراع التاريخي بين الترجمة الحرفية والترجمة بتصرف، على أن لدينا -في هذا السياق- عاملًا يساعد المترجم على الميل نحو إحدى هاتين الجهتين: وهو أن منزلة اللغة الإنكليزية تمنحها (بترجمة حرفية أو دونها) تأثيرًا غير متكافئ على سائر اللغات في عصرنا الحاضر، وخصوصًا للغات القليلة الانتشار أو المتأخرة علميًّا وتقنيًّا، وتعيش هذه اللغات (ومنها العربية) خطر طغيان الترجمة على أدبها الأم، وفي هذه الظروف تتطلع اللغة بشتى كتابها وأدبائها إلى الترجمة و"الاستيراد" لتكوين أسلوبها وهويتها، وهذا خطر يزيل تبريرات الترجمة الحرفية في سياقنا، بل وربما تبريرات الترجمة بأسرها. الدول التي تأتي منها الغالبية العظمى من الكتب المترجمة المنشورة في الولايات المتحدة. - المصدر: Quartz لغات راقية قال الكاهن الفرنسي بيير دانييل في عصر النهضة: «[إن الترجمة] هي نص مكتوب بلغة ذات صيت ليجسد نصًا كتب بلغة ليس لها صيت»،[20] ويبين قوله هذا وجهة النظر الغربية تجاه الترجمة: فالأوروبيون يترجمون آداب الصين والهند والفرس والعرب وجميع اللغات من باب الفضول والاطلاع، وأما في لغات هذه الشعوب -ومنها العربية- فتنعكس الآية، إذ إن الترجمة عندنا ضرورة لا اختيار، ودافعها نقل علوم ومعارف أساسية لا ما يبعث على "الفضول" أو المتعة. ولهذا يظن بعض الباحثين أن الترجمة فعل يرفع موضوعها إلى منزلة متميزة متألقة، فهي تدل -ضمنيًا- على أن النص الأجنبي لا بديل له[21] باللغة العربية، فيلزم استيراده من لسان أعجمي أعلى منزلة منها. اقترح إيفن زوهار في عام 1978 نظرية تصف هذه المسألة؛ اسمها: "نظرية الأنظمة المتداخلة"، والمقصود من اسمها أن العلوم الإنسانية هي "نُظُمٌ" تتداخل، فيتمزج فيها الأدب مع الثقافة والتاريخ وعلم الاجتماع في منظومة مشتركة دائمة التقلب؛[22] إذ تتقلب الميول والأذواق في الإنسانيات حسب أهواء لا تتبع معيارًا ثابتًا، وتتنافس ضروب الأدب دومًا لإرضاء هذه الأهواء، فما كان رائجًا قبل ثلاثين عامًا -مثلًا- ربما لم يعد رائجًا اليوم، ولن يبقى الرائج الآن على رواجه مستقبلًا.[23] وتقول نظرية الأنظمة المتداخلة: إن ذوق كل لغة وثقافتها يجب أن يعطي للأدب المترجم منزلة أقل من الأدب الأصيل، إلا لو وقعت حالات استثنائية ترفع الأدب المترجم إلى منزلة أعلى من غيره في الذوق للعام. ومنها ثلاثة استثناءات كبرى تدعو إلى رفع مقام الأدب المترجم:[24] أن أدب اللغة جديد وحديث العهد، فيسعى للتعلم من لغات أنضج منها وأبلغ. أن أدب اللغة ضعيفٌ ناقص، فيسعى لتعويض نقصه من غيره. أن أدب اللغة في تطور لا يشبعه القديم، فيبحث عن الجديد لدى غيره. ولا شك في أن اللغة العربية تعيش -الآن- زمنًا ارتفعت فيه منزلة الأدب المترجم، فيتهافت عليه القراء أكثر من أدبها الأصلي، بل إن كثيرًا من جمهور القراءة العربي اتجه حديثًا نحو قراءة الكتب الأجنبية بلغتها الأصلية؛ بدلًا من قراءتها مترجمةً، وهذا يعني أن الثقافة الأجنبية تفوَّقت في منزلتها على الثقافة العربية على كل صعيد. فأي من الحالات الثلاث -أعلاه- هو السبب فيما وقع؟ من الأكيد أن الأدب العربي لا يقع ضمن الحالة الأولى؛ لأنه موغل في القدم، ولكن من المحتمل -وما يستدعي البحث- أنه قد يقع في حالة من الحالتين الأخريين، أي أنه يحاول تعويض نقصه أو التجديد من غيره. ومن أمثلة ذلك أن تراث العرب تغلب عليه فنون منها الشعر والخطابة؛ بينما ليس فيه سرد قصصي يذكر. على أن معظم الإنتاج الفني والأدبي الحديث صار متمحورًا حول القصة، فتتصدره الروايات وسيناريوهات الأفلام ومسلسلات التلفاز، وهذه كلها فئات أدبية جديدة على الثقافة العربية، فتضطر لاستيرادها من غيرها من الثقافات لتعويض نقصها. ولهذا تختلط في الأسلوب الأدبي العربي الحديث سمات كثيرة منقولة من الإنكليزية والفرنسية وغيرها من اللغات، وتدخل في هذا فوارق القوة والسلطة التي تناولناها في نظرية الترجمة ما بعد الاستعمارية: إذ إن لغات الأمم الاستعمارية لها منزلة أعلى عالميًّا من لغات الأمم المستعمرة (مثل العربية). ويظن بعض الباحثين[25] أن لغات العالم كلها -بما فيها لغات أوروبا- تعيش حاليًّا صراعًا غير عادل[26] مع «اللغة الاستعمارية الكبرى السائدة في زماننا، وهي الإنكليزية».[27] لكل لغة قدرة على الصبر والاحتمال للترجمة، ومن الأنفع بعدها الانتقال نحو الكتابة والتأليف الأصلي، حتى ولو كان في الموضوعات نفسها والعناوين ذاتها، فهو يأتي أصيلًا عربيًّا لا في سلامة اللغة وحدها بل في يسر وسهولة الفهم، ويشيد البعض بنجاح العرب في تلافي تهديدات الترجمة على لغتهم أثناء حركة الترجمة العباسية، فزادوا (كما يقول علي النملة) في «التأليف على التعريب»،[28] لكن التأليف يقل الآن ويخبو على حساب الترجمة الكاسحة. ويجدر بنا، نتيجة لهذا التأثر غير المتوازن والسباق الذي تخسره اللغة العربية -وغيرها- مع العولمة، أن نميل نحو الترجمة بتصرف بدلًا من الترجمة الحرفية، وأن نتجاوز عن شيء من آراء الباحثين الذين يشجعون الترجمة الحرفية لأن كلامهم موجه نحو لغة العولمة نفسها (وهي الإنكليزية) وليس للسياق المتأثر بها. ولهذا فسوف نتناول في الفصول الآتية الترجمة من منظور الأقلمة والتعريب بلسان وثقافة يفهمها القراء العرب وتقترب من قلوبهم، وهو المنهج الذي تدعو إليه هذه السلسلة بعمومها. _____ اقرأ أيضًا المقال التالي: بين الحرفية والتصرف: تاريخ موجز لنظرية الترجمة المقال السابق: من لسان العرب إلى أكسفورد: المعاجم والقواميس وأهميتها في الترجمة
-
يصطف أمام أبواب متاحف مدينة فلورنسا الإيطالية في معظم الأيام (أو في أيام عملها) مئات ينتظرون دورهم للحصول على تذكرة دخول، وقد يتحرَّق هؤلاء المنتظرون شوقًا لرؤية لوحات ومنحوتات فنانين طليان بلغت شهرتهم أبعد أصقاع الأرض، كما أن من المحتمل أن انتظار الزوار سيدوم ساعات عدة تنتهي بنفاد التذاكر (مثل حال معظم الوجهات الإيطالية الشهيرة). ومما يلفت النظر في اللوحات التي تغص بها متاحف فلورنسا -وغيرها- كثرة ما تتكرر فيها مشاهد متشابهة لرسامين مختلفين، ومن أغربها؛مشهد محبوب يظهر فيه قس بصحبته أسد. تقول القصة: إن هذا القديس اسمه جيروم، وأنه ارتحل إلى بادية الشام ليختلي بنفسه وينكب على دراسة الإنجيل متخليًّا عن ترف الحياة وملذاتها الزائلة، فقابل أسدًا بريًّا جريحًا؛ حيث عالج قدمه بإخراج شوكة منها، فظل الأسد منذئذ رفيقه الأليف. وقد نالت هذه الخرافة عن القسّ جيروم إعجاب كثير من كبار الفنانين الطليان،[1] ولو أن الإنجاز الحقيقي الذي اشتهر به القسّ هو ترجمته للكتاب المقدس من اللغتين العبرية (للعهد القديم) واليونانية (للعهد الجديد) إلى اللاتينية، واللتين وضع فيهما أول حجر أساس لنظرية الترجمة. لوحة "القديس جيروم" بصحبة أسد في بادية الشام، رسمت نحو عام 1450م ومعروضة في متحف ببيرمنغهام. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز اللفظ والمعنى ظهرت الحاجة للترجمة منذ بدأ الناس بالاتصال بعضهم ببعض؛ سواء للتجارة أو الترحال أو نشر الدين أو المفاوضة في السياسية والحروب، فكان عليهم أن يجدوا طريقة ليفهم بعضهم كلام بعض. ومن آثارها الموغلة في القدم في البلاد العربية "حجر رشيد" الشهير في مصر، والذي كان مفتاح علماء الآثار المستشرقين لفهم اللغة الهيروغليفية، فهو نصب حجري نحت سنة 196 قبل الميلاد (أيام الملك اليوناني بطليموس الخامس)، وكتب عليه خطاب واحد بثلاث لغات تاريخية، هي: الهيروغليفية والديموطيقية والإغريقية.[2] وأما "نظرية الترجمة"، أي محاولة وضع أساس علمي ومنهجي لترجمة المعنى بين اللغات، فنشأت في فترة قريبة من تاريخ نحت الحجر، فكان مهدها في مناظرات بين الفلاسفة الرومان والإغريق. إذ نشر الفيلسوف الروماني الشهير شيشرون في عام 46 قبل الميلاد ترجمة من الإغريقية إلى اللاتينية لكتاب عنوانه "عن أفضل الخطباء"،[3] وقدم فيها ملخصًا مختصرًا عن منهجه الذي كان -غالبًا- من أوائل المناهج النظرية في الترجمة في التاريخ. ويقول شيشرون: إنه تعمد في ترجمته نقل "أسلوب الكاتب وروح لغته"،[4] وذلك على عكس جل مترجمي عصره: فهم لم يكونوا يعرفون منهجًا في الترجمة سوى ما نسميه الآن "الترجمة كلمة بكلمة"، أو "الترجمة الحرفية". التزم القس جيروم بمنهج شيشرون بعده بمئتي عام، فأكمل ترجمة الإنجيل إلى اللاتينية في عام 395م، وقال جيروم عن هذه الترجمة في رسالة له: «لست متحرجًا من الإقرار (بل والإعلان صراحةً) بأني آثرت أن أترجم الكتاب المقدس من اليونانية معنى لمعنى، وليس كلمةً لكلمة». وكانت ترجمة الإنجيل هذه؛ هي الحدث الفاصل في ولادة أول خلاف كبير في تاريخ الترجمة: وهو الخصومة بين مدرسة الترجمة الحرفية والترجمة بتصرف، أو الخلاف بين الأسلوب والمقصد، لأن الإخلاص في نقل أسلوب الكتاب الأصلي (وهو هنا كتاب مقدس) عادةً ما يُعسِّرُ فهم المعنى على القارئ.[5] السياسي الروماني "شيشرون"، الذي كان من الرائدين في منهج الترجمة بتصرّف. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز ومنذ ذلك الحين والترجمة متمحورة حول هذين المنهجين المتضادين، واللذين أعيد طرحهما مرارًا بطرق جديدة. وربما يعجز المترجمون أبد الدهر عن الوصول إلى حل لهذه المعضلة، إذ من المستحيل دحضها بأي جواب دامغ يصلح لكل حال وزمان، على أن التبحر فيها قاد الباحثين إلى نظريات كثيرة أثرت الترجمة وأغنتها. ولد الصراع المتأصل بين الترجمة الحرفية والترجمة بالتصرف[6] في زمن القس جيروم (منذ ألفي عام تقريبًا)، وذلك بسبب المعضلات الشائكة التي ألمت بتراجمة الكتاب المقدس والتراث اليوناني، فوجد هؤلاء أنفسهم في حيرة بين الإخلاص المبالغ فيه لتلك الكتب المقدسة -حينذاك- وبين ترجمتها بلغة يفهمها عامة الناس.[7] وسرعان ما وقع معهم في هذا المأزق المترجمون الصينيون، حينما هم أولئك بنقل التعاليم الدينية البوذية،[8] ثم العرب والسريان والفرس حين نقلوا كتب اليونان،[9] ولعل هذا الصراع وصل ذروته منذ خمسمئة عام بسبب: "مارتن لوثر".[10] ترجمة الكتاب المقدس: من عام 1522 إلى 1970 تنقسم الديانة المسيحية (مثل معظم الأديان الكبرى) إلى طوائف عدة، أكبرها هي الكنيسة الكاثوليكية، ورئيسها البابا الذي يقيم في مدينة الفاتيكان بروما، ويعتنق الكاثوليكية معظم سكان إيطاليا وفرنسا وجميع سكان البلاد الناطقة بالإسبانية والبرتغالية، وتليها -بعدد أتباعها- الكنيسة البروتستنتية، التي يتبعها معظم سكان الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا والدول الإسكندنافية. ويلتحق بهاتين الكنيستين أكثر من ثلاثة أرباع المسيحيين في العالم، أي نحو ملياري إنسان.[11] ومن تسبب بانقسام المسيحية إلى هاتين الطائفتين هو قس ألماني عاش في القرن السادس عشر، وخالف تعاليم الكنيسة حتى حكم عليه بأشد عقوباتها حينئذ (وهي عقوبة الإقصاء الاجتماعي)،[12] وكانت إحدى مخالفاته الأولى أنه تجرأ على ترجمة الكتاب المقدس من اللاتينية إلى الألمانية العامية، وهي ما يقال عنها: أنها «أهم ترجمة للكتاب المقدس في التاريخ».[13] ارتكب مارتن لوثر مخالفته لسبب مهم، وهو أن اللاتينية كانت في زمنه -وما تزال- لغة راقية لا يتحدث بها إلا علية القوم؛ ممن يتلقون أحسن تعليم وثقافة، على أن الكنيسة الكاثوليكية لم ترض بأن يدرس الكتاب المقدس بلغة سوى اللاتينية، لأن اللاتينية موروثة عن الإمبراطورية الرومانية فاكتسبت -لذلك- منزلة مقدسة، بينما اعتبرت الألمانية وقتها لهجة عامية لا تصلح للأدب والكتب المقدسة (وهي نظرة مماثلة -تقريبًا- للرأي المعتاد نحو اللهجات العربية في عصرنا). وعدا عن ازدراء اللغة الألمانية كأساس لترجمة الإنجيل، كان التصرف بالترجمة -آنذاك- مثارًا للكثير من الخلافات العقائدية في أوروبا، فقد وضعت الكنيسة قيودًا كثيرةً على ترجمة الإنجيل إلى اللغات العامية خوفًا من العبث بكلام الله أو المساس به، وكانت الترجمة لأي لغة غير اللاتينية سببًا لسُخط الكنيسة، إلى درجة أن بعض المترجمين قضوا نحبهم إثر تجرؤهم عليها.[14] ومن هنا أتت أهمية عمل "مارتن لوثر"، فقد أحدث ثورة فكرية واسعة إثر جرأته في ترجمة الكتاب المقدس إلى الألمانية في عام 1522.[15] وقال "مارتن لوثر" إن الأولوية في الترجمة تقريب النص لأذهان القراء، وليس الحفاظ على دقة أسلوبه وكلماته (حتى وإن كان كتابًا منزلًا من الله)،[16] ولذلك لم يجد رادعًا من أن يستبدل بكثير من آيات الإنجيل أمثالًا شعبية وجد أنها أقرب إلى قلوب الألمان من الأمثال القديمة التي في الإنجيل، قائلًا في ذلك: «عليك أن تسعى إلى السيدة في منزلها والطفل في شارعه والرجل البسيط في الأسواق وتنصت إلى كلامهم، ثم أن تترجمَ الكلام إلى مثله، فحينها سوف يفهمونك ويقرون بأنك تحدثهم بلسان ألماني».[17] أول نسخة من الكتاب المقدس بالألمانية، من ترجمة "مارتن لوثر" في عام 1534. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز. الانحياز للقارئ ناصب "مارتن لوثر" الترجمة الحرفية العداء، وتبعه في رأيه كثيرون في عصر النهضة حتى بالغوا في التصرف والتطرف، ومن أمثلة ذلك الشاعر "أبراهام كاولي"، الذي كان يرى أن من المحتم ضياع جمال النصوص الأدبية (مثل: القصائد والأشعار) عند تنقلها بين لغة وأخرى، وبالتالي فإن من حق المترجم أن يأخذ حريته بحذف بعض من الأبيات وإضافة غيرها وتعديل الموجود منها من وحي إبداعه وابتكاره؛ وذلك لأنه يسعى إلى ترجمة الكلام كما «لو كان كاتبه يعيش بيننا الآن».[18] وهذا رأي مبالغ فيه ويؤدي إلى معضلة أخلاقية، هي التقول على لسان المؤلف عندما ينسب إليه كلام لم ينطق به ولم يكتبه. وكرد فعل على هذا المنهج، وضع الشاعر الإنكليزي ذائع الصيت "جون درايدِن"؛ وهو شاعر البلاط الإنكليزي الأول في التاريخ، التصنيف الآتي لطرق الترجمة في عصره:[19] النقل الحرفي (Metaphrase): الترجمة كلمة بكلمة، مع التزام حرفي بمفردات الأصل وتراكيبه اللغوية. النقل بتصرف (Paraphrase): ترجمة المقصد، ولو أعيدت صياغته بمفردات جديدة تفيد المعنى نفسه. التقليد (Imitation): تقليد للنص الأصلي في معناه وأسلوبه عامة، ولكن دون التزام دقيق لا بكلمات المؤلف ولا بالمعاني التي قصدها. وكان "درايدن" شاعرًا فذًّا ترجم أعمالًا أدبية شهيرة، من أهمها: ملحمة الإنيادة للشاعر "فيرجل" والتي يقول في ترجمته لها أنه حاول قدر الإمكان: «جعل "فيرجِل" ينطق بالإنكليزية كما لو أنه عاش بيننا في إنكلترا -في زمننا الحالي- ونطق بالإنكليزية»، ويقتبس عنه كثيرون هذا المبدأ الشهير لأنهم يرون فيه تعريفًا مثاليًّا للترجمة المتقنة. انجرف المترجمون الأوروبيون بدءًا من نهاية القرن الثامن عشر نحو هذا المبدأ، فاهتموا بالكتابة بلغة يسيرة على القارئ حتى ولو ضحوا في سبيل ذلك بأسلوب المؤلف الأصلي. ويقول الإنكليزي "ألكسندر تايتلر" في تعريف الترجمة الجيدة أن القارئ العادي: «يجب أن يفهمها ويشعر بها كأنها لغته الأمّ، مثلما يشعر قراء النص الأصلي وهم يقرؤونه بلغتهم».[20] القرن العشرون جلب القرن العشرون جيلًا جديدًا من المترجمين بأفكار جديدة، وفي طليعتهم الألماني "فريدريك شلايير ماخر" الذي اقترح تقسيم الترجمة إلى فئتين أساسيتين: وهما الترجمة التجارية والترجمة الأدبية. وقد كانت وجهة نظر "شلايير ماخر" أن الترجمة الأدبية فيها معضلة واحدة كبيرة: وهي المفاضلة بين تكريسها للكاتب الأصلي؛ وذلك بحفظ أسلوبه وإبداعه حين نقل كلماته حرفيًّا، أو تكريسها للقارئ؛ وذلك بتقديم ترجمة مفهومة وبلغة مماثلة لما يتحدث به عامة الناس.[21] وتظهر هذه المعضلة في ترجمات الأدباء الأوروبيين للكتب التاريخية المهمة، مثل الكتاب المقدس والإلياذة والأوديسة، إذ تعمد بعض المترجمين نقل هذه الكتب بلغة عتيقة في ألفاظها للحفاظ على طابعها التراثي، بينما فضل آخرون نقلها بلغة إنكليزية سهلة تشبه حديث الأصدقاء فيما بينهم. ولكن المفارقة أن رأي "شلايير ماخر" في هذه المسألة يتناقض مع كثيرين ممن سبقوه، فهو يقول: إن علينا أن «نُقرِّب القارئ إلى أسلوب المؤلف»، أي أن تصون الترجمة الأصل بحرفيته وغرابته اللغوية. ويرى بعض الباحثين أن نظرية "شلايير ماخر" كانت النظرية الأعمق أثرًا في دراسات الترجمة حتى نهاية القرن العشرين، وربما يظهر تأثيرها على معظم ما تبعها من نظريات ودراسات.[22] ريدريك شلايير ماخر، وهو من أكبر المؤثرين في نظرية الترجمة الحديثة. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز وجاء بعد "شلايي ماخر" بعدة أجيال مترجم كبير آخر اسمه "يوجين نايدا"، وهو عالم لسانيات أمريكي كُلفَ بترجمة الكتاب المقدس، وأراد -في سبيل هذه المهمة- وضع منهج قياسي يسير على خطى العلوم الطبيعية.[23] ويتميز "نايدا" بأنه تخلى عن فكرة كانت متأصلة في تاريخ الترجمة/ فأقر باستحالة "الترادف" بين اللغات بين مفرداتها،[24] ولحل هذه المشكلة اقترح "نايدا" نظرية تسعى لتحقيق "الترادف" أو "التكافؤ" بطريقة تتجاوب مع سياق الكلام وموضعه. وقد اقترح في ذلك نوعين من التكافؤ يذكراننا بخلاف الترجمة التاريخي، وهما:[25] تكافؤ الأسلوب (Formal Equivalance): وهدفه الأول نقل أسلوب النص وشكله وجماله. وتغلب على هذا النوع من الترجمة الحرفية استعارة التراكيب والتعابير اللغوية الأجنبية، ويبدو هذا الأمر غير محبذ، ولكن له مميزات كبيرة: منها الحفاظ على أسلوب المؤلف (بدرجة ما)؛ وكذلك على العناصر الثقافية في النص. فمن يتبع هذا المنهج يترجم الأقوال المأثورة الفرنسية حرفيًّا -مثلًا- عوضًا عن أن يستبدل بها أقوالًا مأثورة عربية، مما يصون شيئًا من روح الأصل. تكافؤ السياق (Dynamic Equivalance): وهدفه الأول نقل معنى النص وفحواه إلى اللغة المترجمة وفقًا لسياقها وأعرافها. وعادةً ما يكون الجمهور المستهدف بهذا المنهج من عموم القراء الذين ليس لهم اطلاع كثير على اللغات الأجنبية، ولذا فالأفضل نقل المغزى إليهم دون إرباكهم بأسلوب أدبي غريب عنهم، وفي هذه الطريقة تستبدل بعناصر النصّ الأصلي (كالأقوال المأثورة والأشعار وربما بعض الأسماء) مقابلات تماثلها في المعنى بلغة أخرى لتعطي في نفوس القراء انطباعًا مماثلًا لما شعر به قراء الأصل. وجدَ "نايدا" (وبعده "بيتر نيومارك")[26] أن "تكافؤ الأسلوب" يحفظ أسلوب الكاتب أو القائل الأصلي، ولهذا فهو ضروري حينما تكون الترجمة مخصصة لجمهور من الطلاب أو الأكاديميين، فهؤلاء يحتاجون للاطلاع على أسلوب الكاتب وتذوق مهاراته وأسلوبه. وأما "تكافؤ السياق" فهو أنسب لجمهور القراء العام، ولهذا يحظى بأولوية في الكتب والروايات والإعلانات والدعايات المقصودة لعامة الناس، فمن الضروري في حالتهم تقديم المعنى على الأسلوب. تعرضت نظرية "نايدا" لبعضِ النقد، فقد احتج علماء اللغة الآخرون بأن "أسلوب النص الأصلي" و"الانطباع الذي يتركه في نفوس القراء" ليست معايير علمية قابلة للقياس، فكيف يمكننا تحديد الانطباع الأصلي"الذي كان يحدثه النص لدى قرائه"، وكيف سنوازن بينه وبين الانطباع الذي تعطيه الترجمة لقرائها؟[27] كانت حجة القياس هذه ضرورية لأن هدف نظريات الترجمة -آنذاك- كان تحويل الترجمة من فن إلى علم، وأهم خواص العلوم هي منهجيتها القائمة على التجربة والقياس والموازنة، وهي تناقض -إذًا- معظم كتابات المترجمين القائمة على الذوق والحكم الشخصي. وقد حاول كثير من الباحثين بعد "نايدا" أن يضعوا طرقًا معقدة لقياس الترجمة ودراستها أكاديميًّا،[28] ولكنَّهم لم يحققوا نجاحًا باهرًا، ومن وقتئذ بزغت مناهج ونظريات كثيرة تضع الترجمة في مكانها الصحيح بين العلوم الإنسانية (وليس الطبيعية)، وما زالت هذه المناهج تتبدل كل عشر سنوات أو عشرين سنة في اتجاه جديد، على أنها حققت نجاحًا كبيرًا مقارنة بما سبقها من مدارس قديمة في الترجمة. النشأة الأكاديمية صحيح أن الإنسان مارس الترجمة منذ آلاف السنين وأنها كانت إحدى عوامل نهضة حضارات كبرى علميًّا واجتماعيًّا (مثل: الإمبراطورية الرومانية وحضارة العرب المسلمين وأوروبا الحديثة)، إلا أن الاهتمام بها -آنذاك- كان منصبًّا على نتائجها، أي على الكتب والأعمال المترجمة، ولم يلق إلا قلة من المفكرين بالاً لدراسة ظاهرة الترجمة نفسها؛ ولتحليلها وتحسينها منهجيًّا، ويرى أحد الأكاديميِّين أن في التاريخ كله لا يوجد إلا 14 شخصًا فحسب استحدثوا مناهج في الترجمة أو أضافوا لها إضافة نظرية قيمة،[29] وهذا لأن تاريخ نظرية الترجمة لم يبدأ -بإجماع كثيرين- حتى نشر ورقة بحثية محورية في عام 1972.[30] الخريطة نشأ المترجم "جيمس هولمز" في مزرعة متواضعة في ريف الولايات المتحدة بمنتصف القرن العشرين، ونال درجة البكالوريوس في اللغة الإنكليزية من جامعة براون الرفيعة، ومنذئذ جعل همه الشاغل كتابة الشعر، ثم انتقل "هولمز" وهو في الخامسة والعشرين إلى أمستردام؛ فتعلم فيها اللغة الهولندية، وكسب جل رزقه بترجمة أشعارها إلى الإنكليزية، ولذا دعته جامعة أمستردام في سنة 1964 لتأسيس قسم أكاديمي جديد مخصص لتدريس الترجمة. وقد ألهم هذا العمل "هولمز" لرسم خريطة لنظرية الترجمة، والتي كانت حقلًا أكاديميًا غير مطروق حينذاك. وتوضح خريطة "هولمز" الفروع التي يجب أن تبحثها دراسات الترجمة مستقبلًا، على أن معظم هذه الفروع لم يكن فيها أبحاث تذكر في زمنه، إذ إن هدف خريطته هو وضع أساس لفهم الترجمة بغض النظر عن الزمان والمكان. ويرى "هولمز" -حسب الخريطة- أن بحوث الترجمة بعمومها تنقسم إلى قسمين:[31] دراسات تطبيقية: تسعى لتحسين تطبيقات الترجمة واستعمالاتها، مثل: تدريب المترجمين وتأهيلهم ونقد ترجماتهم. دراسات بحثية: وهي تنقسم بدورها إلى فرعين: الأول نظري، إذ يسعى لوضع مبادئ لتفسير ظاهرة الترجمة بعمومها ومنه معظم المناهج التي سيأتي شرحها. والثاني وصفي، فيسعى لدراسة الترجمات الموجودة وفهمها وتحليلها. خريطة دراسات الترجمة التي نشرها هولمز في عام 1972، وكانت بداية البحث الأكاديمي في الترجمة بصفتها مجالًا قائمًا بذاته. توضح الخريطة كل المجالات التي يجب على أبحاث ودراسات الترجمة أن تغطيها مستقبلًا، سواء أكانت تغطيها في الوقت الحاضر أم لا. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: عمل شخصي وكانت أبحاث الترجمة في بداية السبعينيات (حين وضع هذه الخريطة) مشتتة بين مجالات كثيرة، مثل علوم اللغة والفلسفة والإنسانيات، لكن أحدًا لم يرَ الترجمة جديرةً بالتفرغ للبحث فيها أو تخصيص مساق دراسي لها؛ ولهذا انكب "هولمز" على رسم الخريطة التي كشفت للباحثين عن اتساع الترجمة وحقلها، ودعت إلى تخصيص مجال أكاديمي لدراستها. وهذا إنجاز تحقق بنجاح كبير،[32] فصارت الترجمة -الآن- تدرس في الجامعات حول العالم ويتفرغ الباحثون للعمل فيها، وظهرت فيها مدارس حداثية كثيرة، ويجدر بالمترجمين أن يعرفوا هذه المدارس ولو بإلمام بسيط. مدرسة التحليل الخطابي يشتهر الفيلسوف الفرنسي "ميشال فوكو" بنظرية يناقش فيها "المعرفة والسلطة"[33] فيقول: إن ثروة المعرفة والمعلومات في عصرنا هي نوع من أنواع السلطة، وأن السلطة والمعرفة وجهان لعملة واحدة:[34] فالسلطة تهيئ صاحبها لتشكيل المعرفة مثلما يشاء، والمعرفة تمنح السلطة لمن يتحكم بها، ويكمن جانب كبير من خلاصة هذا الكلام في القول المشهور: «التاريخ يكتبه المنتصرون». وقد وضع "فوكو" بهذه النظرية -وبنظرياته الأخرى- أساسًا لموضوع جديد مزدهر للبحث اسمه "تحليل الخطاب"، والذي يعنى بدراسة وظيفة اللغة في التواصل الإنساني،[35] وبخواصها الاجتماعية والثقافية في التخاطب بين الناس، ولهذه الدراسات فوائد جمة في الترجمة. يساعد تحليل الخطاب على صياغة الكلام لتتسق أفكاره وتترابط حسب الجمهور المناسب له.[36] مثلًا: إن ظهرت نشرة أخبار في التلفاز تقول: إن «واشنطن وموسكو وقعتا على معاهدة حماية الحياة البرية»، فعلى مترجم هذه الجملة (أو قائلها) أن يخمن إن كان مستمعوه مثقفين كفاية ليفهموا المقصود بـــ"واشنطن" و"موسكو"، وهما ليستا -هنا- مدينتين بحيزهما الجغرافي؛ وإنما حكومتا الولايات المتحدة وروسيا، وهذا تخمين قد يصيب أو يخطئ حسب السياق الخطابي.[37] ولتحليل الخطاب تطبيقات مفيدة كهذه في الترجمة، وتتتميز مدرسته بأنها مبنية على علم اللغة واللسانيات بدرجة فاقعة.[38] ومن الباحثين الذين انكبوا على دراسة تحليل الخطاب في الترجمة أعلام عرب معروفون،[39] فتترأس "منى بيكر" (وهي مصرية الأصل) مركز الترجمة والدراسات في جامعة مانشتسر، وقد خصصت فصولًا عدة لتحليل الخطاب في الترجمة بكتابها الأكاديمي المعروف In Other Words، إذ تتناول فيه تأثير الترجمة على ترابط الأفكار بين لغة وأخرى، وتأتي على ذلك بأمثلة عديدة من اللغة العربية.[40] كما أن "باسل حاتم"، وهو رئيس قسم الترجمة واللغات في جامعة هاريوت واط الإيرلندية (وهو عراقي الأصل)، يتناول مطولًا خصائص التحليل الخطابي في دراسات مع زميله "إيان ماسون"، ومن الأمثلة التي يدرسها صعوبة نقل الكلام باللهجات العامية بين لغة وأخرى، ويستشهد على ذلك بترجمة "ما يقال" بلهجة الطبقة العاملة في لندن إلى العربية.[41] ومن الأدباء النادرين الذين كتبوا عن الترجمة باللسان العربي "محمد عناني"، فله كتب كثيرة تتمحور في أكثر جوانبها حول تحليل الخطاب، ومنها كتاب "فن الترجمة" المعروف. نظرية الوظيفة تشتهر مدينة هايدلبرغ الألمانية بمظهرها البهي ونمطها المعماري الرومانسي (ولذا فإنها تستقطب من السياح كل عام عشرين ضعف سكانها)، كما أنها تشتهر بأن فيها أقدم جامعة ألمانية وثالث أقدم جامعة ما تزال قائمة في العالم؛ إذ تأسست عام 1386. وتفتخر جامعة هايدلبرغ بإنجازات كثيرة، مثل أنها خرجت سبعة وعشرين حائزًا وحائزةً على جائزة نوبل، وكذلك أنها كانت مسقط رأس واحدة من أهم نظريات اللغة الحديثة، هي الترجمة الوظيفية أو "نظرية الغرض"،[42] فقد أسسها أستاذان من جامعة هايدلبرغ في منتصف الثمانينيات، وهما: "هانز فرمير" و"كاتارينا رايس"،[43] وسرعان ما ذاع صيتهما بين المترجمين الألمان والباحثين حول العالم.[44] ولعل المدرسة الوظيفية هي أقرب مناهج الترجمة اتصالًا بعمل المترجم الفعلي.[45] كانت قد اختصت النظريات الأولى بدراسة كيفية ترجمة المفردة أو الجملة بين اللغات، لكن "هولمز" اقترح في خريطته ضرورة دراسة الترجمة على مستوى النص كاملًا،[46][47] مما يعني -مثلاً- أن اقتطاع اقتباس (بل وفصل بطوله) من كتاب دون أخذ باقي الكتاب بالحسبان؛ يؤدي إلى ترجمة ناقصة مذمومة. وقد حملت هذه الراية مدرسة الترجمة الوظيفية، فهي ترى أن الهم الأكبر للمترجم هو فهم وظيفة النص: أي الغرض والهدف المرجو من ترجمته، فكل غرض وكل جمهور له ظروف وأحكام تخصه.[48] والمترجم لا يؤدي عمله إلا لهدف واضح،[49] فكل ترجمة لها جمهور وهدف قد يتماثل أو يتباين مع هدف الأصل، وهذه مسألة جوهرية تختلف فيها الترجمة الوظيفية عما سبقها من نظريات، إذ إنها تفصل بين وظيفة النص الأصلي وبين وظيفة ترجمته.[50] على سبيل المثال: عندما يلقي الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" خطابًا عامًّا، فإن الجمهور المستهدف بهذا الخطاب هو -غالبًا- عموم الشعب الأمريكي، والقصد من الخطاب هو إقناعهم -مثلًا- بتوجهات الحزب الديمقراطي دون غيره من الأحزاب السياسية. ولكن لو ترجمنا هذا الخطاب إلى العربية فإن جمهوره يختلف كليًّا، إذ يتحول إلى قراء ومستعمين يعيشون -في معظمهم- في المنطقة العربية، والغرض من ترجمة الخطاب لهم إطلاعهم على مجريات السياسة الأمريكية، وليس إقناعهم بدعم حزب من أحزابها. مما يعني أن غرض الترجمة غير الأصل. وتترتب عدة نتائج على هذا الأمر، منها أن أولوية الترجمة هي خدمة وظيفتها وجمهورها: أي القراء (لا المؤلف)، ومنها -كذلك- أن النص الواحد قد يترجم عدة مرات وبطرق تختلف في محتواها وهيئتها (كأن تكون مطبوعة أو مسموعة) حسب وظيفتها، وعلى المترجم أن يبدأ عمله دائمًا بأن يقرر الغرض المرجو من عمله بالتشاور مع "مفوضه"، أي: مع صاحب العمل، أو مع نفسه لو كان يترجم بدافعه الشخصي.[51] في مثال عملي: لو تلقيت عرضًا لترجمة رواية من دار نشر، فعليك أن تبدأ بسؤال القائم على دار النشر عن هدفه من ترجمتها، فقد يقول شيئًا من الآتي: أن الناشر يريد ترجمة الرواية لجمهور القراء العرب، مما يعني أن الهدف من الترجمة الربح ولذا يجب أن تميل نحو كفة التعريب والتكييف، فتأتي بلغة عربية واضحة سهلة دون التلاعب بشيء من جوهر الأصل. أن الناشر يريد ترجمة الرواية لطلاب الأدب: مما يعني أن الهدف من الترجمة تذوق جمالها الأدبي، ولذا يجب أن تميل نحو كفة الترجمة الحرفية التي تنقل ألفاظ المؤلف الأصلي كما هي. أن الناشر يريد ترجمة الرواية لنشرها للأطفال والناشئة: مما يعني أن الهدف من الترجمة التعليم، ولذا يجب أن يأتي فيها تكييف وتعديل للقصة لتناسب القيم والأخلاق العربية، وأن يضبط فيها التشكيل وتبسّط المصطلحات. وفي كل هذه الحالات يتبع المترجم أسلوبًا مختلفًا حسب احتياجات مفوضه،[52] وهذا هو سر نجاح الترجمة الوظيفية: فهي لا تفرض قواعد عامة سائدةً، بل تتكيف حسب السياق وضرورته، وهي تتصل بعمل المترجم الواقعي ففيها أسئلة واضحة يوجهها نحو رب العمل وتظهر منها احترافيته وإلمامه بمهنته. المدرسة الوصفية تعرضت نظريات الترجمة الأوروبية لانتقادات بمرور الوقت بسبب حكميتها، فجل هذه النظريات تُنصِّبُ نفسها بموقع المعلم والمرشد بدلًا من الإقرار بما للمترجمين من خبرة، وبأن لاختياراتهم تبريرات قوية قائمةً على التجربة، ودعا لهذا بعض الباحثين اليهود في عام 1995 لإطلاق منهج جديد يقوم على دراسة أعمال المترجمين لفهمها بدلًا من التقوّل عليها وتصيّد أخطائها، وهذا ما يسمى بـ"الدراسات الوصفية". وترى هذه المدرسة أن هناك عادات سائدة بين المترجمين[53] تحكم وتُسيّر عملهم، فثمة اختلافات شتى بين طرق الترجمة حسب جمهورها (كقصص الأطفال) أو لغاتها (كالنقل من الفرنسية إلى العربية) أو فترتها (كزمن النهضة العربية). ولا يحاول الباحث في الدراسات الوصفية أن يرشد المترجمين إلى كيفية تحسين ترجمتهم،[54] وإنما ينحصر عمله في دراسة النصوص المترجمة والبحث عن قواسم مشتركة بينها، مثل التعديلات التي يميل المترجمون في كل لغة إلى القيام بها ومقدار أمانتهم أو تصرفهم بالأصل.[55] ومن تطبيقات الترجمة الوصفية؛ أنها تخبرنا بالأنماط الراسخة في الترجمة. فمثلًا: اكتشفت "منى بيكر" في أبحاثها أن الفعل "يقول" أو "قال" يأتي في الترجمات الإنكليزية عن العربية والإسبانية أكثر بمرتين مما يأتي في النصوص الإنكليزية الأصيلة، وهذا دليل محتمل على أن المترجمين من هاتين اللغتين يستعيضون عن كثير من الأفعال الأدبية والبلاغية في العربية والإسبانية بالفعل الإنكليزي "to say" لتبسيط الأسلوب على القراء، وهذه مشكلة غير واعية وصعبة الكبح للترجمة.[56] ومن الأمثلة الموسعة على الدراسات الوصفية كتاب "الملك لير في خمس ترجمات عربية" لأحلام حادي (2009)، وهو يقارن بين عدة ترجمات لمسرحية "الملك لير" في أمانة نقلها لأسلوب شكسبير، وفي كيفية عرضها أمام القراء العرب. شخصية المترجم يقول الكاتب "إبراهيم زكي خورشيد": «الترجمة عمل غير مشكور. [ففيها] جهد كبير ولا حق في التأليف».[57] وهو ليس وحيدًا في رأيه، فمن أكثر ما يشكو منه منظّرو الترجمة قلة التقدير الذي يلحق بالمترجم وعدم الاكتراث باسمه ولا بإنجازه، بل وتهميش مجال الترجمة كله. فعادةً ما ينسب كل الفضل والشهرة في سائر الكتب والأعمال المترجمة لمؤلفها الأصلي؛ وكأنه كتبها بقلمه في كل لغة من اللغات، بينما لا ترى (إلا ما ندر) حديثًا عن إتقان المترجم نقلًا أو تعديلًا أو تحسينًا. وكان الإحباط الناجم عن هذا التهميش كفيلًا بأن يصنع اتجاهًا مكرسًا في الدراسات الأكاديمية يدعو إلى احترام شخصية المترجم وذاته، أملًا في تعديل كفة الميزان.[58] كان أكثر من التفت إلى هذه المشكلة الباحث الأمريكي "لورنس فينوتي"، حيث نشر في عام 1995 كتابًا كان له وقعه الكبير على نظرية الترجمة، وعنوانه "خفاء المترجم".[59] والمقصود بـ"الخفاء" -هنا- هو أن المترجم في العالم الغربي الحديث أمسى مثل الشبح، والذي تعبره أنظار القراء دون اكتراث بشخصه، ويوجه "فينوتي" نقدًا لاذعًا للناشرين الأمريكيين لأنهم يحررون الترجمة حتى تأتي سلسة وسهلة القراءة، بينما يدعو هو إلى ضرورة أن تحتفظ الترجمة بسمات أجنبية تعبر عن أصلها الغريب،[60] وبالتالي عن مجهود مترجمها في صون هذه الغرابة للقارئ.[61] تدعو هذه المدرسة -أيضًا- لأن يصبح المترجمون موضوعًا للدراسة من وجهة نظر علم الاجتماع.[62] إذ يترك كل مترجم طابعًا شخصيًّا في عمله بناءً على خلفيته وطبيعته المتفردة، وتحاول كثير من الأبحاث أن تكتشف كيفية تمييز الترجمة من خلال صاحبها: فلو أعطيت الجملة نفسها لخمسة أشخاص سيرجعون إليك بخمس ترجماتٍ متمايزة، ومن العصي تفسير هذا التمايز وعزوه لأسباب واضحة،[63] فيستحيل أن تتطابق ترجمتان مثلما يستحيل أن تتطابق ترجمة وأصل.[64] وخلاصة هذه المدرسة هي أنها تدعو للرجوع إلى الترجمة الحرفية، فهي توازن بين "تقريب" النص و"تغريبه" عن القارئ[65] موازنةً ومماثلةً للجدل التاريخي بين اللفظ والمعنى. وقد نرى هذه النظرة للترجمة بعيدة عن السياق العربي كل البعد، إذ إن مبرراتها لا تنطبق تمامًا في سياق اللغة العربية. مدرسة الثقافات كانت مدرسة التحليل الخطابي خطوةً أولى في خروج دراسات الترجمة من قوقعة علم اللغة، إذ أخذت في الحسبان خصوصيات اجتماعية وثقافية لم يلتفت لها الباحثون سابقًا، واكتسب هذا المنحى قوة أكبر في السبعينيات؛ حينما أدرك الباحثون أن موضوعات الترجمة (مثل: الكتب والأدب) ليست إلا وجهًا من أوجه الدراسات والعلوم الإنسانية المتداخلة بعضها ببعض، مما يعني أن فهم الترجمة يستوجب -إلزاميًا- فهم المجتمع والثقافة والتاريخ الذي أخرجها.[66] ويسمى المنهج "مدرسة التخصّصات المتعدّدة" أو "الترجمة الثقافية"،[67] وقد يكون أقوى اتجاه حديث وحالي في نظرية الترجمة. اعترض رواد المنهج الثقافي في عام 1990 على معظم ما أسلفنا من مناهج الترجمة، وكانت حجتهم في ذلك أن الخلاف التاريخي بين "الترجمة الحرفية" و"الترجمة بتصرّف" ينحصر اهتمامه (منذ العصور القديمة) في ترجمة المفردات، بينما انحصر اهتمام المدارس الحديثة (مثل: مدرسة تحليل الخطاب والمدرسة الوظيفية) في ترجمة النص، مما يعني أن تاريخ الترجمة بمعظمه منصب على المفاضلة بين الترجمة والأصل الذي نقلت عنه، ويرى أتباع المدرسة الثقافية أن هذه موازنة ضيّقة تتجاهل البيئة الاجتماعية والإنسانية التي تقع فيها الترجمة، والتي يجب أن توازن بين ثقافتين، وكانت هذه نقطة تحول كبرى[68] تسمى حاليًا: "النقلة الثقافية".[69] ومن روّاد النقلة الثقافية المترجم "ليفيفير"، الذي درس القيود الثقافية والاجتماعية[70] والاقتصادية التي تقنن الترجمة.[71] فمثلًا: لكل ثقافة عادات أدبية سائدة تقيد الأدب المقبول والمذموم فيها، وتتضارب هذه القيود مع اعتبارات اللغة،[72] ومن نتائج ذلك: أن المترجمين قد يتجنبون نقل المشاهد المخلة أو يتلاعبون بها تقديرًا لقيود ثقافتهم، كما قد يحرّفون أوصاف الشعوب والأعراق والتاريخ والسياسة للأسباب نفسها.[73] رسم توضيحي من الباحثين "باسل حاتم" و"جيريمي مندي" للتداخل الكبير بين الترجمة وغيرها من مجالات البحث والدراسة، والذي يتجلى في نظرية الترجمة الثقافية. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: عمل شخصي وتدرس الترجمة الثقافية (مثل النقد الأدبي ومعظم الإنسانيات) القضايا النسوية والشذوذ وتحلل ظهورها في الترجمة، ويدعو بعض الباحثين الثقافيين إلى التلاعب بالترجمة بقصد إبراز هذه القضايا المُهمَّشة، وخصوصًا في الثقافات التي تقمعُها.[74] ومن أهم مجالات الترجمة الثقافية ما يسمى "دراسات ما بعد الاستعمارية"، وهو اتجاه أكاديمي جديد يدرس الآثار الإنسانية والثقافية للاستعمار الغربي،[75] ويدرس الباحثون فيه كيفية الترجمة من لغات الشعوب المستعمرة (مثل: العرب والأفارقة والآسيويين ومعظم الشعوب) إلى لغات المستعمرين (مثل: الإنكليزية وبقية اللغات الأوروبية)، ويتناولون العلاقة غير المتوازنة بين هاتين الجهتين بسبب الفرق الشاسع بينهما في القوّة والسلطة.[76] وينظر كثير من أتباع هذه المدرسة للترجمة على أنها أداة استعمارية و"ملطخة بالعار"، وذلك لأن المستشرقين استغلوا الترجمة -تاريخيًا- في نقل صورة سلبية عن المشرق،[77] كما يرى أتباع هذه المدرسة أن المترجمين الغربيين يأخذون حريتهم في التصرف بآداب الشعوب المستعمرة على أنها "أقل منزلةً" من لغاتهم، فيقربون أسلوبها للمألوف في الأدب الإنكليزي والغربي،[78] ونتيجة هذا السلوك -كما تقول إحدى الباحثات- هي أن: «قلم المرأة الفلسطينية يغدو شبيهًا في أسلوبه بقلم الرجل التايواني».[79] ومما يستحق وقفةً هنا أن نفكر فيما قد يحدث عندما نشرع بترجمة أدب من أطراف العالم كافة إلى اللغة العربية نفسها، أي عن الإنكليزية والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية والهندية وغيرها (وهي حركة تجري على قدم وساق بالفعل)، ولنتخيل الآن هذا الأدب المتباين أشدّ التباين في أشكاله وفئاته وخلفياته الثقافية؛ وقد امتزج بالتعابير والمفردات والجمل العربية التي ننقل بها الأدب عن كل العالم. ألا يعني هذا أننا نلغي -مثل غيرنا- الخصوصية الثقافية لجميع هذه الإنتاجات الأدبية بعرضها في ضوء لغة ومنظومة واحدة توهمنا وكأنها متماثلة؟ اختيار منهجك تناولنا لمحات خاطفة عن مناهج نظرية كثيرة تختلف في أحكامها، وقد وضع جُلها باحثون متخصصون، فليس مطلوبًا من المترجم أن يحيط علمًا بها جميعًا، لكنه سوف يضيف عمقًا واحترافية متفرّدة إلى عمله إن اختار منهجًا منها ودرسه بعمق يكفي لتطبيقه. ولعلّ منهج "الترجمة الوظيفية" هو الأكثر فائدةً في السياق المهني، فلو حصلت على عرض لوظيفة في الترجمة يمكنك أن تسأل صاحب العمل باحترافية عن "الغرض" الذي يسعى له من الترجمة والجمهور الذي يرجوه لها، وبناءً على ذلك تختار الأسلوب الأنسب في العمل بتسلسل عقلاني. كما أن مدرسة التحليل الخطابي والمدرسة الثقافية لهما لفتات جوهرية لأسلوب الترجمة، والتي سنتناول كثيرًا منها بأمثلة عملية لاحقًا. وللمترجم -في نهاية المطاف- حرية اختيار المنهج الذي يناسبه ويتسق مع قناعاته وأسلوبه، على أن من الأفضل أن يلتزم بمنهج واحد من هذه المناهج، وذلك لقيمة ما وضع فيها من بحث ودراسة، وحينما يجمع المترجم ما في هذه المناهج من معرفة نظرية مع خبرته العملية فسوف يحترف مهنته حقًا، ولهذا السبب سوف ترى (في المقالات القادمة) استشهادًا متواليًا بكنوزها الكثيرة. _____ اقرأ أيضًا المقال التالي: كتب تزن ذهبا: تراث العرب والترجمة المقال السابق: آفات الترجمة على اللغة
-
دخل أبو العبَّاس "المأمون" مدينة بغداد منتصرًا في سنة 198 للهجرة (812م) بعد حصار ضربه عليها خمسة عشر شهرًا، وكان دخوله المدينة نهايةً لحرب مع أخيه "الأمين" أُزهق فيها كثير من الأرواح وخلفت خرابًا لا ينسى في مدينة السلام، ولكن ذلك الخراب كان -أيضًا- بدايةً لعصر ذهبي للعلوم والمعرفة لم تشهد الحضارة الإسلامية مثيلًا له. دامت خلافة المأمون عشرين عامًا اتسمت بالهدوء والرخاء، أُسسَت خلالها مكتبة "بيت الحكمة" في بغداد وانطلقت منها واحدة من أكبر حركات الترجمة في التاريخ، ومن أهم شخصياتها: حُنَين بن إسحاق، وهو طبيب سرياني من مدينة الحيرة جنوب العراق،[1] ومن أهم مؤسسي المنهج الإسلامي في الترجمة. قصة "حنين" كان "حُنَيْن بن إسحاق" مسيحيًّا عارفًا باللغة السريانية، وقد عاش حياةً هانئةً في ظل الدولة العباسية في أوج ازدهارها، وهم بالسفر في شبابه قاصدًا القسطنطينية (أو ربما الإسكندرية، فليس لنا من علم في ذلك إلا من أقوال المؤرخين) ليتلقن فيها أصول اللغة اليونانية، وعاد منها إلى بغداد حيث اشتغل بالترجمة في "بيت الحكمة" وهو شاب دون الثلاثين،[2] وسرعان ما ارتقى في سلمه الوظيفي، حيث عينه الخليفة "المتوكل" طبيبًا له، وكلّفه بأن يرأس جماعة من المترجمين.[3] رسم لحنين بن إسحاق، من مخطوطة لكتاب: "الإيساغوجي". - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز ومن سوء حظ "حنين" أن الحسد والغيرة طارداه لِما خُصّ به من كرم، فقد كان يتقاضى من الخليفة "وزن كتبه ذهبًا" كما يقال، ويبدو أن في هذا القول مبالغةً ما، فالأرجح أنه كان يتقاضى مثل وزنها دراهم من فضة[4] (وكان -بالحالتين- يُطوِّل كتبه وويزيد عدد صفحاتها قدر ما استطاع ليزيد أجره).[5] وقد حيكت لـ"حنين" الدسائس من حاسديه فزج به في سجون العباسيين،[6] لكنه ترك خلفه تراثًا ومدرسة في نهج الترجمة وطريقتها لم يسبقها مثيل في تاريخ العرب. ترأَّس "حنين بن إسحاق" مدرسة "بيت الحكمة" بعد أستاذه "يوحنا بن ماسويه"، وتنسب إليه ترجمة نحو مئة كتاب إلى السريانية ونحو أربعين كتابًا إلى العربية، ومن دلائل نجاح "حنين" الكبير[7] أنه اكتسب من القدرة والكفاءة ما خوله أن يؤسس منهجًا ومدرسةً في الترجمة، ووصلنا عن هذا المنهج مصدر ثمين هو رسالة كتبها "حنين" إلى أمير يدعى "علي بن يحيى"، عنوانها: "ذكر ما تُرجِم من كتب جالينوس"،[8] ويروي فيها شيئًا من تجربته في الترجمة العربية والسريانية.[9][10] ومما يلفت النظر في هذه الرسالة أن أسلوب الترجمة العربي التراثي لم يكن قائمًا -بالضرورة- على النقل الكامل، على عكس ما نألفه في الترجمة الحديثة، وإنما تخلله قسط كبير من الاختصار في النصوص وتحجيمها، إذ لم يكن حنين وأصحابه مضطرين إلى ترجمة كتاب بجملة ما فيه، واستساغ كثير منهم اختصار هذه الكتب تارة، وشرحها أو تفسيرها تارة أخرى.[11] بل وكان المعرّبون -آنذاك- يتساهلون في تحريف النص ليناسب جمهورهم من القراء، مثل إضافة اسم "الله تعالى" في مواضع لم يذكر الله فيها بمؤلفات فلاسفة اليونان،[12] كما كثرت عندهم الترجمة بين ثلاث لغات لا لغتين (مثلًا: إلى السريانية ثم إلى العربية) مما يدل على قلة اهتمامهم بصون اللغة والأسلوب عن الأصل.[13][14] كما تخبرنا الرسالة (كذلك) بأن "حنينًا" -ضمن إنجازاته الأخرى- أسس مدرسة في علم الترجمة نهجها هو نقل معنى الكلام ومقصده، وبذلك اختلفت مع تيار كبير للترجمة الحرفية في زمنه[15] والذي كان يدعو لحفظ الكلمات والأسلوب مثلما جاء باللغة الأعجمية.[16] وهاتان مدرستان متناقضتان كل التناقض، ومحور اختلافهما هو الخلاف القديم نفسه الذي يَفرُق كل طلبة الترجمة وأساتذتها إلى فريقين أزليين. مخطوطة عن تشريح العين لحنُين بن إسحق، من كتابه: "المسائل في العين". المخطوطة محفوظة في المكتبة الوطنية في القاهرة، ومؤرخة لنهاية القرن السادس الهجري (بداية القرن الثالث عشر الميلادي). - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز بيت الحكمة عاش "حنين بن إسحاق" في ذروة عصر الترجمة الإسلامي ونال من خيرات ذلك العصر كثيرًا، فقد قيل -فيما قيل- أنه كان يقبض ذهبًا وينعم بحياة فارهة ويستيقظ صباحًا ليأخذ حمامًا برائحة البخور ويحتسي نبيذًا[17] ربحه من مهنته الراقية،[18] على أن جذور الترجمة العربية بدأت بداية متواضعة -مقارنة بهذه النعَم- قبله بأكثر من مئة عام.[19] ترجع الترجمات العربية الأولى إلى عصر الجاهلية والنقوش الصفوية، إلا أنها كانت ترجمات لسطور أو قصائد أو رسائل، وأما ترجمة الكتب وأمهات الأدب فالرائد فيها هو "خالد بن يزيد بن معاوية"، نجل الخليفة الأموي الثاني؛ الذي أرسى أسسًا لحركة ترجمة هائلة، ولو أن ما نُقلَ من الكتب في أيامه وفي عصر الدولة الأموية بعمومها كان قليلًا.[20][21] وما تفرد به "خالد بن يزيد" عن غيره أنه أول من صبّ اهتمامه على ترجمة العلوم، إذ يقول ابن النديم أنه أول من نقل مؤلفات الطب والكيمياء والفلك إلى العربية[22] عن كتب اليونان والهند،[23] وأمضى معظم وقته على كتب الكيمياء والخيمياء خصوصًا،[24] مخدوعًا في ذلك بخرافات اليونانيين، إذ ظن هؤلاء أنهم قادرون على تحويل المعادن الخسيسة ذهبًا فطمع بأن يتعلم السر منهم. رسم تخيلي للحياة في "بيت الحكمة". - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيبيديا. ووقعت في عصره نقلة تاريخية في تاريخ الترجمة العربية، وهي أن الخليفة "مروان بن الحكم" أمر بتعريب الدولة ومؤسساتها، وترتب على هذا ترجمة كل الدواوين وما لحق بها من سجلات ووثائق حكومية.[25] وكان تعريب الدواوين حدثًا محوريًّا لأنه جعل العربية اللغة الرسمية السائدة في سائر أرجاء دولة الإسلام، ومن ثم عمت اللغة العربية في كتب وعلوم بلاد المسلمين على اتساع رقعتها.[26] عاد الاستقرار إثر انتهاء الحرب بين الأمويين والعباسيين وانتهاء الحرب بين الأمين والمأمون بعدها، وهكذا دخلت دولة الخلافة -في بداية القرن الثالث الهجري- عهد الرخاء وعصرها الذهبي، وانطلقت معه واحدة من أكبر حركات الترجمة في العالم على مر العصور، إذ لم تسبق حركة الترجمة العربية (بحسب منى بيكر) أي حملة بهذا الاتساع والتنظيم على مر التاريخ لنقل العلوم والمعرفة من لسان إلى لسان، فقد شملت لغات شتى منها: اليونانية والسنسكريتية والفارسية والسريانية،[27] ونُظمت في مدارس ومكتبات بين بخارى وبغداد ودمشق والقاهرة والقيروان والأندلس (كأمثلة فحسب).[28] وكانت أول وأهم مدرسة للترجمة في التاريخ الإسلامي هي "بيت الحكمة" التي أسسها المأمون في نحو سنة 215 هجرية (830 ميلادية). والواقع أن "بيت الحكمة" لم تكن دارًا عربية للعلوم كما قد يُظَن، بل كانت ملتقى للثقافات[29] ومن أهمّها -بعد العربية- السريانية والفارسية، واعتمد الخلفاء غالبًا على المترجمين السريان لأنهم أتقنوا اللغة اليونانية،[30] وكانت تسبق ترجمتهم العربية ترجمة سريانية[31] أو فارسية،[32] بل إن "بيت الحكمة" في أصله ترجمة للاسم نفسه الذي حظت به -سابقًا- مكتبة الإمبراطورية الساسانية، وقد قلد تصميمها المعماري مكتبات الفرس.[33] مخطوطة عربية لكتاب كليلة ودمنة نحو عام 617 هـ (الموافق 1220م)، وهو من أشهر ما تُرجِم من كتب الهند في "بيت الحكمة"، وترجمه: "عبد الله بن المقفع". - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز. كرس المترجمون العباسيون (والمسلمون بعمومهم) اهتمامًا عظيمًا بأمهات الكتب الأعجمية في العلوم والفلسفة، لكنهم لم يلقوا بالًا لآداب هذه الأمم من شعر ومسرحيات وملاحم،[34] ولعل هذا ينبع من حرص العرب على العلم النافع وعلى الابتعاد عن "الأساطير والخرافات"،[35] أو من شعورهم بتفوق شعرهم وأدبهم على شعر وأدب غيرهم.[36] إلا أن غض الطرف عن آداب الأمم مأخذ كبير، وربما هو المأخذ الأكبر على حركة الترجمة العباسية، فالآداب تختزن جزءًا كبيرًا من حكمة الأمم، وفيها غنى وتنوع ثقافي افتقد العرب شيئًا منه في تراثهم. لم تُترَك ترجمات بيت الحكمة طيًّا للنسيان على رفوف المكتبات، بل تهافت العلماء العباسيون على قراءتها،[37] ولهذا كثرت في زمنهم المناظرات الفلسفية والعقائدية وتعددت المذاهب لتأثرهم بأفكار الأمم الأخرى.[38][39] وبلغ التعريب والنشاط الفكري أوج ازدهاره بين نهاية القرن الثاني إلى نهاية القرن الرابع الهجري (أو بين عامي 800 و1000 للميلاد)،[40] وظل "بيت الحكمة" فاعلًا في نقل معارف الأمم حتى دخول المغول إلى بغداد سنة 656 هـ (الموافق 1258م)، فاندثرت مكتبته ومدرسته مع ما اندثر، حسب ما يخبرنا القلقشندي.[41] ودخلت -بذلك- بلاد العرب عصرًا طويلًا من الجمود الفكري والذهني قارب الستمئة عام.[42] حصار المغول لبغداد، كما صورته مخطوطة من نحو عام 833 هـ (الموافق 1430م). - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز. النهضة ركدت حركة الترجمة والفكر في العالم الإسلامي بعد سقوط بغداد لنحو ستة قرون، وخلت تلك الفترة[43] من أي نشاط يذكر في الترجمة إلى اللغة العربية، بل وقعت فيها حركة تعجيم[44] هائلة في مدرسة طليطلة بالأندلس بعد أن أخذها الإسبان، فنقلوا كتب المسلمين من العربية إلى لغات أوروبا قاطبة.[45] ولم تتجدد حركة الترجمة من بعدئذ حتى عهد "محمد عليّ". كان "محمد علي" والي العثمانيين على مصر، ودامت دولته المستقلة -عمليًّا- في بلاد الشام ووادي النيل لقرابة نصف قرن، وكان له طموح كبير شجع بسببه حركة جديدة للترجمة والاهتمام بالعلوم والمعارف، وأوفد طلابًا إلى أوروبا فكان لأحدهم الفضل بتأسيس حركة الترجمة العربية الحديثة، وهو: "رفاعة الطهطاوي". أقام "رفاعة" في باريس مدة خمس سنوات، تعلم خلالها اللغة الفرنسية وأتقنها، ثم عاد ليؤسس مدرسة للمترجمين في القاهرة سنة 1835، وهي مدرسة أنتج مئة وخمسون من طلابها ترجمات رائدة لأمهات الكتب الأوروبية التي اختارها وأشرف على نقلها "الطهطاوي" بحرص ودقة،[46] غير أن نشر هذه الكتب قد اقتصر على جمهور ضيق من المثقفين.[47] وقد قرر خليفة "محمد علي" (وهو "عباس حلمي الأول") في سنة 1849 إغلاق المدرسة ونفي "رفاعة الطهطاوي" إلى السودان،[48] وذلك كجزء من توجهات رجعية عديدة فرضها وقتذاك. تمثال "رفاعة الطهطاوي" قرب جامعة سوهاج، في المحافظة التي ترعرع فيها. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز. كان رفاعة الطهطاوي يرى أن في الترجمة سبيلًا لنهضة مصر، لذلك انتقى أعمدة الكتب في العلوم والهندسة والعسكرية لترجمتها، وبدأ -بعد وفاته- عصر النهضة العربية، فولَّى فيه جيل جديد من المترجمين وجوههم نحو الآداب والفنون التي افتقدوها في لغتهم، ونقلوا كثيرًا من الملاحم والمسرحيات والقصص التي ترفَّع العباسيون عن ترجمتها قبلهم بمئات السنين،[49] بينما غضوا الطرف عن نقل العلوم الإنسانية والاجتماعية.[50] وكما سلفَ؛ بعد أن بلغت حركة تعريب العلوم ذروتها في عصر "المأمون" ومن بعده،[51] انتهى ازدهارها انتهى إثر غزو المغول وإتلاف مكتبة بغداد وسقوط الخلافة الإسلامية. وقد أدى قيام الخلافة العثمانية إلى قلب الموازين نحو اللغة التركية وصرف الاهتمام عن اللسان العربي، وهو وضع استمر حتى نهاية القرن التاسع عشر، فحينئذ وقعت جُل الدول العربية تحت نير الاستعمار، وبدأ تلاقح الفكر العربي مع الأوروبي وانطلقت حركة التعريب والترجمة الحداثية المستمرة حتى الآن، وهي حركة لا يستهان بها كذلك. حنين وابن البطريق حتى ولو اختفت معظم آثار حركة التعريب العباسية، إلا أنها تركت وراءها منهجًا ومدرسةً في التعريب تُناظِر مناهج الترجمة التي قامت في كثير من الحضارات الكبرى. ونعرف من دراسة تاريخهم أن العرب كانوا ضليعين بخصائص الترجمة ودقائقها، وقادرين على دراستها ونقدها بعمق. فـ"الجاحظ" (وهو لم يكن مترجمًا؛ وإنما قرأ واطلع على ترجمة غيره)،[52] يصف ببلاغة التجاذب الدائم بين اللغة المنقول عنها وتلك المنقول إليها، لأن كل واحدة منهما "تعترض على الأخرى"،[53] فيحلل بهذا التضاد التاريخي بين "اللفظ والمعنى" وتأثير اللغات الأجنبية على المترجم.[54] يذهب "الجاحظ" ليتناول شروط الترجمة، فيقول: إنها تَسهلُ مع كثرة ما يلقاه موضوعها من البحث والدراسة بين جمهور العلماء، فإذا كان موضوعها مطروقًا بين العلماء العرب؛ كانت سهلة، أما إن كان مجالها جديدًا أو قل العلم به؛ زادت الأخطاء فيها وثقلت المهمة[55] (وهو تفسير منطقي جدًا لصعوبة تعريب العلوم المتخصصة في عصرنا). ولهذا اعترض الفيلسوف "أبو حيان التوحيدي" على تعريب فلسفة اليونان قبل إتقانها والإلمام بها، إذ لم تعجبه الترجمة من اللغة الإغريقية التي عفت منذ زمن طويل و"باد أهلها"، كما انتقد الترجمة عبر ثلاث لغات (مثلًا: إلى السريانية أولًا ثم العربية).[56] وركز "الجاحظ" في تحليله لمهنة الترجمة على ضرورة الإخلاص والأمانة للأصل والتأكد من عدم تحريفه على أيدي المترجمين والنسَّاخين والمحقّقين،[57] إذ وصف شرطين للمترجم المقتدر، وهما: أولًا، وزن علمه في فروع المعرفة بعمومها. وثانيًا، أن يكون متبحرًا باللغتين اللتين يترجم بينهما حتى تكونا عنده سواء.[58] رسمة للطبيب والمترجم السرياني "يوحنا بن ماسويه" أول من تولى رئاسة "بيت الحكمة" في عهد "هارون الرشيد"، وكان معلم "حنين بن إسحق". - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز. ويعني ما سبق أن "الجاحظ" كان أقرب في مذهبه إلى الترجمة الحرفية، ونعرف من "صلاح الدين الصفدي"[59] أن الحرفية كانت واحدة من طريقتين في الترجمة سادتا في بغداد أيام العباسيين، وهاتان الطريقتان متضادتان ومتعاكستان في أسلوبيهما، فيقول في وصفهما:[60] كان لكل من هاتين الطريقتين أنصارها فصار لها تيار أو "مدرسة". وترأس "حنين بن إسحاق" المدرسة الأولى، فدعا إلى أن تُولَى الأولوية لمقصد الكلام، فيما ترأس "يوحنّا بن البطريق" المدرسة الثانية منحازًا إلى الترجمة الحرفية. وهاتان المدرستان اللتان قامتا في بلاد العرب قبل ألف وثلاثمئة عام (وقبلهم في بلاد الفرس واليونان وغيرهم)، تمثلان الخلاف الرئيس الذي يدور بين جميع المترجمين منذ قديم الزمان وحتى هذه اللحظة، والذي قد يتغير ظاهره بين حين وحين وإن بقي ثابتًا في جوهره. وتصلنا لمحات عن صراع هاتين المدرستين من كتب التراث، إذ تشير بعضها إلى أن ترجمات "ابن البطريق" الحرفية كانت ركيكةً، فمن العسير فهمها دون الرجوع إلى الأصل اليوناني[62] (مثلما يخبرنا "ابن إسحاق" في رسالته المعروفة)،[63] بل ولعل ترجماته كانت فاشلةً، حتى إن الخليفة "المأمون" أمر بتنقيحها أو إعادتها مرة ثانية.[64] ويعيب "صلاح الدين الصفدي" على الترجمة الحرفية أمرين: الأول، أن اللغة العربية تنقصها مفردات ترادف لكل الكلمات اليونانية (في الموضوعات العلمية مثلًا). الثاني، أن قواعد النحو والصرف والبلاغة لا تتماثل بين اللغات، مما لا يجيز نقلها. وهو يستنتج من ذلك أن طريقة "ابن البطريق" رديئة غير صالحة، وأن طريقة "ابن إسحاق" هي الأجود.[65] ولا ريب أن الخلاف بين "ابن البطريق" و"ابن إسحاق" يختزل الطريقين السائدين في الترجمة حتى يومنا،[66] غير أن في وصف "الصفدي" لهذا الخلاف شيئًا لا يستهان به من التبسيط والسطحية، فالمسألة لا تكاد تقتصر على طريقة رديئة وأخرى صحيحة، وإلا لاختصرنا مئات السنين من مشكلات الترجمة العقيمة. صحيح أن الدولة العباسية شهدت واحدة من أكبر حركات الترجمة على مر الأزمان وأنها خلفت لنا مدارس كبيرة في مجالها، غير أن تراجمة بغداد و"بيت الحكمة" انشغلوا بالنقل والتصحيح والتدريس أكثر من التعمق بالمنهج الأكاديمي.[67] ولهذا السبب فإن مساهمة العرب والمسلمين في تأسيس "نظرية الترجمة" كانت متواضعةً إن قيست بتراثهم الترجمي الهائل، إذ إن محور نقاشاتهم الأكاديمية (بين ابن إسحاق وابن البطريق) لم يختلف في شيء يذكر عن الخلافات التي شغلت كل المترجمين في أنحاء المعمورة، وهذه نتيجة تزداد وضوحًا عندما نلقي نظرةً شاملةً على نظرية الترجمة عالميًا. _____ اقرأ أيضًا المقال التالي: فن الترجمة وأنواعها وأساليب الترجمة الحديثة المقال السابق: بين الحرفية والتصرف: تاريخ موجز لنظرية الترجمة
-
يقول "وولتر بينجامين" في مقالة شهيرة: إن الهدف الأول من الترجمة هو الوصول إلى من لا يستطيع القراءة بلغة أجنبية، وذلك «لتحرير النص من سجن اللغة» التي كُتب بها، وبثّ الحياة فيه بلغات جديدة.[1] ولولا هذه الغاية لصارت الترجمة محض استنساخ قاصر،[2] فهي -بطبيعتها- يكتنفها نقص وعيوب حتمية مهما بذل المترجم جهده وطاقته.[3] فما هي -إذًا- قيمة الترجمة مقارنةً بأصلها؟ الترجمة، أم الأصل؟ لا تكمن غاية الترجمة في نقل الأدب كاملاً ومثاليًّا بين لغتين، وإنما بتيسير الوصول لجوهر هذا الأدب (ولو نقص منه شيء) إلى من لا سبيل له غير ذلك. فلولا الترجمة لما شاهدت في طفولتك أي مسلسلات وأفلام كرتونية تذكر، ولولاها لما كنت لتقرأ كثيرًا من كتب الأطفال المحبوبة (مثل سلسلة "أولادنا" من دار المعارف، وسلسلة "ليدي بيرد" من مكتبة لبنان) بلغتك الأمّ، ولولاها -أيضًا- لما كان ليقرأ إنسان في عصرنا الحاضر قصة ألف ليلة وليلة،[4] ولا ملحمتي: الإلياذة والأوديسة، ولا كتاب "فن الحرب" الشهير، فجميعها ترجمت عن لغات تراثية اندثرت منذ زمن طويل. وتستمد الترجمة معناها ومصدرها واعتبارها من الأصل، فسبب الاهتمام بأي ترجمة هو أنها نشأت من نص أجنبي، ولو لم تكن رواية "هاري بوتر وحجر الفلاسفة" مترجمةً عن Harry Potter and the Pilosopher's Stone لما اكترث بقراءتها كثير من الناس، لكن العكس غير صحيح؛ فالأصل لا يحتاج للترجمة ولا يتأثر بها. ومع مرور السنين قد تتقادم الترجمة، فتتلاشى قيمتها مع تغير ألسنة الناس وأذواقهم وتفضيلاتهم، وأما الأصل فإنه يظل كنزًا أدبيًّا على مدى الزمان، فالأوديسة لا زالت تقرأ إلى يومنا هذا، لكن معظم ترجماتها[5] صارت أقرب إلى "صيحات"[6] تتبدل كل بضع عشرات من السنين،[7] ويزعم الألمان -مثلاً- أن ترجمة شكسبير بلغتهم أفضل من مسرحيات شكسبير الإنكليزية، بينما يشتكي الفرنسيون دومًا من ركاكتها عندهم.[8] ولكثير الأعمال الأدبية صلاحية شبه أبدية، فالناس يقرؤون في عصرنا أشعار المتنبي والمعري، مع أنها نظمت في زمن لا يمت لزماننا بصلة، وأما الترجمات فهي تتقادم بسرعة، إذ تسعى الترجمة -إجمالاً- لمحاكاة ذوق الناس الحالي وليس ذوقهم وقت كتابة النص الأصلي.[9] وليس من دليل أقوى من هذا على صعوبة وظيفة المترجم: إذ لا تكفي ترجمة كتاب عن الإنكليزية إلى العربية مرة واحدة، وذلك فالترجمة عمل نسبي، وهي تختلف في كل مرة حسب الشخص الذي يقوم به والجمهور الذي يستهدفه. ومن أمثلة ذلك ترجمة دريني خشبة للإلياذة، وعنوانها: "قصة طروادة"، فهي ترجمة شعرية اختصر فيها الملحمة وأعاد ترتيب فصولها (سعيًا لتيسير قراءتها بالعربية)، وأما سليمان البستاني فقد ترجم نص الإلياذة الكامل شعرًا -بعربية فصيحة- في نهاية القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين، وتختلف هاتان الترجمتان كل الاختلاف عن ترجمتي عنبرة الخالدي وممدوح عدوان للعربية الفصحى الحداثية. فكل ترجمة مما سلف لها ميزاتها وسيئاتها، بحسب مهارة المترجم وحنكته وهدفه من عمله،[10] وكل منهم خص جوانب من الأصل على حساب أخرى، مثل أن يضحي بجمال النص على حساب الدقة في المعنى.[11] ونجحت الترجمة -في جميع الأحوال- بأن تنقل إلينا كنوزًا أدبية كثيرة عمرها آلاف السنين، والتي أنتجت في ظروف اجتماعية وإنسانية لا تكاد تمت بصلة لواقعنا الحاضر، ونقلت هذه الكنوز -كذلك- إلى مئات اللغات في كل قطر من أقطار الأرض، وما زال الناس (أو بعض الناس) يستمتعون بقراءتها ويتذوقونها في أيامنا، ولو بنكهة وطريقة مختلفة عما عرفه القراء في زمنها، وربما لا يمكن للترجمة إلا أن تصون جزءًا صغيرًا من روعة الأصل، ومع ذلك فإن هذه اللمحة البسيطة تبقى ثمينةً ومؤثرة بما يكفي لتكرس أجيال كاملة من البشر نفسها لقراءتها ودراستها. فلا شك أن الترجمة -على صعوبتها- تستحق عناءها وتأتي بثمارها،[12] ولو أنها قد تتطلب حكمةً وفطنةً هائلةً لتأتي بوقعها المرغوب، وتتجلى كثير من هذه الحكمة في الاختيارات العديدة التي على المترجم أن يقدم عليها. جمل، أم إبل؟ نشر الباحث الإيطالي "أمبرتو إيكو" في سنة 2003 كتابًا بعنوان: Mouse or Rat ("جرذ أم فأر؟")، وهو يطرح في كتابه واحدةً من أكبر المعضلات التي تلقى بحثًا في الترجمة، ولا تدور هذه المعضلة حول الفئران والجرذان (مثلما يوحي عنوان الكتاب)، وإنما يستشهد "أمبرتو" بمثال بليغ له علاقة بتينك الكلمتين لإيصال المقصد من كتابه، إذ يطرح مشكلةً واقعية طالما يواجهها المترجمون الإيطاليون في نقل كلمة rat من الإنكليزية. فهل من الأصح ترجمتها إلى topo ("فأر") أم ratto ("جرذ")؟ غلاف كتاب "جرذ أم فأر؟". مقتبسة بترخيص الاستخدام العادل في مشهد من مسرحية هاملت المشهورة، يقول البطل وهو ينظر إلى ستارة في الغرفة: ?How now? A rat (ومعناها التقريبي: «ما هذا؟ جرذ!»)، والمقصود هنا ليس حيوان الجرذ، بل أن هاملت انتبه لشخص متطفل دخل الغرفة خلسةً واختبأ خلف الستار، واختيار كلمة "جرذ" في هذا السياق اختيار حذق لأن لها دلالتين في اللغة الإنكليزية: فقد يقصد بها حيوان الجرذ (بوصفه كائنًا مزعجًا يرتاع الناس حين رؤيته) أو شخص متطفل (لأن اكتشاف متطفل في الغرفة يثير أحاسيس من الهلع، تشبه تلك التي يثيرها منظر جرذ). ويقول الكاتب: إن من الأسلم ترجمة الكلمة في هذا السياق إلى topo (ومعناها بالإيطالية: فأر)، فكلمة "فأر" لدى الإيطاليين تعطي إيحاءً بالهلع من كائن غير مرغوب به، وهي أقل دقة من كلمة "جرذ" بمعناها الحرفي، لكنها أقرب للإيحاء المطلوب. ولهذا فإن ترجمة "فأر" مناسبة جدًا في السياق الأدبي، وأما عند الحديث عن الجرذان في سياق علمي (كالقول بأن: «الجرذان نشرت وباء الطاعون في أوروبا») فلا بد من ترجمتها إلى ratto، لأنها المفردة الأكثر دقةً على الصعيد الأحيائي. ويسمى الاختيار بين كلمتي الفأر والجرذ -كما سلف- "المساومة" [13] أو "المفاضلة" في الترجمة، أي المفاضلة بين المعاني بعضها على حساب بعض، وانتقاء الأنسب للسياق؛ فكل ترجمة لها سياق صحيح، وسياق خطأ. ويصلح -بظنّي- تقريب هذا المثال المحوري في كتاب "أمبرتو إيكو" إلى مثال قريب في اللغة والثقافة العربية، والتي تكثر فيها أسماء حيوان آخر هو الجمل؛ لما له من منزلة كبيرة في التراث العربي، حتى صعب على المعاجم حصر أسمائه، فيقال أن له منها ثلاثمئة. إلا أن أسماء هذا الحيوان (كما نعلم الآن) ليست مترادفة، فكل منها يأتي محملاً بإيحاءات ذهنية مختلفة، مثل ما يرد في هاتين العبارتين: تعتبر الجمال العربية أول أنواع الجمال التي انتفع بها الإنسان.[14] تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من كل فج بما عليها.[15] ربما يتضح من أسلوب وسياق كلتا الجملتين السابقتين أن: الأولى حديثة، والثانية تراثية، فعندما يسمع العربي كلمة "الجمل" غالبًا ما تتبادر إلى ذهنه صورة جمل ككائن حي (وربما يكون قد رآه بأم عينيه في حديقة للحيوانات، أو في البادية، أو في رحلة ما)، ولو شاهد هذا الحيوان في فيلم وثائقي عن الحياة البرية، فغالبًا ما سيقول عنه: إنه "الجمل"؛ لأن هذا هو الاسم الأكثر شيوعًا في عصرنا، وأما لو كان الفيلم الوثائقي عن تاريخ العرب والمسلمين أو عن قيمة الجمال في الثقافة والتراث العربية؛ فمن المحتمل أكثر أن يأتي بكلمة "الإبل"، لأنها مستساغة في تلك السياقات، وأما لو كان الحديث عن أنثى الجمل في القرآن فقد عبرت كلمة "الناقة" عن ذلك المعنى؛ الذي ارتبط بناقة النبي صالح. وحتى لو كانت هذه الثلاث الكلمات شبه مترادفة[16] في معناها؛ فإن الانطباع اللغوي الذي تثيره في ذهن المستمع مختلف جدًّا. ويفهم الناطقون بكل لغة هذه الاختلافات الطفيفة في وقع الكلمات، فيستخدمون كلًا منها لغاية وهدف بحسب ما يريدون الحديث عنه، سواءً أكان ذلك بوعي منهم أو بدون وعي، وأنت لا تُحذّر -مثلًا- سائق سيارة في بلد صحراوي قائلًا: انتبه، أمامك ناقة تعبر الشارع! وبالمثل، على المترجم حينما يواجه هذه الكلمة بلغة أجنبية في الترجمة فعليك أن يعي سياقها، وأن يختار بناءً على سبب منطقي أيًّا من مقابلاتها العربية هو الأنسب لسياقه، وهكذا "يساوم" بين المعاني مثلما قال أمبرتو إيكو. في الترجمة -دائمًا- طرق عدة تصلح للتعبير عن المعنى، غير أن كل طريقة تحفظ جزءًا من معنى الكلام أو إيحائه وتفقد جزءًا، وجوهر الترجمة وإبداعها هو حسن اختيار الترجمة التي تحفظ الجزء الأكبر. وسبيل المترجم للاختيار بين هذه الطرق أن يرجع إلى مقصد الترجمة وغايتها، فكل سياق وكل جمهور يستدعي غاية مختلفة، وتظهر مهارة المترجم في تسخير اللغة للغاية المرجوة،[17] مثلما أن المترجم الإيطالي يختار -بناءً على غايته- بين كلمتي "الجرذ" و"الفأر"، ومثلما أن المترجم العربي قد يختار ذات يوم بين "الجمل" و"الإبل". وهذا الاستناد الدائم للحكم الشخصي؛ هو ما يجعل الترجمة ضربًا من الفنون.[18] الترجمة فن لا يسمع المرء باسم العم "دهب" إلا ويتخيل مسبحًا مليئًا بالنّقود في قصره الفارهِ بمدينة البط، والذي لا يكاد يتبرع العم "دهب" بقرش واحد مما فيه، ولو كان ذلك لأقربائه اللطفاء (سوسو ولولو وتوتو) ولا ابن أخته "بطوط". لكن اسم عم "دهب" المحبوب بين القراء العرب؛ هو في الحقيقة "سكروج ماك دك"، وابن أخته "بطوط" هو "دونالد دك"، وأقربائه الصغار هم "هُوِي ودُوِي ولُوِي". ولولا أن دار الهلال استحوذت على حقوق نشر القصص عربيًّا في سنة 1959؛ لربما بقي عم "دهب" العم "سكروج" إلى الأبد،[19] مثلما أن مستر "سلطع" (من مسلسل سبونج بوب) ربما كان ليبقى "مستر كرابز"، وأن "بظ يطير" (من فلم "حكاية لعبة") كان سيبقى "بز لايتيير"،[20] وهذه محض شخصيات قليلة من أيقونات كثيرة نشأت عليها أجيال من الشباب والكهول، والتي ندين بها لإبداعات في الترجمة العربية. يقول نعوم تشومسكي: «اللغة إبداع حر، فقوانينها وأسسها ثابتة، لكن في اتباع هذه المبادئ تساهل ينجم عنه تنوع لانهائي».[21] ولأن الترجمة من فروع اللغة فإن لها -كذلك- مبادئ عامة؛ وهي التقيد بمعنى النص الأصلي، وفيها باب كبير للإبداع بإعادة خلق جماليات النص بلغة جديدة، ولهذا فعلى كل مترجم أن يضيف إلى النص شيئًا من ملكته الشخصية، والتي لا غنى عنها للتعويض عن بعض مما فقده النص أثناء نقله.[22] بذل الباحثون محاولات كبيرةً في الماضي للتغاضي عن إبداع المترجم، وذلك بأنهم حاولوا جعل الترجمة نشاطًا علميًّا أملًا بأن تتبع درب العلوم الطبيعية من الرياضيات وأقاربها، إلا أن ثمة اتفاقًا عامًّا بين الباحثين الآن على أن الترجمة عمل إبداعي (أو مزيج بين الإبداع والعلم، أو بين الأدب واللغة[23])، ولذا، لا يجوز تقييدها بقواعد صارمة. فلا بد أن يتحلى المترجم بحرية اختيار الكلمات والتعابير المناسبة في ترجمته؛ بناءً على خبرته وقدراته اللغوية، ولا يمكن إغفال دوره الشخصي في اتخاذ عدد لانهائي من القرارات الصغيرة والكبيرة بالترجمة، والتي قد تغير من وقع هذه الترجمة في نفس القارئ جذريًّا. وتزداد الحاجة إلى موهبة المترجم هذه كلما كان للنص قيمة أدبية وبلاغية أكثر،[24] فنقل جمال الكلام أصعب من مضمونه (كما سوف يأتي في أقسام لاحقة).[25] بسبب الترادف السطحي بين اللغات الذي رأيناه سابقًا، يجب على المترجم أن يحتكم إلى خبرته -أولًا وأخيرًا- ليقرب فحوى الكلام وجماله من الأصل،[26] وهذا يجعله أديبًا وفنانًا أكثر منه عالمًا، فهو يستند إلى ملكة الخيال واللغة؛ لا أنه يبحث عن المعاني الصحيحة والدقيقة[27] (حتى ولو أن تفنّنه يبقى محصورًا ضمن ما يمليه النصّ الأصلي).[28] ولهذا فإن ما يسعى إليه هذا الكتاب ليس إلا أن يعطي المترجم مقدمة ينطلق منها، وأن يعين المترجم على وضع أساس منهجي يحتكم إليه في ترجمته ليتمها على أكمل وجه، وأما اختيار هذا المنهج فهو قرار يرجع إلى المترجم وحده. ولكنْ وقبل الخوض في مناهج الترجمة، لا بد من الإلمام بأنواع الترجمة وفئاتها المتعدّدة. أنواع الترجمة الكتابة أنواع، والترجمة كذلك، فليس كل من يكتب سبقًا صحفيًا قادرًا على تأليف كتاب، وليس الأديب بمؤهل لكتابة إعلانات دعائية لمطعم أو محل تجاري. فالمهمة الأولى تحتاج صحفيًا، أما الثانية فتحتاج مؤلفًا، وأما الثالثة فتحتاج مسوقًا، وجميعهم كتاب، لكن لكتاباتهم أسس وقواعد متباعدة: وكذلك المترجمون، إذ ليست ترجمة رواية لـ"دستويفسكي" كترجمة مقالة علمية في ميكانيكا الكم، لا من حيث المحتوى ولا من حيث جمهور القراء. الترجمة المهنية تعنى الترجمة المهنية بكل نقل بين اللغات له هدف مهني أو وظيفي، ومن أمثلتها المعتادة: ترجمة الوثائق التجارية، وعقود العمل، والأوراق القانونية والحكومية، وأدلة (كتالوغات) استخدام الأجهزة الإلكترونية، وما إلى ذلك. وأهم سمات الترجمة المهنية أنها تتطلب الدقة الشديدة، وعدم الخروج عن معنى النص الأصلي بزيادة الكلام أو نقصانه، وفي الالتزام بالمصطلحات المعروفة والواضحة. والترجمة المهنية ضرورية في الحياة اليومية للناس، خارج إطار الكتب والأدب، ولكنها تتكون -في الغالب- من نصوص يقرؤها المرء في العمل، أو حينما يبتاع شيئًا من متجر، أو حينما يشاهد إعلانًا على شاشة التلفاز. وقد يكون هذا النوع من الترجمة أكثر ما يُطلب في سوق العمل؛ وذلك لفائدته التجارية والعملية، وقد يبدو مضجرًا للمترجمين الشغوفين باللغة والأدب، لكنه -عادةً- مجزٍ أكثر من الناحية المادية. الترجمة العلمية تندرج الترجمة العلمية -عادةً- كفئة ضمن الترجمة الأدبية، وذلك لكون معظم الكتب، والمقالات العلمية، ضربًا من ضروب "الأدب الواقعي"،[29] ولكن بين هاتين الفئتين اختلاف شاسع بالنسبة للمترجم، وذلك لأن الترجمة الأدبية تتطلب منه حسًّا لغويًّا مرهفًا ومبدعًا، أما الترجمة العلمية فالغرض الأساس منها هو نقل المعنى والمضمون الأكاديمي. ومن سمات الأدبيات العلمية وحدة أسلوبها -تقريبًا- في جميع اللغات، فهي لا تتضمن -مثلًا- إحالات ثقافية وليس فيها تلاعب بالألفاظ أو قواف شعرية، لذا من شروط ترجمتها حسن استيعاب الموضوع وفهمه أكثر من الإبداعي اللغوي. ورغم ذلك، من المشكلات الشائعة في الترجمات العلمية الاقتصار على تسليمها لأساتذة العلوم الطبيعية، كونهم الأدرى بها والأقدر على فهم مضامينها المعقدة، ولكن الإشكال يأتي من أن معظم هؤلاء المتخصصين ليسوا على دراية عميقة بعلوم اللغة، وبالتالي قد يقعون -أحيانًا- في أخطاء كثيرة في الكتابة والأسلوب، كما أنهم ليسوا دومًا متمكنين من اللغة التي ينقلون منها.[30] ويندرج ضمن هذه الفئة كثير من أنواع الترجمة المنتشرة حديثًا، و منها ترجمة المجلات العلمية والمقالات الأكاديمية إلى العربية، التي تمارسها كثير من المجموعات التطوعية في الإنترنت والمواقع الرقمية. الترجمة الأدبية تغطي الترجمة الأدبية نقل أي عمل فني أو إبداعي من لغةٍ إلى أخرى، وبالتالي، فهي تتضمن: ترجمة الكتب، والروايات، والمسرحيات، والشعر، والقصص المصورة، والمانغا، والأفلام، والمسلسلات التلفزيونية، والكرتونية. والسمة الأساس لجميع هذه الأعمال أنها مقترنة -إلى أبعد الحدود- بثقافة أجنبية، ولهذا فإن ترجمتها تستلزم خبرة ودراية هائلة باللغتين (المنقول منها وإليها)، وإلى اطلاع كبير على الثقافات الأجنبية، بل وعلى نظرية الترجمة. ولعل الترجمة الأدبية هي أصعب أنواع الترجمة وأكثرها استنزافًا للوقت والجهد.[31] فمن المتوقع من المترجم الأدبي الجيد أن يكون قادرًا على فهم الإشارات الثقافية والحيل اللغوية في الأصل، وعلى ترجمتها أو تعويضها ببديل عنها، إذ لا يكفي أن يترجم المعاني الحرفية. فعلى سبيل المثال: قد تحتوي كثير من الأفلام الأجنبية على إشارات إلى الثقافة الأمريكية يصعب على المشاهد العربي فهمها، وقد تتضمن كثير من الروايات أشعارًا بلغات وأوزان مختلفة عن الشعر العربي، وفي مثل هذه الأمور امتحانٌ لا يستهان به لقدرات المترجم الأدبي وسعة حيلته وخبرته باللغات. في الترجمة الأدبية -خصوصًا- موضوع كبير يستغرق نقاشًا بين المترجمين؛ وهو ترجمة الكلام حرفيًّا، أم التصرّف فيه. والمعضلة هنا هي أن لكل أديب صبغةً متفردة جدًّا تختص بها كتاباته، ولا سبيل لحفظ هذه الصبغة (أو شيء منها) إلا بالترجمة الحرفية، وأسلوب المؤلف ليس مشكلةً في أنواع الترجمة التي سبقت؛ لأن تركيزها على المحتوى، وأما تركيز الترجمة الأدبية فهو على الجمال والأسلوب. وسنعود إلى الحديث عن هذه المشكلة مرات عدة. أساليب حداثية للترجمة أنواع حسب النصوص التي تأتي بها -كما سلف- وكذلك حسب الأسلوب المعتمدة في الترجمة. والطريقة الأبسط وربما الأجود للترجمة هي الترجمة اليدوية، مع الاستعانة بالمعاجم والمراجع، وبها تترجم معظم الكتب والمؤلفات والمطبوعات المنشورة، وتكون مسؤولية المترجم في هذه الطريقة هي قراءة نص بلغة يتقنها وترجمته كاملًا إلى لغة أخرى. على أن في الترجمة -أيضًا- طرقًا حداثية شاعت بعض الشيء، فأصبح بعضها شرطًا ضروريًّا وملزمًا في العمل المهني، ومن أهمها ما يسمى خطأً "الترجمة الآلية". الاستعانة بالآلة نشأ في مدينة الكوفة أيام العباسيين عالم اسمه "يعقوب بن يوسف"، وكان ابنًا لشيخ من شيوخ قبيلة كندة العربية، فلُقب بـ"الكندي". ولمع اسم الكندي في الفلسفة والعلوم، ولفتَ انتباه الخليفة المأمون فجعله رئيسًا لبيت الحكمة -آنذاك- وما فيه من ترجمة حثيثة للعلوم والفلسفة اليونانية إلى العربية، وينسب إلى "الكندي" الفضل في نقل الأرقام الهندية إلى اللغة العربية (ومنها إلى أوروبا فيما بعد)، ولعله استمد من عمله هذا اهتمامًا بالأرقام والشفرات؛ التي سميت دراستها وقتئذ "علم التعمية"، فطوَّر الكندي في هذا العلم أساليب إحصائية تستنبط اللغات التي كتب بها النص وتهيئ لترجمتها أو فك شفرتها. وبعد وفاته بأحد عشر قرنًا، وظف عالم رياضيات أمريكي اسمه "وارين ويفر"[32] أبحاث الكندي[33] في اختراع "الترجمة الآلية"، فنجح في ذلك عام 1949. أولت الحكومة الأمريكية هذه التقنية اهتمامًا شديدًا؛ أملًا بأن توظفها في ترجمة النصوص الروسية إلى الإنكليزية آليًّا لتحقيق مصالحها في الحرب الباردة، ولكن برامج الترجمة البدائية آنذاك اعتمدت على استبدال كل كلمة من اللغة الروسية بكلمة إنكليزية تقابلها في المعنى، وهو خطأ منهجي أعطى الترجمة الآلية سمعة رديئة لحقت بها[34] لنصف قرن، أو أكثر. لكن الزمن تغير، وأصبحت الاستفادة من الترجمة الآلية مهارة مرغوبة ومطلوبة في مجالات العمل الحديثة بالترجمة، وخصوصًا لدى الشركات والمؤسسات الأجنبية، والسبب في هذا ليس نابعًا من جودتها، وإنما من سرعتها وقلة تكلفتها. على أنه ينبغي التفريق هنا بين "الترجمة الآلية" (Machine translation) و"الاستعانة بالآلة" (Computer-assisted translation)، ففي الحالة الأولى تبقى مهمة الترجمة بيد الآلة من الألف إلى الياء، وفي الثانية يستعين المترجم بالآلة كأساس يعمل على تحريره وتنقيحه.[35] والفكرة الأساس التي تقوم عليها الترجمة الآلية هي أن معظم الجمل المستخدمة في اللغة، وخصوصًا في المنشورات المهنية، تتسم بتكرار كبير لتراكيب نحوية ومعجمية مقاربة، وبالتالي لا يحتاج المترجم لإضاعة وقته بإعادة ترجمتها مرة تلو الأخرى.[36] فأهم ميزة لهذه البرامج -على الأرجح- هي أنها تحفظ قاعدة بيانات شاملة لجميع المفردات والجمل الأجنبية وترجماتها التي اختارها المترجم سابقًا، وتسمى هذه البيانات "ذاكرة الترجمة" (Translation memory)،[37] وكلامنا في نهاية المطاف هو تكرار لعدد محدود من المفردات والتراكيب اللغوية، ولذا فإن ذاكرة الترجمة تسمح للمترجم -نسبيًّا- بالاكتفاء بعمله السابق، وكذلك بتوحيد المفردات والصيغ التي يكتب بها.[38] وقد تخفِّض البرامج التي فيها هذه الميزة وقت الترجمة إلى النصف تقريبًا، فتزيد من ربح المترجم -في كل ساعة عمل- إلى الضعف أو نحوه. وتتضمن بعض من هذه البرامج ميزات جيدة أخرى، منها: تقييم جودة الترجمة، واكتشاف الأخطاء اللغوية، والوصول الفوري إلى المعاجم والقواميس (لمراجعة معاني المفردات)، والوصول إلى قاعدة بيانات عملاقة من ذواكر الترجمة التي استخدمها مئات أو الآلاف منهم قبلك. على أن الاعتمادية المفرطة على برامج الترجمة لها مشكلاتها، فهي تحصر اختيارات المترجم في الصياغات السهلة والركيكة، بدلًا من تشجيعه على تطوير أسلوبه البلاغي وملكته اللغوية؛ مما قد يكون مضرًّا بمن يهتم بإتقان الترجمة جماليًّا وفنيًّا. من أشهر برامج الترجمة الآلية المستخدمة في الشركات الاحترافية (لو أردت الاطلاع عليها أكثر) ما يأتي: OmegaT: برنامج مجاني مفتوح المصدر، وهو متخصص ببناء ذاكرة للترجمة، وموجه نحو المترجمين المحترفين في قطاع العمل. SDL Trados Studio: أكثر البرامج استخدامًا وانتشارًا في سوق العمل الاحترافي، يتضمن جميع الميزات والإضافات التي يحتاجها المترجم، وتكلفته ليست أقل ثمنًا من فوائده. Wordfast: إضافة يمكن إلحاقها ببرنامج مايكروسوفت وورد لتحويل أي مستند إلى تنسيق مناسب للترجمة، وهو موجه للمترجم الحر وكذلك للشركات الكبرى. واجهة برنامج OmegaT للترجمة المحوسبة، وهو برنامج مجاني ومفتوح المصدر، واوجهة استخدامه معربة كاملة. منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY الترجمة التلخيصية بالنظر لصعوبة الترجمة الأدبية؛ فقد ابتدع الشغوفون بها من الأدباء طرقًا مبتكرة لتجديدها وتيسيرها، ومن أهم ما تطرَّق إليه المترجمون العرب فيها الترجمة التلخيصية. ومبدأ الترجمة التلخيصية هو؛ أن الأدب لا يأتي عفويًّا وطبيعيًّا إلا لو صاغهُ الكاتب من بنات أفكاره ومن وحي ذهنه، إذ إن البراعة في الترجمة العربية هي أن "يشعر القارئ أنها كُتبت أصلًا باللغة العربية"،[39] والحلّ لهذا هو أن يعتزل المترجم مسؤولية الناقل الأمين وأن يتوجه للتلخيص، فيقرأ كتابًا كاملًا ومن ثم "يعيد تأليفه" بأسلوبه الشخصي، حسب فهمه واستيعابه، فتأتي ترجمته وكأنها كتاب عربي أصيل. ومن أشهر من جروا على هذا المنهج الأديب المصري دريني خشبة، الذي ترجم العديد من الملاحم الشعرية الإغريقية (وأهمها الإلياذة والأوديسة) بإعادة ترتيب أحداثها وفصولها، وباختصار أحداثها بحسب ما رآه مناسبًا للقارئ العربي، حتى انتهت نسخته من الإلياذة بمئتي صفحة، وصفحاتها لدى غيره من المترجمين تتجاوز السبعمئة. وقال دريني خشبة يصفُ رأيه في منهجه بالترجمة: وجرى الأديب المشهور مصطفى لطفي المنفلوطي على هذا النهج كذلك، فلخص من خلاله كثيرًا من الروايات الأوروبية وأخرجها وكأنها عربية أصيلة، فعدَّل تفاصيلها وعناوينها، بل إنه لم يذكر دومًا أصول هذه الترجمات أو مؤلفيها الأجانب، ومن أشهر ترجماته: "الفضيلة" و"تحت ظلال الزيزفون" و"بول وفرجيني" و"الشاعر".[40] وقد تلقت الترجمة التلخيصية نصيبها من الانتقادات بين الأدباء العرب، ممن وجدوا في التلخيص تحويرًا للأدب الأصلي وعبثًا به، ومن أهم هؤلاء: سليمان البستاني، وهو مترجم آخر اعتكف على نقل ملحمتي الإلياذة والأوديسة إلى اللغة العربية شعرًا (وهو عمل شاق وعسير جدًا)، وبالتالي كانت له أسباب قوية للتوجس مما لحق بهاتين الملحمتين بعده من ترجمة تلخيصية، فيقول في نقد أصحاب منهج التلخيص: خطوات الترجمة لا تنحصر وظيفة المترجم في فهم اللغة التي يترجم عنها (SL)،[43] بل عليه -أيضًا- إتقان الكتابة باللغة التي يترجم إليها (TL)[44] إتقانًا احترافيًّا بل وأدبيًّا، إذ يمكننا القول -من زاوية ما- أن المترجم ليس إلا كاتبًا يتقن لغات عدة، والتغاضي عن مهارة الكتابة سببٌ لانتشار الترجمات الرخيصة الركيكة، فمن المحتمل أن من كتبوها كانوا بارعين جدًّا في اللغة التي يترجمون عنها؛ إلا أنهم قد لا يجيدون الكتابة بلغتهم الأم، وبهذا أتقنوا خطوةً واحدةً من الترجمة فحسب. ويرى الباحثون أن الترجمة تسير دومًا بترتيب من ثلاث خطوات متوالية تتكامل معًا:[45] القراءة: وهي أن يقرأ المترجم النص الأصلي لاستيعاب معناه وفهم دلالته بعمق يتجاوز القارئ العادي. ويعمد المترجم هنا إلى المعاجم ليفهم المعاني الظاهرة للنص، فضلًا عن العودة إلى المراجع الأخرى لفهم معانيه الخفية ودلالاته الثقافية.[46] وتحتاج هذه الخطوة إلى إلمام لغوي واطلاع عام لن نتطرق إليه بعمق في سياق هذا الكتاب، ولكننا سنتطرق إلى بعض جوانبه بخصوص الأقلمة الثقافية في الفصل الأخير. السَّبْك: وهي مرحلة وسطى، يتمعن فيها المترجم بما قرأه ويفكر بصياغته الأنسب في لغة أخرى، وهذه هي المرحلة التي يجب أن يستغلها في تفكيك المعاني الحرفية للكلمات، وتكييفها بما يتناسب مع قواعد اللغة التي ينقل إليها. وأما الإسراع إلى المرحلة الثالثة دون تفكير؛ فهو السبب المباشر للترجمة الحرفية.[47] وهذه الخطوة موضوع جوهري يناقشه الكتاب كاملًا. الكتابة: وهي كتابة الجملة الجديدة باللغة المنقول إليها[48] وتعديلها وتحريرها، وسيأتي ذكرُ ذلك في بعض فصول التعريب. خطوات الترجمة الثلاث. منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY المعضلة العصية على المترجم في هذه الخطوات أن يتقمص دور الكاتب، ومثل كل كاتب؛ فهو مضطر إلى الاختيار بين آلاف الألفاظ والمفردات التي قد يعبر فيها عما يريد، ومهمته هنا أسهل من الكاتب؛ لأنه يسترشد بالمعاني الواردة في النص الأصلي، لكن هذه المعاني لن تكفي للاحتكام إليها في قراراته، لأن على المترجم أن يصطدم مرة تلو الأخرى بمعضلة كبيرة حيرت المترجمين منذ نحو ألفي عام، فتضعه أمام خيارين: إما أن يفضل حِفْظ روح النص البلاغية، والمعنوية، فيترجمه حرفيًّا؛ لحفظ معناه، وإيحائه، مثل: نقل كلمتي "Our savior" إلى "مُخلِّصنا". أو أن يفضِّلَ الكتابة بلغة عربية طبيعية، وكأن النص جاء عربيًّا، فيقول: "الرّب" أو "الله" لكنهما المصطلحين المتعارف عليهما في هذا السياق. ولكل من هاتين الطريقتين مدرسة تؤيدها، وتدعمها منذ مئات او آلاف السنين، مثلما سوف يأتي فيما بعد.[49] وعلى كل مترجم -في وقت ما- أن يختار موقفًا يعبر عنه من هذا الخلاف، على إحدى النهايتين المتطرفتين: إما الترجمة الحرفية الحريصة على التقيد بالأسلوب الأصلي، أو الترجمة الحرة التي تفضل بالمعنى. ولهاتين المدرستين هدفان مختلفان، هما: الهدف الجمالي (صون جمال النص، واللغة، وتدفقه، وسلاسته، وسلامته من الأخطاء)، والهدف الدلالي (الدقة، والأمانة في الالتزام بالمعنى الأصلي، وبمزاياه الأدبية، كما أرادها المؤلف). تفضيل الأسلوب يشعر كثير من المترجمين بأهمية صون روح النص الأصلي للقارئ بدافع الأمانة، وهذا الأمر مستحيل في الواقع، لأن أسلوب الكاتب الأصلي يأتي -طبعًا- ضمن حدود لغته الأم، إلا أن أساليب التعبير والبلاغة وبناء الجمل والأفكار؛ تختلف اختلافًا جمًّا بين اللغات، ولهذا فإن محاولة تقمص أسلوب النص الأصلي تعني -إلزامًا- التطرف نحو الترجمة الحرفية، واستيراد صيغ وتراكيب غير مرغوبة من لغة أجنبية. وكثير من المترجمين والباحثين من يدعمون الترجمة بشيء من الحَرْفية، فهم يرون أن الترجمات يجب أن تأتي بلغة غريبة وغير سلسة؛ وذلك لكي تحفظ روح الغربة في الترجمة. فهؤلاء يرون -مثلاً- أن مسرحيات شكسبير المترجمة إلى الفرنسية لا يجب أن تظهر وكأن كاتبها فرنسي، بل من المطلوب أن يشعر القارئ بأنها نقلت عن لغة أجنبية. تفضيل المعنى ويميل مترجمون آخرون (وكذلك يميل الرأي الذي يقدمه هذا الكتاب) إلى ضرورة إشعار القارئ بأنه يقرأ نصًّا بلغته الأم وكأنه كُتبَ فيها؛ ولم يترجم عن لغة أخرى، وهذه الطريقة تعطي الأولوية للمعنى على الأسلوب والتعابير الدخيلة التي استخدمها المؤلف الأصلي. وتتلخص وجهة النظر هذه بما قالهُ "مارتن لوثر" عن ترجمته للإنجيل لأول مرة إلى اللغة الألمانية: فقد أراد أن يفهم عامة الناس من فلاحين وحرفيين كلام الإنجيل، كما لو أنهُ يقال باللغة نفسها التي يتحدثون بها في بيوتهم وبين أهاليهم. ووفقًا لهذه الطريقة تكون للمترجم حرية التصرف بالترجمة، وتغيير الجمل والتراكيب اللغوية التي يراها عصية على الفهم على أبناء لغته،[50] فهو ليس مجبرًا على الالتزام بمواضع علامات الترقيم أو مواضع الكلمات نفسها التي اختارها مؤلف الكتاب الأجنبي (على سبيل المثال)، بل له كامل الحق في تغييرها لتتناسب أكثر مع اللغة التي يترجم إليها. وهذا لا يعني أن للمترجم حقًّا بتعديل النص على هواه، فلابد من أن يحفظ جوهره وتسلسل أفكاره الأصلي، أما الكلمات والجمل فله إعادة صياغتها بحسب ما هو أنسب وأقوم. وسنتناول هذا الخلاف الكبير في الترجمة بشيءٍ من التفصيل، وسوف نبدأ بنبذةٍ عمَّا قاله فيه العرب والمسلمون. إذ إنهم أولوا هذا الخلاف الطويل نصيبه من الاهتمام؛ حينما شرعوا بواحدة من أكبر حملات الترجمة في التاريخ. _____ اقرأ أيضًا المقال التالي: النسبية اللغوية والترجمة: هل تؤثر اللغة على أفكارنا؟ المقال السابق: كتب تزن ذهبا: تراث العرب والترجمة
-
تناولنا في مقالات سلسلة الترجمة والتعريب موضوعات الترجمة من زوايا عدة، من ضمنها الزاوية الأكاديمية (في مقال نظرية الترجمة) وخصوصياتها الدلالية والصرفية (في مقال تعريب المفردة)، وما لها من خصوصيات قواعدية ونحوية (في مقالي تعريب التراكيب والجمل)، وقد ناقشنا بعض مشكلات الترجمة؛ وأهمها النزاع القائم بين الحرفية والتصرّف. على أن في الترجمة معضلات أخرى أوسع، تعود إلى اعتبارات الثقافة واللغة كاملة، والتي يجدر بالمترجم أخذها في الحسبان، فهي أقرب إلى مبادئ عامة تحكم عمل المترجم وترشده، وقد ترى في الصفحات القادمة أن كثيرًا من هذه المعضلات ليس فيها رأي واضح بين الباحثين وليس لها حل واحد معروف، لأنها تتعلق بدراسة الثقافة الإنسانية بمجملها، على أن الاطلاع عليها -على الأقل- يبقى مهمًا للمُعرّب. الحرفية والتصرف ما زال الهم الأكبر للمترجمين إلى الوقت الحاضر متمحورًا حول الخلاف الذي نشأ في مدارس الرومان واليونان والعرب (بين ابن إسحاق وابن البطريق) منذ مئات السنين، وهو ترجمة الكلام مفردة بمفردة "حرفيًّا" أو ترجمة معنى كل جملة "بتصرّف". وفيما سلف من مقالات هذه السلسلة، ميل واضح نحو منهج التصرّف والحرية وذمّ للحرفية، لكن المترجمين ليس بينهم إجماع حتى اللحظة على منهج محدد من ذينك المنهجين دون الآخر، بل لكل منهما حسناته وسيئاته التي يشيد بها الباحثون. فخير الأمور أوسطها، ولعلّ أوسط الأمور أصعبها. نالت الترجمة بتصرّف تأييدًا من كبار المترجمين منذ العصور القديمة، ولهذا سبب واضح؛ هو أنها تُفضّل "القارئ" على الكاتب، فالمهم بحسب هذا المنهج هو أن نضع بين يديه نصًّا يقرؤه كما لو كُتب بلغته هو، ولهذا يتفاخر بعض المترجمين بأنهم يترجمون ما قيل بلسان أعجمي، وكأنه قيل أصلًا بلسان عربي (أو إنكليزي أو فرنسي أو غيرهما).[1] ويرى بعض الباحثين أن هذا هو المنهج الأنسب في الترجمة، حينما يمسّ النص حياة القارئ اليومية، مثل: أن يكون إعلانًا أو دليلًا سياحيًّا، لكنه ليس بالضرورة المنهج الأنسب في كل مكان وزمان.[2] وأما الترجمة الحرفية (واسمها نفسه هو ترجمة "حرفية") فقد تلقّت ذمًّا ونقدًا من مدارس للترجمة في شتى العصور، فنرى صلاح الدين الصفدي ينتقد أتباعها أشدّ انتقاد؛ ويشيد بمن خالفهم، ومثله القديس جيروم ومارتن لوثر وجون درايدن وغيرهم، لكن كثيرًا من الباحثين المعاصرين، يرون ضرورة الحرفية في الترجمة، بل ربما تكون المنهج السائد بينهم حاليًّا.[3] أساس الترجمة الحرفية هو الالتزام بما جاء في الأصل كلمة بكلمة، ونقل أسلوب الكاتب بأمانة دون تلاعب فيه ولا إخلال بهويته، أي أن الأولوية هنا هي للمؤلف (من حيث صون أسلوبه) وليس للقارئ (من حيث يسر تجربته)، ولهذا يرى كثيرون أن هذا هو المنهج الصحيح في ترجمة الأدب؛ لأن قيمة الأدب تأتي من أسلوب المؤلف وقلمه المميز، وأما لو تُرجم إلى لغة يألفها القارئ فقد يمسي مثل أي نص سواه.[4] تتفاوت شدة معضلة "الحرفية" و"التصرف" حسب طبيعة عمل المترجم، إذ إن الترجمة تقع -دائمًا- بين لغتين، وكلما تقاربت هاتان اللغتان كان من الأسهل إجراء الترجمة بينهما بسلاسة، ودون إخلال بأسلوب المؤلف.[5] ومن السهل مثلًا الترجمة بين الإسبانية والفرنسية بإتقان، واعتدال بين منهج الحرفية والتصرّف، لأن هاتين اللغتين تشتركان بكم هائل من المفردات؛ وبقواعد كثيرة في النحو والصرف، لكن العربية بعيدة جدًّا عن كل اللغات الأوروبية، فهي من عائلة اللغات السامية (مثل العبرية والآرامية والسريانية)، وأما لغات العالم الغربي فمعظمها من العائلة الهندو أوروبية. وتختلف -لذلك- العربية عن الإنكليزية في أمور كثيرة، تتجاوز قواعد اللغة ومعانيها، ولهذا فإن نتاج الترجمة الحرفية فيها أسوأ أثرًا، ولا يفيد القارئ كما رأينا في أمثلة كثيرة، كما تزداد صعوبة الترجمة بين العربية والإنكليزية؛ لما بينهما من تباعد ثقافي شاسع، فعلى المترجم أن يبدع ويستعين بموهبته لتعويض ما يضيع من معنى ببدائل تحل مكانه، ولهذا يلجأُ إلى أساليب في التكييف منها: التصريح والأقلمة والاستعاضة، وهي كلها أمور لا يقتصر هدفها على ترجمة المعنى، وإنما الثقافة التي يختزلها أيضًا.[6] التصريح والتضمين نادرًا ما يمضي يوم دون أن يسمع العربي جملة "إن شاء الله"، وهي جملة مشهور لها معنى صريح هو: الاحتكام لمشيئة الله. على أن أي ناطق بالعربية يعرف حينما يسمعها أن لها عشرات المعاني المبطّنة؛ من المجاملة والتهرّب والاعتذار عن عمل الشيء، كأن يُقال: "متى تدفع لي الإيجار؟" فيجيب المستأجر الغارق في الديون: "قريبًا إن شاء الله"، ويفهم القارئ هنا أن المعنى المُبطّن تقريبًا هو: "حين يأتيني مال" أو "حتى أجل غير مسمى". ولو ترجمنا جملة "قريبًا إن شاء الله" بمعناها الحرفي فربما لا يفهم أبعادها المقصودة قارئ صيني أو سويدي، لذا قد يضيف المترجم إلى هاتين اللغتين تفسيرًا أو حاشية لما جاء من معنى مبطن، ويسمى هذا التصريح،[7] أي أن يُقال بواحًا ما نوى الكاتب قوله ضمنًا. وهذا يطرح تساؤلًا كبيرًا في الترجمة: فهل الأصح هو ترجمة النص بمعناه الضمني أم بالتصريح بما فيه؟ يختلف معنى النص الحقيقي -في كثير من الحالات- عن معناه الظاهر، فقد تطلب من شخص أن يذهب معك إلى مكان فيرد قائلًا: "أنا متعب"، ويفهم المستمع أن هذه الجملة بمثابة القول: "لا أرغب بالذهاب"، وهذا معنى ضمني لا حاجة للمجاهرة به لأن عموم الناس يفهمونه.[8] لكن المعاني المبطنة لها خصوصيات ثقافية واجتماعية، فلا يفهمها القارئ دومًا بلغة أخرى، مثل الحال عند التلاعب بالكلمات والألفاظ، إذ تستخدم كلمة مكان كلمتين عمدًا، بينما قد يجمعهما المترجم مرة أخرى في كلمة واحدة، تدل على المعنى بوضوح لم يرغب به المؤلف، وهذه مجاهرة[9] بما كان على القارئ أن يفهمه من السياق.[10] يزعم بعض الباحثين أن الترجمة -بطبيعتها- تستلزم التصريح وتشجع عليه،[11] لأن المترجم ينبغي أن يبدأ بفهم المعنى الضمني لما يود ترجمته ثم يعيد تفسيره بلغة أخرى، فينحو بسبب ذلك إلى نقل المعنى صريحًا -كما فهمه- لا مضمنًا. والتصريح له هنا حالتان:[12] تصريح اختياري: يلجأُ إليه المترجم إن رأى ضرورة مثل: أن يفسر المترجم للقارئ جملة "إن شاء الله" أو أن يشرح مزحة تحتاج اطلاعًا مسبقًا لفهمها، ويزعم بعض الباحثين أن الترجمة في جميع اللغات تشجع على زيادة التصريح بهذه الأساليب. تصريح إجباري: تلزم به قواعد اللغة مثل: أن المتحدث بالإنكليزية قد يقول "I'm sorry" دون تحديد ما إن كان صاحب الضمير "أنا" ذكرًا أم أنثى، بينما على الترجمة العربية أن تصرح بالقول: "أنا آسف" أو "أنا آسفة". وهذا تصريح زائد لا حيلة للمترجم فيه لأن اللغة تسيره. وقد نالت مسألة التصريح في الترجمة قدرًا عظيمًا من البحث فأشبعت اهتمامًا ودراسة،[13][14] ومن أهم الاكتشافات التي حققتها أبحاث الترجمة هي أن معظم النصوص المترجمة تستبدل بالمعنى الضمني معنى صريحًا[15] فتكشف عما يخفيه المؤلف في كتابته من تلميحات مبطنة بالشرح والتفسير،[16] ولهذا السبب قد تطول كثير من الترجمات موازنةً بأصلها.[17] ومن مبررات هذا السلوك (أي إطالة الترجمة موازنةً بالأصل) أن جمهور الترجمة أقل ضلاعة بموضوعها عادة، فهم يحتاجون شرحًا إضافيًا لاستيعاب مبلغ الكلام،[18] مثلًا: يأتي النص الآتي في رواية "صورة دوريان غريه" للمؤلف "أوسكار وايلد": يعرف قراء رواية "صورة دوريان غريه" (بلغتها الأصلية) أن "اللورد هنري" من الأثرياء لأنه يقيم في حيّ مايفير، لكن قراء الترجمة قد لا يعون ذلك. - منشورة تحت ترخيص CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز Dorian Gray was reclining in a luxurious arm-chair, in the little library of Lord Henry's house in Mayfair وقد يختار المترجم إحدى طريقتين في تعريب هذه الجملة، من حيث التصريح أو التضمين بمعلومة أخفاها المؤلف:[19] [تضمين]: كان دوريان جراي جالسًا في استرخاء على مقعد كبير وثير بمكتبة اللورد هنري في بيته بحي مايفير.[20] [تصريح]: كان دوريان جراي جالسًا في استرخاء على مقعد كبير وثير بمكتبة اللورد هنري في بيته بحي مايفير الراقي الذي يسكنه أثرياء لندن. على أن المبالغة بالتفسير قد تضيع مقصد المؤلف، لأنه ربما يتعمد إيصال المعنى بكلمة واحدة مبهمة، بدلًا من بسطه أمام القارئ وكشف كل مقصده؛ وقد يضطر المترجم إلى أن يستبدل بهذه الكلمة جملةً مطولة، لأن الكلمة لا مقابل لها بلغته، فيقع في فخ التصريح.[21] والتصريح مسألة خلافية كبيرة في الترجمة، فعليها مآخذ كثيرة لأن فيها تقوُّلًا على لسان المؤلف، وتفسيرًا ربما يخالف نواياه ومقاصده، وفي الوقت ذاتِه فإن الكلام الضمني لا يجوز نقله بين الثقافات حرفيًّا، إذ قد يلزم التصريح عن شيء منه. ولسنا هنا بصدد تقديم إجابة لمعضلة عويصة، وإنما لعرض وجهات النظر حولها التي تؤخذ بعين الاعتبار، مثلها في ذلك مثل معضلات أخرى كثيرة، لعل من أشهرها كيفية التعامل مع "الجنس" تذكيرًا وتأنيثًا. مؤنث ومذكر من المشاكل ذات الشأن في عصرنا كيفية "تحييد" الجنس في اللغة، لما ينطوي عليه -عادة- من تمييز واستبعاد للمؤنث في أحوال كثيرة، وهو أمر يتطرق إليه كثيرون في هذا العصر. ويرى بعض أساتذة العربية أن الضمائر المحايدة لا مكان لها أو لا حاجة إليها في لغة العرب، ومن ذلك ما يورده أحد الأساتذة في رسالة له[22] عن أن التأنيث هو علامة مضافة إلى الكلام، عُدّت منها خمس عشرة علامة، وما خلاها فهو مذكر بالأصل والمؤنث فرع منه «كما خُلِقَت حواء من آدم». وهذا ليس بالقول الجديد، فقد قال سيبويه منذ أكثر من ألف ومئتي عام: «إن أصل الأشياء كلها التذكير ثم تختص بعد». ويقول الباحث الفلسطيني إلياس عطا الله:[23] «لا حاجة لإجراء عمليات تجميلية في اللغة العربية وأضرابها»، قائلًا: إن التغليب في اللغة العربية «لصيغة المذكر لا للذكر نفسه». وحُجّة هذا الأمر هي اختلاف الجنس الحقيقي (مثل المؤنث في "أم" والمذكر في "أب") عن الجنس المجازي[24] أو الصرفي (مثل المؤنث في "السماء" والمذكر في "الرعد"). لكن هذا الرأي يُنقصُ من دور المرأة بـ"وأد عاطفي واجتماعي" كما تقول أديبة عصر النهضة "عائشة بنت الشاطئ"،[25] فهو لا يتماشى مع متطلبات زمننا الذي يدعو إلى الحرية والمساواة، واللغات الحديثة تستجيب للدعوة لحقوق المرأة وتغير خواصها الذكورية باستحداث الضمائر المحايدة، فأصبحت هذه الضمائر من أهم مشكلات الأدب والأكاديميات الحديثة. يدعو التيار الحديث بعمومه إلى المساواة بين صيغتين التذكير والتأنيث أو الاستعاضة عنهم بضمائر محايدة، وهي ضمائر لعلها تنقص -فعليًا- من أكثر اللغات، إذ إن العربية ليست حالة مميزة أبدًا في تفضيلها "للمذكر"؛ سواء أكان ذلك تفضيلًا للذكر أم لا. ولهذا السبب قرر جمهور الكتاب باللغة الإنكليزية الاستعاضة عن كلمة "he" (التي كانت تعتبر في الماضي كلمة "محايدةً" تصف الجنسين) بـ"they"، والأصل أن الكلمة الأخيرة هي للجمع حصرًا، لكن درج استخدامها الآن في محل المفرد لأن المذكر والمؤنث يجتمعان فيها بصيغة محايدة. وهذا الحل ليس سائغًا في اللغة العربية، فجميع الضمائر وأسماء الإشارة العربية (ما عدا ضمائر المتكلم، "أنا" و"نحن") تميز بين الجنسين، ومنها: هم وهنّ وأنتم وأنتنّ وأنتَ وأنتِ وهذا وهذه. وهلمّ جرّا.[26] وليس هذا فقط: بل إن كل الأسماء العربية لها جنس مذكر أو مؤنث، وكل الأفعال لها شكلان يتطابقان مع جنس الاسم، وعلى هذا فإن اتباع الأسلوب الحداثي والنسوي في العربية يكاد يكون مستحيلًا حتى ولو أراده الكاتب والمترجم،[27] فقد يُقال في جملة من بضع كلمات: "على المسافر/ة أن تـ/يحمل معه/ا وثائقه/ا دومًا". ومن الطرق القليلة التي فيها مخرج من هذه المعضلة هي الأفعال المبنية للمجهول، وهذا ما تنحو إليه كثير من الترجمات التجارية، وهو ما يجعلها -كذلك- غريبةً وصعبة القراءة، فمن ذلك أن يقال في تعليمات منتجٍ ما: "يُغسل الشعر بالشامبو برفق ثم يُدهن بكريم الفيتامينات" أو "تُؤخذ حبة واحدة من الدواء ثلاث مرات يوميًا".[28] والطريقة الأخرى التي يدعو إليها بعض الباحثين هي اللجوء إلى ضمير المتكلم (أنا أو نحن)، لأنها فئة الضمائر الوحيدة في العربية المحايدة جنسيًا،[29] فنقول: "علينا أن نحمل معنا وثائقنا دومًا عند السفر". وللباحث إلياس عطا الله اقتراحات متعمقة في هذا السياق لتحييد جنس الكتابة العربية، دون الإخلال بأصولها النحوية والصرفية، وقد فصّل هذه الأفكار في كتابه "التذكير والتأنيث في اللغة"، ومن الحلول التي يقترحها: استخدام الخط المائل (كحال: "كاتب/ة")، وضمير "نحن" لحياديته الجنسية، وأسمنة الأفعال لتحييدها ("على الطالب أن يُعدّ واجبه" ← "المطلوب إعداد الواجب")، وصيغة المبني للمجهول ("تؤخَذ حبة من الدواء يوميًّا")، كما ويدعو للاستعاضة عن بعض المسميات الذكورية ببدائل عامّة (مثل "لجنة الآباء" ← "لجنة أولياء أمور الطلبة" و"غرفة المعلمين" ← "غرفة الهيئة التدريسية").[30] والجنس المحايد ضروري في الاستخدام الحديث للغة وحاجة ماسة لاستمرارها وازدهارها، فالضمائر الذكورية أمست مشكلة حقيقية في اللغة ولا يجوز التحجج أو التهرب منها بمبررات واهية مثل: أن "الأصل هو التذكير" (فلماذا لا تنعكس الآية ويغدو الأصل هو التأنيث؟). على أن هذه مشكلة واسعة لا تقتصر أساسًا على اللغة العربية، وإنما طالت معظم اللغات الحديثة التي فيها تصريفات للأفعال، مثل الألمانية واللغات الرومانسية وغيرها،[31] فكلما زاد التصريف باللغة استحال تحييدها، والعربية من أكثر اللغات تصريفًا. والحل لهذه المشكلة ليس بيد مترجم ولا كاتب وحيد، ولكن عدم إمكانية حلها بعمومها لا يعني التغاضي عن تحييد الجنس في السياقات التي تسمح به، ولا عن محاولة نقل الضمائر المحايدة في الأصل الأجنبي نقلًا واعيًا حين التعريب، وهو مبدأ من مبادئ الأمانة والأخلاقية في مهنة المترجم. أخلاق المهنة المترجم هو الوسيط الوحيد بين القارئ الذي يتصفح الكتاب بلغته، والمؤلف الذي كتبه بلغة أخرى، وهذا يضع مسؤولية أخلاقية كبيرة على عاتقه: فهو كاتب يتحدث بلسان المؤلف ويزعم أنه ينقل أفكاره ومقاصده، وهو يتحمل -إذًا- وزر أي غلطة أو تقصير في هذا النقل. ويرى الباحثون أن المترجم كاتب، فهو يعيد -عمليًّا- تأليف نص بلغة جديدة وقد يصعب عليه (مهما حاول) أن يتجنب إضافة آرائه الشخصية إلى ما يكتبه، وألا يعدل الأصل قصدًا أو عفوًا ليتوافق مع شروط لغته الأدبية[32] والثقافية، وهذا الأمر من أكبر التحديات التي عليه تذليلها. على المترجم -بديهيًّا- أن يلتزم الأمانة، وقد رأينا أن الحرص على الأمانة لا يحول دون بعضٍ من التصرف بالترجمة، ولكن هذا لا يعني أن يتعمد الإخلال بمعانيها تأثرًا بأفكاره أو ميوله أو هواه. من أكبر المشكلات الأخلاقية والمهنية في الترجمة حذف النص وتغييره، وقد يبرر هذا السلوك بحجة العُرف المجتمعي والديني والسياسي، لكن إذا ظن المترجم أن الكتاب أو المقال أو القصة التي بين يديه لا تليق بثقافته فله أن يعتزل تعريبها منذ البداية لا أن يُحوِّر معانيها ومشاهدها، ولا سيما إن كانت الترجمة لعمل أدبي.[33] وتثبت الدراسات أن المترجم لا يستطيع التخلي عن نظرته، وأفكاره المسبقة واللاواعية حينما ينقل نصوصًا من ثقافات أخرى، فقد يستبعد (بقصد أو بلا قصد) بعضًا من أفكار الكاتب حينما يحاول تقريبها إلى القارئ،[34] ومن المحال فصل المترجم عن ترجمته مهما حاول واجتهد.[35] وتتجلى هذه المشكلة بوضوح في الكتب التي تتناول موضوعات فلسفية أو دينية باللغة العربية، أو ما يُظن أنه يمس الدين والعقيدة، مثل: استبدال الكلمات التي تشير إلى نظرية التطور الدراوينية بكلمات عن الخلق ومعجزة الحياة، أو ما شابه. ولو كان النص الأصلي فيه خطأ بنظر المترجم، كأن يمجد اليهود ويذم العرب مثلًا، فليس للمترجم حيلة إلا أن ينقل الكلام مثلما هو، فتلك هي وظيفته لا أكثر، بل ولا حاجة به لأن يتبرأ فيه مما قيل؛ لأنه ليس مسؤولًا عما يُعرّبه أصلًا، بل من الطبيعي والمتوقع أن تتحدى الترجمة أفكار القُرّاء وتتناقض معها بطريقة أو بأخرى؛ لأنها أتت من ثقافة غريبة عنهم.[36] ومسعى المترجم هو نقل النصّ بأكبر دقة وأمانة ممكنة، وأما الحكم عليه واستحسانه أو استنكاره؛ فهو مشكلة يفضل أن يتركها لسواه. والأمانة في النقل تعني أن يتجنب المترجم إسقاط أفكاره بوعي منه على ما يترجمه، لكن هذا لا يمنعه من محاولة تكييف وأقلمة النص مع ثقافته بطريقة يظن تساعد على فهم معاني هذا النص الأصلية، بل إن تلك ضرورة لا مفر منها لاستكمال التعريب قلبًا وقالبًا. الأقلمة يقول الناس في اللهجات الشامية لأحبابهم كلمة "تقْبرنِي"، ومعناها حرفيًّا: "أتمنى أن تدفنني في قبري". وتصلح ترجمة هذه الكلمة إلى الإنكليزية بطريقتين: أولًا، يمكننا ترجمتها حرفيًّا بأن نقول: "I wish you would dig my grave" أو "put me into my grave"، وهي جملة قد تترك أي قارئ أجنبي في أقصى درجات الحيرة والدهشة. وثانيًا، يمكننا أن نحاول ترجمة المعنى ترجمة مجردة من كل وقع للعبارة الأصلية، مثل أن نقول: "I love you so much". ولكلا هذين الحلين مشكلاته، لأننا نتناول هنا فكرة ثقافية فلا يكفي نقلها حرفيًّا، وكذلك لا تجوز الاستعاضة عنها بجملة عادية يضيعُ فيها وقعها المميز، وإنما تحتاج إلى تكييف وأقلمة. مرّت معنا فيما سبق تعاريف التعريب، ومن معانيه "الترجمة"، لكن لا تُقصد به الترجمة بمعناها المعتاد (أي نقل معنى الكلام من لغة لأخرى) وإنما يمتد إلى أقلمة هذا المعنى وتعديله وتكييفه مع لغة جديدة بما يتّفق مع جمهورها،[37] فالتعريب "أشمل من الترجمة"؛ وما الترجمة إلا وجه من وجوهه.[38][39] ويلفت التعريب نظرنا إلى أن الترجمة ليست مهنة آلية؛ وإنما هي مكتوبة لقُرّاء حقيقيين يرغبون بالاستفادة منها، وما قد يغيب هنا عن كثير من المترجمين (حتى من أتباع منهج التصرّف) أن أقلمة النص للقراء لا تنحصر بتعريب مقصده الحرفي ولا المجازي، بل بنقل ثقافة كاملة يختزلها ضمنه، ولا يمكن للمُعرّب أن ينقل سمات هذه الثقافة المعقدة بدون إجراء تعديلات جذرية على النص:[40] بما في ذلك تبديل أسلوبه أو موضوعه أو عنوانه كاملًا. يعتبر كتاب "تاريخ موجز للزمن" من أشهر الكتب في تاريخ الفيزياء، على أن محتواه ليس علميًا بحتًا، إذ إن فيه بعض الأمثلة والاستشهادات التي تخدم غرضًا أدبيًا يتطلب إبداعًا في تعريبه. - مقتبسة تحت ترخيص الاستعمال العادل تاريخ موجز للزمن والجملة الأخيرة المقتبسة أعلاه تطرح تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة، فكلمة "الأمر" هنا لا تعود على أي "أمر" فعلي ذكره المترجم في جملته السابقة، ولذا يجد القارئ نفسه في حيرة من أمره وهو ما يزال في منتصف الجملة، وأما في نصفها الثاني فلعلّنا نتساءل: ما هو "الطريق" الذي نتحدث عنه والذي يعج -كما يخبرنا المترجم- بالسلاحف؟ فهل هو شارع معبّد (مثل قولنا: "أوقفت السيارة بجانب الطريق") أم هو رمزي (مثل قولنا: "اتبع طريق الحق") أم هو طريق ثالث لا نعرفه؟ وما علاقة الطريق المكتظ بالسلاحف في الحوار السابق؟ وربما يفهم معظم القراء مقصد المترجم أو يخمنون شيئًا منه (وهو أن السلحفاة تقف على عدد لانهائي من السلاحف الأخرى، بعضها فوق بعض)، إلا أنّني لا أنسب الفضل للترجمة العربية، بل إلى أن كثيرًا من هؤلاء القراء على دراية -تقل أو تزيد- بالتراكيب الإنكليزية، وهو أمر قد نعزوه -أصلًا- لكثرة الترجمات الحرفية مثل هذه. فكلمة "الطريق" التي ترد هنا -مثلًا- هي نسخ حرفي لكلمة "way" بمعنى نُقرّه إلى "الامتداد"، فلا تخدم سياقنا هنا بشيء إن تُرجمت إلى "طريق"، ولكن القارئ العربي قد يعرف الكلمة الأجنبية فيسقطها على ما قرأ. ويتضح ضعف هذه الترجمة مباشرةً في حالتين: الأولى هي أن يقرأ الترجمة شخص لا يتقن شيئًا من اللغة الإنكليزية فيجد فيها طلاسم يستحيل فهمها. والحالة الثانية هي أن تأتي ترجمة حرفية عن لغة لا يألفها جمهور القُرّاء (مثل: اليابانية أو الروسية أو غير ذلك)، ووقتها لن يكون لهم أي عون في فهم الترجمة، وهو أمر واجهته -شخصيًا- مرات عدة في قراءة كتب مترجمة عن لغات غير مألوفة. الأسطورة القائلة بأن العالم قائم على ظهر سلحفاة، والتي ترجع أصولها للثقافتين الهندية والصينية، ويصفها "ستيفن هوكنغ" في فاتحة كتابه. - منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر: ويكيميديا كومنز على أننا نجد -لدى العودة إلى الفقرة أعلاه- أنها لا تقبل الترجمة إلى العربية بسهولة، فهي مبنية من بدايتها إلى نهايتها بأسلوب غريب عن اللغة العربية، ويفيدنا في هذا الصدد أن ندرس الهدف من وجود هذه الفقرة في موضعها بكتاب "هوكنغ": فهي لا تخدم قيمة علمية، على عكس معظم محتوى الكتاب، بل هي افتتاحية الفصل الأول، والكاتب يحاول فيها أن يُلطف الجو وأن يأسر انتباه القارئ؛ تمهيدًا للخوض في مواضيع فيزيائية معقدة سوف يتناولها في هذا الفصل وما بعده. والهدف من هذه الفقرة -إذًا- ليس إرباك القارئ؛ بل تقريب النص إلى قلبه بقصة خفيفة ومضحكة، ومن حق المترجم (بل ومن الأجدر به) أن يتلاعب بالقصة وأسلوبها ليثير مشاعر مماثلة في نفس قارئه. يستشهد "هوكنغ" في هذه الافتتاحية بمثل ثقافي مشهور في الولايات المتحدة ومجهول خارجها، وهو: أن "العالم قائم على ظهر سلحفاة" (وهذه أسطورة قديمة تظهر في سلسلة قصص واسعة الشهرة في أمريكا، اسمها Discworld)،[42] كما يأتي "هوكنغ" عمدًا بشخصية يقول عنها: إنها: "امرأة عجوز في آخر القاعة"، وهذا وصف مألوف في الثقافة الأمريكية لامرأة عجوز طويلة اللسان وقاصرة الفهم، ويصفها "هوكنغ" بهذا الأسلوب ليرسم صورة عن شخصيتها في مخيلة قارئه، لكن من الصعب على المترجم أن ينقل هذه الصورة لأي لغة أخرى.[43] وتحتاج هذه الحالات الصعبة إلى حلول مبدعة، ومن أمثلة هذه الحلول: الأقلمة التي أتى بها مترجم أو مترجمة الكتاب إلى اللغة اليونانية، فاختلق قصّة شبيهة بأحداثها لقصّة "هوكنغ"، لكنها تستشهد بشخصيات من رواية "أليس في بلاد العجائب"، والقارئ اليوناني -كما يبدو- يعرف أليس في بلاد العجائب وشخصياتها معرفة راسخة، فيفهم الانطباعات المقصودة عنها، وفيما يلي ترجمة للنص اليوناني:[44] وسآتي هنا بمثال ممكن على أقلمة عربية، ولو أن هذا الأسلوب غير رائج وربما غير متقبَّل في التعريب حاليًّا، واتبع خطى المثال اليوناني بأن استشهد ببديل ليس عربيًّا خالصًا، وإنما هو مجرد بديل يألفه الجمهور العربي (وهذا الأهم في حالتنا): الإيحاء قد تسمع في بعض اللهجات العربية كلمة "خواجات"، وهي في الأصل جمع الكلمة الفارسية "خواجة" (ومعناها: الأستاذ والمعلم)، وما زالت هذه الكلمة متداولة اليوم في كثير من بلدان المشرق العربي؛ فيُقصد بها سكان هذه البلاد من الأوروبيين البيض، لكن من يعرف الكلمة يدرك أن فيها إيحاءً إضافيًا مفاده التكريم وتعظيم الشأن لصاحبها بفضل أصوله الأجنبية. وهذا إيحاء أو انطباع عاطفي تثيره اللغة في نفس المتلقي؛ ولكل كلمة في اللغة إيحاءاتها الدقيقة التي يعرفها الناطقون بهذه اللغة ويستخدمونها بمواضيع دقيقة للتعبير عن مشاعرهم ومواقفهم،[45] ولهذه الإيحاءات أهمية هائلة في الترجمة. تعدّ كلمة Home عصية على الترجمة لمعظم أو سائر اللغات غير الإنكليزية، إذ إن فيها معاني مُبطنة وإيحاءات قد يصعب نقلها، فربما تأتي بمعنى "المنزل" (مثل stay at home) أو "الوطن" و"المأوى"، مثل: "I belong home"،[46] على أن "الوطن" المقصود هنا ليس بلدًا بالضرورة (كما هو الحال في اللغة العربية) بل إنه يضفي إيحاءً عاطفيًّا بمعنى "الألفة" أو "الانتماء" على أي شي، فقد ينطبق على مكان أو شخص أو جماد، وهذه طيف واسع من الأحاسيس التي لا مناص من إسقاطها في الترجمة العربية. لا تقتصر الإيحاءات على المفردة الواحدة، بل قد تختزل في تركيب الجملة وقواعد اللغة ولفظها. فاللهجات واللكنات محملة بإيحاءات عن العِرق (مثل لكنة الأمريكيين السود) والمنطقة (مثل لهجة صعيد مصر) والطبقة (مثل لهجات المهاجرين من بلدان غير عربية)، وقد تضيع كثير من هذه الإيحاءات في الترجمة لأنها مغروزة في الثقافة. وقد حدث -على سبيل المثال- أن بعض المبشرين قصّوا على سكان فنزويلا الأصليين ترجمة لقصة صلب ومقتل يسوع المسيح، وتوقع المبشرون أن تهتز لها قلوبهم؛ لكن القوم الفنزويليين لم يفهموا القصة ولم يكترثوا لها، ففي ثقافتهم يعد الاستسلام للموت علامة على الضعف والهزيمة، وترجمة الكلام إلى لغتهم لم تكن كفيلة بترجمة إيحاءاته وانطباعاته العاطفية.[47] ومثل قصة المسيح؛ فإن للكثير مما يحكيه الناس -أو معظمه- دلالات واستنباطات يحاول المُتحدّث والكاتب أن ينقلها إلى المستمع والقارئ، لكنها ربما تستعصي على الترجمة. فالحديث بلكنة إيطالية في الأفلام الأجنبية يُقصد به -أحيانًا- الانتماء لعصابات المافيا (لكثرة ما فيها من طليان)،[48] والمتحدث بالعربية العامية يُعبّر عن جانب كبير من شخصيته إن ألقى التحية على أحدهم قائلًا "بونجو" أو "هاي" أو "مَرْحَبَا" أو "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، ومن التحديات الكبيرة للمترجم أن يحاول نقل هذه الإيحاءات إلى بديل قد يفهمه القارئ. تمتاز المسلسلات التلفزيونية[49] عن الأدب بأن لغتها عامية أكثر، ولذلك تغص بإيحاءات مرتبطة بثقافة الشارع والناس في بلد أجنبي، والتي قد يصعب نقلها إلى لغة أخرى. ويقال في ترجمة هاوية لمسلسل هزلي اسمه "Big Bang Theory":[50] You know, out of the four of us you have the most veal-like consistency. تعلم أن بين أربعتنا، أنت لديك الكثافة الأقرب للعجل.[51] والمشكلة هنا هي أن الهدف من الجملة ليس وصف حيوان "العِجْل" بمعناه العلمي أو الأحيائي، بل في تشبيه الشخص بكائن مشهور بالضعف والضآلة في ثقافته. ومن غير المألوف -في اللغة العربية- التشبيه بالعِجل في هذه الحالة؛ وإنما بالحَمَل، فمن الأولى القول أنه "الأقرب إلى الحَمَلِ" أو "الحَمَلُ الوديع" ضمن المجموعة. وعلى المترجمِ هنا أن يأخذ بالحسبان مبدأ "الحد الأدنى"[52] الذي ابتدعه المترجم التشيكي "جيري ليفاي"، ويقتضي هذا المبدأ أن يضع المترجم الحد الأدنى اللازم من الجهد، لحَصْد أكبر عائد ممكن في عمله: فالإيحاءات تكثر في الكلام كله وتتعذّر ترجمتها مجتمعة، وإن كان على المترجم بذل جهد هائل وكتابة فقرة مطولة تشرح مزحة عابرة؛ فهذا يتجاوز التزاماته بكثير، ولكن إن كانت هذه المزحة متصلة بحبكة القصة وضرورية لفهمها؛ فلا بد من تفسيرها للقارئ بطريقة ما؛ إذ على المترجم دومًا الموازنة بين أهمية الإيحاء في النص الأصلي وصعوبة نقله إلى القارئ.[53] ولعل هذه الموازنة تصبح أدعى حينما يكون الإيحاء مختزلًا في عنوان النص أو العمل نفسه. أفلام ألمانية لو حاولت -ذات مرة- مشاهدة أفلام أو مسلسلات مدبلجة عن اللغة الإنكليزية إلى لغات أخرى (وخصوصًا اللغات الأوروبية) فقد تلاحظ أمرًا غريبًا، وهو أن عناوين هذه الأفلام باللغات الأخرى قد تختلف تمامًا عن عناوينها الأصلية، إذ تُفضل كثير من مؤسسات الترجمة الأجنبية ابتكار عنوان جديد للفلم، يختزل الفكرة الأساسية منه مع وضعها في سياق يسير ثقافيًا على المشاهدين[54] (بدلًا من التعنت بترجمتها حرفيًّا)، والسّبب هو أن الأفلام من أكثر الإنتاجات الفنية التي تتشرّب الثقافة وتنغمس فيها، وقد يستعصي فهمها بدون أقلمة. فلنأخذ مثلًا فلم Pulp fiction (صادر سنة 1994) للمخرج "كوينتين تارانتينو"، وهو صاحب سابع أعلى تقييم لفلم سينمائي بالتاريخ؛ بحسب قاعدة أفلام الإنترنت.[55] فلو ترجمنا عنوان هذا الفلم حرفيًّا سيصبح معناه بالعربية: "الخيال الإغرائي"، لكن، لهذه الترجمة مشكلتان: الأولى هي أن الثقافة العربية ثقافة محافظة ومتدينة، ولذا فإن معظم المشاهدين لن يتقبَّلوا الاسم، وهو أمر لا بد للمترجم الجيد من أخذه في الحسبان. وأما المشكلة الثانية ولعلها الأكثر أهمية في سياقنا، فهي أن هذا العنوان لا يعني شيئًا للمشاهد العربي، فلو تخيلت نفسك مشاهدًا (عوضًا عن مترجم) سمع بفلم عنوانه: "الخيال الإغرائي" فهل ستتشوّق لمشاهدته أو تجد أي علامة تخمن بها موضوعه؟ في عنوان Pulp Fiction اصطلاح ثقافي يترك وقعًا دقيقًا جدًّا في نفس المشاهد الأمريكي عند سماعه، فمعنى كلمة "Pulp" بحسب المعجم هو: "مجلة أو رواية مطبوعة على ورق رخيص (كورق الصحف) فيها مشاهد عنيفة وفاضحة"،[56] وهذا نوع من المجلات انتشر في الولايات المتحدة منذ عام 1900 إلى فترة الحرب العالمية الثانية، فلاقى رواجًا كبيرًا حينذاك،[57] ويقلد الفلم طابع هذه المجلات لكثرة ما فيه من مشاهد ذات طابع قديم ورخيص، مع إضافة مشاهد عنيفة وإغرائية. ونجد -إذًا- أن للعنوان انطباعًا فريدًا جدًّا محال تعريبه، إذ تتضح مشكلة تعريب هذا العنوان لو عدنا إلى مثال "تقبرني" الذي تناولناه سابقًا، وربما تتفق حينها بأن من حق المترجم الجيد (ومن واجبه كذلك) أن يبتكر عنوانًا جديدًا لهذا الفلم أكثر انسجامًا مع الثقافة العربية، كأن نقول: "حكايات صفراء" تقليدًا لما يقال بالعربية عن المجلات والصحف الرخيصة "الصفراء". من اللغات الرائدة في الابتكار والإبداع بترجمة الإنتاجات السينمائية؛ اللغة الألمانية، فهي لغة لها استقلالية ثقافية عالية تحرص على تميزها عن الثقافة الإنكليزية، وتكثر تعديلات الأسماء فيها حتى إنها تأتي بنتائج غريبة، مثل: فلم "حياة حشرة" (A Bug's Life) من "بكسار" اسمهُ "Das große Krabbeln" (أي "الزَّحف الكبير"، بمعنى زحف أو حَبْو الحشرات) وفلم "موانا" (Moana) من ديزني اسمها "Vaiana" (وهو مشتق من كلمة "Vai" أي "الماء" بلغة تاهيتي، رغم أنها لغة لا يعرفها معظم المشاهدين الألمان). من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة الصادرة حادثًا سلسلة 13 Reasons Why، التي تتحدث عن فتاة اسمها "هانا بيكر" سجلت ثلاثة عشر شريطًا صوتيًّا تتحدث فيها عن أسباب انتحارها. ولو حاولنا ترجمة هذا العنوان حرفيًّا إلى العربية سنخرج بشيء مثل: "13 سببًا لماذا؟"، وهذه الصيغة ليست ذات معنى كبير في العربية لأنها -بالأصل الأجنبي- أقرب إلى جملة خبرية من سؤال، وعلى عكس اللغة الإنكليزية لا يمكن اتباع كلمة "لماذا" العربية بجملة خبرية، مثل جملة: "That is why I went out"، والتي تتحول في العربية إلى: "لهذا ذهبت" (إذ يحل اسم الإشارة: "لهذا"؛ مكان اسم الاستفهام). غلاف المسلسل باللغة الألمانية. - مقتبسة تحت ترخيص الاستخدام العادل وفي اللغة الألمانية، اختار مدبلجو المسلسل نقله إلى لغتهم بعنوان Tote Mädchen lügen nicht، الذي يعني حرفيًّا "الفتيات الميتات لا يَكذِبْن". ويدل هذا العنوان على دراية مُتعمّقة من المترجم بموضوع المسلسل، فخلال أحداثه يحاول كثير من الأشخاص التشكيك بمصداقية الأشرطة التي سجلتها هانا بيكر، واتهامها بالكذب وتحوير الحقائق، ويلقي عنوان المسلسل الألماني الضوء على هذا الجانب من السلسلة، بل ويرد عليه ببلاغة. والمجال هنا مفتوح للإبداع والابتكار بالتعريب كذلك على غرار ما أَلْمَنَهُ الألمان، وقد نقول في أمثلة بسيطة قريبة من العنوان الأصلي: "تسجيلات هانا بيكر الثلاثة عشر"، أو "ثلاثة عشر شريطًا غامضًا"، أو ما شابه. وطُبّق هذا الأسلوب ببراعة -مثلًا- في ترجمة عنوان سلسلة الأنيمي "Food Wars!: Shokugeki no Soma"، فأتى عنوانها على قناة نتفلكس: "لا سلام على طعام" وهي ترجمة تتجلّى فيها روح الأقلمة الثقافية باستعارة تعبير عربيٍّ معروف قديمًا وحديثًا. قد يظن البعض أن هذه الترجمات، التي تأخذ حريتها بتعديل العنوان وإعادة صياغته، تُفسد العناوين الأصلية للأفلام والمسلسلات، ولا شكّ بأننا نفضل الإبقاء على العناوين والأسماء على أصلها متى ما أمكن ذلك، لأننا -في نهاية المطاف- لا نحاول ابتكار إنتاج جديدٍ بل ترجمة جديدة لما هو موجود. والمسألة المهمة هنا دومًا هي أن التعريب ليس محض ترجمة، بل هو تكييف وأقلمة لقارئ عربي، وتحوير الترجمة عن الأصل أفضل من ترجمة غير مفهومة، ولا تحمل أي معنى لثقافة القارئ أو المستمع أو المشاهد العربي، فالتحوير هنا جائز إن دعت الضرورة إليه،[58] وهي تدعو إليه حتى يصبح واجبًا في أحيان كثيرة. النقد الأدبي لو قرأ طفل في المدرسة قصة مثل: "مزرعة الحيوانات" أو "كليلة ودمنة" فربما تعجبه لما فيها من حيوانات عجيبة ناطقة تخوض مغامرات مثيرة، لكنه ربما لا يدرك أن في هذه القصص إسقاطات[59] لمسائل جادة جدًا في الحياة الواقعية. ففي مزرعة الحيوانات منافسة دامية بين الشيوعية (ورمزها الخنزير "نابوليون" الذي يحكم سائر الحيوانات الأخرى) والرأسمالية (ورمزها هو الإنسان الذين تتشبه به الخنازير في نهاية الرواية)، وفي كليلة ودمنة إسقاطًا دقيقًا لشؤون الحكم عند الملوك (ورمزهم الأسد، زعيم الغابة) وما يلقونه من غدر من حاشيتهم (من دمنة الذي يوقعُ بالثور باحتياله وخداعه). ولعل معظم المترجمين المتمرسين يفهمون مغزى هاتين القصتين، ولا يخلطونهما بقصص الأطفال، لكن قلة منهم قادرون على التعمق في الرموز والأفكار الأدبية العميقة الكامنة في الروايات والشعر وشتى ألوان الأدب، والتي يستحيل على المترجم أن ينقلها إلى قارئه كما ينبغي؛ إن هو نفسه أغفلها. نشر الكاتب لويس كارول قصة "أليس في بلاد العجائب" في إنكلترا عام 1865، وزرع فيها صورًا كثيرة أراد منها -ضمنيًّا- نقد المجتمع الإنكليزي في عصره، وكان هذا المجتمع وقتذاك متيمًا بالآداب الاجتماعية وحسن التصرف (الإتيكيت)، وتتناقض شخصيات "بلاد العجائب" مع هذا المجتمع لأنها تفتقر إلى العادات الاجتماعية قاطبة،[60] وتكتظ القصة بشخصيات كثيرة لها معانٍ رمزية، مثل: الأرنب الذي يقفز متفحصًا ساعته ومشتكيًا من تأخره، في صورة تذكر بالموظفين الإنكليز الذين يركضون بين التزاماتهم كل يوم دون أن يبلغوها أبدًا، ومثل "ملكة القلوب" التي يصعب إرضاؤها فتأمر بضرب عنق كل من لا يعجبها سلوكه، والتي تمثل تزمت المجتمع البريطاني آنذاك وقسوته مع من يخالف أعرافه، وهلم جرّا. الأرنب الذي "تأخر عن مهامه" في قصة "أليس في بلاد العجائب". - منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر: ويكيميديا كومنز وخلف كل نص أدبي احترافي جذور ثقافية عميقة كهذه، حتى يمسي من المستحيل تعريبه تعريبًا كاملًا ينقل للقارئ كل ما فيه من معانٍ،[61] لكن، للمترجم أن ينقذ بعضًا من هذه المعاني أو يعوضها ببدائل تحل مكانها وتحفظ للقارئ شيئًا من الفكرة، فتبقى ضلاعته بخفايا النقد الأدبي شرطًا ثمينًا في ترجمة الروايات والمسرحيات والأدب الرفيع. ولا ريب أن المترجم نفسه قارئ يتذوق الأدب، إلا أن قراءته هي دراسة متعمقة وتحليلية تختلف تمامًا عما يقوم به القارئ العادي.[62] ويستعين الأدباء في كتاباتهم (وكذلك في الأفلام السينمائية والمسلسلات وكرتون الأطفال) بحيل وأساليب فريدة ربما لا يستوعبها جميع القرّاء بالضرورة، على أن هذه الأساليب تحتوي على رسالة موسعة يريدها المؤلف من النص، ولا تقتصر هذه الرسالة على النصوص الأدبية الصرفة، فكثير من الكتب العلمية فيها هذه الأدوات أيضًا؛ مثلما رأيناه في كتاب "ستيفن هوكنغ". ومن أشهر أمثلة الأدوات الأدبية "الموتيفة"،[63] وهي حدث أو فكرة أو محسوس يتكرر في القصة فيعطيها عمقًا رمزيًّا ومعنويًّا، وللموتيفة أهمية فائقة في كل نص أدبي؛ لأن الأدب قائم على بناء الصلات والروابط وتكرار الأفكار.[64] على سبيل المثال: "Winter is coming" ("الشتاء اقترب")[65] هي جملة تتكرر عشرات المرات في سلسلة "لعبة العروش" الشهيرة، فتتصل بها عناصر القصة، إذ تنبئ هذه الجملة القارئ -أو المشاهد- بفصل الشتاء الوشيك وما سوف يأتي به من برد ومتاعب (كما يرمز الشتاء عادة) لأبطال القصة وشخصياتها، وتتضح فحوى هذه الموتيفة حينما تتحول الجملة إلى "Winter is here" ("الشتاء حل") في المواسم الأخيرة، ثم حينما ينقشع الشتاء ويحل الصيف في نهايتها، فتكتمل رمزية القصة في تناغم "النار والجليد" (وهو عنوان الرواية الأصلية) أو الشتاء والصيف أو النور والظلام، أو متضادات أخرى كثيرة قد يسقطها عليها المحللون. ومن أمثلة الموتيفات في الأدب: الوصايا السبع في "مزرعة الحيوانات"، والتي يستغلها الخنازير للتحايل على حيوانات المزرعة، فتصبح الوصايا وسيلة للظلم بدلًا من العدل. ومن أمثلتها -كذلك- المحارة في رواية "سيد الذباب"، والتي ترمز لسطوة القانون والانضباط، فلحاملها الحق بالكلام دومًا أمام الجماعة، ويكتمل معناها كموتيفة حينما يدفع أحد الأولاد الأشرار صخرة نحو حاملها (وهو الولد "بيغي") فينسحق تحتها وتتحطم المحارة التي يحملها، ومعها آخر بقية باقية للمتجمع المتحضر على الجزيرة. وعلى المُعرّب هنا أن يدقق في الموتيفات والرموز المحورية في القصة، فلا يجوز حذفها ولا التقليل من ظهورها في النص. وربما يخال المترجم المبتدئ أن هذه الموتيفات هي عناصر عشوائية مبعثرة دون صلة واضحة؛[66] فيرتكب خطأ جسيمًا بأن يترجمها في كل سياق بصيغة جديدة أو يسميها بمصطلح مختلف، فتضيع فكرتها أو لا تتضح العلاقة بينها وبين مسار القصة. وليس هذا سوى عنصر واحد من عشرات العناصر والأدوات الدارجة في الآداب التي ينبغي دراستها والانتباه إليها لمن يهم في تعريبها. البلاغة يقال أن الأدباء فئتان: فئة تترجم (أي يصلح أدبها وكتابتها للترجمة)، وفئة لا تترجم. والمقصود هو أن أصحاب الفئة الأولى يكتبون الأدب للحديث عن فحوى وعبرة؛ مثل وضع كتاب في علم من العلوم، وأصحاب الفئة الثانية يكتبونه للتفنن باللغة والكشف عن مكامن جمالها وبلاغتها؛ مثل الشعر وغيره. وعبرة أدب الفئة الثانية هي في لغته وأسلوبه،[67] لكن الترجمة تنقل المعنى وليس الجمال ولا البلاغة. مثلًا، يقول "تورفالد" في بداية مسرحية "بيت الدمية" لهنريك إبسن (بحسب ترجمتها العربية):[68] «أهذه أرنبتي الصغيرة التي تمرح؟»، فتجيبه زوجته نورا بـ«نعم»، فيسأل ثانيةً: «ومتى عادت الأرنبة؟»، فتخبره نورا وهي تتناول قطعة من البسكوت وتمسح فمها أن يأتي ويرى ما اشترت، فيفتح باب غرفته ليندهش من كثرة ما اشترت، ويقول لها مداعبًا: «أعادت مسرفتي الصغيرة إلى [التبذير] مرة أخرى؟» ولهذا الحوار أهمية فائقة في الكشف عن شخصيات المسرحية وحبكتها، ويدل اختيار الكلمات في ترجمته العربية على براعة فائقة في نقل جمال هذا الحوار. أداء واقعي لمسرحية "بيت الدمية"، التي تتمحور قصّتها حول كيفية تحكّم "تورفالد" بزوجته "نورا". - منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر: ويكيميديا كومنز فـ"أرنبتي الصغيرة" أصلها "my little squirrel" (أي "سنجابتي الصغيرة")، وهذا تشبيه بلاغي وأدبي اختاره المؤلف لسببين (وربما أكثر): أولًا ليرينا أن زوج "نورا" يعتبرها مثل "حيوان أليف" يملكه لا "إنسانًا" مستقلًا أو قادرًا على تدبر أمره. وثانيًا ليدل على طباع "نورا" وشخصيتها كما يراها زوجها، ولا سيما أنها تظهر في المشهد نفسه وهي تقضم البسكوت "مثل السنجاب"، ويبدع المترجم في التعويض عن هذه المفردة بـ"الأرنب" في العربية، والأرنب تشبيه سائغ أكثر للقارئ العربي، ولكنه ينقل المعنى الأدبي المقصود، وعلى الرغم ذلك فهو يظل تشبيهًا "غريبًا" فيحفظ غربة الترجمة. ونرى أن اختيارات الكلمة الأخرى، مثل "مسرفتي الصغيرة" بل وعنوان المسرحية نفسه (وهو بيت الدمية) يلمحان إلى الفكرة نفسها، والتي لن يفلح المترجم في حفظها إن لم يلحظها أولًا. وقد نَصِف هذه المفردات الدقيقة على أنها علامات على بلاغة الترجمة، إذ يقول "معجم الدوحة التاريخي" في تعريف البلاغة: إنها «إجادة القول باختيار أحسن لفظ وأوجزه وأدقه في التعبير عن المعنى المراد»،[69] وفي تعريف الفصاحة أنها: «حُسْن البيان مع الإصابة في القول»،[70] وفي الترجمة قدر هائل من البلاغة والفصاحة لا يشعر بها المرء إلا بالتمرّس والخبرة، فكل كلمة في الأدب (أو الأدب المتقن) يختارها الكاتب بعناية شديدة لمعناها ووقعها ومزاياها الصوتية والجمالية وتناغمها مع باقي الكلمات، وعلى المترجم أن يفهم هذه السمات اللغوية، وأن يدرسها ويسعى إلى صونها إن استطاع. وفي ما جاء أعلاه سمة نالت حظًّا وافرًا من الدراسة والاهتمام من المترجمين هي الـ"Markedness"، ولعل أفضل ما يقرّب به هذا المصطلح إلى العربية هو "الفصاحة"، ويُقصد به أن يكون وقع الكلمة في نفس القارئ أو المستمع مألوفًا وعاديًّا على عكس ما إن كان وقعًا غريبًا يدفعه إلى التوقف والتأمل (مثل: كلمة "أرنبتي" في هذه الحالة). وكثيرًا ما يقصد المؤلف أن يختار مفردات لها وقع غريب وخاص، وقد ينجح المترجم بالحفاظ على هذا الطابع أو قد يستعيض عنه بمفردات لها وقع عاديّ في اللغة التي يترجم إليها، وهذا خطأ واضح.[71] اختيار الكلمات في الكتابة مهم جدًّا لأن كل ما يُكتب له أسلوب وألفاظ تختلف حسب موضوعه، فالأخبار الصحفية -مثلًا-[72] تعتمد على اللغة الجادة التي تسرد وقائع واقتباسات متتالية، والكتب الفقهية تتناول أحكامًا دينيَّة لا يجوز الزج بينها بمزحة أو هزل عابر. ومما يدل على أهمية الأسلوب، أن لكل نوع من الأدب جمله المعروفة التي يتوقعها القارئ، فلعلك تعرف موضوع النص إذا كانت فاتحته: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين" أو "كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان". ولكن هذه أمثلة فاقعة واضحة، ويحدث في حالات كثيرة غيرها أن يسيء المترجم فهم التركيب البلاغي الذي يستخدمه الكاتب لإضفاء طابع مقصود على كتابته.[73] وقد نأخذ على ذلك مثالًا حداثيًا من جملة "forget about it" التي تتكرر عشرات المرات في فلم "دوني براسكو"،[74] والذي يتناول قصة حقيقية لعميل أمريكي اخترق صفوف عصابات المافيا، والتي تكثر في لهجتها هذه الجملة (والواقع أن الجملة تأتي في هذا السياق كـ"موتيفة"، لكننا سنتغاضى عن ذلك لأغراض الشرح)، حتى إن في الفلم ذاته مشهدًا مطوَّلًا يشرح معانيها العديدة. وفيما يلي اقتباسات من الفلم ومن ترجمته العربية على قناة نتفلكس، مع دلالات الجملة بحسب مكانها:[75] table { width: 100%; } thead { vertical-align: middle; text-align: center; } td, th { border: 1px solid #dddddd; text-align: right; padding: 8px; text-align: inherit; } tr:nth-child(even) { background-color: #dddddd; } اقتباس ترجمة نتفلكس المعنى What's that, you want me to sign it? Forget about it. ماذا؟ تريدني أن أوقّعها؟ انس الأمر. [حرفيّ]: دعكَ من الأمر. Is he a good old guy? Forget about it. هل يمكن الاعتماد عليه؟ انس الأمر. [موافقة]: بلا شكّ. A Lincoln is better than a Cadillac? Forget about it الـ(لينكولن) أفضل من (الكاديلاك)؟ انس الأمر. [نفي]: مستحيل. I’m known, forget about it أنا شهير. انسَ الأمر [توكيد]: لا يساورنَّك الشك Forget about it, I ain't doing it انس الأمر، لن أفعل ذلك [حسم]: لا تناقشني والنقد الأدبي وما فيه من أدوات قصصية وبلاغية هو بحر واسع، ولا تكفي هذه المساحة لتغطية قسم يذكر من آثاره وتداعياته على التعريب، لكن الهدف هو أن يعرف المترجم الذي يعمل في هذا المجال أن النقد موضوع غنيّ ثمين ولا يفهم المرء الأدب دونه، ولا يصلح لتعريب الرواية والمسرحية والقصة من لم يتسلّح به. ويُنصح من يطمح إلى الترجمة الأدبية أن يتعمّق في هذا الموضوع، بل وأن يدرسه كاختصاص دراسي. إلا أن مشكلات الثقافة في الترجمة لا تقتصر على ما قد يبذله المترجم من جهد في فهم النص وتحليل ما فيه، بل وفي كيفية تعويضه بثقافة أخرى. اللهجات الدارجة يقول طبّاخ السفينة في ترجمة لرواية موبي ديك:[76] «إنتوا هيوانات قرش وهو بطبؤه شره كتير، لكن بردو أقول لكم يا إكواني إنه الشره داك - امنأوا اللطم بالدنب! كيف ممكن تسمأوا ان كان بقيتوا مسمرين في اللطم والأض الملئون هناك؟».[77] والطباخ هنا (واسمهُ "فليس العجوز") هو عجوز زنجي ينطق الحروف والكلمات بلكنته، فيقول "dat" بدل "that" و"zay" مكان "say"، وارتأى المترجم محاكاة هذا الأسلوب بالعامية المصرية لنقل شيء من الواقعية الاجتماعية التي أرداها هيرمان ميلفل، و"تعويض" اللهجة باللهجة بهذه الطريقة هو من الأساليب الشائعة في ترجمة الأدب. تصوّر رواية "موبي ديك" حياة بحارة بسطاء على متن سفينة لصيد الحيتان، فتحتاج لمحاكاة لهجاتهم العامية بواقعية. - منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر: ويكيميديا كومنز اللهجات مسألة شائكة لها أبعاد سياسية ومجتمعية. فاللهجة في علم اللسانيات هي فرع من اللغة، تختلف فيه بعض المفردات ومخارج الحروف وشكل الألفاظ، على أن غير الناطقين بها يفهمونها دون حاجة لتعلمها (ويسمى هذا "الفهم المتبادل" بين اللهجتين)،[78] إلا أن اللهجات تعبّر -أيضًا- عن انتماءات جغرافية واجتماعية وعرقية للمتحدثين بها،[79] فالأمريكيون السود لهم لهجة غير البيض، وسكان المدن لهجتهم غير سكان الريف. وقد كان من الشائع قديمًا ألا يعتد إلا بلهجة واحدة من اللغة لتصلح لكتابة الأدب[80] (مثل الفصحى بين اللهجات العربية[81] والبريطانية في الإنكليزية)، لكن هذا الأمر تغير فصار الأدباء يُدخلون اللهجات العامية في كتاباتهم؛ لينقلوا كلام الناس بواقعية، ولذا أصبحت ترجمة هذه اللهجات من لغة إلى لغة معضلة عصيبة. إن هدف الترجمة الأسمى هو أن تُقرّب نصًّا من لغة أجنبية إلى لغة يألفها القارئ، لكن المعضلة هنا أن بعض النصوص فيها تنوع لغوي لا يجب أن يألفه القارئ أصلًا: فاللهجات كلام غير مألوف له دلالات قوية على الطبقة الاجتماعية، واللكنات والمفردات لها دلالة على سمات شخصية في الحديث تميز كل إنسان عن سواه، واللغة تتغير مع الوقت فتكسب نصوصها التراثية طابعًا عتيقًا،[82] ويستعين الأدباء بهذه الصنوف اللغوية قصدًا[83] فيأتون بلهجات تختلف في نطقها أو مفرداتها أو تراكيبها النحوية والصرفية عن اللغة الفصيحة السائدة،[84] وبين هذه اللهجات ولغتها -دومًا- علاقة مميزة لا يمكن نقلها إلى أي لغة سواها. وتكثر اللهجات واللكنات في الأعمال الأدبية الحديثة نسبيًا،[85] ومن أشهر أمثلتها روايات "تشارلز ديكنز"؛ التي تُصوّر طريقة حديث العمال الفقراء في بريطانيا بالقرن التاسع عشر. وينقل معظم المترجمين العرب هذه الروايات وما فيها من حوارات إلى لغة عربية فصيحة، وهذه مشكلة لأن العربية الفصحى لغة تقتصر على الكتب؛ ولا أحد -تقريبًا- يتحدثها مع عائلته أو أصدقائه في عصرنا، فكيفَ -إذًا- يمكن لهذه اللغة أن تنقل الطابع الثقافي الذي أراده "تشارلز ديكنز" في رواياته، وهو يقصد أن يصف لهجة المواطن الإنكليزي الفقير؟ مثلًا، يقول "جو غارجيري" في ترجمة عربية لمشهد من المشاهد الأخيرة في رواية "آمال كبيرة":[86] وفي هذه الترجمة قصور هائل لأنها تُصوّر جو وكأنه رجل متعلم يتحدث لغة فصيحة وكأن الناطق بها أستاذ من الأساتذة، ولكنه في الرواية حداد فقير يتكلم لهجة عامية متضعضعة، فيقول "wery" (مكان very) و"lookee" (مكان look)[87] ولم يختر ديكنز هذه اللهجة عبثًا وإنما لها قيمة جوهرية في الحبكة، إذ إن "جو" يتملكه التوتر والارتباك كلما تحدث أمام الناس؛ وذلك لأنه رجل قليل الأهمية في المجتمع، بينما صديقه وبطل القصة (واسمه "بيب") هو سيد فاضل[88] كبير الاحترام والثروة. وقد كان حلم "بيب" منذ بداية الرواية أن يغدو سيدًا فاضلًا، لهذا فإنه يخجل من أن يراه الآخرون مع صديقه الفقير "جو"، لكنه يدركُ فيما بعد أن "جو" -رغم منزلته المتدنية اجتماعيًا وحديثه العامي- يتحلى بصفات السيد الفاضل أكثر من ذوي الجاه والمال الكثير. ويساعد تفاوت اللهجة في مشاهد القصة (لو أجاد المُعرّب تعريبها) على استيعاب هذه العبرة والتباين بين "جو" وباقي الشخصيات، مما يعود بنا إلى ما يحتاجه المترجم من باع وخبرة في أدوات تحليل الأدب وفهمه.[89] للغات لهجات متنوعة تحمل كل منها ثقافة تخص منطقة وفئة من الناس دون غيرها، وتستخدم هذه اللهجات لزرع انطباعات مدروسة في الأدب. - منشورة تحت ترخيص CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز ويستعين المترجمون على مشكلة اللهجات هذه بطريقة الأقلمة، فيأتون بلهجات قروية أو مهمشة من لغتهم؛ للتعويض عن العامية في اللغات الأخرى، كما رأينا في المثال البارع من رواية "موبي ديك" المُعرّبة. ومن أمثلة ذلك -أيضًا- أن "شيموس هيني" عوَّض في ترجمته الشهيرة لقصيدة "بيولف" عن اللهجة القديمة للإنكليز (التي كانت ذات طابع بدوي وعامي اجتماعيًا) بلهجة المزارعين الإيرلنديين في الوقت الحاضر، والتي تحفظ عناصر بائدة كثيرة من الإنكليزية القديمة.[90] وتتسم اللهجات العامية المعاصرة بسمات محددة يدرسها اللغويون ويحللون طريقة استخدامها، ومن أمثلتها الشائعة التي قد يواجهها المترجم من اللهجات الإنكليزية هي تكرار النفي، مثل جملة: "Sorry I ain't got no money" (وقد تكرر النفي فيها، مرة بأداة not ومرة بكلمة no). وتجوز ترجمة هذه الجملة من منطلقين: إما بترجمتها إلى لهجة عربية سائدة في المناطق المهمشة؛ لتُعبِّر عن الفئة الاجتماعية المقصودة،[91] أو بترجمتها إلى عربية فصيحة فيها خاصية اللهجة التي استعان بها المؤلف هنا (وهي تكرار النفي مرتين) فتحتفظ بالسمة اللغوية التي أرادها المؤلف:[92] معذرةً فلا مال ليس بحوزتي. والله يا زلمة معيش ولا قرش. والأسلوب الثاني غير شائع في الترجمات العربية بعد، ولو أنه الأصلح في سياقات كثيرة، فهو ينقل روح الطبقة المقصودة اجتماعيًا وليس السمات اللغوية والنحوية الجامدة للهجات التي ربما لا يفهمها القارئ. لكن على المترجم إن سلك الطريق الثاني أن يتوخى أشد الحذر، لأن اللهجات نوعان: لهجات اجتماعية (تقسم الناس حسب طبقتهم وتعليمهم) ولهجات جغرافية (تقسم الناس حسب مكان معيشتهم)، والجمهور العربي يعزو فروق اللهجات غالبًا لاختلافات جغرافية لا اجتماعية، وهذا يعني أن الاستشهاد بلهجة عربية في الترجمة قد يفسره القارئ على أنه انتقاص لشعب بكامله، على أن ولو كان المقصود -كالحال هنا- هو استعارة لهجة واقعية لفئة من الناس تتحدث عنها الرواية (مثلًا: طبقة العامة)، وليس استعارة لهجة بلد بعمومه. ولهذه الطريقة سلبيات أخرى: فهي تستوجب من المترجم تعمقًا باللهجات العربية الدارجة، وهو أمر صعب،[93] ثم إن فيها غموضًا مبهمًا، فكيف للمُعرّب أن يجد دومًا لهجة مماثلة في الثقافة العربية -مثلًا- للهجة الطبقة العاملة في لندن أو سكان أسكلتندا؟ فلكل لهجة سمات ثقافية فريدة تميزها عن غيرها.[94] ولعل استبدال اللهجات الأجنبية بمثيلاتها العربية أسلوب مناسب في أدب الأطفال وفي السياقات العامة، إلا أنه قد لا يصلح إن كان لهذه اللهجات وظيفة في حبكة القصة، كفلم تاريخي عن بطل أسكتلندي ("وليام والاس" مثلًا) يحارب الإنكليز، إذ ترتبط اللهجة هنا بسياق تاريخي وجغرافي محدد لا تجوز الاستعاضة عنه بغيره. وتقحم في الروايات الأجنبية -أحيانًا- اقتباسات كاملة من لغات أخرى، وخصوصًا الفرنسية والألمانية،[95] ولاقتباس هذه اللغات في الإنكليزية أهداف محددة لها جذورها التاريخية، فأبناء الطبقة الثرية في إنكلترا كانوا يخلطون كلامهم بالفرنسية في فترات عدة -مثلًا- فيدل اقتباسها على طبقة المتحدث. ونقل هذا الواقع في الترجمة العربية ممكن في بعض الحالات إن كانت لغاتها مألوفة للجمهور العربي، فبعض الكلمات الفرنسية مثل "ميرسي" و"شوفير" و"أمبيونس"[96] مألوفة كثير من البلاد العربية بحكم التاريخ كذلك، ومن الأفضل للمترجم أن يحاول صون هذه الكلمات إن ظن أن جمهوره يفهمها، كما يمكن أن يستبدلها بما يعطي وقعها للقارئ العربي، وإلا فإن جزءًا مهمًّا من روح النص قد يذهب أدراج الرياح.[97] يرى بعض الباحثين الأكاديميين قيمة خاصة لعامل الزمن في لغة الأدب، فهم يميزون بين ترجمة الأعمال الأدبية المعاصرة، وبين ترجمة التراث الأدبي الذي يعود عمره إلى مئات أو آلاف السنين.[98] ويرى الأكاديميون أن في هذه الترجمة طريقتين: إما نقلها بلغة حداثية[99] أو الحفاظ على طابعها التراثي العتيق:[100] إذ تتعمد الترجمة -في الطريقة الثانية- استخدام مفردات عتيقة وعلامات ترقيم تراثية،[101] وقد يصلح هذا الأسلوب في نقل الملاحم الشعرية القديمة إلى العربية، مثلما نحاه -تقريبًا- "دريني خشبة" في الإلياذة والأوديسة، وهو ما تحدثنا عنه في المقالات الأولى لهذه السلسلة. وللمترجم -إذًا- طرق عدة في نقل اللهجات واللكنات، وجميع هذه الطرق غير مثالية؛ حالها كحال الترجمة كلها، على أن من اللازم أن تذكر أمرًا مهمًّا حين الاختيار بين هذه الطرق: وهو أن العربية الفصحى ليست إلا لهجة ولا لغة يتحدث بها الناس في حياتهم، ولذا فإن المبالغة والتزمت في الالتزام بها يتناقض أساسًا مع سبب إقحام اللهجات في الأدب، وهو محاكاة ألسنة الناس وما ينطقون به في البيوت والشوارع. فالفصحى لغة أدبية لا تخرج عن إطار المطبوعات والخطابات الرسمية، وأما اللهجات فهي لغة إنسانية تلمس أحاسيس الجمهور، والفرق بينهما ليس لغويًّا بحتًا وإنما هو اجتماعي وثقافي يصنع هوّة عميقة لا مجال لترميمها. الشعر يرى "الجاحظ"، حسبما يتضح مما سبق، أن ما يميز أدب العرب عن سائر الأمم هو نظمه ووزنه في الشعر، فبدونه لا فرق بين حكمتهم وحكمة الأمم الأخرى: ولعل قوله يرجع إلى ما اشتهر به العرب من إبداع وتألق في نظم الشعر، لكن تميزهم فيه لا ينفي خصوصية الشعر في كل لغة وثقافة؛ فجماله مزيج للمعنى (الدلالة) واختيار الألفاظ (الحصيلة المعجمية) ومزاياه الصوتية (النظم والوزن والقافية). ولهذا يحار المترجمون للشعر في إمكانية ترجمته بين اللغات، فيظن كثيرون استحالة ترجمة الشعر بالجملة، فيما يقول آخرون أن الشعر لا يترجمه إلا شاعر،[102] ويتبرأ بعض الشعراء مما تُرجم من أشعارهم وكأنه لم يعد من تأليفهم،[103] ومع ذلك فإن ترجمة الشعر صنعة قائمة جرّبها وما زال يسلكها كثيرون. أشعار الأمم يقال: إن "الخليل بن أحمد الفراهيدي" قصد شوارع بغداد ذات يوم، فمر بسوق الصُّفارين (والصُّفر هو النحاس حين يصفر لونه،[104] أي حين يُطرق)، وهو سوق يصدح دومًا بأصوات مطارق النحاسين التي يطرقون بها مصنوعاتهم؛ من أوان وأباريق وأطباق، فتحدث ضجة مثل قرع الطبول.[105] وتوقف "الفراهيدي" ينصت لهذه الأصوات وما فيها من طرق كلحن الموسيقى، حتى ظنه المارة -كما تقول الحكاية- مخبولًا،[106] إلا أنه استنبط مما سمعه بحور الشعر العربي وعلم العروض.[107] إلا أن علينا أن نعلم أن ما اكتشفه "الفراهيدي" (لو غضضنا النظر عن صحة القصة أو عدمها) كان وزنًا ينتظم به الشعر العربي، ويختلفُ هذا النظم في أوزانه وأسلوبه ونظامه عن نظم وأوزان وأسلوب اللغات الأخرى، فيكاد الشعر في كل من هذه اللغة يكون لونًا مختلفًا عن الأدب في أي لغة أخرى. تُنظَم بحور الشعر في اللغة العربية بحسب علامات حروفها الساكنة أو المتحركة، فتنقسم إلى أسباب (نحو "بَلْ"، وهي متحرك يتبعه ساكن) وأوتاد (نحو "رَمَى"، وهي متحركان فساكن) وفواصل (نحو "سَمَكَاً"؛ أي "سَمَكَنْ" بالتقطيع الشعري، وهي ثلاث متحركات فساكنْ).[108] وتتناغم بحور الشعر بحسب سكونها وحركتها مثل: قرع أواني الصفارين التي ألهمت "الفراهيدي"، وعدد هذه البحور -جميعًا- ستة عشر بحرًا،[109] وقد رتبها "الفراهيدي" وأعطى لكل منها اسمًا، كالمَديد والبَسيط والسَّريع. مخطوط في بحور الشعر العربي من تأليف الشيخ "عبد الله الشبراوي"، وكتبها الشيخ "قاسم أفندي المفتي" بخط يده عام 1257 هـ. - منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر: ويكيميديا كومنز وفي اللغة الإنكليزية -كذلك- "بحور" للشعر تتبع نغمته وموسيقاه، لكن تقطيع هذه البحور يقوم على خاصية لغوية قلّما ينتبه إليها العرب، ما عدا طلبة التجويد وخبراء اللغة، وهي النَّبْر. والنَّبْر هو التركيز على مقطع من الكلمة لإبراز صوته فوق غيره، ويقال له بالإنكليزية stress، وقد يتضح معناه في اختلاف اللفظ بين أفعال وأسماء لها التهجئة نفسها، فيقال: "content" (وهو اسم معناه "محتوى"، فيأتي النَّبْرُ في المقطع الأول) و"content" (وهو فعل معناه " يُرضي"، فيأتي النَّبْرُ في المقطع الثاني). وفي اللغة العربية نبر كأن نقول: "مُتعلِّم" أو "مُعلِّم"، فيأتي النَّبرُ على التاء في الأولى واللام في الثانية. والنَّبرُ هو أساس نظم الشعر الإنكليزي فيأتي في مقاطع عليها نبر وأخرى بدونه بتتابع ثابت مثل بحور الشعر العربي، لكن كثيرًا من الشعراء تخلوا عن هذا الأسلوب، فبدؤوا بنَظْم الشعر المُرسل (Blank verse) أي دون قافية واحدة مع الحفاظ على الوزن، ثم الشعر الحر (Free verse) دون قافية ولا وزن، فأسقطوا سمتي الشعر الأصليتين، ولهذا ربما يكون الشعر الحديث أسهل في ترجمته. شعر أم نثر؟ للمترجمين منهجان غالبان في نقل الشعر إلى أي لغة: فإما نقله إلى شعر موزون يحفظ جمال الصوت (ولو أنه غالبًا ما يأتي مع تغيير في المعاني والكلمات لتتناسب والصوت المرغوب)، أو نقله إلى نثر يحفظ معنى القصيدة (ولو أن هذا يأتي -غالبًا- بدون سمات الشعر الصوتية من وزن وقافية وغيرها، لصعوبة جمعها مع المعنى). ولكل من هذين الأسلوبين مؤيدوه وخصومه، وهذا لأن نقل خواص الشعر مجتمعة من لغة إلى أخرى مستحيل واقعيًّا، فلا بد من التنازل عن شيء منها لقاء شيء.[110] وللأسلوب الأول (أي نقل الشعرِ شِعْرًا) أنصار كثر من المترجمين العرب، بذلوا محاولات طويلة في نقل الأشعار والملاحم الأجنبية إلى اللسان العربي، وخصوصًا رُوّاد فترة النهضة مثل: "دريني خشبة"، وهو مشهور بترجمته "للإلياذة" و"الأوديسة" شعرًا (مع أنه غيَّر فيهما تغييرًا جمًّا)، ولعل ترجمته مثال على ما يصفه الباحثون بأنه "ترجمة تتفوق على أصلها".[111] وأما الأسلوب الثاني (نقل الشعر نثرًا) فلم يلقَ تشجيعًا كبيرًا في التعريب بسبب تَعلّق النقاد العرب بجماليات الصوت؛ وعدم تقبلهم للأسلوب المُحدَث في الشعر المُرسَل والشعر الحر،[112] ومن أمثلة هذا الرأي قول الناقد والمحقق "إحسان عباس": إن الشعر لا تجوز ترجمته «وإلا تقطَّعَ نظمُهُ وبَطُلَ وزنُهُ».[113] وترجمة الشعر طريق محفوف بالمتاعب، وقد يكون من الأحق أن تُذلّل في حقول أخرى لها نفع أكثر، فلعل الأولى بهذا الجهد أن يذهب إلى تأليف شعر أو نثر عربي أصيل عوضًا عن النقل من أمم أخرى. ولنا هنا الاستشهاد بقول "عبد الخالق عيسى": «السر في جمال الشعر لا يكمن في المعنى أو الصورة الشعرية، بل في التعبير بطريقة غير مألوفة». فإذا رأينا (في المقال الأول من هذه السلسلة) أن نقل المعنى بين لغة وغيرها يتسم بالاستحالة، فكيف بنقله حينما يتحد مع أسلوب اللغة ومظهرها ووقعها الصوتي في منظومة واحدة متكاملة، تضع أمام المُعرّب أصعب تحدياته مجتمعة؟[114] _____ اقرأ أيضًا المقال التالي: تعريب الجملة وأقلمتها
-
في مقدمة هذه السلسلة، اللغة ومفهوم الترجمة بين اللغات، ذُكر أن كثيرين قد يسيؤون فهم الترجمة فيظنون أنها تسير في اتجاه واحد: إذ يخالون أن كل ما على المترجم هو إتقان لغة أجنبية ليترجم منها إلى لغته، وأما الواقع فهو أن الترجمة شطران: فالأول هو إتقان لغة جديدة والقدرة على قراءتها واستيعابها بعمق ودقة، وأما الشطر الثاني (الذي لا يقل أهمية عن الأول)، فهو إعادة صياغة هذا النص بلغة المترجم الأم، وهي العربية في حالتنا هذه، وهذا يعني أن المترجم هو -بدرجة أو بأخرى- كاتب أو أديب، وتستلزم مهنته استيعابًا دقيقًا لقواعد الكتابة واللغة والبلاغة. ربما أدت حركة الترجمة والعولمة والاحتكاك باللغات الأخرى؛ إلى تغيير طريقة تفكيرنا بلغتنا وصياغة الكلام فيها من جمل وكلمات، وترى هذا التغيير بسهولة لو وازنت أي كتاب عربي صادر في سنة 2020 بكتاب شبيهٍ به من القرن التاسع عشر أو الثامن عشر؛ أو أيّ زمن أسبق، والفرق الشديد الذي ستراه بينهما في اللغة والمفردات ليس سوى نتيجة لتراكم كثير من المؤثرات التي تغيرت لغتنا (كما ورد في مقال آفات الترجمة على اللغة)، والتي تتجلَّى كثير منها في الترجمة على مستوى الجملة. الفهم قبل الفعل من أول وأهم التزامات المترجم؛ أن لا يكتب كلامًا قبل أن يفهمه، إذ كيف يتوقع من القارئ أن يفهم كلامه، والمترجم نفسه يفتقر إلى فهم ما كتب؟ وقد يبدو هذا مبدأ بديهيًّا جدًّا، لكنه من أكثر المشكلات وقوعًا في الترجمة، حتى ولو كانت من دار نشر معروفة، أو مترجم صاحب خبرة وسمعة. والسبب في شيوع ذلك هو أن اطلاع المترجم ومعرفته محدودان؛ مثله في ذلك مثل أي شخصٍ سواه، إذ يغلب أن لا يكون متعمقًا بمجالات اختصاصية كثيرة خارج مهنته، على أن الترجمة تجبره -بالضرورة- على التعامل مع نصوصٍ من شتى المجالات والاختصاصات، فيقابل عددًا لا يستهان به من الكلمات والجمل؛ التي يعجز عن فهمها تمامًا، والمشكلة أن تلك ليست حجة جائزة له في الإخلال بتعريبها. لا سبيل لتوفير الوقت في هذه السياقات الصعبة، فعلى المترجم أن يكرس جهدًا لا يستهان به للاطلاع على موضوع ترجمته واستيعابه؛ سواء في معجم لفهم الكلمات الجديدة عليه، أو في مرجع علمي[1] لفهم موضوعها جملةً تفصيلًا. وقد يضطر المُعرّب هنا إلى استغراق وقت أطول مما يستغرقه في الترجمة؛ ليتعمق في الموضوع الذي يترجم عنه ويفهمه، فيتبحر في علم الفلك أو الهندسة أو الأحياء أو القانون؛ حتى يشعر أنه ملم بالنص، كما أنه قد يجد ضرورة -في حالات كثيرة- لإعلام القارئ ببعض ما تعلمه خلال الحواشي والملاحظات، فلو استغرق ساعة في مراجعة الموضوع والتوسع فيه، فمن الأولى أن يحتاج القارئ لذلك أيضًا. وتزداد تداعيات هذه المشكلة سوءًا في الكتب والروايات الطويلة، ففي مثل هذه الحالات يقدم الكاتب عبر النص أفكارًا، ومفاهيم تأسيسية يبني عليها باستمرار طبقة فوق طبقة، فمثلًا: لو كان موضوعه يتعلق بنظرية فيزيائية لآينشتاين؛ فسوف يبدأ بأفكار تأسيسية عن النظرية، كمجال الجاذبية والقصور الذاتي للأجسام، ومن ثم سينتقل منها إلى نسيج الفضاء والزمان، وامتزاجهما في الزمكان، وهلم جرّا، حتى تتضح كل فكرة في ذهن القارئ. ولو عجز المترجم نفسه عن فهم أفكار الكتاب الأساسية بعمق ووضوح شديد، فقد يسيء ترجمة تسلسل أفكار المؤلف كاملة، والنتيجة أن القارئ يفقد استيعابه من الصفحات الأولى في الكتاب ولا يستطيع أن يسترجعه أبدًا. ويحل كثير من المترجمين هذه المشكلة (رغبة منهم بتوفير وقتهم وجهدهم) بأن ينقلوا كل ما لا يفهمونه كلمة بكلمة من اللغة الإنكليزية إلى العربية، ويقي هذا الإجراء المترجم من الاضطرار لاقتطاع أي جزء من النص الأصلي، فيتفادي إظهار قصور فهمه أمام صاحب العمل، ويضمن حصوله على أجره كاملًا (إذا كانت الجهة الناشرة متساهلة بما يكفي، وهذه هي الحال غالبًا)، إلا أنه لا يعني أي شيء بالنسبة للقارئ: لأن هذا الكلام الحرفي لن يضيف أي معلومة جديدة للقارئ، ولن يعينه على متابعة النص. وفيما يلي مثال بسيط من ترجمة قصة "الأولاد السود" (The Black Boys)، وهي قصة أطفال ألمانية مشهورة، وتحولت لاحقًا إلى مسلسل أنمي يعرفه بعض المشاهدين العرب باسم "عهد الأصدقاء"، وأقتبس من ترجمتها العربية الحوار الآتي من لقاء روميو بصديقه ألفريدو:[2] "مرحبًا بك. أنا ألفريدو. من أنت؟". "أنا جوليان. من أين أنت قادم يا ألفريدو؟". "أنا قادم من وادي ميسوكو. وماذا عنك؟". لم يفهم المترجم المبتدئ هنا معنى جملة أساسية هي "Where do you come from"[3] (ومعناها: "من أي بلد أنت؟") أو أن كتابته العربية ضعيفة جدًا فلم يفلح إلا بنقل الجملة إلى اللغة العربية كلمة بكلمة، فصار وقعها وكأن السؤال هو: "من أين أتيت إلى هنا؟" لا "من أي بلد أصلك؟". وهذا مثال متألق على الترجمة الحرفية التي يتجنب فيها المترجم إرهاق نفسه باستيعاب المعنى الحقيقي الكامن وراء الكلام، فيأتي بترجمة آلية لا معنى لها. والنقطة الجوهرية هنا هي: أن الترجمة لا تعني نقل نص من لغة إلى أخرى، فهذا لا يفي بأي غرض، ولكن الترجمة الحقيقية هي في فهم المعنى ثم إعادة صياغته للقارئ بلغته الأم، بحيث تصله الرسالة بأسلوب المترجم، وليس بأسلوبها الأصليّ. وسنعود لمناقشة هذه النقطة من خلال زوايا أخرى لاحقًا، وخصوصًا فيما يتعلق بتغيير الأسلوب؛ الذي قد يتردد بعض المترجمين في الإقدام عليه. ترتيب مكونات الجملة مما يلفت النظر، أن المكونات الرئيسة للجملة هي نفسها في معظم لغات العالم، وهي الفعل والفاعل والمفعول به (التي تقابلها بالإنكليزية Verb، وSubject، وObject، على الترتيب)، لكن الأهم من ذلك هو أن ترتيب هذه المكونات ليس عشوائيًا: ففي كل لغة تسلسل سائد لمكونات الجملة قد لا يتغير أبدًا (أو قد يتغير في حالات محددة معروفة)،[4] وترتيب الجملة العربية السائد؛ يختلف عنه في معظم اللغات اللاتينية، ولهذا الاختلاف أثر لا يستهان به في الترجمة. تعتمد اللغة الإنكليزية على ترتيب SVO في بناء الجملة، مما يعني أن كل جملة إنكليزية تبدأ دائمًا بالفاعل، ثم الفعل فالمفعول به، أما الجملة الفعلية العربية فتبدأ عادة بالفعل، ومن ثم يكون ترتيبها الصحيح هو VSO. وتقبل اللغة العربية البدء بالفاعل (بأن تسبق الجملة الفعلية أخرى اسمية) لأنها مرنة إعرابيًّا،[5] على أنها ليست الحال المألوفة. ولعل البدء بالفعل أصبح يندر بالفعل في اللغة العربية الفصحى بسبب تداعيات الترجمة؛ والاختلاط باللغات الأجنبية، فقد أصبح من المعتاد أن تبدأ بالفاعل كثير من الجمل العربية المترجمة أو الحداثية، على أن المترجم لو انجرف مع هذا التيار فإنه يؤثر على لغته وكيفية استخدامها بين الناس،[6] إذ إن الترتيب الجملة وقعًا كبيرًا في النحو والخطاب، وهو موضوع نال بحثًا معمقًا في دراسات الترجمة.[7] وعلى الرغم من مرونة اللغة العربية إجمالًا، إلا أن المترجمين قد ينقلون إليها (تأثرًا باللغة التي يترجمون عنا) تراكيب ليس من الطبيعي أو المألوف استخدامها فيها بكثرة. ومن أمثلة ذلك ضمير الغائب، الذي يعتاد الكتاب عمومًا (والصحفيون خصوصًا) في اللغة الأجنبية تقديمه على صاحبه بقصد التشويق أو التغيير، فيبدؤون كثيرًا من الجمل قبل الإفصاح عمَّن يرجع عليه الكلام فيها، مثل الآتي: In His speech, president Barack Obama promised to raise the salaries. إذ جاء هنا الضمير الذي يعود على "باراك أوباما" قبل صاحب الضمير، وأصبح هذا الأسلوب شائعًا في الصحافة العربية كذلك (سواء كانت مترجمة أو مكتوبة بالعربية أصلاً)، فيأتي على شاكلة: في خطابه، وعد الرئيس باراك أوباما بزيادة الرواتب. وعلى الرغم من الخلاف على جواز هذا التقديم[8] فإنه بلا شك يخالف المألوف، وكان من الأنسب تقديم الفاعل على ضمير الغائب، أو أن نحذف الضمير كله لأنه لا يضيف قيمة للجملة العربية فنقول: وعد الرئيس باراك أوباما في خطابه بزيادة الرواتب. وعد الرئيس باراك أوباما في خطابٍ بزيادة الرواتب. أنواع الجملة الإنكليزية تناولنا سابقًا مثال كلمة مشهور من الآية: «وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ» (سورة الحجر، الآية 22): تأتي كلمة "فأسقيناكموهُ" في هذه الآية بالمعنى التقريبي: "أنزلنا لكم [أو أسقيناكُم إياه] ماءً عذبًا"،[9] ولو درسنا إعرابها نجد فيها حرف العطف (الفاء) والفعل (أسقى) والضمير المتصل في محل رفع فاعل (نا الفاعلين) والضمير المتصل في محل نصب مفعول به (كُم) وضمير الغائب في محل نصب مفعول به ثانٍ (الهاء).[10] ولو تُرجمت هذه الكلمة إلى أي لغة لاتينية لأمست جملة كاملة من أربع أو خمس كلمات على الأقل، لكن يجوز في اللغة العربية جمعها كلها في كلمة واحدة: وهذا لأن أنواع الجملة وتراكيبها، تختلف بين اللغات، ومن المهارات الضرورية في الترجمة استيعاب أنواع الجمل هذه في كل لغة. تختلف اللغة الإنكليزية عن العربية؛ بأن الجملة فيها مقسمة إلى مجموعات من الكلمات، واسم كل مجموعة منها "clause" أو "الإسناد"، وربما من الأدق القول: إن الـ"clause" يماثل الجملة الفعلية باللغة العربية: فهو كل جملة فيها فعل، وأما ما يسميه أهل اللغة الإنكليزية "الجملة" (sentence) فيماثل باللغة العربية عدة جمل ملحقة بعضها ببعض. والقاعدة السائدة دائمًا وأبدًا في اللغة الإنكليزية هي أن كل جملة تبدأ بحرف كبير (CAPITAL) وتنتهي بنقطة، فالنقطة علامة مؤكدة وحاسمة فيها على نهاية الجملة،[11] وترتبط الجملة الإنكليزية بجمل بعدها وقبلها لتكون فقرة، وفي كل فقرة (أي كل مجموعة من السطور المتصلة) فكرة واحدة يعرضها الكاتب لا تقل أو تزيد؛ وهذه كلها معلومات جوهرية في عمل المترجم كما سنرى. من الصعب أن نتعمق في شرح الجملة الإنكليزية بهذا السياق، لكن لنا أن نتطرق -باختصار- إلى جوانبها التي تتعلق بوظيفة المترجم. في اللغة الإنكليزية ثلاثة أنواع للجملة، تختلف في بنائها النحوي؛ وهي الجملة البسيطة (Simple) والمركبة (Compound) والمعقدة (Complex).[12] وفيما يلي أمثلة توضيحية على هذه الأنواع بالترتيب، وهي مقتبسة من أحد فصول رواية "جزيرة الكنز":[13] [Simple] He is called Long John Silver [Compound] He is called Long John Silver, and has lost a leg [Complex] He is called Long John Silver, and has lost a leg; but that I regarded as a recommendation, since he lost it in his country's service. ولتفسير ما في هذه الأمثلة، قد يلحظ القارئ أن الجملة البسيطة هي جملة عادية من فعل وفاعل ومفعول به، وهي أساس الكلام وأبسطه في اللغة الإنكليزية،[14] وأما النوعان الآخران ففي كل منهما مزج لجملتين بسيطتين -معًا-، لكن بينهما اختلاف واضح: تجمع الجملة المركبة بين جملتين بسيطتين دون تغيير شيء فيهما، ما عدا أن تضع بينهما حرف عطف[15] يجمعهما، كحال المثال الثاني ففيه جملتان قائمتان بذاتهما، ومن أمثلة حروف العطف: and, or, but وغيرها.[16] تمزج الجملة المعقدة بين جملتين بسيطتين فترتبطان -معًا- ارتباطًا لازمًا، إذ لا يكتمل معنى الواحدة منهما إلا بالأخرى، ولو فصلت واحدة منهما عن الأخرى فستصبح جملة غير مفهومة. فلو أخذنا شطرًا من الجملة الثالثة دون الآخر؛ لنقص المعنى، ويقع ذلك بسبب أدوات تدخل على الجملة فتعدل تركيبها منها: while, although, since وغيرها.[17] وبما أن للغة الإنكليزية ثلاثة أنواع من الجمل لا غير (ويضاف إليها نوع رابع هو مزيج بين جملة مركبة وأخرى معقدة)، فإن من النافع للمترجم أن يدرسَ أسلوب ترجمة كل نوع من أنواعها في الظروف العامة؛ فالجملة البسيطة جملة فعلية عادية نترجمها إلى جملة اسمية أو فعلية قريبة في معناها، وأما الجملة المركبة فهي جملتان فعليتان أو اسميتان متواليتان، ولذا نستطيع ترجمة كل منهما منفردة ثم نجمعهما بحرف عطف عربي مثل الواو أو الفاء، وبذلك يبقى تركيبهما قريبًا من الأصلي الإنكليزي. لكن معضلة الترجمة العربية (كما يقول صفاء خلوصي) هي في الجملة المعقدة، لأنها تجلبُ إلى اللغة العربية تركيبًا نحويًّا دخيلًا وغريبًا عليها، ولهذا فإن الجملة المعقدة هي أصل معظم مشكلات الترجمة نحوًا،[18] ومن المهارات المتقدمة للمترجم العربي أن يتقن تعريبها. جون سيلفر، من رواية جزيرة الكنز. - منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر: ويكيميديا كومنز لنعد إلى المثال السابق: قد نحاول ترجمة الاقتباسات التي أخذناها من "جزيرة الكنز" إلى الصورة الآتية: اسمه جون سيلفر اسمه جون سيلفر، وله ساق واحدة اسمه جون سيلفر، وله ساق واحدة، على أنه خسر ساقه الأخرى دفاعًا عن وطنه فرأيت هذه نقطة في صالحه. فتغدو -إذًا- الجملة الأولى جملة عربية إسمية (بدلًا من الجملة الإنكليزية البسيطة)، والثانية جملتين اسميتين جمع بينهما حرف عطف (بدلًا من الجملة المركبة)، ولو أننا عدلنا الثانية تعديلًا طفيفًا؛ لأن التعبير عن خسارة جزء من الجسم في العربية لا يصح أن يأتي فعله بضمير المتكلم، بعكس الإنكليزية (فلا نقول "قطع ساقه" بل "قُطعت ساقه").[19] وأما الثالثة فعربناها إلى جملتين فعليتين وعكسنا ترتيبهما، وستتبين أدناه الحاجة الماسة إلى تعديل ترتيب الجملة المعقدة في حالات كثيرة أدعى من هذه. يتعمد الكاتب الجيد التنويع في تراكيب الجمل وأنواعها، للتفنن بالأسلوب ولتجنب التكرار الممل الرتيب،[20] لكن هذه النعمة قد تنقلب نقمة في الترجمة؛ لأن أنواع الجمل ليست متساوية ومتماثلة بين اللغات، فلا يستطيع المترجم أن ينقل تراكيبها وبُناها النحوية دون حذر وتعديل، وبعض هذه الحالات تكون صعبة جدًّا لأنها تستدعي تفكيك الجملة وإعادة تركيبها جذريًّا، مما يقتضي من المترجم فهمًا دقيقًا لأنواع الجملة باللغتين. أسلوب الخطاب توثق كثير من الدراسات -في علم الخطاب- التباين في تركيب الجمل بين اللغتين العربية والإنكليزية. وتشير هذه الدرسات إلى أن الإنكليزية تميل إلى تركيب جمل بسيطة وقصيرة تيسيرًا للقراءة؛ وتفصل بينها بعلامات ترقيم دقيقة جدًّا، بينما تعمد اللغة العربية إلى الإطالة في الجملة الواحدة، وصهر أفكارٍ كثيرة متتابعة فيها.[21] فمن الطبيعي أن تشغل الجملة العربية الواحدة فقرةً كاملةً، فيما تعد هذه زلة مبتدئ للكاتب الإنكليزي. وقد يعْزى ذلك إلى أن علامات الترقيم جديدة على اللغة العربية؛ إذ قلّما استخدمت في تدوينها التراثي،[22]فلم تفرض ضوابط الترقيم فيها المباعدة بين الجمل إلا بالفاصلة؛ فظلت فقراتها مطولة ومتتابعة. ولهذا الاختلاف بين اللغتين أبعاد كبيرة قد لا يلحظها المترجم إن لم يكن حسن الاطلاع على الأدب العربي. رأينا أن اللغات تختلف في نحوها وتصريفها، فتعتمد كل منها على أسلوب في الكلام يتناسب معهما، وفي الإنكليزية سبب قوي يجبر من يكتب فيها على أن لا يطيل في الجملة الواحدة: وهو أن اللغة الإنكليزية ليس فيها تصريف للأفعال للجنس والعدد، ففعل "act" له شكلان فقط (act أو acts) بينما لو ترجمناه إلى العربية قد يصبح: "يُمثِّلُ" أو "تُمثِّلُ" أو "يُمثّلان" أو "تُمثِّلان" أو "يمثِّلون" أو "يُمثِّلْنَ". ويترتب على نقص التصريف في اللغة الإنكليزية صعوبة التمييز بين الفاعل والمفعول به، ولهذا يفضل أهل اللغة الإنكليزية كتابة جمل قصيرة منفصلة خشية الغموض اللغوي (وهو مسألة سنأتي على بيانها فيما بعد). وبسبب أهمية الوضوح والدقة من أوليات الكتابة الإنكليزية، نرى تكرارًا هائلًا للضمائر فيها للتوثق من أن القارئ يستوعب الشخص المقصود بكل فعل، ولا يضيع عليه معنى الكلام،[23] على أن هذا الأسلوب ليس ضروريًا في اللغة العربية لأن كثرة التصريف[24] تيسر على القارئ فهم الجملة ولو طالت وتفرعت، بينما يغدو تكرار الضمائر -في العربية- تكرارًا فارغًا لا مغزى له. وقد نرى ذلك في المثال الآتي (من رواية The Great Gatsby): "She didn't like it," he insisted. "She didn't have a good time." [حرفيًّا]: "هي لم تعجبها [حفلة الرقص]"، أصرّ هو، "هي لم تحظَ بوقت جيد". [بتصرّف]: قال مصرًّا:"لم تعجبها الحفلة ولم تستمتع بها". على عكس اللغة الإنكليزية، يستصعب القارئ العربي التوقف باستمرار أثناء القراءة؛ لأن تصريف الأفعال والأسماء في العربية يسمح بتدفق الكلام وبإطالة الجملة، وهذه سمة من سمات اللغة التي يجب أن يستوعبها المترجم ويحسن استعمالها، فيمكن لثلاث جمل أو أربع جمل إنكليزية أن تمتزج في جملة عربية واحدة (كالمثال أعلاه)، وينبغي على المترجم العربي أن يتعلم مزجها حينما يسمح السياق بذلك، إذ إن الضرورة اللغوية التي ألزمت فصلها بالإنكليزية تسقط حين تعريبها. وقد يستوجب مزج الجمل -كذلك- أن يعاد ترتيب علامات الترقيم فيها، إذ إن للمترجم حرية تركيب الجمل وتغييرها بما يتلاءم مع احتياجات اللغة، فيمزج بين الجمل البسيطة ويزيل النقاط بينها[25] ويحذف الضمائر الزائدة ويربط الجملة مع ما بعدها بحرف عطف. ويحدث كثيرًا- لهذه الأسباب- أن يقل طول النص الإنكليزي حين تعريبه باحترافية وبإلمام لغوي صحيح، على أن بعض سياقات التعريب قد تسلتزم العكس، ومنها تعريب الصفات والحال. الصفة والحال يقول الروائي الشهير ستيفن كينغ: "the road to hell is paved with adverbs"، وهو تحذير للكتاب المبتدئين من الإسراف بإضافة ألفاظ "الحال" إلى كتابتهم،[26] إذ تملي مَلَكة كثير من الكتّاب الجدد عليهم أن يكتبوا جملًا منمّقة بالحال مثل: "فتح شخص الباب مسرعًا، ثم دخل الغرفة لاهثًا، وتوجه إلى الخزانة فزعًا" (ربما بدلًا من: "دخل الغرفة وفتح الخزانة"). لكن هؤلاء الكتاب الهواة لا يُلامون تمامًا؛ لأنهم يقتدون بأصول الكتابة في اللغة الإنكليزية، وهي لغة تُثقل جملها بالأحوال والصفات لتحشد كمًّا هائلًا من المعلومات[27] في جملها القصيرة الكثيفة. وفيما يلي مثال متطرف (ولو أنه حقيقي) اجتمعت فيه خمس عشرة صفةً في جملة واحدة تتحدث عن فنون المسرح:[28] As broad farce surrendered to cloying melodrama, with its fitful bouts of frenzied shouting, wooden acting, and intermittent violence scenic effects, we were subjected to savage tickling, sentimental pleading, emotional blackmail, religious pandering, vehement exhortation and downright bullying. ولعلك تلاحظ في أي ترجمة كم تأتي هذه الصفات والأحوال ثقيلة على اللسان العربي؛ لأنها غير مألوفة فيه، فيحشرها المترجمون في الكلام حشرًا ويضطر القارئ لتفكيكها في ذهنه -بعضها عن بعض- إن أراد فهم النص، وهذا يجبرنا على البحث عن وسيلة لتكييف هذه السمة الصّعبة باللغة الأجنبية مع عادات الكتابة العربية. وفيما يلي أمثلة واقعيّة من عدّة روايات معرّبة تْظهر الجمل الصعبة التي ينتجها تعريب الصفات والأحوال (وقد ميزتها بخط أسفلها، مع ملاحظة أن المقصود هنا هو الطريقة التي تظهر بها الصفات والأحوال الإنكليزية بعد تعريبها، ولا يعني هذا -بالضرورة- أنها تعد "صفة" لا "حالًا" بالعربية): كان البحر المتلألئ يرتفع ويموج لأعلى، ويتحرك متفككًا إلى مستويات مسطحة صاخبة...أما الشعاب المرجانية وأشجار النخيل القليلة المتشبثة بالأجزاء المرتفعة فإنها كانت تطفو لأعلى في السماء (سيد الذباب، ص109).[29] وكان حين وجوده على سطح السفينة السفلي وسط زحام الأصوات المنبعثة من مائتين من أقرانه، ينسى نفسه ويسبق عمره بالعيش في خياله في حياة البحر (لورد جيم، ص6-7).[30] وكانت إحدى عابرات البحار من البواخر التي تحمل البريد، قد وصلت عصر ذلك اليوم (لورد جيم، ص121). لم تستطع السيدة بينيت -ولا حتى بمساعدة بناتها الخمس- أن تستدرج زوجها ليعطي أوصافًا وافية عن السيد بينغلي (كبرياء وهوى، ص17).[31] وهذه الجمل صعبة الفهم لأنها مثقلة بدفق كبير من المعلومات التي اختصرتها بضع صفات وأحوال في النص الأصلي، وذلك لأن اللغة الإنكليزية تسمح بإلصاق سوابق ولواحق كثيرة بالصفات تضيف إليها معانٍ يطول تعريبها، مثل كلمة: unremarkable (أي [un] [remark] [able])، التي تعرّب إلى: "غير جدير بالملاحظة".[32] ومن الطبيعي أن يُضطر المترجم هنا -كما رأينا أعلاه- إلى تعريب هذه المعاني المتشابكة بجمل إسمية متتابعة بالعربية، والتي تُصبح ثقيلة ومزعجة على القارئ الذي لم يعتد هذه الكثافة من المعلومات. وقد يحلّ المُعرّب مشكلة الصفات والأحوال بأن يُحوّل هذه الجملة الإسمية المتتابعة إلى جمل فعلية، فنقترح: أن يُفرّق المترجم الجملة الإنكليزية الواحدة -المثقلة بالصفات والأحوال- إلى جمل عربية قصيرة؛ نبدل فيها الصفة بفعل (أي أن نقلد أسلوب التعبير الإنكليزي بما فيه من جمل قصيرة وبسيطة). وفيما يلي الأمثلة السابقة نفسها، بعد تطبيق هذه الطريقة عليها: كان البحر متلئلئًا، وأخذ يموج ويرتفع فيتفكك إلى طبقاتٍ مستوية، فأحدث ضجة صاخبة…أما الشعاب المرجانية فبدت وكأنها تطفو نحو السماء، ومثلها أشجار النخيل، والتي تشبثت بعضها بالمرتفعات. وكان ينسى نفسه حين وجوده أسفل سطح السفينة، إذ تزدحم حوله أصوات مائتين من أقرانه، فيسبق عمره بالعيش في خياله في حياة البحر. وكانت تعبر البحر باخرة تحمل البريد، فوصلت عصر ذلك اليوم. لم تستطع السيدة بينيت أن تستدرج زوجها ليوفي بوصف السيد بينغلي، حتى حينما هبّت بناتها الخمس لمساعدتها. ليس من الضروري أن تدعو كل حالة إلى هذا الأسلوب المعقد قليلًا في التعريب، لكنه يصبح حلًا ثمينًا في الجمل المتطرفة التي يَجْهَد المُعرّب في نقلها. وفي ما سلف من أمثلة بعض من التصرّف في ترتيب الجمل الأصلية، وهو تغيير يجوز لسببين إن لزم: الأول هو أن يساير تركيب مكونات الجملة بلغة الترجمة (إن كان مختلفًا عن تركيبها باللغة الأصل)، والثاني هو أن يقرّب النص إلى جمهور الترجمة إن كانوا أقل دراية بموضوعه (مثل أن يكونوا أقل إلمامًا من جمهور النص الأصلي باللغة الأكاديمية والاختصاصية).[33] ولعل كلتا الحالتين تنطبقان على الأمثلة أعلاه؛ لأن التركيب اللغوي غريب عن العربية، ولأنه صعب -غالبًا- على جمهور القُرّاء. وينطبق هذا على أنواع أخرى من أدوات التعبير الإنكليزية. وعلى الرغم من.. يحدث في اللغة الإنكليزية أن تأتي أدوات للنفي في بداية الجملة المعقدة أو في منتصفها، ومن أكثرها ترددًا although (ومثلها while..وhowever)، وإذا صادف المترجم جملة تبدأ بهذه الطريقة[34] -وهي كثيرة- فعليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن لها شقين: الشق الأول يصف معلومة، والشق الثاني ينقضها أو يخلص إلى استنتاج غير متوقع منها. وهذا نوع من الجمل فيه صعوبة بالتعريب. ويعرف القارئ الأجنبي (مثل الكاتب) من تركيب هذه الجملة أن شقها الثاني سينقض الأول، ويحاول المترجمون العرب أن يقلدوا هذا التركيب بأن يبدؤوا الجملة العربية بكلمتي "على الرغم من.."، ولكنّ استيعابها يبقى صعبًا لأن بناءها دخيل، ولأن اللغة العربية لا تساعد على ربط شقي الجملة معًا، وقد يكون من الأسهل للمترجم والقارئ، حذف كلمتي "على الرغم من" في بداية الجملة، والاستعاضة عنهما ببديل مثل "لكن" و"إلا أن" و"على أن" و"مع أن" في بدء الشق الثاني، أي بتأخير النفي بدلًا من تقديمه. وفيما يأتي مثال على الفرق بين الطريقتين (من مقالة لويكيبيديا عن نوعٍ من الديناصورات):[35] Although the completeness, preservation, and scientific importance of this skeleton gave "Big Al" its name; the individual itself was below the average size for Allosaurus. [حرفيًّا]: على الرغم من أن اكتمال هيكله وحُسن حفظه وأهميته العلمية، أعطوا لـ"بغ آل" اسمه، إلا أنه كان تحت الحجم المتوسط للألوصور. [تصرُّفًا]: سُمّي هيكل الألوصور "بغ آل" لاكتماله وحُسن حفظه وأهميته العلمية، على أن حجمه كان أصغر من المعتاد بين بني جنسه. المبني للمجهول تتجلى الترجمة الحرفية بكثير من الكلمات والتراكيب الدخيلة على اللغة العربية؛ ولعل إحدى أكثر علاماتها انتشارًا هي كلمة "تم"، والتي جرت العادة على الاستعانة بها في ترجمة الأفعال المبنية للمجهول.[36] ولا تقع الركاكة في ترجمة هذه الأفعال بدون سبب، إذ إن صيغة المبني للمجهول صعبة ومربكة لأن فيها اختلافًا جوهريًا بين اللغتين العربية والإنكليزية: إذ إن فاعلها باللغة الإنكليزية ليس "مجهولًا" دومًا. مثلما تختلف اللغات في كثير من خصائصها؛ كالتي تناولها المقال الأول من هذه السلسلة، فإن صيغة المبني للمجهول هي واحدة من الاختلافات المعتبرة بين العربية والإنكليزية: ولا يقتصر ذلك على أنها تأتي في سياقات متفاوتة في هاتين اللغتين، بل في اختلاف فكرتها الأساسية. فقد نقول: "كُتِبَ الكتاب"؛ إن كان مؤلف الكتاب غير معلوم (أو لم نرغب بإعلام القارئ فيه)، فينوب عنه في هذه الجملة نائب الفاعل ("الكتاب"). وهذه صيغة لا يحتاجها الكاتب العربي إلا في سياقات محددة، لذا قد يبدو من الغريب أن تشيع الأفعال المبنية للمجهول في الإنكليزية حتى يكاد يصادفها المترجم في كل نص وكل فقرة يقف عليها.[37] حينما نقول أن اللغة الإنكليزية فيها أفعال "مبنية للمجهول" فإننا نحاول إسقاط قواعد لغتنا على لغة أخرى بالتشبيه والمقاربة، لكننا رأينا أن اللغات لا تترادف في معانيها ولا في قواعدها، وما يحل مكان "المبني للمجهول" (كما نعرفه) في اللغة الأجنبية هو ما يسمى -حرفيًا-: "النبرة الخاملة" (passive voice)، ومعناها أن الفاعل في الجملة يصبح مفعولاً به: فيتلقى فعلًا بدلًا من أن ينفذه، وهي عكس "النبرة الفعالة" (active voice). ومن أمثلتهما ما يأتي:[38] [Active]: Christopher Nolan directed “The Dark Night”. [Passive]: “The Dark Night” was directed by Christopher Nolan. لكلا هاتين الجملتين معنى واحدٌ، على أن الفاعل والمفعول به ينعكسان في الجملة الثانية، فيتصدر "كريستوفر نولان" الجملة الأولى فيكون "فاعلًا" فيها، بينما يمسي مفعولًا "خاملاً" في الثانية. وهاتان هما الطريقتان الأساسيتان لصياغة أي جملة في اللغة الإنكليزية، ولذا فإن كليهما شائعتان جدًا في لغتهما، وهذا فرق شاسع عن المبني للمعلوم كما نعرفه. السبب الرئيسي للخلط بين "المبني للمجهول" (بالعربية) و"النبرة الخاملة" (بالإنكليزية) هو إمكانية حذف ما كان الفاعل سابقًا (وأصبح مفعولًا به هنا) من الجملة الخاملة في اللغة الإنكليزية لتصبح "مبنية للمجهول" بحق، فقد يُقال: "The Dark Night was directed in 2008" (أي: بدون ذكر "كريستوفر نولان" الذي أدى فعل "الإخراج")، ويمكننا ترجمة هذه الجملة إلى صيغة المبني للمجهول بالعربية، فنقول: «أُخرِج فلم "ذا دارك نايت" في سنة 2008». لكن هذا لا يعني أننا نستطيع ترجمتها مع إضافة فاعل معلوم إليها، وهذه هي المشكلة التي ابتُدعت كلمة "تم" لحلها، والتي أصبحت عُرفًا راسخًا بين المُعرّبين الهواة في ترجمة الأفعال الإنكليزية حينما تأتي بالنبرة الخاملة؛ التزامًا منهم بقوانين الترجمة الحرفية الصارمة التي تملي تقليد كل جملة باللغة الأجنبية. بل إن كلمة "تم" أصبحت دارجة في مؤلفات كثير من الكُتَّاب العرب غير المترجمة، فيكتبون على شاكلة: تم الإخراج بواسطة كريستوفر نولان. وفي هذه الجملة مشكلتان بالعربية: الأولى والبديهية، هي أن المبني للمجهول -كما يدل اسمه- فاعله غير معروف، ولهذا فلا صحة (ولا منطق) في إتباع فعل مبني لمجهول ("تم الإخراج") بفاعل ("كريستوفر نولان"). وأما المشكلة الثانية، فهي أن هذه الترجمة الحرفية لا تأخذ بعين الاعتبار شروط اللغة الأجنبية التي استدعت اختيار المبني للمجهول، إذ إن قواعد اللغة الإنكليزية تفرض على الفاعل أن يسبق الفعل عادةً (كما ذُكر في ترتيب مكوّنات الجملة)، لكن المثال الذي نتاوله هنا خرق العادة؛ إذ تقدم الفعل الإنكليزي "directed" على الفاعل "Christopher Nolan"،[39] ولذا لزم -لدواع نحوية- أن يُضاف إليها حرف الجر by، بينما تبدأ الجملة العربية بالفعل أصلًا، فالأيسر أن نُعرّبها إلى صيغة المعلوم، ودون حاجة لكلمات زائدة فنقول: "أخْرَجَهُ كريستوفر نولان" أو "أخْرَجَ الفلمَ كريستوفر نولان". ينطبق هذا الأمر على سائر سياقات الكلمة الكثيرة، فنُعرّب "Computer was invented in 1871" إلى: "اختُرِعَ الحاسب في 1871"، و"America was discovered in 1492" إلى: "اُكْتُشِفَت أمريكا في 1492" (بدلًا من "تم اختراع الحاسب"، و"تم اكتشاف أمريكا"، وهلم جرّا). ومن المناسب تعريب "النبرة الخاملة" بتعريبها -أحيانًا- إلى صيغة المبني للمجهول السليمة بالعربية (بدون كلمة "تم")، ولو أن الأسلم منها هو الاستعاضة عن البناء للمجهول بالبناء للمعلوم؛ تماشيًا مع أعراف اللغة وأصولها. على المترجم أن يتجنب مخالفة أصول اللغة التي ينقل إليها، وعليه -كذلك- أن يأخذ بعين الاعتبار أعراف هذه اللغة. إذ على المُعرّب أن يُدرك هنا أن "النبرة الخاملة" متأصلة في الإنكليزية بسبب قواعدها، وحتى ولو احتجنا -في بعض الحالات- إلى تعريبها للمبني للمجهول، فهذا لا يفرض الإكثار منها في الترجمة العربية، والاختيار يقع على عاتق المُعرّب بناءً على فهمه لاختلافات اللغات وللوزن الأدبي لصيغة المجهول أو المعلوم فيها.[40] صيغة الملكية مثل جميع المشكلات التي تنتج عن الترجمة الحرفية، قد يحاول المترجم والكاتب غير المتمرس قد نقل صيغ الملكية كما هي، من لغة أجنبية، مما يؤدي إلى توليد كلمة جديدة مثل: "خاصّتي". ثمة طريقتان للتعبير عن الملكية باللغة الإنكليزية: إما بإضافة حرف s زائد في نهاية اسم أو بالاستعانة بضمائر التملك، وهي mine وyours وhers وhis وits وours وtheirs. وبما أن الالتزام بأصول الترجمة الحرفية يستلزم إبدال كل كلمة في اللغة الإنكليزية بمثيلة لها في العربية، فقد ابتدع المترجمون كلمات "خاصّتي" و"خاصّتكم" و"خاصّته" و"خاصّتها" و"خاصّتنا" و"خاصّتهم" لتكافئ كل هذه الضمائر، وخصوصًا حينما تأتي صيغة التملك لاسم مضاف معه مضاف إليه. وفي اللغة العربية ضمائر ملكية -أيضًا- لكنّها ضمائر متّصلة لا منفصلة، فهي تأتي ملحقة بالاسم المملوك، ومنها مثلًا: الياء للمتحدّث المفرد (بيتي) والنون وألف لجماعة المتحدثين (بيتنا). وفيما يلي مثال توضيحي لها من ترجمة لرواية "أقمار المشتري" لأليس مونرو:[41] [حرفيًا]: دلفتُ إلى غرفة جولي ووجدتها تحزمُ حقيبة الظهر خاصتها. [تصرُّفًا]: دلفتُ إلى غرفة جولي ووجدتها تحزمُ حقيبة ظهرها. ترابط مكونات الكلام مرت بنا لمحات من علم اللغة على مستوى المعنى (علم الدلالة) واللفظ (الصوتيات) والكلمة (الصرف) والجملة (النحو)، وهي أربعة من مستويات هذا العلم الخمسة، فيبقى أن نجمع بين هذه الجمل والكلمات وما لها من دلالات ومعان؛ لتكوين كلام متصل له معنى: وهذا مجال يدرسه علم تحليل الخطاب، ومن أهم مواضيعه دراسة العلاقة بين مكونات الكلام أو النص (Cohesion) لإيصال معنى مترابط متماسك، وهذه العلاقة هي التي تنظّم استخدام اللغة، وتسمح بفهم الكلام بناءً على ما يسبقه ويتبعه. وتختلف علاقة مكوّنات الكلام بين اللغات كثيرًا، وتصنع عوائق وعقبات للترجمة، وبعضها نال اهتمامًا كبيرًا من أساتذة اللسانيات ودارسيها.[42] اتصال الكلام لا يكفي أن ننظر إلى الترجمة وكأنها كلمات وجمل مجزأة، فمن السهل جدًّا على المترجم المبتدئ، وكذا البرنامج الآلي، أن ينقل كثيرًا من الجمل نقلًا متقنًا من لغة إلى لغة، ويأتي دور المترجم الماهر في سبك هذه الجمل؛ وما فيها من أفكار وكلمات -معًا- في فقرات ومقالات وفصول متكاملة. ويحتاج ربط هذه الأفكار بعضها ببعض إلى مهارة خاصة، مثل مهندس معماري يخطط لبناء تقوم فيه كل طبقة على غيرها، ولو فشل المترجم -بعد إتقانه ترجمة ما فيها- في ربطها معًا فقد يخرج ترجمة يستعصي فهمها: لا بسبب لغتها؛ بل لكلامها المتباعد الذي لا تتضح علاقته ببعضه.[43] رأينا أن المترجم يضطلع بعمل الكاتب، فهو يعيد صياغة الكلام وكأنه يكتبه من جديد، ولذا فعليه أن يوظف أدوات لتماسك الأفكار مثل الكاتب تمامًا، ومن هذه الأدوات؛ أن تبدأ كل جملة وتنتهي بما يربطها بسابقتها ولاحقتها، وبأن يلتزم فيها بزمن وسمت ثابت للأفعال.[44][45] فنقل الجمل أثناء الترجمة يعيد ترتيب مكوناتها، ومن السهل أن يضيع ترابط الأفكار بين فقرات المقالة أو فصول الكتاب. فيبدأ الكاتب الجملة -عادةً- بمعلومة يعرفها القارئ، ثم تلحقها معلومة مبنية عليها، ولم تأت سابقًا،[46] مثل القول: thead { vertical-align: middle; text-align: center; } td, th { border: 1px solid #dddddd; text-align: right; padding: 8px; text-align: inherit; } لأن للإلكترونات شحنةً سالبة فإنَّ اجتماعها مع البروتونات الموجبة يُحيِّد شحنة الذرة. معنى معلوم معنى جديد من أهم مستويات ترابط الكلام هي الانتقال من جملة إلى أخرى، وتساعد على ربط هذه الجمل والأفكار ببعضها أدوات لغوية (مثل حروف العطف)، وهذه الأدوات ليست لها معانٍ بذاتها، وبالتالي فإنها ليست دائمًا مما ينقله المترجم من لغة أخرى، وإنما عليها إضافتها -في أحيان كثيرة- ضمن مهمة التعريب التي يؤديها. ولو تغاضينا عن تأثير اللغات الأجنبية؛ فإن أكثر أدوات ربط الجمل ومكونات الكلام تداولًا في اللغة العربية -تراثيًا- كانت الواو والفاء العاطفتان،[47] والمترجم ليس مضطرًا بأن يحصر استخدامه بهاتين الأداتين،[48] وإنما يمكنه المزج بينهما (في مواضع النقص) وبينما ما أتى في النص الأصلي؛ ليحفظ شيئًا من أسلوب المؤلف الإنكليزي لكن دون الإكثار منه بما يفسد السليقة العربية.[49] وفيما يلي مثال مقتطع من كتاب كليلة ودمنة، لابن المقفّع؛ للتدليل على طريقة ربط الكلام في اللغة التراثية:[50] قال دمنة: إن إرادة الأسد لما يريد ليس لشيء مما ذكرت من تحميل الأشرار ولا غير ذلك، ولكنه الغدر والفجور، فإنه جبَار غدّار، أول طعامه حلاوة، وآخره مرارة، بل أكثره سم مميت. قال شتربة: صدقت، لعمري لقد طعمت فاستلذذت، فأراني قد انتهيت إلى الذي فيه الموت. أحرف الجر قال بعض النحاة: إن «حروف الجر ينوب بعضها عن بعض» لأن حروف الجر هي -عمومًا- ما دل على معنى في غيره. وقد يؤخذ من ذلك جواز التبادل الوظيفي لحروف الجر، بحيث يستخدم أي حرف جر مكان الآخر دون وازع أو ضابط، وحروف الجر متعددة في وظائفها إجمالًا،[51] ولهذا السبب -تحديدًا- من السهل الخلط بينها، خصوصًا أثناء الترجمة. فلكل لغة استخدامات تخصها لحروف الجر، فلا يأتي كل فعل فيها إلا مع حروف محدّدة، ولا يمكن ترجمة هذه الحروف من لغة إلى أخرى حتى بأكثر مناهج الحرفية تطرفًا.[52] حروف الجر هي عنصر آخر من عناصر اللغة الوظيفية التي لا تحمل معنى في ذاتها، وإنما تضيف معنى إلى غيرها من الكلمات، ولهذا فإن ترجمتها بين اللغات ليست منطقيّة. إذ إن لحروف الجر في كل لغة أفعال أو سياقات محدَّدة ترد فيها، ويمكن التوثق من هذه السياقات بمعاجم التصاحبات اللفظية (إن وجدت)، إلا أن معرفة ذلك ترجع -أيضًا- إلى الحفظ والخبرة، وقد تكون متفاوتة جدًا بين أي؛ لغتين مهما كانتا متشابهتين جدًّا في أصولهما التاريخية وبنائهما اللغوي. ويظهر هذا بالمثال الآتي لحروف الجر بالإنكليزية والألمانية: [بالإنكليزية]: I write in German. [بالألمانية]: Ich schreibe auf Deutsch. يماثل حرف الجر "auf" باللغة الألمانية في معظم استعمالاته كلمة "فوق" العربية، وربما يبدو من المدهش أننا لو ترجمنا هذه الجملة آليًّا من الألمانية، سوف تعني -حرفيًا-: "أنا أكتب فوق الألمانية" أو "على الألمانية"، والقصد هو: "باللغة الألمانية". وبالمثل؛ فإن جميع أحرف الجر قد تختلف استخداماتها وسياقاتها، بطريقة لا تتبع نظامًا من الأنظمة. ولو أخذنا حروف الجر العربية مثالًا، فسنجد أن الحرف "في" يأتي بعشرة معانٍ مختلفة بحسب سياقه، ومنها الظرفية (جريتُ في الملعب) والتعويض (فيمَ تُفكِّر؟) والتعليل (دخلت امرأة النار في هرّة حبستها) وغير ذلك. وقد نجد أن حرف الجر in في اللغة الإنكليزية يقابله في معاني الظرفية المكانية والزمانية، ولكنه لا يقابل حرف الجر العربي في وظيفة التعليل والتوكيد وغيرها، ومن المستحيل أن تجد أي حرف جر إنكليزي يماثل "في" أو أي حرف جر عربي يماثل "in" فهذه من خواص اللغات. وهذا يعني أن ترجمة حروف الجرّ ترجع إلى خصوصيّة السّياق، كما يعني أن حروف الجرّ الإنكليزية قد تختلفُ في تعريبها، وقد يصلح أويلزم إهمالها تمامًا، ويتضح هذا إن عدنا للمثال أعلاه فجاز أن نقول: "أنا أكتبُ الألمانيَّة". فوجود حرف جر بلغة أخرى، لا يعني وجوب مقابلته بحرف جر عربي، بل ربما يقتضي البناء السليم للجملة غير ذلك. وينطبق هذا الأمر على كثير من الإضافات التي تختص بها اللغات. الإبداع بالألقاب تقول إحدى الباحثات: «لكل لغة أعرافها في وصف الأفعال وفاعليها، ولا سبيل لغض النظر عن هذه الأعراف في الترجمة، إلا إن أردنا غض النظر عن قارئها -كذلك-».[53] والمقصود هنا هو خصوصية طريقة الإشارة إلى الأسماء (reference) من فاعل أو مفعول به، كأن نقول: "ذهبت لين إلى مدرستها" فتعود على لين تاء التأنيث في "ذهبت" والهاء والألف في "مدرستها" فنعرف أنها هي المقصودة بفعل الذهاب، وأنها ذهبت إلى مدرسة هي طالبة فيها. وقد نلاحظ هنا أن الإشارة المعتادة في العربية تكون بالضمائر، وأما الإنكليزية ففيها إبداع وتفنن كبير بالألقاب. قد تتنوّع طرق الإشارة إلى اسم واحد، فتلقي كل طريقة ضوءًا على سمة من سمات هذا الاسم، فقد تكون الإشارة بضمير أو اسم عادي (رأيته أو رأيتُ الطالب)[54] ومنها ما يأتي باسم مرادف في معناه (رأيتُ التلميذ) أو أعمّ منه (رأيتُ الفتى) أو أخص (رأيتُ مُحمَّدًا)،[55] وفيما يلي مقتطفات من تقرير لقناة فرانس24 العربية فيها عدة إشارات لشخص واحد:[56] تحدث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما السبت إلى طلاب في حفل تخرج افتراضي… وأكد أوباما أن الأزمة الصحية كشفت اللامساواة التي يعيشها الأمريكيون السود… ولا يهاجم الرئيس الديمقراطي السابق -عادةً- دونالد ترامب بالاسم ... تحبّذ اللغة الإنكليزية التنويع في الألقاب[57] للتفنن بها وتشويق القارئ لها، وقد تُألف هذه الألقاب في الأدب الأجنبي فتأتي على شاكلة: "ذهب حسام"، "عاد العجوز"، "جلس المسنّ"، "ابتسم الهَرِمُ الذكي"، "غمزَ ذو اللحية البيضاء". وقد لا يكون هذا الأسلوب التعبيري مألوفًا دومًا للقارئ العربي، وإن لم يكن ذلك من منطلق لغوي فلأنّ مثل هذه الألقاب هي -كذلك- لها طابع ثقافي وقد يكون فهمها صعبًا بدون معرفة مسبقة بالثقافة (كما سيأتي في المقال الأخير). وقد نحفظ بعضًا من الألقاب الواردة في الأصل من باب الأمانة، لكن لعلّ من الحكمة التخفيف منها كلّما أمكن لأن فيها صعوبة كبيرة، خصوصًا إن أتت في نص غير أدبي، فهذه الإشارة ليست قائمة على قواعد النحو الصّرفة، بل تلزم القارئ معرفة ودراية مسبقة لفهمها، فهو لن يعرف معنى "الرئيس الديمقراطي السابق" (في المثال أعلاه) إن لم يسمع من قبل بالرئيس باراك أوباما، وتلزم إزالة الإشارات والألقاب إن كانت متجذرة بثقافة أجنبية تجعل فهمها محالًا على القارئ العربي.[58] الإبدال مثلما تحل الألقاب مكان الاسم الواحد، فقد تخدم أدوات لغوية مخصّصة وظيفة اسمها "الإبدال" (Substitution) أي: أن تحل مكان[59] كلمات أو جمل سبقتها في الكلام، وليس لهذه الأدوات مقابل حقيقي في اللغة العربية؛ لا لأننا لا نستطيع ترجمتها، بل لأنها تهدم في الإنكليزية وظيفة وغرضًا غير موجود بسياقاته نفسها بالعربية.[60] ومن أهم هذه الأدوات كلمتا Do و That. وقد نراها بالترجمة في المثال الآتي: هل تحب السباحة في الطقس البارد؟ نعم، أحبّ ذلك. هل أقفلت باب المنزل؟ نعم، فعلت. وفي المثالين السابقين حلّت كلمة That أو "ذلك" مكان جملة اسمية ("السباحة في الطقس البارد") وكلمة Do أو "فعلت" مكان جملة فعلية ("أقفلتَ باب المنزل")، فعلينا أن نُعرّبهما على هذا الأساس. وقد نُصحّح هذه الترجمة، فنُضيف إلى الجملة الأولى ضمير الغائب (لأنه يعود على الاسم وما يتبعه) فنقول: "نعم، أحبّها". ونُكرّر في الثانية الفعل مع ضميره، فنقول "نعم، أقفلتُه". ترجمة Already يواجه المُعرّب مفردات محددة قد يكثر استخدامها في اللغة الأجنبية بأسلوب يخص ثقافاتها وأسلوبها في التعبير، ومن أكثر الكلمات التي قد تثيرُ حيرته -على هذا الصعيد- "already"، فهي كثيرة الاستعمال والتكرار في اللغة الأجنبية المعاصرة؛ حتى لا تكاد تمضي بضع دقائق من أي فلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني بدونها، على أنها كلمة ليسَ لها مقابل بالسان العربي إلا "بالفعل"، وهي الترجمة التي شاعت لها، إلا أنها لا تنجح تمامًا في نقل معنى الكلمة الأجنبية حرفيًا ولا فعليًا. ولو سرنا على منهج التعريب، فقد نجد حلين للتعامل مع هذه المفردة: الحل الأول هو احتسابها كلمة زائدة لأن وظيفتها توكيدية بحتة، فلا فرق في المعنى الفعلي بين قولك: "I got there already" أو "وَصَلْتُ بالفعل" أو "وَصَلْت"، وأما ما زاد على فحوى الكلام فهو إيحاء إضافي أراده الكاتب بلغته الأجنبية، وهو إيحاء لا مقابل له في العربية، لذا لا حاجة لترجمته ولا فائدة ترجى منه. الحل الثاني هو الاستعاضة عنها بكلمة عربية تصف معناها بدقة أكثر حسب السياق، وهو أن الحدث قد وقع في الزمن الماضي، فلنا أن نقول "وصلتُ سلفًا" أو "وصلتُ منذ بُرْهة" أو "وصلتُ منذ فترة". وقد يصادف المُعرّب كثيرًا من المفردات التي جرت العادة على ترجمتها بطريقة معينة، حتى ولو لم يكن لهذه الترجمة -المألوفة- معنى كبير باللغة العربية. معان خادعة قد يستغرب الناطق باللغة العربية قبل مئات السنين إن قيل له: إن عازفًا "يلعب على العود" أو "يهوى لعب الأدوار بالمسرح". ويكثر في زمننا هذان الاستعمالان بسياقات لا تتوافق مع معنى فعل "لعب"، وربما نعزو هذه المعاني المحدثة إلى ظاهرة لغوية يقال لها -حرفيًا-: "الصداقات الخادعة" (False friends)، والمقصود بها أن يخال المرء أن لكلمة في لغته معناها نفسه بلغة أخرى؛ بسبب تشابه الكلمتين شكلًا أو دلالة، وهذا خطأ دارج يقع -عادةً- في اللغات التي لها أصول متقاربة،[61] لكن ظاهرة الترجمة ساعدت على انتشاره بأسلوب جديد. ومن المستغرب أن يقال عمّن يستعمل آلة العود أنه "يلعبُ عليها" بدلًا من "يعزفَ بها"، والتفسير الراجح لهذا المعنى الجديد هو أن اللغة الإنكليزية تختزل بكلمة واحدة أفعالًا منها اللعب والعزف والتمثيل والتشغيل (وهي play)، فانتقلت معانيها الأخرى إلى العربية -تدريجًا- بالترجمة وتعلم اللغة الأجنبية. وقد تستغرب لو توقفت وتمعنت قليلًا بجملة شاعت بالترجمة مثل: "يلعبُ الوزراء دورًا في السياسة.."، فكيف يصلح فعل "اللعب" فيها؟ على المترجم الجيد أن يستوقف نفسه مرارًا للتفكير بدقة الكلمات التي حفظها واعتادها قبل أن تقفز أنامله لكتابتها أو طباعتها. فمن الأمثلة المتكررة -أيضًا- على المعاني الخادعة في الترجمة فعل Enjoy، والذي يأتي بمعنى "الاستمتاع" وكذلك بنِسْبة صفة إلى الشيء: Amman, a mountainous city, enjoys good weather. [ترجمة حرفية]: تتمتَّعُ مدينة عمَّان الجبلية بطقسٍ لطيف. [ترجمة بتصرف]: تتَّسِمُ مدينة عمَّان الجبلية بطقسٍ لطيف. [ترجمة بتصرف]: لمدينة عمَّان الجبلية طقسٌ لطيف. كما تأتي كلمة special وparticular (ومشتقاتهما) بمعنى التخصيص؛ وكذلك بمعنى الكثرة، فيُقال: Superman was particularly popular during the time of World War II [ترجمة حرفية]: اكتسب سوبرمان شعبية خاصة في فترة الحرب العالمية الثانية [ترجمة بتصرف]: اكتسب سوبرمان شعبية كبيرة في فترة الحرب العالمية الثانية الإطناب والإيجاز يُشبّه صفاء خلوصي المترجم الجديد بــ"غريب تاه في مدينة حل بها حديثًا"، إذ يضرب في شوارعها وميادينها ساعات بدلًا من سلوك الطريق السهل إلى وجهته،[62] ويذكرنا نيومارك أن: «الترجمة الجيدة وجيزة كلما أمكن»،[63] فكل كلمة زائدة ولا تضيف جديدًا هي عبء على الورق والحبر والمحرر والقارئ، وإزالتها تزيد النص بلاغة وتأثيرًا وأما الإطالة والإطناب فيها فتسبب الغموض وصعوبة في استيعاب المعنى.[64] ويستشهد عمر محمد الأمين في كتاب "أساسيات التحرير وفن الكتابة بالعربية" بمثال عن الإيجاز في ذكر الأفعال الدالة على المشاركة الصريحة (ومنها "المنافسة" و"المساجلة")، فيقول: «ومن الخطأ أن يُقال تقاتل الخصمان مع بعضهما؛ لأن الوزن نفسه يدل على المشاركة ولا داعي لذكر (مع بعضهما)"، فيُقال: "تقاتل الخصمان"».[65] ولنا (مثلما يقول نيومارك) أن نميّز بين المترجم الجيد والمترجم المبتدئ بعدد الكلمات التي يترجمان بها جملة واحدة. وفيما يأتي اقتباسٌ من ترجمة لكتاب: "أثر العلم في المجتمع" للفيلسوف الشهير برتراند رسل:[66] (مع تحرير لها):[67] إذا اعتقدتَ أن قيصر قام بعبور نهر الروبيكون فإن اعتقادك صحيح لأن قيصر قام بعبور الروبكيون فعلًا. إذا اعتقدتَ أن قيصر عَبَرَ نهر الروبيكون فاعتقادُكَ صحيح، لأنه عَبَره حقًّا. وتركيبة "قُم بكذا" أو "قام بكذا" ليست شائعة في الترجمة فقط، بل هي -أيضًا- متداولة على ألسنة الناس في كثير من اللهجات العامية مثل: "قاعد عم أمشي" (أنا أمشي). ولا بأس في هذا بالكلام المحكي، ولكنه يجعل الكتابة أقل بلاغة ويضيّع وقت القارئ سدى، إذ تقول القاعدة إن: «كل ما يحذف من غير إخلال بالمعنى يكون أبلغ».[68] ومن المفيد جدًّا تحرير الترجمة لتتبّع الكلمات الزائدة وحذفها، ففيما يلي أمثلة أخرى متداولة على ما قد تصادفه من كلام زائد: "هذا يشكّل خطرًا" ← "هذا خطير" "ذلك يستلزم التعريب" ← "يلزمُ تعريبه" "يحتوي الكتاب على فصول" ← "الكتابُ فصول" "هناك نوعان من الإحباط" ← "الإحباطُ نوعان" "قُمْ بتغيير العجلة" ← "غيِّر العجلة" الغموض إحدى المشكلات الابتدائية التي يهتم بتقصيها علم الدلالة (وهو من فروع اللغة) هي ما نسمّيه الغموض اللغوي، والمقصود به أن يحتمل الكلام أكثر من معنى. وعادة ما يكون المعنى المقصود بالكلام واحدًا، ولو ضل عنه القارئ فهذا خطأ يقع على عاتق الكاتب (وهو في حالتنا المترجم)، وهو ما قد يأتي من الكتابة غير الناضجة أو غير الواعية. لو قيل -مثلًا-: "زار علاء حديقة المدينة الجديدة"،[69] فقد يجد القارئ المتعمق صعوبة في تحديد الموصوف هنا، إذ ربما يكون المقصد أن ما زاره علاء هو "حديقة جديدة" في مدينة، كما يمكن أن يكون حديقة في "مدينة جديدة". وبإمكاننا أن نحاول تخمين الصحيح منهما من السياق، ولكن الجملة ليس فيها أي دلالة حتمية على المعنى مهما حللناها، مما قد يؤدي -أحيانًا- إلى غموض وحيرة كبيرين. ولنا أن نعالج حالة واقعية تسببت فيها ترجمة رديئة بغموض لغوي يفسد تجربة القارئ، فنقتبسُ الآتي من ترجمة عربية لكتاب لعالم الفيزياء الأمريكي "ريتشارد فاينْمَان" عنوانه "متعة اكتشاف الأشياء" (Pleasure of Finding Things Out):[70] لي صديق فنان كان يلتقط -أحيانًا- صورة لمنظر قد لا أوافق عليه تمامًا. كان يمسك بالوردة ويقول: "انظر كم هي جميلة، وأوافق معه. ثم يقول: "ألا ترى، أنا كفنان أستطيع أن أرى كم هي جميلة ولكن أنت كعالم عندما تجرّدها من هذا كله" تصبح شيئًا باهتًا، وأنا أعتقد أنه غريب الأطوار. وقد لا يطول بك الأمر حتى تلاحظ أن في هذا النص مشكلات لغوية كثيرة فيكاد لا يُقرأ؛ وليس على القارئ أن يظن السبب في ما سلف أن هذا الاقتباس قطع من سياقه، وإنما ما اقتُبس -أعلاه- هو الفقرة الافتتاحية من كتاب "ريتشارد فاينمان" بترجمته العربية. غموض بصري مشهور في رسم من رسومات قصة "أليس في بلاد العجائب"، إذ قد يظهر فيه الكائن الذي يدخّن النارجيلة وكأنه رأس رجل له ذقن وأنف نحيلان وبارزان، أو وكأنه دودة قزّ برز رأسها وساقان من سيقانها. - منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر: ويكيميديا كومنز تبدو الجملة الأولى واضحة تقريبًا، إذ يقول ريتشارد أن لديه صديقًا يهوى التصوير ويظهر أنه يلتقط صورًا لـ"مناظر" طبيعية، ولسبب ما فإن فاينمان "لا يوافق تمامًا" على هذه المناظر، ولكن، ما هو الذي لا يوافق عليه فاينمان في المنظر أو الصورة؟ يُفضل المترجم أن يتركنا حائرين على أن يُقدم لنا أي تفسيرًا، وهنا تكمن مشكلة الغموض الأولى.[71] تأتي المشكلة الثانية في استخدام علامات الترقيم (فثمة أسباب جيدة تُفسّر ولع الأساتذة بها، وإلا لامتلأت صفحات الكتب غموضًا وألغازًا). ويرتكب المترجم هنا خطأ كبيرًا هو عدم فصل الحوارات بعلامات الترقيم الصحيحة، فلا يتضح لنا من علامات التنصيص متى يتحدّث فاينمان، ومتى يتحدَّث صديقه الفنان، وقد نحاول استنتاج هذا من السياق. وأما أكثر ما ينبغي التركيز عليه هنا هو العبارة الأخيرة، التي تقول: "وأنا أعتقد أنه غريب الأطوار". فهل يمكن لقارئ حذر أن يُحدد من هو أو ما هو الشيء غريب الأطوار في النص؟ علينا أن نرجع إلى الاقتباس، وندرُسَ الاسم الذي يعود عليه كل ضمير فيه لنحل مشكلة الغموض، إذ على الضمير بالعربية أن يرجع دائمًا على آخر اسم ذُكرَ في الجملة. وتُصرّف اللغة العربية الضمائر للجنس بتذكيرها وتأنيثها مما يساعدنا على تجاوز هذه المشكلة أحيانًا (على عكس الإنكليزية)، فيمكنكَ القول: "شعرت سارة بالسعادة لأن محمدًا زارها اليوم" فتعود كلمة "زارها" على سارة. ولكن في هذا النص اسمان مختلفان من الجنس نفسه قد يعود عليهما الضمير، إذ يقول: «ولكن أنت كعالم عندما تجردها من هذا كله تصبح شيئًا باهتًا، وأنا أعتقد أنه غريب الأطوار»، وكما ترى، يمكن لاصطلاح "غريب الأطوار" أن يعود على "الشيء الباهت" أو على صديق "ريتشارد فاينمان"، فأيهما هو المقصود؟ نجد حين العودة إلى الأصل الأجنبي أن المقصود لم يكن أيًّا منهما، فما قاله ريتشارد فاينمان هو أن محاججة صديقه أو وجهة نظره تنم عن "غرابة الأطوار" عامة. وكان يمكن للمترجم أن يتنازل ويوضح هذه الجملة بأن يكتب: «"أنت عالم فتجرّد الوردة من كل جمالها لتُصبح شيئًا باهتًا"، وأنا أعتقد أن ما يقوله كلام غريب الأطوار». وإذا وضع المترجم نفسه مكان الكاتب والمُعرّب، فعليه الانتباه إلى تفاصيل ما يكتبه وإلى ما قد يحصل لقُرّائه من سوء فهم، على عكس ما رأينا من أمثلة هاوية. وهذه المهمّة ليست سهلةً أبدًا، فالمترجم ينغمس بقراءة نص أجنبيّ ثم عليه أن يخرج من غمار هذا النصّ ليكتب بقلم عربيّ، ولهذا فلا يمكنه أن يكتفي بدراسة اللغة كمفردات وجمل، بل عليه أن يعد نفسه لدراستها على مستوى ثقافة أجنبية مكتملة الأركان. _____ اقرأ أيضًا المقالي التالي: تعريب تراكيب اللغة المقال السابق: تعريب الثقافة: مسائل لغوية في الترجمة
-
الحل الواضح والسهل نادر في الترجمة، وإنما الغالب فيها أن يبحث المترجم في عدد من الحلول، فيوظف رأيه وخبرته في الاختيار بينها مرات متوالية خلال عمله اليوم.[1] وتصعب هذه الاختيارات -خصوصًا- في التراكيب اللغوية، حتى ولو كانت تراكيب عادية وطبيعية جدًّا في اللغة، ذلك لأن عقل الإنسان الذي يتقن لغتين؛ يعتاد على ترجمة هذه التراكيب إلى مكافئ عربي لها دون تفكير، فتأتي بصيغة حرفية جدًّا دون إدراك ولا إحساس منه، وهذه آفة تلزم -لتجاوزها- كثير من الممارسة. معنى الكلام وأسلوبه ربما يجد المترجم نفسه شارد الذهن -أحيانًا- فينقل ما أمامه من كلمات دون تفكير أو تمعّن كافٍ بمعانيها، إذ اعتاد كل مترجم من تجربته في اللغة على مزاوجة كثير من الكلمات والتعابير الإنكليزية؛ مع كلمات تشبهها بالمعنى -الحرفيّ غالبًا- باللغة العربية، ولو فقد تركيزه فقد يقفز إلى هذه المكافئات الحرفية دون وعي منه، فيظن أنه احترف الترجمة سرعة وإتقانًا[2] بينما يكون نتاج يديه أقرب لعمل برنامج آلي. قد نجد مثالًا جيدًا في كلمة Individual الإنكليزية، التي تُحيّر المترجم الجيد، بينما يستسهلها المترجم غير المتمكن: فهي كلمة لا مرادف لها في وقعها ولا في معناها باللغة العربية، ومن ثم تختلف ترجمتها -حسب السياق- اختلافًا جمًّا. وقد يختار المترجمون العرب في أغلب الأحوال ترجمة هذه الكلمة حرفيًا إلى "فَرْد"، دون بذل أي جهد إضافي بالتفكير في دلالتها، ولكن هذه ترجمة تتناسى أن كلمة "فَرْدٍ" باللغة العربية نادرة الاستخدام وتعطي انطباعًا مختلفًا عن مقابلها الإنكليزيّ. فلننظر إلى المثال الآتي، وهو قول مأثور من العالمة الأمريكية "جين غودول": Every individual matters. Every individual has a role to play. Every individual makes a difference. [حرفيًا] كل فرد له أهميته. كل فرد له دور ليلعبه. كل فرد يصنع فرقًا. [بتصرّف] كل إنسان له قيمته. كل إنسان له دور يؤدّيه. كل إنسان له قيمة. نقلت في الترجمة الأولى الكلمات الإنكليزية واحدة تلو الأخرى إلى العربية دون تغيير في ترتيبها ولا هيئتها، فكلمة individual ترجمتها الحرفية "فرد"، وplay a role "يلعب دورًا"، وmakes a difference "يصنع فرقًا". وأما في الترجمة الثانية فقد غُيّرت الكلمات لتناسب السياق: فمن الواضح أن هذا الاقتباس لا يتحدث عن أي "فردٍ" محدد، بل هو يصف كل شخص يعيش على الأرض؛ سواء أكان رجلًا أو امرأة أو طفلًا ومن أي بلد أو انتماء، والمفردة المألوفة في اللسان العربي لهذا المعنى هي "الإنسان". وأما كلمتا "يصنع فرقًا" فهما ترجمة حرفية لتعبير تقصد به أن للشيء أهمية (إذ ثمة "فرق" بين وجوده أو عدمه)، وهذه الدلالة واضحة في كلمة "القيمة" أكثر من "الأهمية"، فنحن لا نتحدث عن "أهمية" الإنسان لغرض بعينه، وإنما عن قيمة وجوده بذاته. وأخيرًا فإن عبارة "يلعب دورًا" هي صيغة إنكليزية يقصد بها التشبيه بأداء دور على المسرح، فاستبدلنا كلمة "اللعب" بـ"الأداء"،وهذه مشكلة سنتناولها من جذورها فيما بعد. المفاضلة والإبداع تقودنا المقاربة بين الترجمات التي يدخل فيها التصرّف أو الحرفية (مثل "فرد" و"إنسان") إلى مشكلة جوهرية من مشاكل الترجمة. إذ لا تنحصر معضلات ترجمة المصطلحات والتراكيب في المفردات الأكاديمية الصعبة (والتي تناولناها في الفصل السابق)، وإنما يصطدم المترجم -كثيرًا- بمصطلحات لها في الحياة اليومية معانٍ وإيحاءات متشابكة، فتصعب ترجمتها سواء بكلمة أم بجملة كاملة. وهذه مشكلة عالمية تقع لجميع المترجمين،[3] ولها عدة حلول مُتبَّعة. الحل الأسهل في هذه الحالات هو التعريب إلى كلمة أوسع في معناها،[4] مثل قولنا في العربية: "حشرة" ترجمة لـ"bug" (وهي كلمة لا ترجمة لها، فتقصد بها مجموعة محددة من أنواع الحشرات غير الطيارة)،[5] فيُستعاض عنها بكلمة "الحشرة" الأعم في معناها لافتقار مرادف عربي لها. وتشبه هذه طريقة ثانية، هي لجوء المترجم إلى كلمة أقل دقة في معناها من الأصل،[6] مثل تعريب "relatable" إلى "مألوف" (ويقصد بها شيء أو تجربة يألفها الإنسان، فيشعر وكأنه ربما مرّ أو قد يمرّ بما يشابهها أو يماثلها،[7] وهو معنى دقيق تستعصي ترجمته). على أن هذه الحلول لها نقطة ضعف واضحة؛ هي أنها تُضيّع جُلّ المعاني الدقيقة للكلمات التي يختارها الأديب بعناية، فيقصد بكلّ كلمة فكرة واضحة في ذهنه، على أن مفرداته الدقيقة تنمسخ بالتعريب إلى تعابير فضفاضة، حتى تختفي منها صبغة الأديب وقلمه.[8] ولهذا يبحث بعض المترجمين عن حلول أصعب منها "الإبدال ثقافيًا"، وهو أن يأتي المترجم بمعنى جديد أقرب إلى ثقافة القارئ فيألفه ويفهمه، ولو أن هذا التصرف يسلتزم تصرّفًا كبيرًا -من جهته- بالنص.[9] خريطة لبلدان العالم بحسب مواعيد العطلة الأسبوعية فيها. يظهر من الخريطة أن للعطلة الأسبوعية بُعدًا ثقافيًا دينيًا، إذ يُخصّص لها يوما الجمعة والسبت في كثير من البلدان الإسلامية (ومعظم البلدان العربية)، ويوما السبت والأحد في معظم البلدان المسيحية. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز فمن الجائز -مثلًا- ترجمة كلمة "Friday" إلى يوم "الخميس" بدلًا من "الجمعة"، وذلك إن جاءت في سياق الخروج مساءً للاحتفال بنهاية الأسبوع، وهي في معظم البلاد العربية يوما الجمعة والسبت، بينما هي يوما السبت والأحد في البلاد الغربية، مما يعني أن المقصود هنا باسم اليوم هو معنى يختلف حسب البلد والثقافة، وليس معنى "اليوم" بالمُطلق. ومن الجائز -أيضًا- التلاعب بترجمة أصناف الطعام (مثل: القمح والدخن و"البفرة") إن كان ذلك ضروريًّا للفهم. ومن أصناف الكلام التي يرى بعض أساتذة الترجمة نفعًا في إبدالها بما هو أقرب للقارئ؛ الكلمات الدالّة على سمات ثقافية (مثل: nerd أو geek بالإنكليزية العامية)، والمصطلحات التي تختلف إيحاءاتها بين الشعوب (مثل: "يساري" و"يميني"، فربّما لا يفهمها كثير من القُرّاء العرب)، والتراكيب الغريبة نحويًّا، والتشبيهات والاستعارات، والأمثال، والأقوال الشعبية، وألاعيب الكلمات، والموسيقى والشعر.[10] ويأتي إبراهيم زكي خورشيد في كتاب "الترجمة ومشكلاتها" بمثالٍ على الإبدال الثقافي من جملة أعطاها لطلاّبه لترجمتها: Writers are passionate about the jam of fiction. الكُتّاب شغوفون بمُربَّى الخيال. ويشكو إبراهيم زكي من أن على طلابه أن يتمعّنوا أكثر بالمعنى المقصود من هذه الجملة وليس بكلماتها، إذ كان من الأجدر بهم تعريبها إلى: "الكُتّاب شغوفون بحُلو الخيال" أو "بحلاوة الخيال"، فذلك أبلَغ وأوضَح. وهذه المعادلات الثقافية مفيدة للمتلقي؛ لأنها تأتي سهلةً وطبيعية على لسانه وتحفز استجابة عاطفية منه (عكس الترجمة الحرفية)، ولهذا فإن لها أفضلية على التعميم[11] الذي ورد أعلاه، لكنها تظل قليلة الدقة؛ لأنها تستعيض عن رمز أو مصطلح ثقافي، له جذور عريقة من ثقافة أجنبية؛ ببديل عربي تختلف أصوله تمامًا، وهذه تضحية كبيرة بقسم من المعنى. حتمية التضحيات تعود بنا هذه الحكمة الخالدة من منى بيكر إلى مسألة "المساومة" في الترجمة (من الفصل الثاني): فكل مفردة في كل لغة تغص بمعانٍ كثيرة كما رأينا مرارًا، وربَّما تحتفظ مفردة عربية واحدة بمعظم هذه المعاني، وربما يحتاج بعضها إلى جملة أو جمل لتفسيرها، وما نسأله هنا هو: متى تستحق هذه المعاني عناء ترجمتها؟ على المترجم أن يصب اهتمامه دومًا على نقل معنى الكلمة الجوهري؛ والذي يحتاجه القارئ لفهم النصّ، بينما عليه أن يضحي بكثير من المعاني الهامشية التي يصح الفهم دونها،[12] بل ومن المسموح والمقبول للمترجم أن يحذف كلمات وجملًا كاملة إن خمن أنها لا تنفع القرّاء.[13] وقد يعود في الحذف إلى واحد من تبريرين: أن يختزل الكلام المحذوف فكرةً ثقافيةً لا تعني جمهور القرّاء ولا تضيف قيمة للنص بنظرهم. أن ترجمة أو تفسير هذا الكلام يستوقف النصّ ويعترض تدفّقه فيعرقل القراءة[14] (ولا يعني هذا أن يكون نقل الكلام صعبًا أو متعِبًا للمترجم، وإنما المهم هو الصعوبة على القارئ). على سبيل المثال، تُميز اللغة الإنكليزية بين كلمتي "sound" (وهو أي صوت من الأصوات) و"voice" (وهو الصوت الذي يخرج من الفم حصرًا، وخصوصًا صوت وكلام الإنسان)، والأصل أن معنى كلا هاتين الكلمتين في العربية هو "صوت"، لكن يحدث -أحيانًا- أن تأتي الكلمتان في سياق واحد. فعنوان إحدى حلقات سلسلة "ستار ترك" الشهيرة للفضاء عنوانها: "The Sound of Her Voice"، وهي جملة ليست نادرة جدًّا في الإنكليزية، وقد يجاهد المترجم في البحث عن تعريب لها بالمعاجم، فيأتي بشيء مثل: "صوت عقيرتها"، على أنه يكفي -تبسيطًا- أن يقال: "صوتها" مع إسقاط المعنى الزائد، فلو كان هذا المعنى ضروريًا في اللغة العربية لوُجد فيها من المفردات ما يصفه. ويورد محمد عناني في كتابه "فن الترجمة" مثالًا على ظاهرة التعميم التي ذكرناها أعلاه، فيتحدث عن ثلاث كلمات أجنبيَّة لها معنى واحد عام بالعربية هي: hides وskins وleather، وجميعها تعني جلد الحيوان.[15] وهو يستشهد هنا بجملة صادفها في تقرير كان يترجمه لليونسكو: «Some developing countries trade hides and skins for leather». وفي هذه الجملة حيرة شديدة، لأنها تحتاج للتمييز بين ثلاث كلمات لها معان متماثلة في لساننا، ويقول محمد عناني في ذلك: «وردت هذه العبارة في سياق نص اقتصادي وبالذات في الاقتصاد الزراعي كنت أترجمه لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، فسألت أحد الزملاء المتخصصين فشرح لي أنهم يقولون: الجلود الكبيرة والجلود الصغيرة؛ للكلمتين الأوليين، والجلود المصنعة للكلمة الثالثة. وسرّني هذا التصرف أو التحايل لأن فيه اختصارًا للمعنى وهو "جلود الحيوانات الكبيرة" (hides) و"جلود الحيوانات الصغيرة" (skins) وتبيانًا للمعنى الكامن في كلمة leather، إذ إنها تشير إلى الجلد بعد إعداده لصناعة الأشياء الجلدية».[16] وهكذا، تصير ترجمة الجملة: إنّ «بعض البلدان النامية تستبدل بالجلود الكبيرة والصغيرة الجلود المصنّعة». جلود للعجل في المغرب، وهي تسمى بالإنكليزية "Calfskins" أو "جلود العجل الصغيرة" حرفيًا، على أن المألوف في العربية هو أن يقال لها "جلود" بغض النظر عن حجمها. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز ولكن السؤال الذي تجاوزه محمد عناني هو: هل نحن بحاجة للتمييز بين هذه الكلمات الثلاث؟ في الإنكليزية ثلاث مفردات تختص بالجلود لأن قراء التقرير الإنكليزي -المتخصصين بالمجال- يعرفون بدقّة مصطلحات جلود الحيوان في لغتهم، ولذلك يرون اختلافًا (بفضل خلفيتهم الثقافية واللغوية) بين جلود الحيوانات الكبيرة، مثل: النمر أو التمساح، والصغيرة مثل: الفئران والسناجب. ولكن هذا الأمر سيان عند القارئ العربي: لا لأنه غير مختص بالضرورة، وإنما لأن جلود الحيوانات -بكبيرها وصغيرها- لها اسم واحد في لغته؛ هو "الجلود"، وأما "الجلود الكبيرة" و"الجلود الصغيرة" فهما تركيبتان مبتدعتان لا تضيفان معنى ضروريًا.[17] وبناءً على هذا نُعدّل الجملة نفسها إلى صيغة أوجز فنقول: «بعض البلدان النامية تستبدل بالجلود الخام الجلود المصنعة». وفي مثال من كتاب متخصّص عن تاريخ الأدب الإنكليزي:[18] Major innovations in staging resulted principally from continental influences on the English artists, who accompanied the court of Charles II into exile in France. ويمكننا هنا أن نلتزم بتقديم المعنى كاملًا للقارئ فنقول عن "continental influences" أنها "التأثيرات القارية من أوروبا" (أي من بلدان أوروبا المتصلة برًّا بها، والتي يُستثنى منها هنا الكتاب الإنكليز لأنهم يسكنون الجزر البريطانية)، لكننا نبتدع في ذلك مصطلحًا جديدًا يجهله القارئ العربي ويدخله في حيرة مريرة، يمكن تجاوزها إن تغاضينا عن شيءٍ من الأمانة وحوّلنا المصطلح إلى "التأثير الفرنسي"؛ وهو المعنى المقصود غالبًا، أو "التأثير الأوروبي" التزامًا بعمومية المصطلح الأصلي. وكما يقول "بيتر نيومارك"، فإن الترجمة الجيّدة (مثلها في ذلك مثل الكتابة الجيدة) تسير على نهج الإيجاز والاختصار، فالفقرة التي تُفسّر الفكرة أبلغ من الفقرتين، والكلمة أبلغ من الكلمتين إذا لم يختلفا في الفائدة والمعلومة.[19] وهذا ما عبرت عنه القاعدة العربية القديمة: "البلاغة الإيجاز". حذف وزيادة يقول الباحث "نيومارك" -أيضًا- أن العامل الأهمّ في الإتقان بالترجمة هو أن تؤدي غرضها الضروري. فلنأخذ -مثلًا- جملة: "يتكون الماء من الهيدروجين والأكسجين"، فهدف هذه الجملة -كما يبدو- هو إيصال معلومة؛ وليس إيصال جمال أو بديع لغوي كما في الشعر وغيره، وبناءً عليه فليست كل عناصرها ضرورية، إذ لنا أن نستعيض -مثلًا- عن كلمة "يتكون" فيها ببدائل كثيرة دون أن يخل ذلك بمقصد الجملة، منها: "يتركب" أو "يتألف" أو "يحتوي" وغير ذلك.[20] وقد تعجز الترجمة عن نقل معنى الكلام غير الضروري؛ أو قد تتجنّبه عمدًا في أحيان كثيرة. قد تقول فتاة بالفرنسية حين دخولها إلى المنزل: "Je suis arrivee"، وهي جملة بسيطة تعني: "وَصَلْتُ"، لكن هذه الجملة تُخبرنا كذلك -بالفرنسية- أن الذي وصل هو امرأة، لأن تصريف الفعل مؤنث. ويضيع هذا المعنى في الترجمة العربية. فهل هو معنى ضروري للترجمة؟[21] تختلف عناصر الصرف والنحو اختلافًا جمًّا بين اللغات، وهذه مشكلة تبدو جذورها لغوية، لكنها جزء من هوية الأمم وميولها. ومن أمثلة ذلك: العدد (كما رأينا في المقال الأول) فالعربية واحدة من لغات نادرة تميز في المعدود بين المثنى وما زاد عن اثنين (وهي سمة سقطت في صيغ الأفعال عن اللهجات العامية)، بل إن بعض اللغات النادرة[22] تميّز بين المثنى والثلاثة وما زاد عليهما.[23] وبعض اللغات لا تلزم العد أصلًا مثل: الصينية واليابانية، فلك أن تقول أن لك "أخ" دون أن تحدد ما لو كان أخًا أم أخوين أم إخوة. ولنا أن نستنتج من هذا الاختلاف أمرًا مهمًّا، وهو أن من يتحدّثون لغة ليس فيها تصريف للعدد لا يكترثون -عادةً- بمعرفة عدد الأشياء؛ إلا إن كان ضروريًّا في سياقه. ليس من السهل على العربي تقبّل هذه الفكرة الغريبة؛ لأنه معتاد على تصريف الكلمات مفردًا أو مثنى أو جماعة. لكن يمكننا القول -من جهة أخرى- أن العربي لا يهمه أن يعرف في تصريف الفعل إن كان المقصود به ثلاثة أم أربعة أشخاص؛ فكلاهما "جماعة" (أو "أشخاص") في لغته، وهذا اختلاف بين لغتنا وبين لغة فيجي التي فيها مثنّى ومثلّث؛ وهو يُوضّح حدود اهتمام القارئ العربي. وفي هذه الحالة، لا يجب أن نستغرب من أن الصيني لا يهتم لأن يعرف إن كان عدد الأشخاص المقصودين واحدًا أم اثنين أم أكثر؛ إن لم يتطلب السياق ذلك، مثلما أن الإنكليزي لا يهمه أن يعرف إن كان المقصود اثنين أم ثلاثة. إذًا: ما تهمله قواعد الصرف في اللغة قد يكون نتيجةً لا سببًا. فالعدد هنا هو خاصية من خصائص البناء الصرفي والنحوي في اللغة،[24] وعلى المترجم أن يُفرِّق بين ما يقال إلزامًا في اللغة لأن قواعدها تفرضه (مثل العدد)، وما يختار الكاتب قوله بمشيئته: لأن الأولى هي سمةٌ لغوية يسهل التغاضي عنها؛ وأما الثانية فهي أساس كل ترجمة. تختلف درجة التفصيل المعجمي في كل مجال بين اللغات، مثلما مر علينا من كلام الجاحظ؛ الذي يرى صعوبة الترجمة من لغة أجنبية في موضوع غير مطروق، فيقول: «وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق، والعلماء به أقل، كان أشد على المترجم، وأجدر أن يخطئ فيه». ونرى ذلك في كثير من المصطلحات الحداثية التي تحرص اللغة الإنكليزية على الدقة والتحديد في معانيها، إذ إن "الهيئة" غير "اللجنة" و"اللجنة" غير "المؤسسة" و"المؤسسة" غير "الدائرة"، وأما الكلمات العربية التي تقابلها فقد تحمل معانٍ فضفاضة غير واضحة (وتسمّى هذه: "المظلات الدلالية") فتميل إلى قلة التحديد وزيادة المقاصد المحتملة، وذلك أنها اقتبست هذه المصطلحات بالنقل فجاءت مجرّدة من الأفكار الثقافية التي وراءها.[25] ومن الحري -بل والجدير أحيانًا- بالمُعرّب أن يُهمِل هذه التراكيب الإنكليزية المتيمة بالدقة؛ إن لم يرَ ضرورة لها، فهناك سبب لأن تصريف العربية مختلف عن تصريف اللغات الأوروبية؛ وما يهتم المؤلف الأجنبي بتحديده ليس مهمًّا دومًا للقارئ العربي.[26] تميل اللغة الإنكليزية إلى أن تصف الأفعال بأسلوب غير مألوف بالعربية، فهو وصف يفرض على المتكلم تمييز فرصة "حدوث الأشياء" أو "عدم حدوثها" (وهو ما يسمى في علم اللغة: Modality)،[27] فيقول: إن هذا الفعل أكيد "certainly, definitely" أو راجح "probably" أو محتمل "likely, maybe" أو ممكن "possibly, potentially" أو مستبعد "unlikely" أو مستحيل "impossibly"، وتدل درجات التفرقة الكثيرة هذه على تحرّز الشعب الإنكليزي من الجزم بالأمور، وعلى اهتمامه بالتدرج بين كلمتي "الأكيد" و"المستحيل". وقد لا يتفق هذا تمامًا مع ما جرت عليه العادة في التعبير العربي، فهو لا يستوجب مثل هذه الدقة وقد يتساهل المتحدثون فيه بالتعظيم من الأشياء والإكثار من الألفاظ الجازمة والحاسمة، ولنا -لذلك- أن ننصح بإسقاط بعض هذه الكلمات أو معظمها في الترجمة،[28] فهي لا -غالبًا- تهمّ القارئ العربي؛ مثلما أن التفصيل في وصف المفرد والمثنى والجمع لا يعني القارئ الآسيوي في شيء.[29] يمكن أن يمتد الحذف والأقلمة إلى أي مكون في الكلام إن لم يلزم، فمن مكوّنات اللغة التي يغفل المترجم عن إسقاطها في العربية الضمائر، وهي تكثر في اللغة الإنكليزية لأن أفعالها لا تعبر عن جنس وعدد الفاعل،[30] فيُقال "I went home" لأن ضمير الفاعل لا يتضح بالإنكليزية إلا إن جاء مستقلًّا، وترجمتها "ذهبتُ إلى المنزل" (وليس: "أنا ذهبتُ إلى المنزل")، لأن ضمير المفرد المتكلم مقدّر على التاء في "ذهبتُ".[31] تتطلب الترجمة -إلزامًا، لا اختيارًا- محاكاة[32] للنص الأصلي إلى ثقافة القارئ، وقد تضيع في ذلك بعض التفاصيل "المهمة" في ثقافة أخرى على صعيد المعنى والمفردات. فليس من الضروري -على سبيل المثال- ترجمة أسماء الأحزاب السياسية في البلدان الأخرى أو الإشارات الضمنية إليها؛ إلا إذا كانت جوهرية للفهم، فقارئ الترجمة لن يعرفها في معظم الحالات،[33] ولو قال شخص في رواية "إن جاري ديمقراطي جدًّا" (أي يشبه في آرائه الحزب الديمقراطي) فمن المستبعد جدًّا أن يفهم القارئ العربي معنى ذلك أو يستنتج شيئًا مفيدًا منه. ومن أمثلة الزيادات الثقافية التمييز بين "المنزل" و"الشقة" أو "الغرفة" في مجمّع سكني فيُقال: "ذهبتُ إلى شقتي" أو "عدتُ إلى غرفتي"، لكن الناطق العربي قد يُفضّل أن يقول "عدتُ إلى منزلي" لأن المعتاد هو أن يكون "المنزل" شقة. والحالة المعاكسة للحذف (أي الأمثلة السابقة) هي الزيادة، أي أن تجبرك اللغة العربية على إضافة تركيب نحوي غير موجود باللغة الإنكليزية، مثل التذكير والتأنيث ومسميات الأقارب، ومثال على ذلك من رواية North and South الشهيرة لـ"إليزابيث غاسكيل": “With my aunt,” replied Margaret, turning towards Mrs. Shaw. “My niece will reside with me in Harley Street. ولا سبيل هنا لمعرفة ما إذا كان المقصود "عمة" أم "خالة" و"ابنة أخ" أم "ابنة أخت" -لسوء الحظ- إلا بقراءة باقي النص حتى يتوثّق المترجم من هوية الشخصية المقصودة. والدقة في الألفاظ أفضل دومًا، لكن من المبرر (وربما من الحكمة) أن يختار المترجم -هنا- عشوائيًا بين كلمة "عمة" أو "خالة"، وذلك لأن النص الإنكليزي لم يُعن بالتفريق بينهما، مما يعني أن اختلاف هذين اللفظين ليس مهمًا في هذه الرواية ولا في اللغة التي كتبت بها؛ ومن ثم يجوز التغاضي عن فروقاتها. وتسهل الزيادة والاستعاضة عن أي تراكيب نحوية ناقصة في اللغة بإضافة مفردات إضافية إليها، فمن ذلك جملة: "This word is translatable"؛ وفيها تصريف ناقص من اللغة العربية، لكننا نعوضه بزيادة مفردة فنقول: "ترجمة هذه المفردة ممكنة"، ولو أن في هذا تصريحًا عن معنى زائد لأن تحويل لاحقة نحوية (-able) من الإنكليزية إلى كلمة عربية قائمة بذاتها ("ممكنة") قد يضيف توكيدًا لم يقصده الكاتب الإنكليزي.[34] يأتي علينا التساهل بالحذف والزيادة بمشكلة أخرى: فبما أن المترجم هو من يقرر أي معنى يُسقِط وأي معنى يَصون، فهل يجب عليه أن ينقل المعنى الواضح للنص، أم المعنى الذي يفهمه بناءً على استيعابه وتحليله وخبرته باللغة؟ وسنعود للإجابة عن هذه المعضلة لاحقًا.[35] التصاحب اللفظي لو صادفت (في رواية رومنسية صفراء، ربما) جملة تقول: "وقعت فتاة وسيمة في حب فتى جميل"، فقد تشعر بمشكلة فيها ولو لم تستطع وصف هذه المشكلة ضمن إطار قواعد اللغة، فهي صحيحة نحوًا وصرفًا ودلالةً (أي في ثلاثة من أقسام علم اللسانيات الخمسة)؛ على أنها تفشل في ما يسمى "التواصل الخطابي" أو تحليل الخطاب. فكلمتا "الجمال" و"الوسامة" تكادان تترادفان في المعنى، لكنهما تأتيان -عادةً- مع الجنس الأنثوي للفظ الأول والذكوري للثاني،[36] وتسمى هذه الظاهرة "الضَّميمة" أو "التصاحب اللفظي"، ولها أهمية كبيرة في شتى تطبيقات اللغة؛ بما فيها الترجمة. تُسمّى -على سبيل المثال- المطاعم المتخصصة ببيع الوجبات السريعة بالإنكليزية: "Fast food outlets"، أي -حرفيًا-: "محلات الطعام السريع". ولمعنى المقصود هنا هو "السرعة" في إعداد الطعام، ولذا قد يبدو من المنطقي أننا نستطيع استبدال كلمة "fast" بكلمات شبيهة بها بدون إخلال بالمعنى، فقد نقول: "Quick food" أو "Rapid food"، ولكن الناطق بالإنكليزية -كلغة أم- يعرف أن هذه التراكيب غير صحيحة، مع أنها تخلو من أي خطأ نحوي أو دلالي, فالسبب الوحيد في خطئها هو أن العُرف السائد يقتضي الحديث عن "المأكولات السريعة" بكلمة "fast" دونًا عن غيرها، وبالتالي فإن كلمتي "fast food" متصاحبتان لفظًا. لو نظرنا إلى اللغة بعمومها، فسوف نجد أن أساس كل لغة هو كلمات نرتبها في جمل مختلفة: فلنا أن نمزج هذه الكلمات ونركبها بجملٍ لامعدودة لوصف معانٍ وأفكار معدودة، على أننا -فعليًّا- لا نصوغ كلامنا بحُريّة مطلقة؛ بل نكرر عددًا محدودًا من تسلسلات الكلمات والتراكيب المألوفة. وقد تسمح لنا اللغة بابتداع تراكيب جديدة كثيرة تدل على المعاني التي نريدها بدقة تامة، إلا أن التراكيب غير المألوفة تصبح ركيكة بسهولة؛ لأن لها وقعًا مزعجًا ومخالفًا للسليقة، ومن أكثر المشكلات عند المترجمين المبتدئين؛ عجزهم عن إدراك وقع ترجمتهم الركيكة في نفس القارئ أو المستمع، وهي مشكلة يواجهونها كثيرًا مع الضميمة. فالضميمة -إذًا- ليست مجرد كلمتين صدف أنهما جاءتا معًا، بل هما كلمتان قصد المؤلف والكاتب أن يأتيا معًا لأن لتصاحبهما وقعًا ومعنى خاصًا في نفوس قرّائه. ولهذا السبب، وربما يجد المترجم نفسه في حيرة بين أمرين أمام ترجمة الضّميمة: فإما أن يستعيض عنها بضميمة عربية يعرفها القارئ العربي وتثير وقعًا قريبًا في نفسه؛ ولو أخلّت بشيء من المعنى، أو أن يستعيض عنها بضميمة ركيكة في وقعها ودقيقة بمعناها. ويتعارض هذان الأمران -غالبًا- لأن الضمائم العربية غير الإنكليزية، ونرى مثالًا في جملة: "There's a good law and a bad law"، فترجمتها الحرفية هي: "ثمة قانون جيد وقانون سيئ"، على أن ترجمتها إلى ضميمة عربية مألوفة سوف تكون: "ثمة قانون عادل وقانون غير عادل"؛ والجملتان تدلان على معنى قريب أو متماثل، لكن الأولى اقتبست الضميمة الأجنبية والثانية جاءت عربية.[37] موازنة تاريخية لكثرة استعمال كلمتي "native language" موازنة مع "mother language"، والتي تظهر منها غلبة الأولى على الثانية (الرسم مستخرج من قاعدة بيانات "كتب غوغل") - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: Google Books Ngram Viewer وتكثر الأخطاء في ترجمة التصاحبات اللفظية،[38] وخصوصًا إذا كان المترجم قليل الاطلاع في اللغة التي ينقل إليها. فمثلًا: من الأسئلة المعتادة لمن يتعرف إلى شخص أجنبي أن يقول: "What is your native language؟"، ويكثر أن تترجم هذه الضميمة إلى العربية فيقال: "ما هي لغتك الأصلية؟". قد يبدو معنى هذه الجملة واضحًا، لكنها غريبة لأن جملة "اللغة الأصلية" جاءت مكان اللفظ المألوف في العربية، وهو "اللغة الأم"؛ وضميمة "اللغة الأصلية" -هنا- صحيحة نحوًا ودلالةً، لكنها تخالف العُرف السائد. وتتضح مشكلة الركاكة بالضميمة في ترجمة المبتدئين من العربية إلى الإنكليزية، إذ قد يلمس المترجم المختص الركاكة بالعربية لأنها لغته الأم التي يعي دقائقها وتفاصيلها، لكن الإلمام بلغة -بهذا القدر- ليس ممكنًا إلا عندما يستخدمها المرء في حياته اليومية لسنين: والسبب هو أن استعمالنا للغة -كما سلف- لا يقتصر على وصف المعاني الصحيحة؛ وإنما على اختيار الكلمات الصحيحة في وصف هذه المعاني، وذلك بناءً على خبرة طويلة تراكمية. ونعود هنا إلى المثال السابق؛ فنلاحظ أن من يترجم من العربية كثيرًا ما يقول عن اللغة الأم "mother language"؛ مع أن ترجمتها الصحيحة إلى الإنكليزية هي إما "mother tongue" أو "native language"، فالأخيرتان ضميمتان مألوفتان للمتحدث بالإنكليزية؛ والأولى نادرة (كما يظهر في الرسوم البيانية)، رغم تساويهم جميعًا في المعنى. موازنة تاريخية لكثرة استعمال كلمتي "mother tongue" موازنة مع "mother language" (الرسم مستخرج من قاعدة بيانات "كتب غوغل") - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: Google Books Ngram Viewer كما قد تتغير معاني بعض الكلمات جذريًّا بحسب تصاحبها اللفظي دون أن يعي المترجم ذلك، فعليه أن يحرص على مراجعتها والتدقيق فيها، مثال ذلك أن كلمة dry (ومعناها المعتاد "جاف" أي "ليس فيه ماء") يتغير معناها تمامًا إن جُمعت مع لفظ آخر فيُقال:[39] Dry voice: صوت بارد (خال من المشاعر) Dry country: بلد يحظر بيع الخمور Dry run: اختبار للأخطاء أو المشاكل من الأصح -عمومًا- ألا يكتب المترجم بأسلوب لا يألفه قُرّاء اللغة، إن لم يقصد بذلك غاية واضحة، فالتراكيب الجديدة أو غير المعتادة تلفت النظر وتعطل تدفق النص، بل وقد تضيف هذه العرقلة وقعًا جديدًا في الترجمة لم يُرده المؤلف فليس من الأمانة زيادته.[40] ولو احتجت للتأكد من استعمالك لكلمتين معًا بتصاحبهما الصحيح أو للتوثق من معنى ضميمة، فلكَ أن تراجع معاجم إنكليزية متخصصة بالتصاحبات اللفظية، ومرتبة بحسب ما يتصاحب مع كل مفردة في اللغة، وهي أدوات مفيدة جدًا للكاتب والمترجم.[41] الاستعارة لعلك سمعت في فلم إنكليزي جملة تقول: إن عمل كذا مثل "تناول قطعة من الحلوى" أو "خطف حلوى من طفل"، وهذا نوع من المجاز أو الاستعارات المعروفة، ومعناها بالأساس أن هذا "أمر يسير" أو "سهل المنال"، لكن الأدباء وكتّاب المسرح والسينما يحبون التفنن بهذه الأمثال (وهو ما يسمى إحياء "المجاز الميت")،[42] ومن أمثلتها قول ألفريد هتشكوك: For me, the cinema is not a slice of life, but a piece of cake. حرفيًّا: بالنسبة لي، السينما ليست قطعة من الحياة [لصعوبة الانخراط بها] بل قطعة من الكعك [لسهولتها]. وهذه الأقوال عسيرة لأن وقع الاستعارة بالعربية يأتي غريبًا إن تُرجمت بمعناها الحرفي، فعلى المترجم أن يختار بين: 1. ترجمتها حرفيًّا، أو 2. الاستعاضة عنها بمثل عربي قريب في معناه،[43] أو 3. الإبداع في تعريبها (مثلما أبدع الكاتب في سبكها). الطريقة الأولى ظاهرة أعلاه، والثانية غير محبذة لأنها تذهب بجمال الاستعارة وتأتي بما ليس له صلة بالأصل، والثالثة قد تكون الأنسب و-كذلك- الأصعب في تطبيقها. وفيما يأتي أمثلة متواضعة على الطريقة الثالثةـ والتي فيها دومًا مجال للإبداع من المترجم: السينما بنظري مثل طريق معبد لا طريق وعر. السينما بنظري ليست طريقًا معبدًا بالحصى وإنما بالحلوى. يرى بعض أساتذة الترجمة أن من الجائز نقل الاستعارات والتشبيهات بصورتها الحرفية؛ إن كان النص المعني أدبيًّا أو شعريًّا أو جماليًّا في طابعه، وأما لو كان نصًّا علميًّا أو معرفيًّا فإن الأرجح هو ترجمة الاستعارة إلى بديل متعارف عليه في لغة القارئ، وهو معيار يمكن الاحتكام إليه في الاختيار من طرف الترجمة أعلاه.[44] الإحالة [45] بطل فلم "شريك" (Shrek، صدر سنة 2001) هو غول مرعب يخشاه الجميع؛ يرافقه حمار قصير ومحط سخرية في مهمة لإنقاذ أميرة حبسها تنين في قلعته، وتنتمي قصة هذا الفلم إلى فئة تسمى "المحاكاة الساخرة"،[46 وهي مثال ممتاز على الإحالة التي تتوقع من القارئ (أو المشاهد؛ في هذه الحالة) اطلاعًا سابقًا على قصص أو نصوص أخرى؛ "فيحال إليها" لفهم المعنى المقصود، فحبكة فلم شريك ليست مضحكة إلا لو عرف المشاهد شيئًا من الحكايات المشهورة الكثيرة من العصور الوسطى؛ التي ينقذ فيها فارس مغوار فتاة أو أميرة في مأزق،[47] ومكمن السخرية هو أن غولًا حلّ -في هذا الفلم- مكان الفارس وحمارًا مكان فرسه. ومن المستبعد جدًّا وربما المستحيل أن يُكتب نص أو قصة (سواء أكانت رواية أم مسرحية أم فلمًا أم كرتون أطفال) بمعزل عن غيره، فكل الإنتاجات الثقافية بينها علاقات متشابكة وثيقة بالإحالة والإشارة إلى بعضها بعضًا. تُصوّر هذه اللوحة مشهدًا نموذجيًا لفارس العصور الوسطى الذي يُنقذ فتاة في خطر، ويحارب فيها القديس "جرجس" تنينًا يهاجم إحدى الأميرات (رُسمت سنة 1407م). - منشورة تحت ترخيص الملكية العامة. المصدر: ويكيميديا كومنز تأتي الإحالات الثقافية على صورتين، فإما أن تكون: 1. اقتباسًا صرفًا من نص ما، مثل اقتباس آية من القرآن الكريم أو قول لشخص مشهور (وترجمة الإحالة يسيرة في هذه الحالات)، أو 2. تلميحًا ضمنيًّا لنصّ يألفه قارئ الأصل، وذلك بتقليد أسلوبه وهيئة النص الذي يريد الكاتب التلميح إليه (كحال المحاكاة الساخرة أعلاه)،[48] وهذه الإحالات عسيرة على الترجمة جدًّا، فهي تأتي خلال تلميحات مبطنة ربما يسهو عنها المترجم، أو لا يفهمها أساسًا إن لم يكن له اطلاع واسع على ثقافة الأصل. ثم إنه حتى لو فهمها فقد يجد ترجمتها شبه مستحيلة، فكيف يمكنه أن ينقل تلميحًا من الثقافة البريطانية -مثلًا- لقارئ عربي دون أن تضيع الفكرة؛ أو دون إفساد هذا التلميح الخفي بشرح طويل ومفصل؟ يفهم المرء ما يقرؤه أو يسمعه بإسقاطه على معرفته واطلاعه، فحينما يسمع مزحة يسقطها على ما سمعه سابقًا من مزحات أو ما يعرفه من أمور؛ ليفهم مكمن الفكاهة فيها، لكن هذه المزحة لن تضحكه في شيء إن كانت خارج إطار معرفته أصلًا.[49] ولذا يتعامل المترجم مع الإحالات الثقافية بحسب جمهوره، فلو توقع أن معظم الجمهور عارف بالإحالة؛ أمكنه أن يترجمها حرفيًّا دون قلق، وأما لو توقع أن الجمهور لا يعرف الإحالة لخصوصيتها الثقافية فعليه أن يفسرها بطريقة أو بأخرى.[50] ومن الأصح أن يفترض أن القارئ أجهل منه، فإن لم يفهم المترجم الإحالة فمن الأرجح أن القارئ العربي العادي لن يفهمها كذلك، حتى ولو كانت إحالة مشهورة بين الأدباء والمفكرين.[51] كثيرًا ما يُحال إلى قصة قابيل وهابيل في الأدب العربي (في أشعار بدر شاكر السياب مثالًا) كمثال على الخير والشر. - منشورة تحت ترخيص المشاع الإبداعي CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز ومن المسائل الشائكة هنا؛ إن كان من الأجدر بالمترجم أن يضيف تفسيرًا للإحالات في متن النص (مما يعني أنه قد يتقولها على لسان المؤلف، وهو غير محبذ)، أو أن يكتبها في الحاشية لمن أراد الرجوع إليها. وينصح اللغوي "ثومسون" بأن كل معلومة لها ضرورة في استيعاب النص يجب أن تكون في المتن، حتى ولو كانت زيادة زادها المترجم، فهذه ضرورة للحفاظ على تماسك وتتابع الأفكار، وأما الحواشي فتخصص للاستزادة فحسب، وينطبق ذلك على تعريب العناصر الغريبة عن القارئ كافة.[52] الأفعال المركبة والأمثال تمتد فائدة المعاجم لمراجعة معاني الأمثال والأقوال المأثورة، فربما تقابل -أحيانًا- تعابير إنكليزية في سياق غريب لا يتوافق مع معناها المعتاد، فتحار في ترجمتها، وتكثر هذه المشكلة مع نوعين من التعابير الإنكليزية: هما الأفعال المركبة (Phrasal verbs) والأمثال أو الأقوال الشائعة (Idioms). الأفعال المركبة كثيرة في اللغة الإنكليزية وهي تتألف من فعل معه حرف جر، فمن أمثلتها "Take off" و"Take on" و"Take out" و"Take down" وما شابهها، ومن الشائع أن يخطئ المترجمون المبتدئون في ترجمة هذه الأفعال؛ لأنهم لا يستوعبون أن الفعل المركب -بعد ارتباطه بحرف الجر- يكتسبُ معنى جديدًا قد لا تكون له علاقة واضحة بمعناه الأصلي. فلنأخذ الفعل Put (بمعنى "يضع") وأشكال المركبة الآتية كمثال: Put on: بمعنى ارتداء الشيء، مثل: "Rami put on his shirt"، أي: "رامي ارتدى قميصه". Put off: بمعنى تأجيل الشيء، مثل “Sara put off her homework”، أي: “سارة أجلت إنجاز فروضها المنزلية”. Put out: بمعنى إطفاء الحريق، مثل: “Hala put out the fire”، أي: "أطفأت هالة الحريق". ومن الواضح أن معاني هذه الأفعال لم تعد ذات صلة بعضها ببعض بعد تعريبها، ولذلك يقول محمد عناني: إن المترجم إذا وجد معنى الكلمة غريبًا فهذا يعني أنها جاءت في معنى جديد على المترجم،[53] وفيما يلي مثال ترفيهي من بداية عهدي بالترجمة، وهو بالأصل عنوان فصل من فصول موسوعة أطفال:[54] Did Dinosaurs Baby-sitt? [ترجمتي الحرفية] هل كانت تجلس الديناصورات الصغيرة؟ [ترجمة سليمة] هل اعتنت الديناصورات بأطفالها؟ وتأتي الأقوال المأثورة[55] -على عكس الفعل المركب- واضحة في النص لأنها ذات وقع غريب عادة، والمهم هو أن يحرص المترجم على مراجعة معنى القول المأثورة في معجم، وليس أن يقفز إلى استنتاج متسرع أو تخمين لمعنى هذا القول، فمن المرجح أن يخطئ تخمينه تمامًا. وفيما يلي أمثلة على عدد من الأقوال الإنكليزية المعروفة، التي قد لا يكون معناها واضحًا لمن لم يألفها: "It’s raining cats and dogs". الترجمة الحرفية: "إنها تمطر قططًا وكلابًا"، المعنى القصود: "المطر غزير". "To feel a bit under the weather": الترجمة الحرفية: "الإحساس بأنك تحت الطقس بعض الشيء"، المعنى المقصود: "شعور بالمرض". "To give the benefit of the doubt": الترجمة الحرفية: "إعطاءُ منفعة الشك"، المعنى المقصود: "قبول حجة أو فكرة دون دليل قاطع على صحتها". “Every cloud has a silver lining”: الترجمة الحرفية: “لكل غيمة بطانة فضية”، المعنى المقصود: “في كل مصيبة خير". "Diamonds cut diamonds": الترجمة الحرفية: "الألماس يقطع الألماس"، المعنى المقصود: "لا يفل الحديد إلا الحديد". وفي الأقوال المأثورة مذهبان: 1. إما نقل فحواها ومعناها (كالأمثلة الثلاثة الأولى أعلاه)، أو 2. تقريبها إلى قول مأثور معروف في لغة الترجمة (كالمثالين الأخيرين). ويحذر المترجمون المحترفون من المبالغة في البحث عن قول مأثور في الترجمة يقابل كل قول أجنبي، فهذه الأقوال ليست ضرورية دائمًا، بل غرضها جمالي في كثير من الأحيان، وأما الحاجة إلى ترجمتها فتعود إلى كيفية توظيفها في النص وإذا ما كان الكاتب مهتمًّا بالإحالة إليها في باقي كتابه.[56] ومن الطرق المتبعة في التعويض عن هذه الخصائص الجمالية للأقوال المأثورة؛ الاستعاضة عن الأمثال الإنكليزية في الأصل بأمثال عربية في مواضع جديدة (أي تبديل مكان الأقوال المأثورة في النصّ، كأن يحذف أحدها من الصفحة السادسة ويضيف غيره إلى الصفحة العاشرة)، وذلك للحفاظ على الهوية الأدبية عامةً، ولو لم يحفظها بدقتها. وهذا حل متبع في استراتيجيات الترجمة، ومنه ما طبقه مترجمو قصص أستريكس المصورة من الفرنسية إلى الإنكليزية.[57] والمبالغة في التركيز على ترجمة الأمثال والتشبيهات وغيرها من جماليات النص؛ ليست ذات شأن إلا إذا جمعها المترجم بإخلاص وإتقان في صياغة النثر العادي، فهذه كماليات تزين الترجمة، وأما الجوهر والأساس فهو معنى النص وما يصفه من أحداث القصة أو هدف المقال والكتاب. والمفارقة هي أن نقل المعنى ممكن في معظم الأحوال، مع بعض الشرح والتفصيل والإبداع، وأما نقل الأسلوب وجماليات اللغة فهو محال لاختلاف اللغات في أسلوبها وبلاغتها،[58] وهذه أمر أساسي يجدر بالمترجم أن يتعايش معه حين يحول اهتمامه من ترجمة الكلمات والتراكيب -منفردة- إلى جمل كاملة ومتناسقة في اللغة. _____ اقرأ أيضًا المقال التالي: تعريب المفردة والمصطلح المقال السابق: تعريب الجملة وأقلمتها
-
رجع حنين بن إسحاق من القسطنطينية إلى بغداد في القرن التاسع الميلادي؛ حاملًا معه عشرات الكتب اليونانية[3] ليتولى -هو وتلامذته- نقلها إلى العربية في بيت الحكمة. وكان ما دفعه لهم الخليفة العباسي من رواتب مجزية (وهي "وزن كتبهم ذهبًا"؛ كما يقال)[4] مبررًا إلى حد ما، إذ حفّت وظيفة حنين ورفاقه المشقّات: فقد كانوا أول من عرّب علومًا لم يعرفها العرب قبل زمانهم ولم يعرفوا من فحواها ومفرداتها شيئًا يذكَر، فوقع على عاتقهم الاجتهاد والإبداع بنقل تلك الكلمات إلى اللسان العربي؛ كي يتوارثها فلاسفة المسلمين وعلماؤهم لمئات السنين من بعدهم.[5] وكان الحل الأسهل لهذه المشكلة نقحرة الكلمات اليونانية؛[6] ثم تكييف لفظها ليتناسب مع اللغة العربية،[7] وهكذا عُرّبت أسماء يونانية كثيرة نألفها، منها: "أفلاطون" و"أرسطو" و"المجسطي". على أن هذا العمل ليس هيِّنًا، فمن أول المشكلات التي تقف في وجه المترجم العربي، وتعيقه عن المضي في عمله؛ المصطلحات التي ينقصها تعريب، وهي مسألة تتفاقم مرات كثيرة جدًا عند الخوض في غمار أي تخصص أكاديمي، وخصوصًا المجالات التقنية والعلمية المعقّدة والمطلوبة في عصرنا. اسما الشخصيتين الرئيستين في "كليلة ودمنة" هما تعريب للاسمين الهنديين الأصليين: "كاراتاكا" و"داماناكا". - منشورة ضمن الملكية العامة. المصدر: ويكيميديا كومنز المصطلحات الصعبة إحدى أهم وأولى المعضلات التي تواجه المترجم مع المصطلحات الصعبة هي أن يقرر طريقة التصرف بها؛ سواء أكان ذلك بترجمتها أم بتعريبها أم بنقحرتها. فهل الصحيح أن نقول "ترانزيستور" أم "مقاوم النقل"؟ وهل نقول "بيجنغ" أم "بكين"؟ وهل الأنسب هو "اليونسكو" أم "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"؟ وهذه الأسئلة كلها فيها معضلات مطولة على المترجم أن يقرر كيف يتعامل معها بناءً على علمه وخبرته، لكن، لخبراء اللغة فيها قول مفيد لا غنى عنه. بسبب خواص اللغة العربية وبُعدها عن اللغات الأوروبية؛[8] فليس من اليسير إدخال كلمات من هذه اللغات عليها إلا لو عُدّلت وكُيّفت لتتناسب مع اللفظ العربي، ولذا فإن نقل المصطلحات اللاتينية إليها صعب جدًا إن قورن باليابانية مثلًا[9] (والتي تكثر فيها استعارة الكلمات الإنكليزية في الإنتاجات الحديثة، مثلما قد يلاحظ من يتابع الأنمي وغيره من المرئيات اليابانية). ويميل كثير من المترجمين -إن لم يكن معظمهم- للجوء إلى الخيار الأسهل؛ حينما يقع بين أيديهم مصطلح صعب: وهو اقتباسه من لغته الأجنبية مباشرة، إما بصورته الأصلية ("Transistor") أو بنقحرته لحروف عربية ("ترانزيستور")، ولعل حجتهم هي الهرب من الاجتهاد في التعريب، أو توفيرًا لعناء البحث في المعاجم. ولكن لهذا القرار نتائج تُخلّ بوظيفة المترجم كلها. فمهمة المترجم النموذجية هي إيصال المعنى للقارئ من لغة لا يفهمها، وإذا خرج مترجم فذ بعد عمله الشاق والطويل بنص "عربي" محشو بكلمات مثل "(chain-growth polymerization)" و"(Number average molecular weight)"؛ وإذا لم يتعب نفسه بأكثر من أن يربط بين هذه الكلمات الرنانة بحروف جر عربية، فعمله لا يرقى إلى أن يكون نصًا عربيًا، وذلك لأن محاولة استخراج معاني النص الخفيّة -إن وُجدت- تمسي أصعب على القارئ من حل لغز كلمات متقاطعة. هل يعني هذا الانتقاد أن الاستشهاد بالكلمات الأجنبية ممنوع بتاتًا في الترجمة؟ قد تختلف الإجابة حسب السياق، ويدخل فيها -مرة أخرى- حكم المترجم، لكنه حكم يصدره حسب الحقائق المعلومة. فلنقل أننا صادفنا كلمة تقنية معروفة مثل: Computer، فمعناها يبقى واضحا للقارئ سواء أقرر المترجم نقحرتها إلى "كمبيوتر" أم ترجمتها إلى "حاسوب" أو "حاسب" أو "مِحْساب"، والسبب في ذلك أن كل هذه المفردات دارجة في اللغة العربية الحديثة، مما يعني أنها كلها صحيحة[10] بالنتيجة، وأن للمترجم حرية الاختيار بينها كما يشاء. ومثلما يمكننا التسامح مع نقحرة كلمة "كمبيوتر" من الإنكليزية؛ بناءً على شهرتها، فيمكننا أن نتغاضى عن النقحرة في حالات أخرى، منها: "الواي فاي" و"البلوتوث" و"السيلفي" و"النانو" و"التوربين"، والسبب أن هذه المفردات كلها مفهومة عند عموم الناس دون الحاجة لتكييف لفظها ولا لترجمتها، وبالتالي فهي لا تفسد عمل المترجم في إخراج نصّ يفهمه الناس. لكن الأمر يختلف جذريًّا في الكلمات غير المعروفة، فلو كتبت في مقال مترجم كلمة مثل: "موليكيولار غاسترونومي"، ثم فسرتها باقتباس بأصلها بين قوسين (وهي عادة مترجمين كثر) على شاكلة: "موليكيولار غاسترونومي (Molecular gastronomy)"، فهذا التصرف ليسَ دليلًا على أمانة المترجم ولا على حرصه الأكاديمي؛ وإنما على فشله الذريع بنقل أي معنى مفيد للقارئ العربي، فهو لم يقدم فيما سبق أي إضافة جديدة للقارئ تختلف عن قراءة الكتاب أو المقال بلغته الأصلية. والمثال الوارد هنا ليس بحالة متطرفة، فكتب علوم الطب والأحياء والتقنية العربية تغص بمفردات أجنبية مقتبسة بهذا الأسلوب. ويعدّ بعض الباحثين في الترجمة هذه النقحرة (مثلها مثل الترجمة الحرفية) علامةً من علامات إهمال القارئ؛[11] في سبيل راحة المترجم وتيسير وظيفته. وتوثيق الأصل الأجنبي للمصطلحات المعربة ليس مذمومًا من حيث المبدأ، بل هو إجراء ضروري ويساعد القارئ على الرجوع إلى المصطلح والتوثق منه؛ أو التوسع فيه، لكن مكان هذه الاستشهادات -في معظم المواضع- يُفضل أن يكون في حواشي الكتاب، أو مَسرَد بخاتمته وليس في متن النص. والسبب في هذا؛ هو أن القارئ الطبيعي لا يرغب -عادةً- بتشتيت انتباهه بمئات من الكلمات الأجنبية التي لم يسمع بها قط، فلو كان يعرف معاني هذه الكلمات لذهب وقرأ النص بلغته الأصلية، ولكن ما دفعه للتوجه نحو الترجمة هو أن يقرأ معنى مفهومًا بلغته الأم. ولهذا يجب للمترجم أن يعرف أن النقحرة ليست نقلًا للمعنى، بل للفظ صوتي ليست له أي دلالة في اللغة العربية ولا للقارئ العربي إن لم يكن على اطلاع مسبق بالموضوع الذي يقرأ فيه. وقد يصعب -في بعض الحالات- حصر المصطلحات الأجنبية بالهوامش وحدها، وذلك بسبب كثرة هذه المصطلحات وكثافة ورودها في النص، ومن أمثلة ذلك الموضوعات التقنية والبرمجية، التي قد يَلزم فيها إقران المصطلح الأجنبي بتعريبه؛ إذ إن البرمجة بأساسها تكون باللغة الإنكليزية. ويمكن في هذه الحالة جمع المصطلحات الأجنبية (التي من الضرروي معرفتها للمبرمج، رغم صعوبة فهمها)، مع تعريب يُفسر معناها أو يربطه بأصل عربي. على سبيل المثال، قد يبدو مصطلح "Salt" في تقنيات التشفير عسيرًا جدًا على الترجمة، إذ الترجمة الحرفية له "ملح" ولكن استعماله في سياق التشفير والتعمية يشير في الحقيقة إلى قيمة عشوائية تضاف إلى الكلمات السرية للمستخدمين أثناء التشفير (إذ تجرى عملية التعمية على عدة مراحل بهدف تعمية كلمات المرور قبل تخزينها)، على أن الرجوع إلى مصادر عربية تراثية في هذا المجال، مثل كتاب "علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب"، يثبت وجود مصطلح عربي أصيل لها باسم "الغُفْل".[12] وهذه طريقة في التعريب تطبق في "أكاديمية حسوب" و"موسوعة حسوب"، حتى كونت مع الوقت معجمًا كاملًا من نحو ألف كلمة. ونقل جوهر معنى الكلمة (أو "تعريبها") ليس مسعى سهلًا، إذ طال اشتغال أساتذة اللغة ومجامعها به؛ ولم يتفقوا إلا على قليل، لكنه يبقى -للأسف- ضرورةً لا مفرّ منها إن أراد المترجم نقل المعنى للقارئ. ويخشى كثيرون تعريب أي مفردة تقابله دون الرجوع إلى مصدر أو دون استشارة أستاذ متخصص، بل قد يظنون أن أي محاولة أو اجتهاد بهذا الصدد فاحشة مرعبة، لكن الواقع هو أن المترجم يجد نفسه مضطرًا لترجمة كل (أو جُل) ما يقابله من مصطلحات في النص الأجنبي؛ مهما كانت صعبة، وحينما يُكلَّف المترجم بنقل مقال متخصص قد يصطدم بعشراتٍ من هذه المفردات في كل صفحة، وإن لم يسعفه في تعريبها أي قاموس بين يديه، فقد يصبح ملزمًا بالاستعانة بقدراته اللغوية (وأساليب التعريب المتعارف عليها) في تعريبها بوسيلة أو بأخرى، حتى ولو خشي من إفساد السليقة العربية أو تجاوز أحكام مجامع اللغة. سبل التعريب السبعة ولد المترجم أحمد عيسى بك في مدينة رشيد (وهي موقع اكتشاف "حجر رشيد" المشهور) على ضفاف النيل؛ قبل نحو مئة وخمسين عامًا، ودرس الطب في "المدرسة الخديوية" المرموقة، وتخصص بأمراض النساء والطب الباطني، على أن شغفه الحقيقي كان باللغة والأدب، فتعلم لغات سامية ولاتينية شتى[13] والتحق بـ"مجمع اللغة العربية بدمشق" و"الأكاديمية الدولية لتاريخ العلوم" في باريس، واشتُهرَ بشغفه في الترجمة؛ فكان من أهم آثاره فيها كتاب "التهذيب في أصول التعريب"،[14] الذي ترك بصمته على كثير من المترجمين في زمن النهضة العربية، وعلى التعريب خصوصًا. يقترح أحمد عيسى بك في هذا الكتاب خمس سبل لنقل المصطلحات الأعجمية الجديدة إلى اللغة العربية، والتي اقتبسها عنه كثير من الكتاب والمترجمين العرب من بعده. وقد رتب عيسى بك هذه الطرق بحسب أولويتها في لجوء المترجم إليها، فإذا لم تصلح الأولى ينتقل المترجم إلى الثانية فالثالثة؛ حتى ينتهي إلى آخرها.[15] وسوف أقتبس هنا قائمته نفسها مع شرح كل بند فيها وبعض سياقاته، على أني زدت عليها طريقتين في آخرها لتصير سبعة، واجتهدت بأني أدخلت تعديلًا واحدًا في ترتيبها فنقلت "التعريب" من المركز الخامس إلى الثاني في أولويته، وذلك لأني أظن أن التعريب[16] أصبح ضرورة في عصرنا أكثر مما كان حين نشر الكتاب المذكور، والذي قد مضى عليه نحو مئة عام أو أكثر، فتغير الزمن والأحوال. الترجمة الترجمة هي أسهل طريقة في تعريب الكلمات الأجنبية، فالمقصود بها -ببساطة- هو ترجمة معنى المصطلح الأجنبي إلى معنى قريب في العربية. والمصطلحات التقنية التي تغيب من القواميس العربية كثيرة، ولا تحتاج كلها لاختصاصي لترجمتها، فعلى سبيل المثال: من الواضح أن عبارة "Cognitive Revolution" معناها التقريبي هو "الثورة الإدراكية" أو "الثورة المعرفية"، وللمترجم أن يجتهد في نقلها هكذا لو لم يجدها في قاموس أو مرجع لغوي معتمد، وينطبق المثل على كثير من الكلمات التي ليس لها تعريب معتمد. وللترجمة المباشرة خطر؛ هو أنها قد تبدو سهلة في عين المبتدئ، ولكنها تتأثر -في الواقع- بتفكير المترجم وميوله، ولهذا قد تؤدي إلى ظهور ترجمات عربية عديدة لما كان مصطلحًا واحدًا في اللغة الأجنبية. فكلمات "حاسب" و"حاسوب" و"محساب" و"حاسبة" جاءت وليدة ترجمات عديدة؛ توافق كل منها ميولًا شخصية أو مجتمعية لمترجم أو لمؤسسة لغوية، ومعظم القراء يفهمون أن هذه الكلمات مترادفة لأنها كلها مشهورة، لكن من يقرأ كلمة "الحَاضُوْن" لأول مرة قد لا يعرف أن المقصود بها هو "الحاسوب المحمول" أو "اللابتوب"، وقد يضيع القارئ بسهولة بين هذه الترجمات المتفرّقة، التي قد يضيف إليها كل مترجم إضافةً جديدةً حسب هواه. ولا تخرجُ أي من وسائل التعريب التي سوف نأتي عليها خارج نطاق التأثير الشخصي للمترجم، لكن الترجمة تبقى وسيلةً محدودة، وقد لا تكفي دومًا (على سرعتها، وبساطتها) لتلبية الحاجة، فينتقل المترجم منها إلى الوسيلة التالية أدناه -على الترتيب- حتى يجد الطريقة الأنسب. التعريب لكلمة "التعريب" عدة معان دارجة ربما يختلط بعضها ببعض، فمنها الترجمة والنقل إلى اللغة العربية عامة، ومن معانيها -كذلك- ترجمة الكلمة المنفردة من لغة أجنبية إلى العربية (وهو موضوع هذا المقال بعمومه)، ومنها (وهو المقصود هنا) نقحرة المفردة الأجنبية باللسان العربي مع تكييفها و«[صبغها] بصبغة عربية».[17] ومعنى "المُعرَّبُ" هو ما استعمله العرب من ألفاظ لمعان من غير لغتهم،[18] وتعريبها من أنفع الوسائل في نقل الألفاظ بين اللغات؛ ومن أقدمها كذلك. يقول أبو هلال العسكري،[19] وهو أديب ولغوي من الأهواز عاش في عصر الدولة العباسية: «والكلمة الأعجمية إذا عُرّبَت فهي عربية، لأن العربي إذا تكلم بها مُعرّبة لم يُقَل إنه يتكلم بالعجميّة». فالتعريب -إذًا- هو استعارة مفردة من لغة أجنبية مع تعديل في لفظها وشكلها؛ ليتّفق مع الصوت والصرف العربي، فتلحق بكلام العرب وتعامل بأحكامه، وأحيانًا تترك على أصلها فتعامل مثل اللفظ الأجنبي (كما سيأتي في بند "النقحرة").[20] ويقول في المعربات الأمير مصطفى الشهابي،[21] وهو رئيس "مجمع اللغة العربية في دمشق" -سابقًا- وأحد روّاد الترجمة في النهضة العربية: «ولا ضير في التعريب كلما مسّت الحاجة إليه، وكلما تعذر العثور على كلمة عربية تقابل الكلمة الأجنبية، أو تعذّر إيجاد كلمة عربية تفيد معناها بوسائل الاشتقاق المعروفة». ويضيف لكلامه رائد مشروع المعجم الطبيّ الموحد محمد هيثم الخياط: «وكذلك حين تكون الكلمة العربية المقترحة أشد عُجمةً من الكلمة الدخيلة».[22] والتعريب أو "الإدخال" موجود منذ القدم في اللغة العربية، وفي شتّى لغات العالم، فهو لا يكون مقصودًا بالضرورة بل قد يقع عفوًا؛ حينما تدخل لفظة أجنبية إلى اللغة ثم تتغير -مع الزمن- حتى تتماشى مع ألسنة الناس. ومن المعرّبات المألوفة: "التقنية" (technology) و"الموسيقى" (music) و"الديمقراطية" (democracy) و"الأكسدة" (oxidation) و"المغناطيس" (magnet). وقد شاع التعريب في اللغة العربية منذ بداية تاريخها، فدخلت عليها آلاف الكلمات المعرّبة قبل الإسلام، بل وفي القرآن من لغات الفرس والروم والحبشة والسريان،[23] كما دخلت عليها كلمات في العصر العباسي من اللاتينية واليونانية،[24] وفي العصر العثماني والاستعماري من التركية والفرنسية والإيطالية والإنكليزية. ومن الأمثلة الحديثة المنتشرة على التعريب "تلفاز" الناتجة عن تحوير اللفظة الإنكليزية Television و"أكاديمية" المُحوّرة عن Academy، وقد يحدث التعريب في اللهجات (أيضًا)، مثل كلمة "أصنصير" في بعض اللهجات العربية، وهي تعريب الكلمة الفرنسية ascenseur (ولفظها الأصلي: آسينسوغ، أي مصعد كهربائي). والتعريب مفيد جدًا لأنه سهل بالنسبة لعموم الناس وقريب لأذهانهم، لكنه يبقى غير مُحبّذ في بعض السياقات؛ لأنه يخلق ألفاظًا جديدةً قد لا يألفها القارئ دون تكرارها وانتشارها، وفيه اجتهاد باللغة ربما لا يحق للمترجم الإقدام عليه.[25] فالتعريب يكسب قوته من انتشاره العفوي على ألسنة الناس، كالأمثلة أعلاه ولكنه يخسر هذه المنفعة إن أتى مبتدعًا ومقصودًا. ولعل إحدى اكبر فوائد التعريب هي في ترجمة الأدب، إذ تعج كثير من الروايات والأشعار بمصطلحات مختلقة أو نادرة تصعب ترجمتها، وليست لها مكافئات بالعربية، فقد تكون من اختراع المؤلف أو الأديب نفسه (كما في الروايات الفانتازية التي تكثر فيها المدن والشعوب واللغات المصطنعة)، وفي هذه الحالة قد يحظى المترجم بحرية التلاعب باللغة، لأنه لا يعرب لفظة دارجة في لغة حقيقية، وإنّما كلمة مختلقة ينحصر استخدامها في كتاب أو سلسلة من الكتب. الاشتقاق يعد الاشتقاق من أكثر ما يُشاد به من مزايا اللغة العربية، فهي تتميز بقدرتها على اشتقاق الألفاظ وتنويعها وتسهيلها. وللغة العربية قياس؛ حيث يشتق كلامها من بعضه، وذلك بأن يؤخذ عن الأصل فرع يوافقه في حروفه ويدل عليه، ومنها أن يشتق من الفعل اسم وصفة وغير ذلك. فمن "سَرَعَ" يقال: "السرعة" و"التسارع" و"الإسراع" "و"المُسَارَعَة" و"المُسْرِع" و"السَّريع".[26] تكثر المشتقات في اللغة العربية، ومن أهمها سبع فئات من المشتقات (هي: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المُشبّهة، وأفعل التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة). وتظهر فائدة طرق الاشتقاق هذه بسياقات كثيرة في التعريب نُقلت بها كلمات مألوفة لنا،[27] مثل: أسماء المكان (ومنها: "محطة" من حطّ، و"مُختَبر" من "اخْتَبَرَ"، و"مَوْقِف" من "وَقَفَ")، وأسماء المفعول ("مُنْطَاد" من "انطاد" أي: "صعد في الهواء)، وأسماء الآلة ("مِصْعَد" من "صَعَدَ"، و"غوَّاصة" من "غَوَصَ")، وهذه كلها مسميات لأماكن أو أشياء حديثة اشتقّت من جذور عربية. وبعض الأسماء المعرّبة عن اللغات الأخرى تقبل الاشتقاق،[28] مثل: "مَغْنَط" و"مِغْنَاطيسيَّة" (وأصلها مَاچنِتْ)[29] و"التقنيين" و"التقانة" من تقنية (وأصلها تكنولوجي)، وهذه من أفضل الوسائل في إثراء اللغة بمصطلحات جديدة وتنويعها ممّا عُرّب واقتبس عن لغات أخرى من الكلمات الحديثة.[30] المجاز وهو تقريب المعنى أو النقل المجازي من وسائل الترجمة الشائعة، وخصوصًا منذ بدء النهضة العربية في القرن العشرين: وهذا ليس بالأمر المستغرب، فمتى ما تعوّد القارئ العربي على المجاز؛ قد يصبح أيسر المعرّبات وأجملها ربما. وأساس هذه الطريقة هو أخذ مفردة عربية في أصلها، وإضفاء معنى جديد عليها -إما عمدًا أو عفوًا- يتسق مع معناها الأول و"يجوز مجازه"، إما لأن بينهما شبهًا؛ أو لاتصال العام للبعض؛ أو بالإضافة؛ أو بغير ذلك،[31] ويقال في تعريف المجاز أنه: "كل كلمة أُريدَ بها ما وقعت له في وضع واضعٍ وقوعًا لا يستند فيه إلى غيره".[32] وللمجاز أمثلة مألوفة كثيرة منها كلمة "قطار"، ومعناها التراثي "قافلة الإبل" ثم وُسِّع بالمجاز ليشمل القطارات الحديثة، ومثلها "السيارة" التي كانت تصف جماعات المسافرين، فأمست لفظة للمركبات الحديثة، وكذلك الطائرة والدبابة والشاحنة والغواصة والهاتف والجوال والخلاط والغسالة والثلاجة وغيرها من أسماء الاختراعات والآلات.[33] والفرق بين النقل المجازي، والترجمة المألوفة؛ أن المجاز لا يبتدعُ لفظًا جديدًا، بل "يعيدُ تدوير" ألفاظ عربية أصلًا وقريبة في معناها السابق من معناها الجديد. فالقطار والسيارة مفردتان متداولتان منذ القدم؛ إذ كانت تعني الأولى صفًا متواليًا من الإبل والثانية قافلة، ولمعنيَيْهما القديمين صلة وشبه واضحان بالمعنَيين المستحدثين. وليست كل أسماء الاختراعات العربية مجازًا، فكلمة "المُحرِّك" جديدة لم يستخدمها العرب بمثل هذا السياق -أو ما يشبهه- قبل اختراع المركبات؛ وقبل استحداث كلمة Motor في اللغات اللاتينية، ولكن بعد ظهور هذا الاختراع اشتُقت لها ترجمة من فعل "حَرَكَ" (وذلك اهتداءً بأصل الكلمة اللاتينية moto ومعناه "تحريك")، وهذا يعني أنها ليست مجازًا حتى ولو بدت عربية الأصل. ولا بد للمُعرِّب (إن أراد اتباع طريقة المجاز) من إحاطة هائلة باللغة العربية ومفرداتها الواسعة، فدون ذلك لن يعثر على الكلمات المناسبة في معناها وسياقها التاريخي. وللمجاز مشكلة أخرى؛ وهي أنه يختلق معاني جديدة للكلمات، ولذا قد لا يختلف كثيرًا عن اختلاق مفردة جديدة من العدم، ويبقى دون فائدة تذكر إن لم يتعوّد عموم الناس على المجاز، وإن لم يدوّروه على ألسنتهم. فعلى سبيل المثال: لم يكن لقرار أحد مجامع اللغة بتعريب كلمة "الحاسوب المحمول" (Laptop) إلى "الحاضون" أي قيمة تذكر، لأن هذا قرار لم يكترث به عدد ذا قيمة من الناطقين باللغة العربية، ومن المستبعد أن يكترثوا باتباعه لأنه لا يتفق في شيء مع الاستعمال المألوف والجاري للغة حاليًّا. النحت والتركيب النَّحْتُ أو "التركيب المزجي" في اللغة هو مزج كلمتين أو أكثر في كلمة واحدة اختصارًا وتسهيلًا، مثلما «ينحت النجار خشبتين يجعلهما خشبة واحدة». ومن أمثلة النحت "الحَوْقَلَة" (وأصلها "لا حول ولا قوّة إلا بالله")،[34] وشبيه بها اللفظ المركب؛ وهو إلحاقُ كلمتين معًا (أصلهما مضاف ومضاف إليه) بحيث تدلاّن على معنى جديد واحد، مثل: "لاإرادي"، فهي تدل على معنى يمكن إيجازه بلفظ واحد؛ ولكنه رُكّب بكلمتين متداولتين في اللغة. كان مشروع "المعجم الطبي الموحد" من أهم المساهمات في نشر النحت والترويج له في تعويض النقص بالمصطلح العربي، ويساعد النحت على اختصار الألفاظ المركبة وتسهيل اشتقاقها واستعمالها في اللغة، ويعامل اللفظ المنحوت على أنه مفردة واحدة، فيقال "الاثناعشري" لعضو في جسم الإنسان، ولا تستبدل الألف فيها ياءً عند جرّها (على عكس الحال عند جرّ رقم "الاثني عشر" مثلًا). كما أن النحت يقع بصورة طبيعية غير مقصودة، فكثير من اللهجات العامية نحتت الكلمات بمرور الوقت، مثل: كلمة "إيش" أو "ليش" من "لـ/أي شيء هو"،[35] و"هسَّع" أو "لسَّة" من "لـ/هذه الساعة"،[36] و"فذلكة" من "فذلك العدد كذا"، وهلمّ جرا.[37] النحت طريقة لها أنصارها وخصومها، ويدعو كثير من اللغويين العرب إلى عدم الإكثار منه لغرابته على اللغة، بينما يعتقد آخرون أنه قد يكون الوسيلة المناسبة للتعويض عن القصور الكبير في المصطلحات التقنية والعلمية في العربية الحديثة. ويولِّد النحت ألفاظًا غير مألوفة وربما تبدو منفّرة لذوق القارئ؛ مثل "الركمجة"،[38] ولذا يستعاض عنه كثيرًا باللفظ المركّب؛ فيقال: "ركوب الأمواج". والتركيب -من ناحية أخرى- من أسهل وسائل التعريب، ولكنه قد يفسد بلاغة اللغة، ويلجئ لاستخدام كلمات كثيرة في التعبير عن معنى واحد. التأثيل لو كُلّفتَ بالترجمة في علم الفلك ذات يوم، فقد تصادف أسماء أعلام تصعب ترجمتها مثل Betelgeuse، وهو اسم نجم مشهور، ومن المحتمل أن ينحو المترجم العربي -إن لم يرَ سبيلاً آخر- إلى نقحرة هذه الكلمة كما صنع مترجم مقالة لموقع "سي إن إن" عنوانه: «لغز فلكي جديد: نجم "بيتيلجوس" العملاق يتقلص».[39] وربّما تظهر هذه ترجمة مقبولة لمن لا يعرف أصل الكلمة، على أن البحث عنها في أي معجم سوف يبعث في نفس القارئ مشاعر لا يستهان بها من الحزن والأسى، لأن كلمة Betelgeuse العجيبة ليست إلا تحريفًا لاتينيًّا لاسم "يد الجوزاء"،[40] وهو مأخوذ في اللغات اللاتينية عن العربيّة مثله في ذلك مثل معظم أسماء النجوم المشهورة، وكان على مترجم المقال أن يكتشف هذه المعلومة لو أمضى بضع دقائق في تقصّيها. خريطة للنجوم من كتاب "صور الكواكب الثمانية والأربعين" لعبد الرحمن الصوفي، ويظهر فيها نجم "يد الجوزاء" باسمه العربي الأصيل. - منشورة تحت ترخيص الملكية العامة. المصدر: ويكيميديا كومنز لهذا السبب أضيف التأثيل إلى سُبل التعريب الخمسة التي اقترحها أحمد عيسى بك. ومعنى التأثيل هو تقصي أصل الكلمة التاريخي، فجُلّ مفردات اللغات -كافة- هي عبارة عن اقتباس وتحريف واشتقاق واستحداث للمفردات من أصول ما، وتحفظ لنا المعاجم تاريخ هذه الأصول، وحينما نرجع لها قد نفهم معاني كثير من الكلمات العلمية والأكاديمية؛ التي يستعصي تعريبها بأي وسيلة أخرى، مثل كثير من أسماء الحيوانات والنباتات والأمراض وأعضاء جسم الإنسان؛ المأخوذة أصلًا عن اللاتينية. على سبيل المثال، كلمة "Acanthopterygii" هي اسم لمجموعة من الأسماك، ولعله يبدو اسمًا عجيبًا أو دون معنى للوهلة الأولى، لكن، وبالرجوع إلى معجم ميريام ويبستر المعروف يتضح أنه مزج بين كلمتين من اللغة الإغريقية القديمة: وهما "acanth" (أي "شوك") و"pterygii" (أي "زعنفة" أو "جناح"، وبما أن ما يشار إليه في هذا السياق هو نوع من الأسماك، فمن الواضح أن المعنى المقصود الزعنفة وليس الجناح). وعند مراجعة بعض المعلومات عن هذه الفصيلة في موسوعة مثل "ويكيبيديا"، يتبين أنها تمتاز بأن زعانفها تتخللها عظام رفعية أقرب إلى الأشواك، ومن هنا يكتمل تعريب الاسم معنى وسياقًا وهو: طائفة "شوكيّات الزعانف"، أي الأسماك ذات الزعانف الشوكيَّة. ولنا أن نسير على النهج ذاته في تفسير آلاف المصطلحات الغريبة والمستعصية التي تواجه المترجم، والتي قد يكون من الصعب -بل المستحيل- الاستعانة بالمصادر العربية لترجمتها. وهذا حل فيه قدر كبير من الاجتهاد، لكنه يبقى ملجأ عظيم النّفع في التعريب إن لم يصلح ما سلف. النقحرة[41] من أكثر الأخطاء التي يرتكبها المترجمون الجدد (والكُتّاب إجمالًا)؛ هي ابتداع تهجئات جديدة للكلمات المستعارة من لغات أجنبية حين "نقلها حرفيًا". فمن السهل حين ترجمة كتاب أو مقال طويل فيه أسماء صعبة، أن يخترع الكاتب ثلاث أو أربع تهجئات لاسم واحد بسبب السّهو والنسيان، وتعود هذه المشكلة إلى الغموض الكبير في تهجئة الألفاظ اللاتينية بالعربية، وتسمى هذه "النقحرة"[42] (وهي كلمة معرّبة بطريقة النحت التي تناولناها أعلاه من: "النقل الحرفي")، وتعني نقل صوت غير عربي إلى اللغة العربية مع الحفاظ على شكله الأصلي، وهو -للأسف- أمر غير سهل أبدًا. تفتقر اللغة العربية الحديثة إلى قواعد قياسية للنقحرة، ولذلك لا بد لنا -في كثير من الأحيان- من الاعتماد على شيوع الكلمة أو اتفاق مجامع اللغة عليها، وليس على "صحتها". على سبيل المثال، من أكبر المعضلات في النقحرة العربية صوت الـG اللاتيني (والمعروف -أيضًا- بالـ"الجيم المصرية" أو "القاف الحجازية")، فيجوز نقله إلى اللغة العربية بما لا يقل عن ست أو سبع صور نراها في التهجئات الشائعة لاسم شركة Google، ومنها "جوجل" و"غوغل" و"قوقل" و"گوگل"،[43] ولا بد هنا أن نعد جميع صور الكتابة المتعارف عليها صحيحة لأنها جميعًا أو معظمها تحظى بتأييد أساتذة ضليعين باللغة العربية، وبالتالي فلا أفضلية لواحدة منها على سواها إلا بذوق الجمهور المستهدف أو ذوق المترجم. يجدر بالمترجم المتقن أن يبحث عن تهجئة معروفة للكلمة المعنية؛ إن كانت معروفة، فاختراع النقحرة الجديدة غير محبذ إلا حين الضرورة، ومن السهل أن ينقحر المترجم اسمًا مثل Samuel إلى "سامويل" أو "صَمويل" أو "صاموِل" أو "سموِيل" أو غير ذلك. ولا وسيلة -مرة أخرى- للاحتكام إلى واحدة من هذه النقحرات بناءً على "صحتها"، إذ لا توجد قواعد واضحة أو ثابتة بهذا الخصوص، لكن من الأفضل الاعتماد على نقحرة مستخدمة -مسبقًا- في مصادر معتبرة باللغة العربية، وذلك اهتداءً بالسائد والمعروف في كتابة الاسم. نقحرة لاسم محل McDonald's من الإنكليزية للعربية. - منشورة تحت ترخيص CC-BY. المصدر: ويكيميديا كومنز والقاعدة السائدة في أسماء الأعلام هي أنها لا تترجم أبدًا؛ وإنما تجب نقحرتها في كل سياق، ولكننا ربما نغير لفظها لتكييفه وتعريبه. ومن الأعلام جميع أسماء الأشخاص والأماكن والبلدان والشركات والعوالم التخيلية وكثير غير ذلك، فاسم شركة Caterpillar لصناعة الأحذية لا يُترجَم بل يُنَقحَر إلى "كاتَربيلار"، واسم Wikipedia هو "ويكيبيديا" (وليس "موسوعة الويكي"). وبعض أسماء الأعلام معربة؛ فهي لا تكتب بنقحرة كاملة، بل بلفظ حوّره اللسان العربي بمرور الوقت، فيقال: "النرويج" بدلًا من "نُورْواي"، و"بكين" بدلًا من "بيجنغ"، وفي هذه الحالات يُرجع إلى التهجئة المعربة. وبعض أسماء الأعلام لها مقابلات عربية تختلف في اللفظ (وربما في المعنى) عن أسمائها الأجنبية، وفي هذه الحالة يُرجَع للتسمية الأكثر شيوعًا بين الاثنين، مثل: دولة "مونتينجيرو" في شرق أوروبا التي يقال لها -بالعربية-: "الجبل الأسود"، ودولة "كُوْتْ دِيْفْوَار" التي قد يقال لها "ساحل العاج" (حسب جمهور الترجمة[44])، وهلم جرا. أسماء الأعلام إحدى الحالات الأكثر تعقيدًا في التعريب؛ هي أسماء الإنتاجات الفنية والأدبية (الحديثة منها والقديمة)، مثل: عناوين القصص والروايات والمسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية وألعاب الفيديو، وهذه تحتاج إلى تأمل ومناقشة لأن أسماءها طويلة ومعقدة؛ إذ تمسي قراءتها صعبة عند تهجئتها بحروف عربية، كما أن أسماءها غالبًا ما تهدف لإيصال معان ودلالات واضحة تضيع عند نقحرتها. ومن الشائع في لغات العالم تعريب أسماء الأعمال الأدبية (مثل: الكتب والروايات) بالترجمة، فنقول "الجريمة والعقاب" و"كبرياء وهوى"، على أن الأمر يصبح عسيرًا جدًا في الإنتاجات الحديثة، (مثل: ألعاب الفيديو والأفلام)، والسبب هو أن أسماء هذه الإنتاجات كثيرًا ما تستمد أصلها من مصطلحات ثقافية يصعب نقلها بين اللغات، ولأن لكثير منها مجتمعات كبيرة من المعجبين والمتابعين، الذين يعرفونها بأسمائها الأصلية؛ ولكنهم لا يتقبلون تغيير اسمها ولا ترجمته. ومن أمثلة الأسماء ذات الخصوصية الثقافية عنوان رواية "Hickory Dickory Dock" -الحديثة نسبيًا- لأغاثا كريستي، وفلم "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (إنتاج 2004)، ولعبة "Counter-Strike: Global Offensive": فضلًا عن أسماء جميع ألعاب الفيديو تقريبًا. فلو عرّبنا اسم اللعبة الأخيرة -مثلًا- إلى: "الضربة المضادة: الهجوم العالمي"، فهل سوف يتقبّل أي من اللاعبين العرب الحديث عنها بهذا الاسم؟ وأما أسماء الناس، سواء كانوا حيقيقيّين أم شخصيات خيالية تظهر في رواية أو لعبة أو فلم، فليس من المقبول -إجمالًا- أن يعبث بها المترجم ولا يغيرها.[45] وتستثنى حالة واحدة عامة من هذا: هي ترجمة أدب وإنتاجات الأطفال، لأن الأسماء الأجنبية قد تبدو غريبة على مسامعهم وصعبة اللفظ والفهم لديهم، ومن أمثلة ذلك تعريب الأسماء في دبلجات قناة "سبيستون" للأطفال (مثل: "سابق" بدلًا: من "Seiba Go"، و"لاحق" بدلًا من: "Seiba Retsu"). وربما تضاف إلى ذلك حالات قليلة، منها: أن يكون للاسم أصل أو مكافئ عربي، كأسماء الأنبياء، فيجوز أن نترجم اسم David إلى "داوُد" إن ورد في سياق ديني. توحيد المفردات إحدى أهم المسائل في الترجمة الأدبية؛ هي الحرص على توحيد المصطلح الواحد في كل موضع يرد فيه ذكره بالمقال أو الكتاب الواحد. وقد أمست في اللغة العربية كثير من المصطلحات المتضاربة التي استحدثت لتعريب العلوم والآداب، ومنها أسماء الأجهزة الإلكترونية الحديثة والمفردات العلمية الاختصاصية، ومثل هذه التعريبات لم يأتِ بصورة طبيعية على ألسنة الناس؛ بل ابتدعها كل مؤلف ومترجم وهيئة حسب الحاجة فضلّلت القراء. ومنها أن يقال: "التقنية" و"التقانة" و"التكنولوجيا" و"التقنولوجية"، وهي كلها تعريبات لأصل واحد. ولا شك بأن المترجم لا يستطيع توحيد أي من هذه المصطلحات في البلاد العربية جمعاء (فمجامع اللغة لم تستطع)، ولكنه قادر على توحيدها في ما يترجمه. فلدى تعريب بعض من هذه الكلمات في مقال أو كتاب، فلا بد من تسجيل أي تعريب يجتهد المترجم فيه ضمن قائمة أو مسرد يعود إليه فيما بعد، وتساعد هذه القائمة على تثبيت المصطلحات في ذهن المترجم وإيجاد تصاريف واشتقاقات عربية مناسبةٍ لها في بعض الأحيان، كما تجبره على التفكير بتعمق قبل تعريب أي مصطلح. هاري بوتر مثالا سلسلة هاري بوتر هي أكثر سلاسل الكتب مبيعًا في التاريخ، فقد بيع منها أكثر من 500 مليون نسخة منذ نشرها، ولهذه الروايات جانبان جعلاها محط اهتمام باحثي الترجمة: الأول هو أنها ترْجمت إلى نحو ثمانين لغة؛ فأصبحت من أكثر الكتب ترجمة ونقلًا بين اللغات، والثاني هو أنها رواية خياليّة تعج بأسماء شخصيات وأماكن ومخلوقات ترهق المترجم وتستلزم إبداعًا وخيالًا خلّاقًا؛ فأصبحت موضوعًا للمقارنة والدراسة بين الترجمات الكثيرة. في روايات هاري بوتر رمزيّة كبيرة لكل المسميات، فهي تستشهد بأماكن معروفة كثيرة لقرّاء اللغة الإنكليزية (مثل محطة "كينغز كروس" بمدينة لندن)، كما تأتي بأسماء مخلوقات أسطورية من ثقافات أوروبية (كالتنين و"الترول") وبأسماء كثيرة لها معانٍ رمزية (كاسم "ألبوس دمبلدور"؛ ومعنى اسمه الأول "البياض" باللاتينية، فيرمز اسمه إلى خصاله الخيّرة، وبعكسه "دراكو مالفوي" فمعنى اسمه الأول التنّين)،[46] بل واسم صحيفة "Daily Prophet"؛ وهي محاكاة لصحيفة "Daily Mail" البريطانية المعروفة. ومن اللغات التي تُرجمت إليها هذه الروايات: الإسبانية والإيطالية، وكلاهما تألفان التكييف والتعديل في الترجمة ليتناسب مع ثقافتيهما. وتحتفظ هاتان الترجمتان بمعظم أسماء الشخصيات والأماكن في الرواية على حالها، ولكنهما تتلاعبان ببعض الألفاظ الهامشية أملًا في نقل بعض من إيحائها الثقافي، ومن أمثلة ذلك: أسماء الكتب التي يدرسها طلاب المدرسة ومنها كتاب "Magical Theory by Adalbert Wafflin"، وعدلت النسخة الإيطالية اسم المؤلف إلى "Adalbert Incant" أي "أدالبرت المشعوذ".[47] ومن غير المناسب في هذه الحالة ترجمة أسماء الشخصيات الرئيسة في القصة (مثل "هاري بوتر" و"دمبلدور") على الرغم من رمزيّتها الثقافية، وذلك لأنها مألوفة لقارئ القصّة العربي، ولن يكون من المفيد ولا الممتع له أن يرى أسماء شخصياته المفضلة وقد عُدّلت وأفسدت في الترجمة (إلا لو كانت أسماءً ألفها القارئ العربي بترجمتها قبل أن يعرف أصلها الأجنبي، كحال شخصيات بعض من القصص المصورة المترجمة التي سوف نتحدث عنها لاحقًا). وقد يختلف الأمر مع عنصر هامشي بالقصة، مثل: أسماء الكتب، فالقارئ لن ينزعج من تغيير أسمائها غالبًا، وبالعودة للمثال أعلاه، فما من بأسٍ بتعريب عنوان الكتاب إلى ما يشبه الكتب العربيّة التراثية (وهي نظيرة التراث اللاتيني الذي تغص به القصة) فنقول: "فن الأسحار لأدالبرت المِغوار" أو ما شابه. وتلتزم الترجمة العربيّة لهاري بوتر -عمومًا- بتعريب متزن، لكن فيها أخطاءً منهجيّة مما ذكرناه أعلاه، مثل: كونها تعدد في ترجمات الأسماء نفسها ، فتعريب "Prefect" يأتي تارةً "رئيس التلاميذ" وتارةً "رائد الفصل"، و"Poltergeist" يصبح حينًا "الشبح الشرير" وحينًا "الشبح المشاغب"، وفيها أمثلة أخرى تناولها الباحثون.[48] إجمالًا، على المترجم أن يحاول أن يكون مبدعًا وخلاّقًا، باستغلال جمال العربية وإمكاناتها في تجديدها بما ينقصها. ولكن مهما كانت الوسيلة التي تلجأ إليها حينما تنخرط بنفسك في التعريب، فعليك أن تتذكر أن اللغة ظاهرة اجتماعية، وأن كل كلمة ومصطلح يُضاف إليها باجتهاد شخصي، لن يكون له معنى يُذكر ما لم يندرج على ألسنة الناس في حديثهم اليومي، وهذه -دومًا- هي العقبة الأولى والكبرى للمعرّب. _____ اقرأ أيضًا المقال التالي: من لسان العرب إلى أكسفورد: المعاجم والقواميس وأهميتها في الترجمة المقال السابق: تعريب تراكيب اللغة


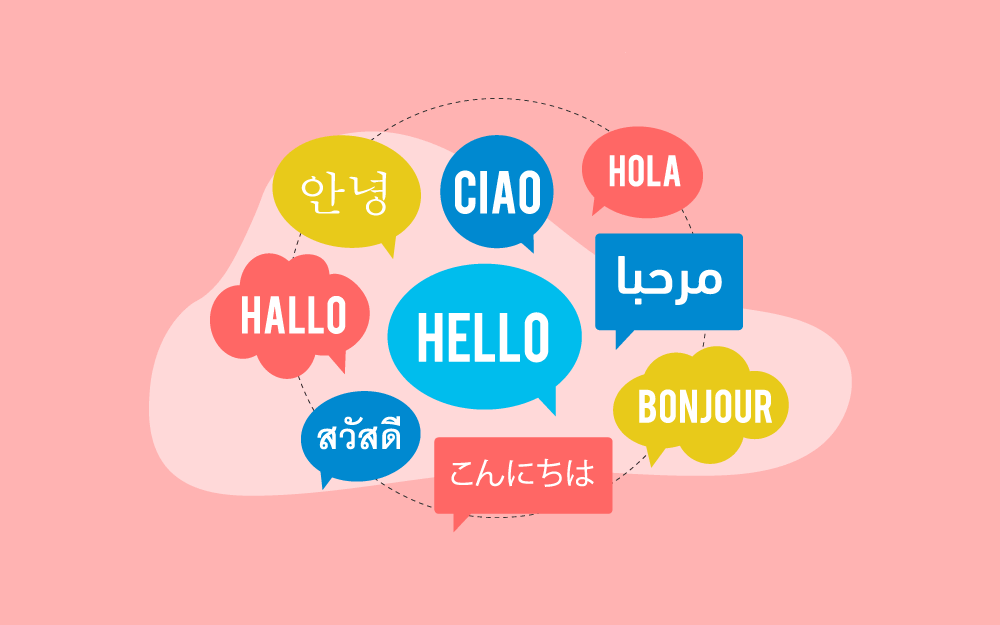
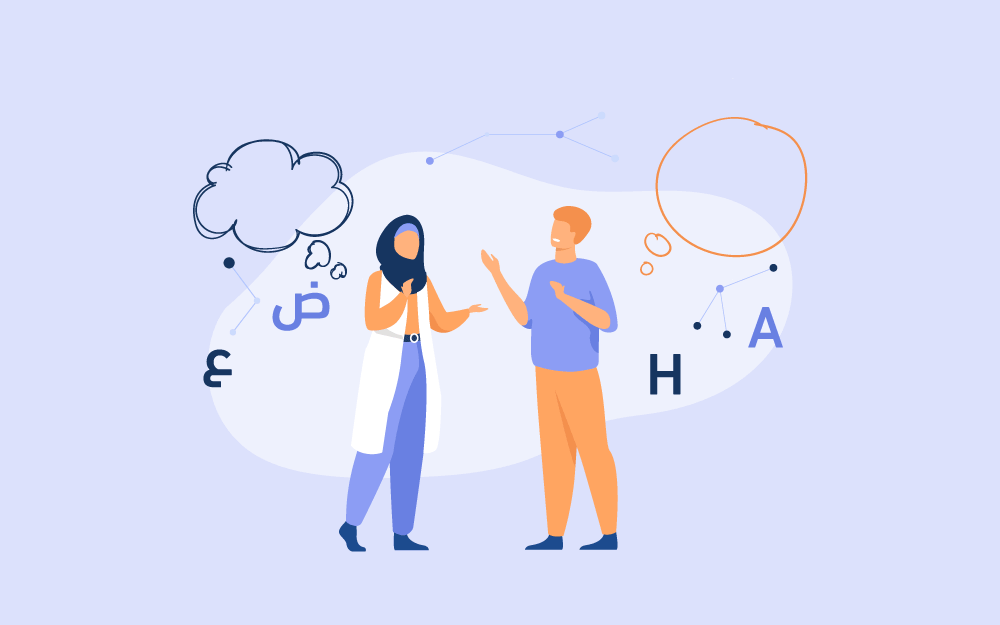
.png.c39a1c6a7f2269fd3d08e8f899106c2c.png)