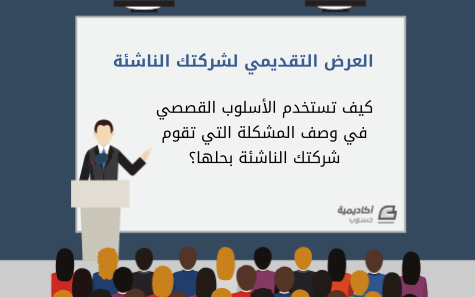لوحة المتصدرين
المحتوى الأكثر حصولًا على سمعة جيدة
المحتوى الأعلى تقييمًا في 04/03/16 in مقالات ريادة الأعمال
-
تكلمت في مقال سابق عن كيفية ترتيب العناوين في العرض التقديمي، والآن أرغب في التحدث بشكل تفصيلي عن قسم "المشكلة" وتقديم بعض الاقتراحات حول كيفية وصف المشكلة الحقيقية التي تقوم بحلّها. تستخدم العديد من الشركات الناشئة الإحصائيات والأخبار لوصف المشاكل التي تقدّم حلولًا لها، فعلى سبيل المثال نرى العبارة التالية في كثير من الأحيان: وعادة ما ترتبط هذه الأخبار مع بعضها البعض وبشكل متتابع لتدعم إحداها الأخرى وتساعد في البرهنة على وجود مشكلة واضحة. وعلى الرغم من أنّ استخدام الإحصائيات والأخبار مفيد في إثبات وجود المشكلة، يجب أن لا تكون السبيل الوحيد لوصفها. بدلًا من ذلك، يجب تحويل الموضوع إلى قصّة يتم من خلالها توضيح المشكلة، ويمكن أن يكون أحد العملاء الحقيقين أو الافتراضيين بطل هذه القصة. إنّ إطلاع الناس على قصّة شخص معيّن (أو شركة معيّنة) واجه مشكلة معينة وبخصائص وصفات معينة أكثر تأثيرًا من مجرّد استخدام الإحصائيات. إليك بعض الأمثلة: Shockwave Innovations من العملاء الذين نتعامل معهم، وقد واجهت هذه الشركة مشكلة تتعلق بـ ________ (ابدأ بإلقاء القصة). التقينا بعدد كبير من الشركات في قطاع _______، وقد كان _________ (اذكر المشكلة) من الأمور التي كنا نسمع عنها مرارًا وتكرارًا، فعلى سبيل المثال في شركة Shockwave Innovations ________ (ابدأ بإلقاء القصة). أعرفّكم بـ Gordon Daugherty. Gordon هو مؤسس شركة Shockwave Innovations، وهو مستثمر ملاك واستشاري في شؤون الشركات الناشئة. عندما يستيقظ Gordon كل صباح ________ (ابدأ بسرد قصة بعنوان (يوم في حياة Gordon) توضّح فيها المشكلة التي يواجهها). لا تقم بوضع قائمة من المشاكل المتتابعة في قصتك، فمثلًا لا تخضع العبارة التالية للأسلوب القصصي: بدلًا من ذلك أعد صياغة الجملة لتصبح بالشكل التالي: لاحظ أنّ إعادة صياغة الجملة قد أسست للغاية المنشودة ووصفت الأمور بطريقة تجعل القارئ يتعاطف مع بطل القصّة، وإن قمت بذلك بشكل صحيح، فقد يشعر من يسمع القصة بالمعاناة التي تطرحها القصة، ألا تشعر بالأسف تجاه Gordon المسكين؟ ابدأ بالقصة ثم أتبعها ببعض الإحصائيات التي تدعم الموضوع الذي تطرحه، وهذا متّسق مع ما قدّمته من نصائح حول ترتيب العناوين في العرض التقديمي حسب ترتيب: "المشكلة" ثمّ "السوق". سيكون الانتقال من "المشكلة" إلى "السوق" جيدًا عند استخدام بعض المعلومات غير المؤكدة حول السوق والتي ترتبط بالمشكلة التي تقوم بوصفها، وبعد ذلك يمكنك الاستمرار في طرح المزيد من المعلومات حول حجم السوق وما شابه ذلك. ما يميّز الأسلوب القصصي أنّك تستطيع العودة إلى القصّة عندما تصل إلى قسم "الحلول": يمكنك الآن الحديث عن الصفات والخصائص المتعددة للحلول التي تقدّمه. باختصار، يتذكّر الناس القصص بشكل أسهل من الإحصائيات والأخبار غير المؤكدة، لذا حاول أن تجعل قصصك حقيقية وقابلة للتذكر وذلك عن طريق رسم صورة وصفية كتلك التي وضّحتها في المثال السابق. ساعد الجمهور على الشعور بالمعاناة التي تطرحها خلال القصة، ولكن لا تقم بذلك عن طريق تضخيم الأمور والمبالغة فيها، بل حاول جعل القصة قابلة للفهم والتصديق. يمكنك تجربة القصة التي قد ألّفتها بأن تلقيها على شخص ما ثم تطلب منه أن يقصّها عليك من جديد، وبعد مرور يومين اطلب منه تذكُّر القصة مرة أخرى لتنظر إن كان قادرًا على القيام بذلك أم لا. ترجمة -وبتصرّف- للمقال Use Storytelling to Describe the Problem You Solve لصاحبه Gordon Daugherty.1 نقطة
-
بغض النظر عن قضيته الجدالية فقد كان تشارلز داروين خائفًا، حيث وبحلول 1859 كان قد قضى 22 عامًا في السّفر حول العالم، حيث دأب خلال سفره هذا على تدوين ملاحظات والبحث في أصول المخلوقات، لينشر نظريّته حول التّطور، ويواجه أيديولوجيّات متأصّلة ومقبولة على نطاق واسع. من البديهيّ أن لا ينتظر شخص ما 22 عامًا من أجل إنهاء مشروعه، بغضّ النّظر عن الجدل الذي قد يخلقه. صحيح أنّ مجال نظريّة داروين قد يكون غالبًا أكبر بكثير من مشروعك الذي تعمل عليه حاليًا، إلّا أنّه يمكن لنا أن نقارن ما بين ما تمر به حاليًا وما بين الاضطرابات الدّاخليّة التي عانى منها داروين فيما يتعلّق بإنهاء مشروعه الكبير -وهذا هو بيت القصيد-. ويكون هذا القلق حاضرًا في مشاريعنا أيضًا، حيث يمنعنا القلق من العمل نفسه وإمكانية نشره من مواصلة العمل إلى النهاية. بالنسبة للكثيرين، فإن القلق حول إنهاء مشاريعنا وحول كيف سننشرها هو السبب الذي يقف وراء عدم إنهائنا لها. حيث يمنعنا القلق من العمل نفسه وإمكانية نشره من مواصلة العمل إلى النهاية. حتّى ولو قضيت الساعات الطّوال في الحديث حول مدى التّأثير الكبير الذي قد تُحدثه فكرة ما فإنّه ما لم تطلق منتجك فلا تتوقّع حدوث أي تأثير، حيث أنّ إنجاز الفكرة وإطلاقها هو ما يُسبّب هذا التّأثير. لذا فإن عمَلنا كروّاد أعمال يتمثّل في إنهاء ما بدأناه، صحيح أنّ مشاركة عملنا المكتمل قد يكون شاقًّا، إلّا أنّه أهمّ حافز من أجل التّغيير. دعونا نتعرّف على بعض العوائق التي تحول دون تحقيق وإخراج المشاريع التي نحلم بها إلى الوجود. هناك فرق ما بين الاستعداد والإعداد (التحضير) هنالك أسئلة مهمّة وضروريّة يجب طرحها في هذه الحالة: هل السّوق المستهدف جاهز لاستقبال مشروعك؟ هل أنت جاهز لإطلاق المُنتج؟ هل مشروعك في المستوى؟ هل الوقت مناسب؟ كتب Seth Godin –كاتب ورائد أعمال متقن لفنّ الوصول إلى المنتج النّهائي- عن الاختلاف بين الأمرين قائلًا: يمكن البدء بالعمل حالما يتقبّل الشّخص هذا الاختلاف ويعرف مكانته، فأحيانًا، تكون أفضل طريقة لاختبار فكرة ما هي عدم النّظر في العديد من المتغيّرات أو النّتائج في سبيل بلوغ الكمال، بل العمل على إخراجها إلى العالم والتّأقلم إلى جانبها، حيث ستراقب الفكرة مثل مراقبة الطّفل، تتعثّر، تتعلّم، تنمو، تفشل وتنجح. الحاجة للكمال إنجاز مشروع وتسليمه يتطلّب التّعلّم، وعندما يصبح التّعلّم عادة يوميّة، يصبح طريق النّجاح حينها معبّدًا. يعمل نخبة الكتّاب، العلماء، الفنّانون وروّاد الأعمال على ترجمة أفكارهم على أرض الواقع، تعلّم كل ما يمكن تعلّمه، تكرار ذلك، ثم إنجاز نفس العمليّة مجدّدًا. لا يتعلّق الأمر بإزالة الخوف أو الشّكوك من العمليّة، ولا بتقليص أيّ فرصة للفشل أو التّعثّر، حيث يجب توقّع حدوث مشاكل أثناء العمل على إنتاج شيء ممتاز، وأن تكون جاهزًا للتعامل معها برويّة، لأن ذلك سيساعدك على تعلّم ما يمكن تحسينه ويمنح المشروع فرصة لإحداث الفارق. قدّمنا مؤخّرًا خدمة Beacon على Help Scout، حيث كان واضحًا لمن كانت الخدمة موجّهة، ما نفعها، والتّغيير الذي كنّا نحاول إحداثه، صحيح أنّ الخدمة لم تكن كاملة عند إطلاقها، لكنّها كانت جاهزة، مع ذلك، ظهرت مشاكل في الأسبوع الأول واستطعنا حلّها، كما أنّ الأفكار وردود الفعل التي وردتنا ساعدتنا على توسيع مجالات إدراكنا. وبالتّالي فإن عمليّة إطلاق Beacon لم تكن بسيطة، حيث لم نطلق الخدمة ونحتفل بإطلاقها ثم انتقلنا للتركيز على شيء آخر، بل واصلنا متابعها عن كثب، وشهدنا تحسنّ طريقة تفاعل عملائنا، مع تعلّمنا لأشياء جديدة كل يوم. تخيلّ إن كنّا انتظرنا أن تصبح الفكرة كاملة، تخيّل إن لم نطلق الخدمة، هل كنّا لنتعلّم؟ آراء الآخرين من حولك؟ يكون الكشف عن فكرة أو منتج ما محفوفًا بالمخاطر ويفتح المجال للانتقادات. نشعر كبشر بالقلق إزاء آراء الآخرين حولنا كوننا اجتماعيين بالفطرة، لذا سيكون من الصّعب عدم الشعور بالإهانة أو الإحباط في حال فشل الفكرة، كما سيكون الأمر أسوأ بكثير في حال تم استثمار مال كثير وقضاء وقت طويل في العمل عليها دون تحقيق عائدات منها، لذلك فإنّه من البديهي أن يكون التّفكير في الفكرة أسهل بكثير من إنجاز الفكرة والخروج بمنتج نهائي. مع ذلك، يجب ألّا يُنِمّ أيّ مشروع عن شخصيتك أو هويّتك، بل التّغيير الذي تودّ إحداثه من خلال تلك الفكرة، وإذا لم يتمّ هذا التّغيير، عندها تكون الفكرة هي التي تحتاج إلى التّرقيع لا هويّتك. قدّم المخترع الألماني Johannes Gutenberg آلة طباعة في القرن الخامس عشر، حيث كان حوالي 96% من سكّان القارة الأوروبية أميّين، كان من الممكن أن تفشل فكرة الطبّاعة حينها ليعتقد الجميع أن Gutenberg مجرد أبله، لكن كما علّمنا التاريخ، فإن هذا المشروع الجريء غيّر النّاس، المجتمعات، والعالم برمّته. أعظم عقبة قد تواجهها لإنهاء ما بدأته هي أنت وشعورك بالقلق، الخوف والشكّ. يكون جزء من هذا التّردّد عائدًا إلى رغبتك في الحرص على كون كافّة الأمور في محلّها، لكنّ الأمر يتحوّل لاحقًا إلى وهم تختبئ فيه بحجة المراجعة والتّلميع. وكلّما طالت فترة تأجيلك، كلما استغرقت وقتًا أطول لتعلم شيء مهمّ يساعدك ومشروعك على المضيّ قدمًا. أحد الدّروس الأساسيّة التي يمكن تعلّمها من إحداث تغيير ما هي أنّك لن تستطيع أن تعلم ما إذا كانت الفكرة ستنجح أم لا إن لم تنفّذها. ترجمة -وبتصرّف- للمقال The Importance of Finishing What You Start لصاحبه Paul Jun.1 نقطة